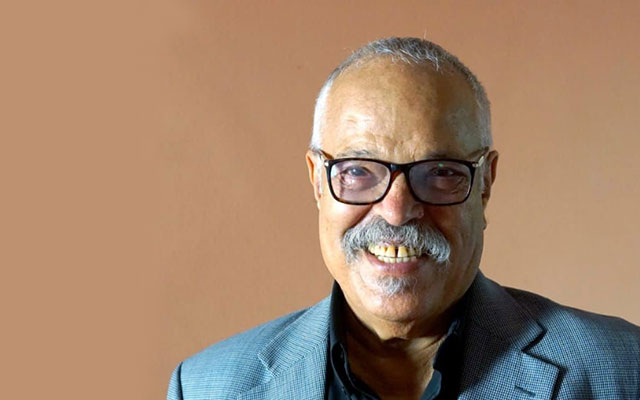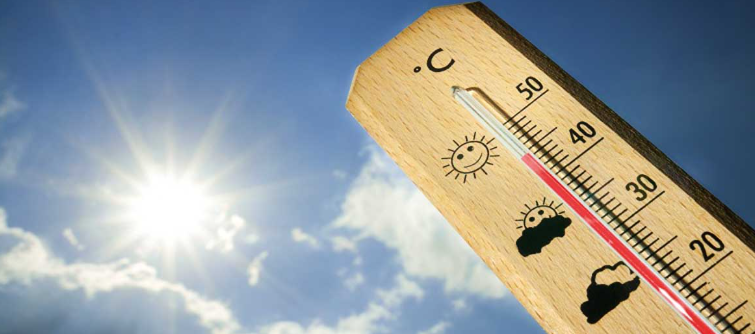على إثر صدمة الحداثة التي تولدت عن الاحتكاك بالغرب الأوروبي، دخلت البلاد مرحلة من "الاستيقاظ الفكري" بعد عصور من الركود الثقافي، فأخذت النخب تعي أنها تعيش تمزقا بين اختيارين: لا هي في مستوى حداثة أوروبا، ولا هي محافظة على تراثها. تولد عن ذلك جدال حاد، طرح قضايا جوهرية كمسألة الهوية، وقضية "الأصالة والمعاصرة". فانقسم مفكرو النهضة إلى دعاة إصلاح في إطار الخصوصية، ثم دعاة تحديث وانفتاح على الغرب: المحافظون من جهة، و"المتغربون" من جهة أخرى. المحافظون اعتبروا الدين ركيزة للهوية، لذا تشبثوا بالتراث، وعابوا على أوروبا فردانيتها، مقابل تمجيدهم للروح الجماعية التي تسود بلدهم. أما المتغربون فدعوا إلى إدخال المؤسسات الليبرالية على النمط الأوروبي، ولم يروا في التحديث ما من شأنه أن يخلخل الهوية، ولا أن يمس الأصالة.
كان لهذا الانفتاح التدريجي على أوروبا، بإرسال البعثات، وترجمة المؤلفات، ونقل المؤسسات والنظم الإدارية والإصلاحات العسكرية، أعمق الأثر على الحياة الفكرية. مما جعل النخب تطرح على نفسها عدة أسئلة: كيف يمكن تبني الحداثة من غير تفكيك الهوية؟ وكيف نوازن بين الجماعة والفرد؟ كيف نتبنى تحديث التعليم دون طمس اللغة؟ وكيف نقيم دولة حديثة، دون إحداث شرخ بين الدين والمجتمع؟ وكيف نواكب التطور التكنولوجي من غير خضوع للفكر الغربي؟
قد يظن القارئ أننا بصدد إجمال الأسئلة، ووصف التطورات التي عرفها العالم العربي منذ نهايات القرن التاسع عشر، وما واجهته نخبه غداة الاحتكاك بالاستعمار الأوروبي، إلا أن الأمر يتعلق هنا بالتطورات التي عرفتها روسيا خلال القرن نفسه
هذه التطورات هي موضوع الكتيب الذي نشره ألكسندر كوييري سنة 1929 تحت عنوان "الفلسفة والمسألة القومية في روسيا بداية القرن التاسع عشر"، وهو عبارة عن دروس كان الفيلسوف الروسي ألقاها في "معهد الدراسات السلافية" التابع لـ"جامعة باريس" خلال السنة الأكاديمية 1925-1924.
يبدأ الكتاب بالعقد الثاني من القرن التاسع عشر، ليقف عند أصول تيارين فكريين سيطبعان القرن كله، وعند الجدالات والصراعات التي كانت تدور بين دعاة النزعة السلافية، وبين الموالين للغرب الأوروبي.
ينطلق كوييري من عهد بطرس الأكبر الذي قاد أولى محاولات تحديث روسيا واعتماد مؤسسات غربية: الجيش، البيروقراطية، العلم. هذا التأسيس الحضاري يعتبر نقطة الانطلاق لقضية الهوية بعد ذلك. ثم يأتي تأثير الحروب النابوليونية التي هزت أوروبا، وألقت بظلالها على النخبة الروسية، وزادت إحساسها بالأزمة الثقافية والسياسية.
ولد الاحتكاك بأوروبا، خصوصا عبر هذه الحروب النابوليونية، مشكلا مزدوجا: فقد طرح من جهة الروابط التي تربط روسيا بأوروبا، والعلاقات بين "الكيان الوطني الروسي بالحضارة الأوروبية"، ومن جهة أخرى العلاقات بين النخبة والعامة، بين الأنتلجنسيا وجمهرة الشعب. فانقسمت النخب فئتين:
المتغربون (Occidentalistes): وهم مجموعة من المفكرين الروس الذين رأوا أن طريق التقدم والتحديث، يتطلب استيراد المؤسسات والنظم الأوروبية، وتبني العلمانية أو ما شابهها، وتبني مناهج التعليم والأنماط التنظيمية الغربية.
السلافوفيليون (Slavophiles): وهم مفكرون محافظون، يرون أن روسيا لها خصوصية ثابتة مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية، بالقرى والقيم الجماعية و"الروح الخاصة" (Sobornost) أي الترابط الروحي والمجتمعي، وأن مجرى التاريخ الروسي لا يجب أن يقلد الغرب، بل يعيد تأكيد أصالته الروحية والثقافية.
كان الموالون للسلاف ينحدرون من أسر النبلاء، وكانوا متشبعين بتربية دينية عميقة، منفتحين على الفلسفة الرومانسية الألمانية، يعتبرون أن مستقبل روسيا، لا يمكن أن يستمد إلا من ماضيها. أما الموالون للغرب فكانوا أصغر سنا، وكانوا منفتحين على الفكر السياسي الفرنسي، وعلى فلسفة هيغلية غير مأخوذة من مصادرها. فكانوا يرون خلاص روسيا في الاعتناق التام للحضارة الغربية.
هذا التوتر بين التحديث (تحديث المؤسسات، التقنية، العقلانية) والتقليد والروح الدينية والعادات سرعان ما أخذ يتأجج، وأصبح كل جانب يرى أن الآخر يهدد الهوية الأساسية. وقد عملت التغيرات السياسية والاجتماعية (الإصلاحات القيصرية، الرق، التعليم، انتشار مثقفين على اتصال بخارج روسيا) على استفحال المعضلة، فطرحت الأسئلة الجوهرية: كيف ندخل الحداثة دون فقدان الأصالة؟ وكيف نحافظ على وحدة المجتمع الروسي المتنوع؟ بمعنى كيف نصون القومية التي فهمت في البداية كقومية ثقافية/روحية، قبل أن تأخذ معناها السياسي.
غير أن التأثر بالفلسفة الأوروبية مثل الهيغلية، والرومانسية الألمانية، وكذلك شيوع أفكار مستمدة من مفكرين ينتمون إلى مدارس اجتماعية مثل سان سيمون (Saint-Simon) وفورييه (Fourier) في الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشر، وبداية استيعاب النخب الروسية لهذه المدارس، سرعان ما دفع هذه النخب إلى أن تمزج بين الفكر الغربي والوعي القومي الروسي.
وقد يسّر الطريق لكل ذلك، الإجماع الذي كان سائدا داخل النخب الروسية، سواء من السلافوفيليين أو المتغربين، على مصطلح "تفرد الروح الروسية"، أي الإيمان بأن هناك جوهرا روسيا مميزا، وروحا لا تختفي أمام التأثير الخارجي. هذه الفكرة ستظل تستخدم لتبرير التمايز الثقافي رغم الرغبة في التحديث، والإيمان بـ"الرسالة الروسية"، أي بفكرة أن روسيا لها مهمة أممية أو مؤسسية في التاريخ العالمي، ليس فقط أن تكون قوة سياسية أو عسكرية، بل أن تقدم نموذجا روحيا وحضاريا متميزا.
يحاول كوييري أن يجد السمة المشتركة التي طبعت هذا المخاض الثقافي، وما يجمع بين التيارين السلافي والمتغرب، رغم اختلافهما الظاهري، وهو ينتهي إلى القول إن كلا منهما كان يشعر بأنه "غريب في موطنه وغريب في أوروبا".
ذلك أن الغرب الذي يتشبث به "المتغربون" في نظره، يعادل في بعده عن الواقع روسيا القديمة التي يتوهمها الموالون للنزعة السلافية. فالطرفان كلاهما، "السلفي" و"الحداثي"، غارقان في نزعة تغريبية عميقة غير واعية بذاتها.
المحافظ الذي يرفع راية "الروح الروسية" يستعير مفاهيمه من الفلسفة الألمانية تماما كما يفعل المتغرب. بل إننا، في نظر المؤلف، لو نظرنا عن قرب، لوجدنا أن أكثرهما قربا من "الغرب" هم المحافظون: "ذلك أن جهازهم المفاهيمي، والطريقة التي يسعون بها إلى صياغة الهوية القومية، والنقد الذي يوجهونه للحضارة الغربية، آخذين عليها كونها ليست إلا عقلانية ضيقة، ونزعة ذرية وآلية عقيمة، وهو انتقاد لا يخلو من صواب وعمق، إن كل ذلك لدليل على مدى تأثر هؤلاء بالفكر الغربي". فكأن نقد الغرب هنا يتم بسلاحه، وكأنه ثمرة من ثماره.
صحيح أنه غرب "يعادل في بعده عن الواقع روسيا القديمة التي يتوهمها المحافظون"، وأنه غرب "ابتدعه الشرق"، إلا أنه ظل يعمل عمل "الآخر" الذي تتحدد به الذات. لقد واجه الطرفان معا السؤال ذاته: هل يمكن لخطاب الهوية أن ينهض من دون استعارة لغات الآخر الذي نحاول أن نتمايز عنه؟ أم إن كل تعريف للذات لا بد وأن يمر عبر مرآة الآخر؟
عن: مجلة " المجلة"


 (1).png)