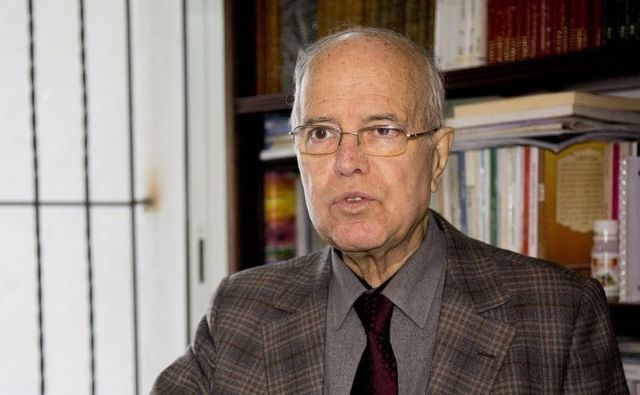المذهب المالكي في المغرب لم يكن مجرد منظومة فقهية جامدة، ولا خياراً سياسياً عابراً؛ بل هو مشروع حضاري متكامل ارتبط بتكوين الهوية المغربية وصياغة وعيها الديني والفكري عبر ما يزيد عن 1000 سنة. فمن المدينة النبوية بالمملكة العربية السعودية حيث أسّسه الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ )، إلى القيروان حيث نقله كبار تلاميذه كالإمام سحنون (ت 240 هـ )، ثم إلى مدينة فاس بالمملكة المغربية، وقد كان لحكام دولة المرابطين الأدوار الطلائعية في إشعاع هذا المذهب درسًا ورواية وتدوينًا، حتى صار مرجعية يعتمد عليها في جميع شؤون الحكم والقضاء؛ مع العلم أن المذهب المالكي في المغرب لم يكن مجرد فقه للأفراد؛ بل فلسفة عملية للوجود الجماعي .
لقد كان الإمام مالك رحمه الله صاحب عقلية مقاصدية، يدرك أن النصوص الشرعية لا تُفهم إلا في سياقها العملي، ولذلك اعتمد عمل أهل المدينة باعتباره شاهداً على التجربة النبوية في بعدها التطبيقي، كما اعتبر المصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف أصولاً معتبرة في الاجتهاد، هذه الاختيارات لم تكن مجرد تقنيات فقهية؛ بل رؤية فلسفية ترى أن الشريعة غايتها العدل وصيانة مصالح العباد، وأن النصوص ليست أوامر منفصلة بل إشارات هادية نحو مقاصد كبرى. وحين وصل المذهب المالكي إلى المغرب ، وجد مجتمعاً متعدد القبائل، متنوع الأعراف، مفتوحاً على صراعات سياسية وثقافية، فكان في حاجة إلى مدرسة فقهية قادرة على تحقيق التوازن بين التنوع الاجتماعي والوحدة الدينية، وقد تحقق هذا التوازن على يد المرابطين الذين جعلوا المالكية المذهب الرسمي للدولة في القرن الخامس الهجري، ليتحول مع الزمن إلى "الثابت الديني" الذي يحمي وحدة المغاربة من التشرذم والانقسام، غير أن المدرسة المالكية في المغرب لم تقف عند حدود النقل، بل تطورت لتصبح مدرسة اجتهادية كبرى . فقد برز علماء أمثال القرافي الذي فتح الباب أمام قراءة عقلانية دقيقة للفقه، وابن رشد الجد والحفيد اللذين وسّعا أفق المذهب عبر الفلسفة والمنطق، وبلغت التجربة أوجها مع الشاطبي الذي صاغ علم المقاصد في كتابه "الموافقات" ، مؤكداً أن الشريعة وُضعت لحفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، النسل، والمال. وبهذا أرسى الشاطبي الأساس النظري لما كان يعيشه المذهب المالكي عملياً منذ قرون، ولم يقف الأمر عند التبني السياسي، بل تطور المذهب في المغرب والأندلس ليصبح مدرسة فكرية كبرى، فقد برز أعلام أغنوا المذهب وأعطوه بعداً فلسفياً أعمق . فالإمام شهاب الدين القرافي (ت 684 هـ ) قدّم إسهامات عظيمة في تطوير أصول الفقه المالكي، وأبرز أهمية المقاصد في فهم النصوص، حتى عُدّ من أوائل من مهّدوا الطريق أمام الشاطبي. وفي كتبه مثل "الفروق" و "تنقيح الفصول" نجد روحاً عقلانية دقيقة، تجعل من الفقه علماً منفتحاً على المنطق والفلسفة، دون أن ينفصل عن مقاصده الشرعية، أما أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ ) فقد بلور هذه الروح في مشروع متكامل في كتابه "الموافقات".. لقد جعل المقاصد أصلاً مستقلاً، وأكد أن الشريعة في جوهرها إنما وُضعت لتحقيق مصالح العباد، وحفظ كلياتهم الضرورية، هذا التصور المقاصدي كان قفزة فلسفية كبرى، لأنه نقل الفقه من النظر الجزئي إلى الرؤية الكلية، ومن التعامل مع النصوص كأوامر متفرقة إلى اعتبارها منظومة متكاملة لها غايات عليا، وقد تأثر المغرب بهذا الطرح حتى صار المقاصد جزءاً من بنية الفكر الديني المغربي .
ولا يمكن أن نغفل كذلك إسهام ابن رشد الجد (ت 520 هـ ) والفيلسوف ابن رشد الحفيد (ت 595 هـ )، اللذين أعطيا المالكية بعداً عقلياً صارخاً، فابن رشد الجد في كتابه "البيان والتحصيل" جسّد موسوعية فقهية هائلة، أما الحفيد فقد ذهب أبعد حين حاول التوفيق بين العقل الفلسفي والشريعة، في مشروع عقلاني نقدي ترك بصمته على الفكر الأوروبي لاحقاً. حضور ابن رشد في البيئة المالكية يبين أن المذهب لم يكن مغلقاً؛ بل كان مجالاً للتفاعل مع العقل الفلسفي والبرهان المنطقي.
إلى جانب هؤلاء، برز علماء آخرون كالونشريسي في "المعيار المعرب" ، وهو موسوعة فقهية ضخمة جمعت فتاوى المالكية عبر الأندلس والمغرب، لتُظهر كيف تفاعل الفقه المالكي مع قضايا المجتمع اليومية، من التجارة إلى السياسة، ومن القضاء إلى العادات والأعراف، هذه النصوص تكشف أن المالكية لم تكن نظرية في الكتب، بل ممارسة حية تنظم تفاصيل الحياة. لقد شكّل هذا التراث المتراكم أساساً لما يمكن تسميته بـ"المالكية المغربية"، وهي في الحقيقة ليست مجرد فرع من المذهب المالكي؛ بل صيغة خاصة به، تتسم بالمقاصدية، العقلانية العملية، والانفتاح على العرف والواقع، وقد صار هذا المذهب مع العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي ثلاثية "الثوابت الدينية" للمغرب، وهي الثوابت التي حفظت للمغاربة وحدتهم الدينية والسياسية، وجعلتهم محصنين في وجه تيارات التطرف والغلو والانقسام المذهبي ، أما من الناحية الفلسفية، يمكن القول إن المذهب المالكي كما تبلور في المغرب يمثل نموذجاً فريداً للجمع بين النص والعقل والمقصد، فهو يرفض الحرفية الضيقة التي تغلق النصوص على ظاهرها، ويرفض العقلانية المنفلتة التي تفصل العقل عن الوحي، ويؤكد أن النصوص لا تُفهم إلا في ضوء مقاصدها الكبرى، هذه الرؤية جعلت المدرسة المالكية المغربية تجربة حضارية قائمة على التوازن بين الثبات والتجديد: ثبات المرجعية من جهة، وتجديد في تنزيلها على الواقع من جهة أخرى.
ومع تطور الحياة الاجتماعية في المغرب، كان لابد أن تتجلى مرونة المالكية في اجتهادات عملية، ومن أبرز هذه الاجتهادات ما قدّمه الفقيه أبو عبد الله محمد بن عرضون الشمالي التطواني (ت 999هـ/ 1590م)، الذي أبدع في قضية حق الكد والسعاية. فقد قرر أن المرأة التي تعمل وتشارك زوجها في الإنتاج الزراعي أو التجاري تستحق نصيباً من الثروة المشتركة، يُضاف إلى حصتها الشرعية في الإرث، بهذا الرأي أعطى ابن عرضون للمرأة مكانة فاعلة باعتبارها شريكاً اقتصادياً، معترفاً بجهدها في بناء الثروة الأسرية، هذا الاجتهاد كان ثورياً بمقاييس عصره؛ لكنه انسجم تماماً مع أصول المذهب المالكي، فقد استند إلى العرف المغربي الذي يشهد بمشاركة النساء في الكدح اليومي، وإلى قاعدة المصلحة المرسلة التي تجعل العدل مقصداً شرعياً، وإلى روح المقاصد التي تحمي الحقوق وتصون الكرامة، وهكذا نرى أن المالكية في المغرب لم تكن مجرد تقليد لآراء القدماء؛ بل كانت اجتهاداً حياً يتفاعل مع الواقع ويطوّع نصوصه لتحقيق غايات الشرع، ولم يبقَ اجتهاد ابن عرضون في حدود التنظير؛ بل امتد أثره إلى الواقع العملي، فقد تبنّت بعض المحاكم العرفية في شمال المغرب وجنوبه هذه القاعدة، خاصة في المجتمعات القروية حيث كانت المرأة تشارك الرجل بجهد فعلي في الفلاحة وتربية المواشي وإدارة البيت . وكانت هذه المحاكم تقضي للمرأة بنصيب من الثروة التي ساهمت في بنائها، وهو ما أصبح يُعرف في الوثائق القضائية بـ "الكدّ والسعاية".
ومع مرور الزمن، صار هذا المبدأ جزءاً من الوعي القانوني المغربي، واستندت إليه بعض الأحكام القضائية الحديثة في قضايا النزاع الأسري، باعتباره تجسيداً عملياً للعدل وروح الشريعة. إن إدخال مفهوم "الكد والسعاية" في الفقه المغربي يُظهر بجلاء أن المالكية لم تكن نظرية ميتة، بل كانت قادرة على إنتاج عدالة اجتماعية متجددة، ولعل هذا المثال يكفي لإثبات أن المذهب المالكي في المغرب كان فضاءً للفكر الحي، حيث تلتقي النصوص بالمقاصد، والفقه بالواقع، والشرع بالعدل، من هنا نفهم أن المذهب المالكي في المغرب ليس مجرد تراث فقهي، بل هو خيار فلسفي حضاري، فهو يرفض الحرفية الجامدة التي تحصر الدين في قوالب مغلقة، ويرفض العقلانية المنفلتة التي تفصل العقل عن الوحي، ويقدم صيغة ثالثة: نصوص تُقرأ في ضوء مقاصدها، وعقل يُستعمل لترشيدها، وواقع يُؤخذ في الاعتبار عند تنزيلها. هذه الصيغة جعلت المغاربة قادرين على الحفاظ على هويتهم الدينية دون انغلاق، وعلى الانفتاح على الحضارات دون ذوبان، وعلى الجمع بين الثبات والتجديد .
ختامًا، إن العلاقة بين الشعب المغربي والمذهب المالكي لم تكن يومًا علاقة اتباع شكلي أو تقليد جامد، بل كانت حوارًا حيًّا بين النص والعقل، وبين المقاصد والواقع، فالشعب المغربي وجد في المالكية مدرسة تحفظ وحدته، وتصون هويته، وتمنحه القدرة على التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وهكذا تمازجت المدرسة المالكية بروح المغاربة، فصارت جزءًا من كيانهم الثقافي والديني، وضمانةً لوحدتهم واستقرارهم، وعنوانًا لهويتهم الدينية الراسخة في وجه كل عواصف التكفير والتطرف والمذهبيات البغيضة..فاستمرارها في المغرب عبر اثني عشر قرناً ليس مجرد صدفة تاريخية؛ بل تعبير عن عمق التوافق بينها وبين الروح المغربية الطيبة .
لقد كان الإمام مالك رحمه الله صاحب عقلية مقاصدية، يدرك أن النصوص الشرعية لا تُفهم إلا في سياقها العملي، ولذلك اعتمد عمل أهل المدينة باعتباره شاهداً على التجربة النبوية في بعدها التطبيقي، كما اعتبر المصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف أصولاً معتبرة في الاجتهاد، هذه الاختيارات لم تكن مجرد تقنيات فقهية؛ بل رؤية فلسفية ترى أن الشريعة غايتها العدل وصيانة مصالح العباد، وأن النصوص ليست أوامر منفصلة بل إشارات هادية نحو مقاصد كبرى. وحين وصل المذهب المالكي إلى المغرب ، وجد مجتمعاً متعدد القبائل، متنوع الأعراف، مفتوحاً على صراعات سياسية وثقافية، فكان في حاجة إلى مدرسة فقهية قادرة على تحقيق التوازن بين التنوع الاجتماعي والوحدة الدينية، وقد تحقق هذا التوازن على يد المرابطين الذين جعلوا المالكية المذهب الرسمي للدولة في القرن الخامس الهجري، ليتحول مع الزمن إلى "الثابت الديني" الذي يحمي وحدة المغاربة من التشرذم والانقسام، غير أن المدرسة المالكية في المغرب لم تقف عند حدود النقل، بل تطورت لتصبح مدرسة اجتهادية كبرى . فقد برز علماء أمثال القرافي الذي فتح الباب أمام قراءة عقلانية دقيقة للفقه، وابن رشد الجد والحفيد اللذين وسّعا أفق المذهب عبر الفلسفة والمنطق، وبلغت التجربة أوجها مع الشاطبي الذي صاغ علم المقاصد في كتابه "الموافقات" ، مؤكداً أن الشريعة وُضعت لحفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، النسل، والمال. وبهذا أرسى الشاطبي الأساس النظري لما كان يعيشه المذهب المالكي عملياً منذ قرون، ولم يقف الأمر عند التبني السياسي، بل تطور المذهب في المغرب والأندلس ليصبح مدرسة فكرية كبرى، فقد برز أعلام أغنوا المذهب وأعطوه بعداً فلسفياً أعمق . فالإمام شهاب الدين القرافي (ت 684 هـ ) قدّم إسهامات عظيمة في تطوير أصول الفقه المالكي، وأبرز أهمية المقاصد في فهم النصوص، حتى عُدّ من أوائل من مهّدوا الطريق أمام الشاطبي. وفي كتبه مثل "الفروق" و "تنقيح الفصول" نجد روحاً عقلانية دقيقة، تجعل من الفقه علماً منفتحاً على المنطق والفلسفة، دون أن ينفصل عن مقاصده الشرعية، أما أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ ) فقد بلور هذه الروح في مشروع متكامل في كتابه "الموافقات".. لقد جعل المقاصد أصلاً مستقلاً، وأكد أن الشريعة في جوهرها إنما وُضعت لتحقيق مصالح العباد، وحفظ كلياتهم الضرورية، هذا التصور المقاصدي كان قفزة فلسفية كبرى، لأنه نقل الفقه من النظر الجزئي إلى الرؤية الكلية، ومن التعامل مع النصوص كأوامر متفرقة إلى اعتبارها منظومة متكاملة لها غايات عليا، وقد تأثر المغرب بهذا الطرح حتى صار المقاصد جزءاً من بنية الفكر الديني المغربي .
ولا يمكن أن نغفل كذلك إسهام ابن رشد الجد (ت 520 هـ ) والفيلسوف ابن رشد الحفيد (ت 595 هـ )، اللذين أعطيا المالكية بعداً عقلياً صارخاً، فابن رشد الجد في كتابه "البيان والتحصيل" جسّد موسوعية فقهية هائلة، أما الحفيد فقد ذهب أبعد حين حاول التوفيق بين العقل الفلسفي والشريعة، في مشروع عقلاني نقدي ترك بصمته على الفكر الأوروبي لاحقاً. حضور ابن رشد في البيئة المالكية يبين أن المذهب لم يكن مغلقاً؛ بل كان مجالاً للتفاعل مع العقل الفلسفي والبرهان المنطقي.
إلى جانب هؤلاء، برز علماء آخرون كالونشريسي في "المعيار المعرب" ، وهو موسوعة فقهية ضخمة جمعت فتاوى المالكية عبر الأندلس والمغرب، لتُظهر كيف تفاعل الفقه المالكي مع قضايا المجتمع اليومية، من التجارة إلى السياسة، ومن القضاء إلى العادات والأعراف، هذه النصوص تكشف أن المالكية لم تكن نظرية في الكتب، بل ممارسة حية تنظم تفاصيل الحياة. لقد شكّل هذا التراث المتراكم أساساً لما يمكن تسميته بـ"المالكية المغربية"، وهي في الحقيقة ليست مجرد فرع من المذهب المالكي؛ بل صيغة خاصة به، تتسم بالمقاصدية، العقلانية العملية، والانفتاح على العرف والواقع، وقد صار هذا المذهب مع العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي ثلاثية "الثوابت الدينية" للمغرب، وهي الثوابت التي حفظت للمغاربة وحدتهم الدينية والسياسية، وجعلتهم محصنين في وجه تيارات التطرف والغلو والانقسام المذهبي ، أما من الناحية الفلسفية، يمكن القول إن المذهب المالكي كما تبلور في المغرب يمثل نموذجاً فريداً للجمع بين النص والعقل والمقصد، فهو يرفض الحرفية الضيقة التي تغلق النصوص على ظاهرها، ويرفض العقلانية المنفلتة التي تفصل العقل عن الوحي، ويؤكد أن النصوص لا تُفهم إلا في ضوء مقاصدها الكبرى، هذه الرؤية جعلت المدرسة المالكية المغربية تجربة حضارية قائمة على التوازن بين الثبات والتجديد: ثبات المرجعية من جهة، وتجديد في تنزيلها على الواقع من جهة أخرى.
ومع تطور الحياة الاجتماعية في المغرب، كان لابد أن تتجلى مرونة المالكية في اجتهادات عملية، ومن أبرز هذه الاجتهادات ما قدّمه الفقيه أبو عبد الله محمد بن عرضون الشمالي التطواني (ت 999هـ/ 1590م)، الذي أبدع في قضية حق الكد والسعاية. فقد قرر أن المرأة التي تعمل وتشارك زوجها في الإنتاج الزراعي أو التجاري تستحق نصيباً من الثروة المشتركة، يُضاف إلى حصتها الشرعية في الإرث، بهذا الرأي أعطى ابن عرضون للمرأة مكانة فاعلة باعتبارها شريكاً اقتصادياً، معترفاً بجهدها في بناء الثروة الأسرية، هذا الاجتهاد كان ثورياً بمقاييس عصره؛ لكنه انسجم تماماً مع أصول المذهب المالكي، فقد استند إلى العرف المغربي الذي يشهد بمشاركة النساء في الكدح اليومي، وإلى قاعدة المصلحة المرسلة التي تجعل العدل مقصداً شرعياً، وإلى روح المقاصد التي تحمي الحقوق وتصون الكرامة، وهكذا نرى أن المالكية في المغرب لم تكن مجرد تقليد لآراء القدماء؛ بل كانت اجتهاداً حياً يتفاعل مع الواقع ويطوّع نصوصه لتحقيق غايات الشرع، ولم يبقَ اجتهاد ابن عرضون في حدود التنظير؛ بل امتد أثره إلى الواقع العملي، فقد تبنّت بعض المحاكم العرفية في شمال المغرب وجنوبه هذه القاعدة، خاصة في المجتمعات القروية حيث كانت المرأة تشارك الرجل بجهد فعلي في الفلاحة وتربية المواشي وإدارة البيت . وكانت هذه المحاكم تقضي للمرأة بنصيب من الثروة التي ساهمت في بنائها، وهو ما أصبح يُعرف في الوثائق القضائية بـ "الكدّ والسعاية".
ومع مرور الزمن، صار هذا المبدأ جزءاً من الوعي القانوني المغربي، واستندت إليه بعض الأحكام القضائية الحديثة في قضايا النزاع الأسري، باعتباره تجسيداً عملياً للعدل وروح الشريعة. إن إدخال مفهوم "الكد والسعاية" في الفقه المغربي يُظهر بجلاء أن المالكية لم تكن نظرية ميتة، بل كانت قادرة على إنتاج عدالة اجتماعية متجددة، ولعل هذا المثال يكفي لإثبات أن المذهب المالكي في المغرب كان فضاءً للفكر الحي، حيث تلتقي النصوص بالمقاصد، والفقه بالواقع، والشرع بالعدل، من هنا نفهم أن المذهب المالكي في المغرب ليس مجرد تراث فقهي، بل هو خيار فلسفي حضاري، فهو يرفض الحرفية الجامدة التي تحصر الدين في قوالب مغلقة، ويرفض العقلانية المنفلتة التي تفصل العقل عن الوحي، ويقدم صيغة ثالثة: نصوص تُقرأ في ضوء مقاصدها، وعقل يُستعمل لترشيدها، وواقع يُؤخذ في الاعتبار عند تنزيلها. هذه الصيغة جعلت المغاربة قادرين على الحفاظ على هويتهم الدينية دون انغلاق، وعلى الانفتاح على الحضارات دون ذوبان، وعلى الجمع بين الثبات والتجديد .
ختامًا، إن العلاقة بين الشعب المغربي والمذهب المالكي لم تكن يومًا علاقة اتباع شكلي أو تقليد جامد، بل كانت حوارًا حيًّا بين النص والعقل، وبين المقاصد والواقع، فالشعب المغربي وجد في المالكية مدرسة تحفظ وحدته، وتصون هويته، وتمنحه القدرة على التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وهكذا تمازجت المدرسة المالكية بروح المغاربة، فصارت جزءًا من كيانهم الثقافي والديني، وضمانةً لوحدتهم واستقرارهم، وعنوانًا لهويتهم الدينية الراسخة في وجه كل عواصف التكفير والتطرف والمذهبيات البغيضة..فاستمرارها في المغرب عبر اثني عشر قرناً ليس مجرد صدفة تاريخية؛ بل تعبير عن عمق التوافق بينها وبين الروح المغربية الطيبة .
الصادق العثماني - أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية