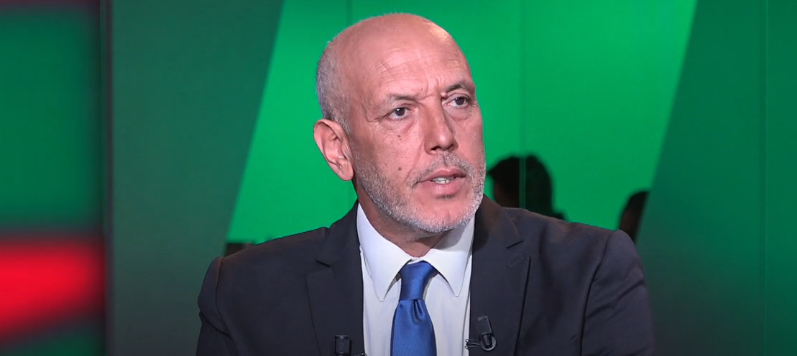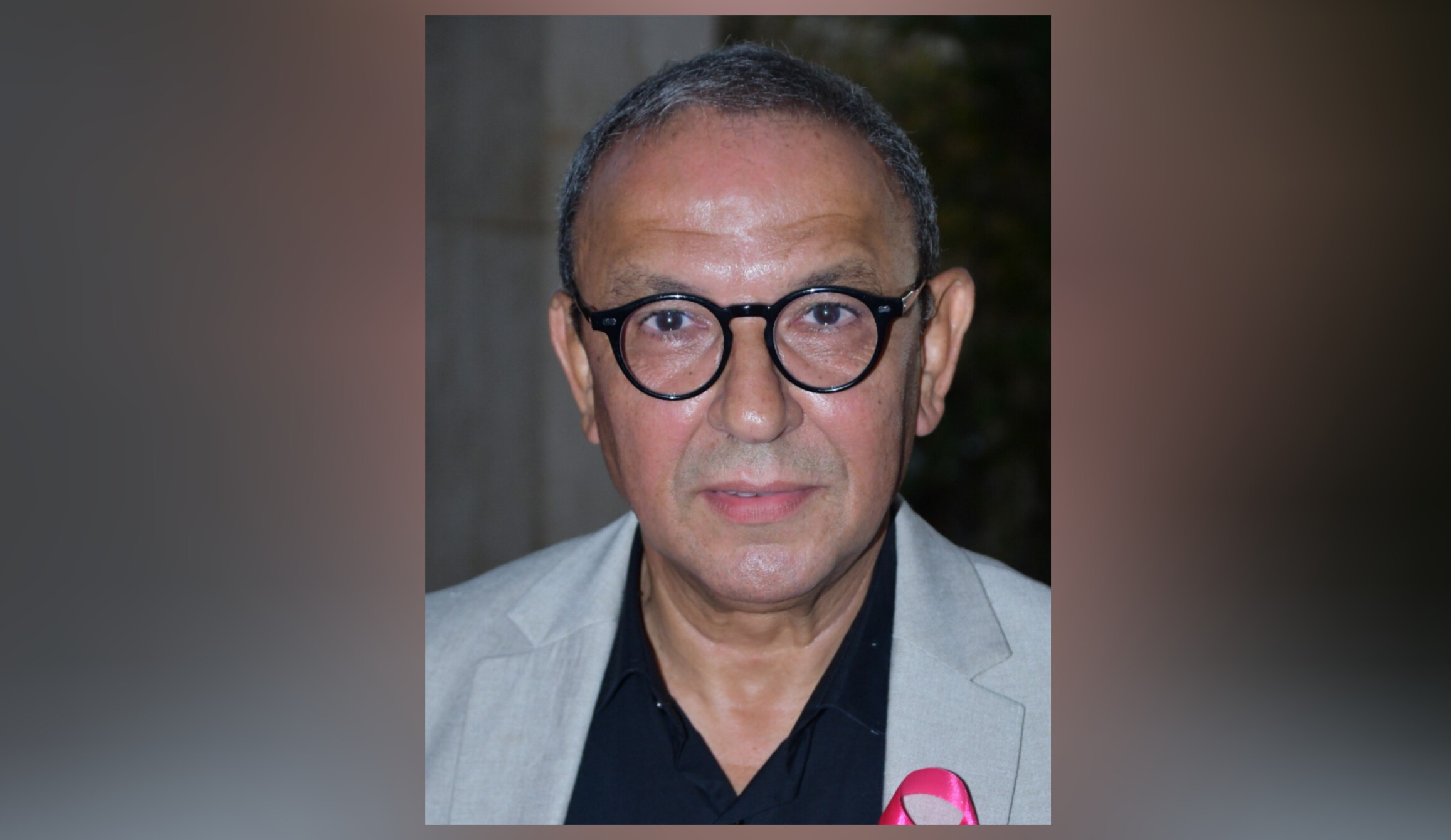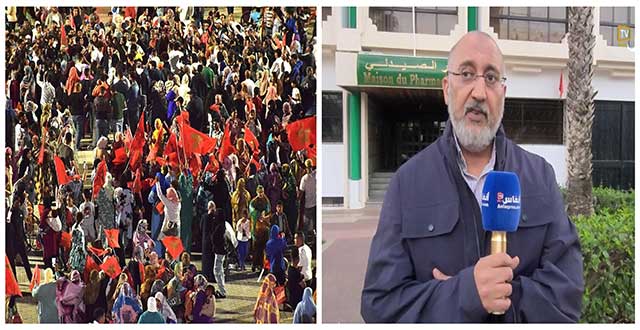في عصر الرقمنة المتسارعة، لم تعد العلاقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمواطن قائمة على المواجهة التقليدية بين سلطة ضابطة وأفراد خاضعين، بل صارت محكومة بخيوط غير مرئية تنسجها الكاميرا الصغيرة في جيب كل فرد. فالهواتف الذكية، بما تمنحه من قدرة على التوثيق الفوري وسرعة الانتشار، تحولت إلى عين ثالثة تراقب وتُسائل وتُشهّر في آن واحد، إلى الحد الذي جعل مشاهد تصوير المنتسبين إلى أجهزة إنفاذ القانون تتكرر بشكل شبه يومي في الفضاء الرقمي، مما يضع المؤسسات الأمنية والمواطنين على حد سواء أمام تحديات جديدة في فهم السلطة والمساءلة، وضبط العلاقة بين القانون والمجتمع، والتفاعل مع سلطة الإعلام الرقمي وثقافة الفرجة التي تتحكم في الرأي العام.
غير أن هذه العين الرقمية، التي يُفترض أن تعزز قيم الشفافية والعدالة، كثيرًا ما تتحول إلى أداة تصيّد، تُقتنص بها اللحظة العابرة وتُنتزع من سياقها، لتغذي خيالًا جمعيًا مشحونًا بالاتهام والريبة. ومن هنا يبرز سؤال جوهري: لماذا يفتعل بعض الأفراد سيناريوهات محبوكة للإيقاع بمنتسبي أجهزة إنفاذ القانون وتصويرهم في وضعيات ملتبسة أو محرجة أو مثيرة للجدل؟ - لا يسعني هنا إلا التذكير بأن ترويج أو تحريض الغير على ارتكاب جريمة يُعد بحد ذاته فعلاً مجرماً ويخضع للمسؤولية الجنائية وفق القوانين السارية، مما يضفي على هذه الممارسات بعدًا قانونيًا واضحًا يستحق التوقف عنده-.
ومن هذا المنطلق، تكشف الإجابات المحتملة عن تعدد الدوافع النفسية والاجتماعية والسياسية التي تحرك هؤلاء الأفراد. فهل يكون الهدف استدعاء رمزية "الضعيف في مواجهة السلطة" قصد كسب التعاطف الشعبي؟ أم تحقيق مكاسب سياسية أو نفعية عبر تسويق صورة الضحية وتوجيه الرأي العام ضد المؤسسة الأمنية؟ أم بدافع الانتقام الشخصي أو الرمزي، بما يحمله من محاولة لتقويض الهيبة وزعزعة الشرعية؟ أم مجرد السعي وراء الشهرة الرقمية وتحقيق الانتشار في زمن تتحول فيه المشاهد المثيرة إلى "رأسمال رمزي" قابل للتحويل السريع إلى مكاسب مادية بفعل منطق الخوارزميات وثقافة الفرجة؟ إن تداخل هذه الدوافع وتعدد مستوياتها يكشف أن الأمر لا يتعلق دومًا بفعل توثيقي بريء، بل قد ينطوي أحيانًا على ممارسة مقصودة ومؤدلجة تسعى لصناعة حدث افتراضي يستمد قوته من جاذبيته الرقمية أكثر مما يستمده من صدقيته الواقعية.
إن تداخل هذه الدوافع وتعدد مستوياتها يكشف أن الأمر لا يتعلق دومًا بفعل توثيقي بريء، بل قد ينطوي أحيانًا على ممارسة مقصودة ومؤدلجة، تسعى إلى صناعة حدث افتراضي يستمد قوته من جاذبيته الرقمية أكثر مما يستمده من صدقيته الواقعية. ومن ثَم، فإن هذه الظاهرة لا تمثل مجرد سلوك فردي عابر، بل تعكس تحولات بنيوية أعمق في علاقة المجتمع بمؤسساته، وتكشف عن تصدعات متنامية في نسيج الثقة والشرعية وأطر التواصل الاجتماعي.
على هذا الأساس، يصبح من الضروري تأطير هذه الممارسات ضمن سياق سوسيو-تاريخي مركب، تتقاطع فيه العوامل البنيوية والثقافية والتقنية. فقد عرف المجال العمومي تحوّلًا نوعيًا انتقل فيه التفاعل الاجتماعي من فضاءاته التقليدية إلى المنصات الرقمية، حيث برز نمط جديد من "المواطنة الرقابية الرقمية" يتيح للأفراد مساءلة السلطة، وفضح التجاوزات، والمشاركة الفاعلة في بناء المعنى الجماعي للأحداث.
وفي خضم هذا التحول، ساهم تراجع مستويات الثقة الاجتماعية، سواء بين الأفراد أو داخل الشبكات، في إضفاء شرعية على الكاميرا كوسيط لإنتاج "الدليل الشعبي". وبذلك صار للتوثيق الفردي أحيانًا مصداقية تفوق الوسائل المؤسسية، مما جعل التسجيل والمشاركة ممارسة متواترة تكاد تبلغ الطابع اليومي. هذا التواتر أسس لآلية رصد مستمر تُعيد تشكيل أنماط المراقبة وآليات الضبط في الحياة الاجتماعية الراهنة.
وما يعزز هذا المنحى أكثر هو صعود ثقافة التشهير، التي يغذيها منطق الخوارزميات ورغبة الجماهير في الفرجة، فتحول اللحظات العابرة إلى مادة مشحونة بالاتهام والريبة، بدل أن تكون وسيلة لتوضيح الحقائق أو تقويم الممارسات. إن هذا التواتر المتصاعد في تسجيل الأحداث لا يقتصر أثره على إعادة إنتاج الوقائع، بل يمتد ليترك آثارًا نفسية ومهنية على الفاعلين، فيولد حالة دائمة من الحذر المفرط، والقلق من المراقبة المستمرة، والانفعال المتكرر، بما يثقل الممارسة ويضعف القدرة على الأداء الطبيعي للواجب.
ومن هنا يمكن القول إن الظاهرة لا تعكس مجرد انتقال في الوسائط، بل تجسد انقلابًا في أنماط السلطة الرمزية داخل المجتمع. فالتوثيق الرقمي، من جهة، يحمل في جوهره فعل مواطنة يسعى إلى مساءلة السلطة ورصد مدى انسجام الفعل القانوني مع المعايير الحقوقية، ويأتي ضمن تقاليد ديمقراطية تُعلي من شأن الشفافية والمساءلة. لكن التصيّد، من جهة أخرى، يتحول إلى شكل من أشكال الاغتيال الرمزي، حيث تُستغل الكاميرا لرصد الهفوات وتضخيمها، فتنقلب من أداة لتقويم الأداء إلى أداة لتشويه الوقائع وتقويض الثقة.
بهذا المعنى، تتجلى أبعاد متعددة للظاهرة. فهي، أولًا، تعيد توزيع السلطة الرمزية، إذ لم تعد القوة المعنوية محصورة في المؤسسات الرسمية أو وسائل الإعلام التقليدية، بل صار المواطن "المُصوِّر" يمتلك قدرة على إنتاج المعنى قد تنافس تلك المصادر ذاتها. وهي، ثانيًا، تفرض هشاشة مهنية على الفاعلين الأمنيين، الذين يجدون أنفسهم دائمًا تحت احتمال التسجيل والمساءلة الرقمية، بما يضاعف ثقل ممارسة واجبهم ويزيد الضغط النفسي المرتبط بالمسؤولية. وهي، ثالثًا، تفتح الباب أمام سرديات مضادة للرواية الرسمية، إذ تتحول المقاطع المصورة بسرعة إلى أدوات لإعادة تشكيل المعنى، قادرة على زعزعة الثقة العامة وتغذية خطاب الارتياب.
وعليه، فإن التعامل مع هذه الظاهرة لا يجوز اختزاله في منطق التجريم المطلق أو الإباحة الكاملة. بل يقتضي الأمر تبني مقاربة متوازنة تراعي في آن واحد حق المجتمع في الرقابة، باعتباره ضمانة للشفافية وحماية للحقوق، وحق أجهزة إنفاذ القانون في الحماية من التشهير الممنهج والتأويل المغرض، بما يحفظ توازن المعنى ويتيح ممارسة النشاط الأمني بشكل مسؤول وآمن. وعند هذا التوازن وحده يمكن استعادة رصيد الثقة وترميم الرمزية المؤسسية، ليظل الجسر الرفيع الذي يربط بين القانون ووجدان المجتمع قائمًا، بدل أن ينهار تحت ثقل الشكوك والريبة.
د.عبد اللطيف رويان /باحث في سوسيولوجيا الجريمة والانحراف