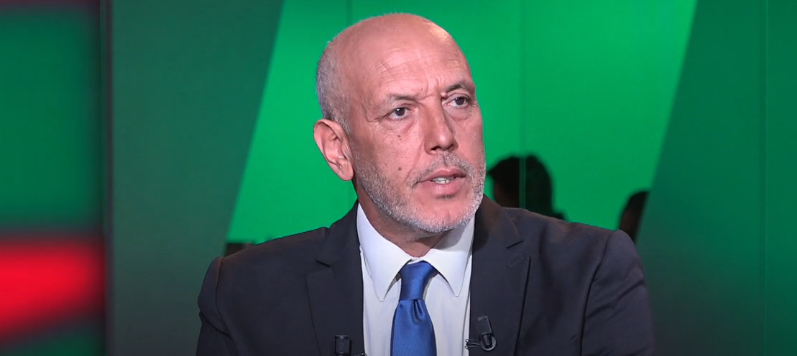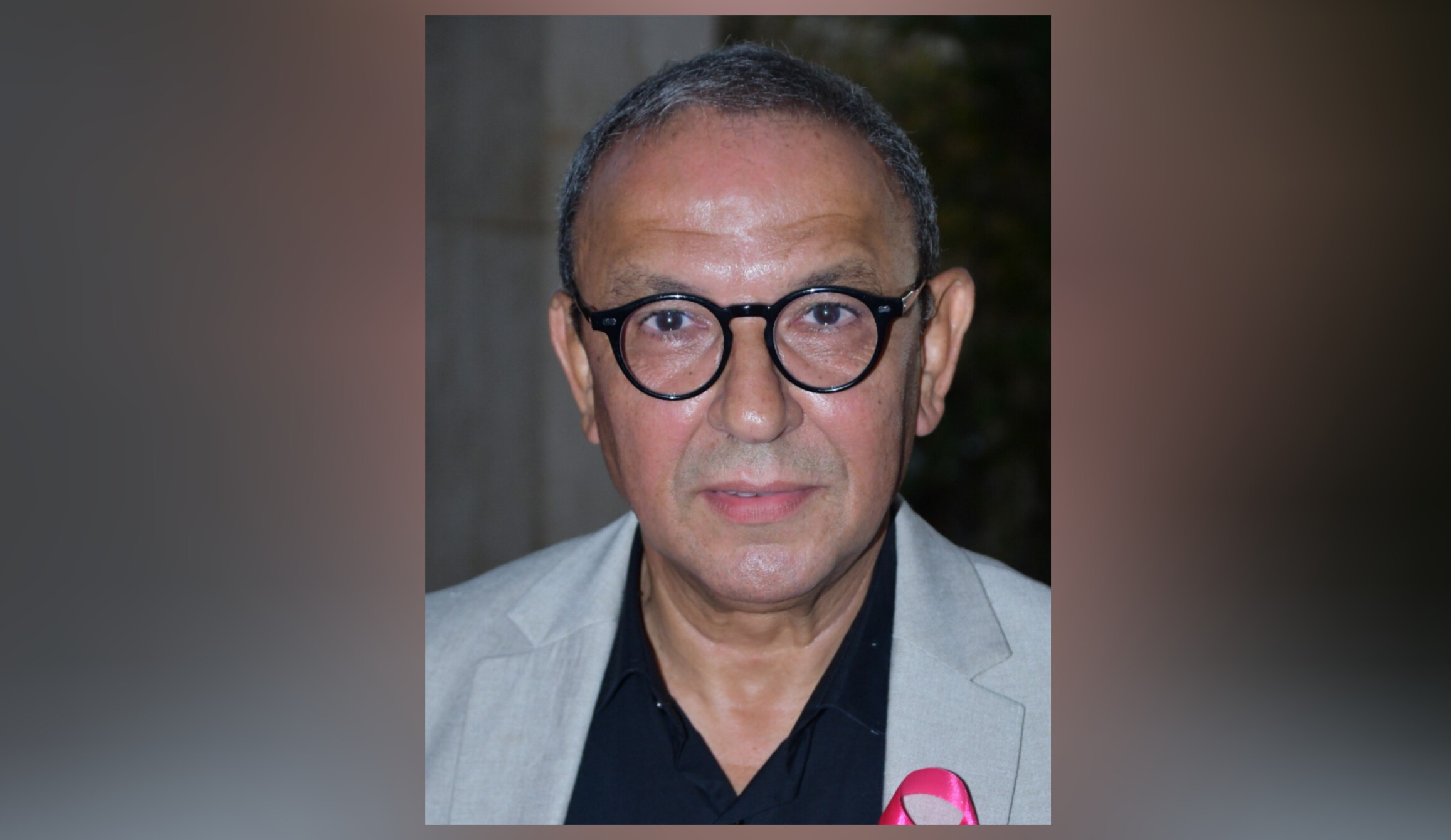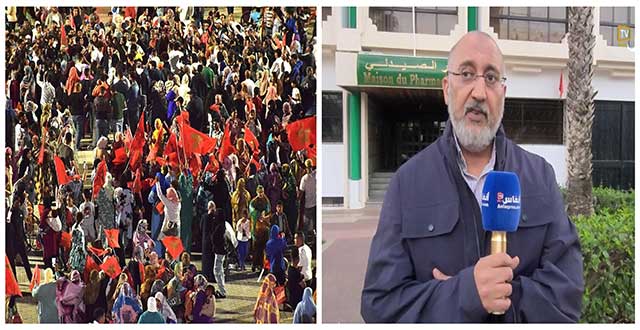أثارت سلسلة المواد التي نشرتها جريدة "لوموند"، حول المغرب، ردود فعل كثيرة، انتقدت مضامينها، وخاصة أسلوبها الذي تميز بغياب الصرامة المهنية، التي من المفترض أن تحرص عليها صحيفة فرنسية، تقدم نفسها نموذجا لصحافة الجودة، غير أنها في السلسلة المشار إليها لجأت، في أغلب ما قدمته للقراء، إلى منهجية تميزت بغياب مصادر موثوقة ومحددة، وبتغليب سردية أقرب إلى التخيل منها إلى الحقيقية.
وبغض النظر عن الدواعي المباشرة لهذا الانحراف المهني، فإن ما يثير الاستغراب والتساؤل؛ كيف تسمح الجريدة الأولى في فرنسا، لنفسها بأن ترتكب مثل هذه الأخطاء المهنية؟ هل كان المسؤولون عن التحرير سيتغاضون عن هذه الأخطاء، لو تعلق الأمر بعمل صحافي حول فرنسا؟ ما دور "جمعية المحررين" والمدير المفوض المكلف بالتفاعل مع القراء، في الجريدة المذكورة، تجاه نشر مواد غير مهنية؟
مثل هذه التساؤلات خطرت ببالي، أيضا، خلال تغطية بعض الصحف الفرنسية، لزلزال الحوز، حيث ابتعدت كل البعد عن المهنية، في المواد والصور التي اختلقتها، في الوقت التي كان من المفترض فيه أن تنقل للجمهور الحقائق عن فاجعة إنسانية ناتجة عن كارثة طبيعية. وهي نفس التساؤلات التي تثار دائما لدي، عندما أتابع العديد من المواد التي تنشرها الصحافة الإسبانية حول المغرب، والتي تتجاهل فيها القواعد المهنية المعروفة في ميدان الصحافة. لماذا لا تحترم هذه الصحافة، مقومات مهنة الصحافة، عندما يتعلق الأمر بالمغرب، أو بما يسميه الغرب، الآخر؟
هل يتعلق الأمر بمنهج منقول بصفة مشوهة، عن الطريقة التي تعاملت به كتابات غربية مع العالم العربي والإسلامي، والتي سميت بالاستشراق؟ من الممكن أن تكون هذه المقاربة مفيدة، في فهم السطحية و"الخفة الفكرية"، التي تعكسها هذه الصحافة، التي تعودت على تطبيق أسلوب لا يرى ضرورة احترام الصرامة المهنية، مادام الموضوع يتعلق بفضاءات وأناس من عالم آخر، غير العالم الغربي.
خصص علماء ومفكرون لهذه النظرة الإستشراقية دراسات غنية، عملت على تفكيك بنيتها وانتقاد الأخطاء التي وقعت فيها، منها ما كتبه ماكسيم رودنسون في كتابه "الافتتان بالإسلام"، حيث استنتج أنه لا يوجد "استشراق"، ولا "علوم صينية"، ولا "علوم إيرانية"، إلخ. هناك تخصصات علمية محددة بموضوعها وإشكاليتها الخاصة، مثل علم الاجتماع، والديموغرافيا، والاقتصاد السياسي، واللغويات، والأنثروبولوجيا أو الإثنولوجيا، والفروع المختلفة من التاريخ... يمكن تطبيقها على شعوب أو مناطق مختلفة في عصر أو آخر. لا يوجد "شرق"، هناك شعوب، بلدان، مناطق، مجتمعات، ثقافات كثيرة العدد على الأرض، لكن لا يزال العديد من المستشرقين أسرى للاستشراق، محبوسين في غيتو، تعزز بسبب هيمنة مجتمعهم على الآخرين وقد شوه هذه الوضع رؤيتهم بشكل كبير.
نتيجة هذا التشوه معروفة لدى المتخصصين، يتمثل في دراسات وأبحاث، طبقت مناهج غير علمية، منطلقة من أفكار مسبقة على مجتمعات "الشرق"، وغيرها، وهو ما انتشر في العديد من الدراسات الإثنولوجية والأنثروبولوجية، حول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مستعملة مناهج خاصة، تنظر إلى مجتمعات هذه القارات، كما لو كانت كلها بدائية، غرائبية، يسودها التوحش. وكانت هذه القصص، التي تعج بالخيال، تقدم كدراسات علمية، من أجل تبرير نظرة الاستعلاء والعنصرية والاستعمار.
الأخطر في كل هذا هو أن هذه النظرة أصبحت سائدة لدى العديد من المهتمين بالمجتمعات غير الغربية، ويقول هنا ردونسون إن الامر لم يعد مرتبطا بالاستعمار، بل بمنهجية مازالت قائمة، رغم نهاية العهد الاستعماري. أي أن هناك نظرة نيوكولونيالية، تشكل خلفية هذه الكتابات والروبورتاجات، سواء تلك التي تقدم نفسها كدراسات علمية أو كعمل صحافي.
إنه الوعي المبثوث، الجيوسياسي، الذي نجده في النصوص العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية واللغوية، وهو تطوير تفصيلي ليس فقط للتمييز الجغرافي الأساسي (الذي يقول إن العالم ينقسم إلى نصفين غير متكافئين هما الشرق والغرب)، بل أيضًا لسلسلة كاملة من «المصالح» التي يستعان في تحقيقها والحفاظ عليها بشتى الوسائل، كما يقول إدوارد سعيد، في كتابه "الاستشراق".