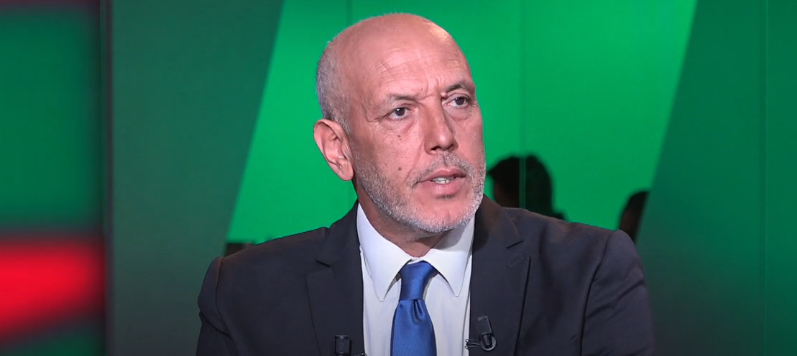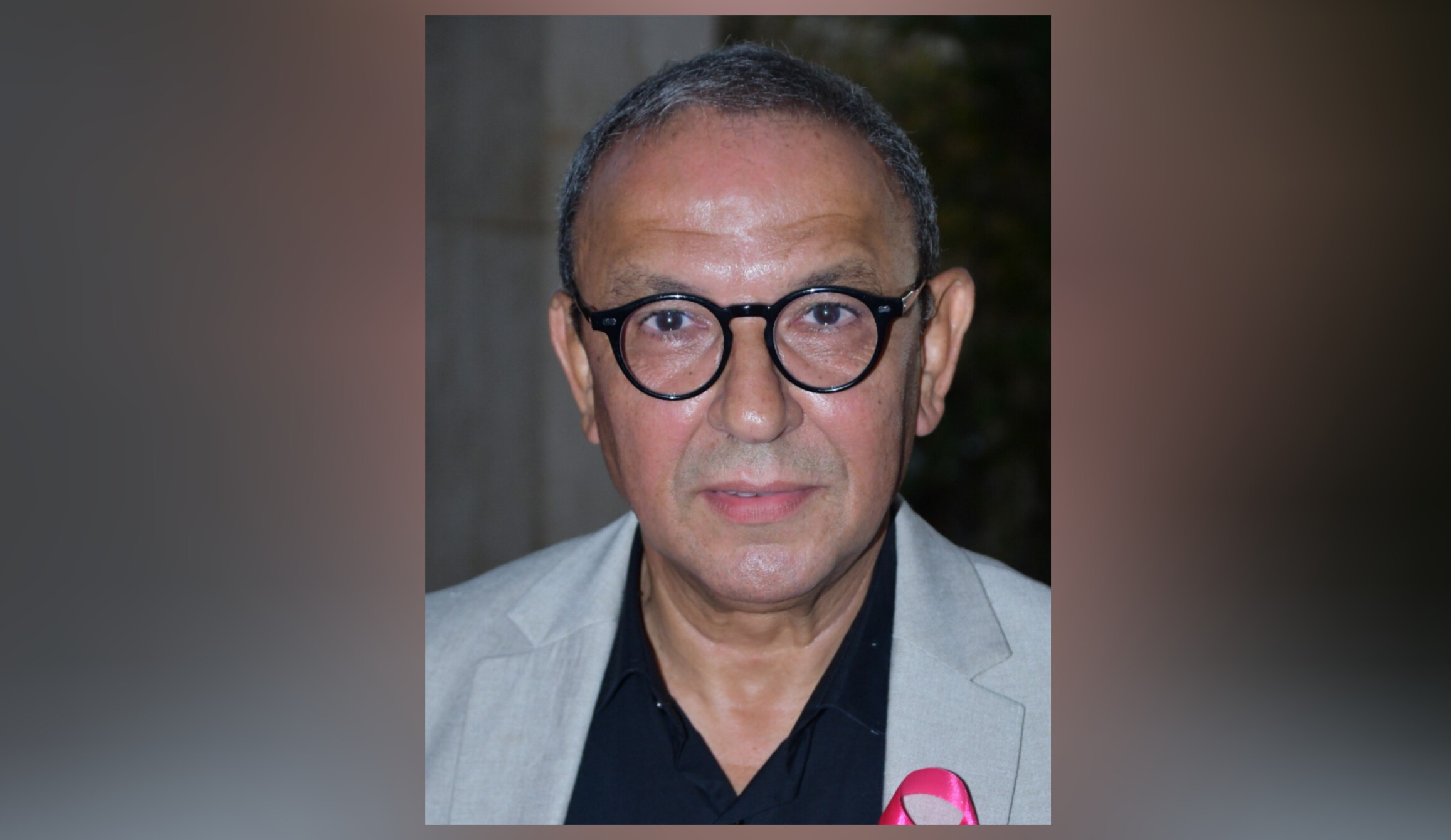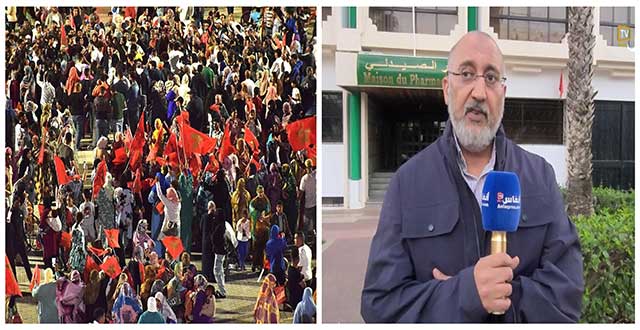كما يقول سيزر بيكاريا في مؤلفه الجرائم والعقوبات: "الإنسان لا يختار خرق القانون إلا بعد أن يوازن بين اللذة التي يجنيها من الفعل، والألم الذي قد يلحقه العقاب به". هذه المقولة التأسيسية ما زالت، بعد قرون، محتفظة براهنيتها، إذ وجدت امتدادها في ما طوره لاحقًا كلارك وكورنيش ضمن نظرية الاختيار العقلاني، التي ترى أن الفعل الإجرامي ليس مجرد اندفاع غريزي، بل عملية محسوبة تُشبه معادلة اقتصادية دقيقة: تقدير للاحتمالات، قياس للمخاطر، وموازنة بين الكلفة والعائد قبل اتخاذ القرار.
وبهذا المعنى، لا يمكن تصور الجريمة على أنها مجرد نزوة عابرة، بل هي قرار عقلاني يُتخذ داخل سياق اجتماعي متشابك، يُجبر الأفراد على التصرف كما لو كانوا في لعبة معقدة تتقاطع فيها المصالح؛ ففي هذه اللعبة لا يربح الجميع، بل يُحدد موقع كل فرد بحسب موارده وقدرته على تفادي الأسوأ، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين.
في المقابل، تتنامى ما يمكن تسميته بـ"ثقافة التحفّظ إزاء الجريمة"؛ فالشهود يترددون في الإدلاء بشهاداتهم خشية الانتقام، والضحايا يفضلون الصمت تفاديًا للفضيحة أو درءًا لمزيد من الأذى، بينما يميل الأفراد إلى الانسحاب من آليات التبليغ مفضلين الحياد السلبي. هنا يمكن استحضار إرفينغ غوفمان في تحليله لـ"إدارة الانطباع"، حيث يُظهر الأفراد سلوكًا يتسم بالحذر الشديد، فيسعون إلى التحكم في ما يبدونه من مواقف أو أقوال لتجنّب وسمهم اجتماعيًا أو وضعهم في مواجهة مباشرة مع المجرم. إنهم، على حد تعبير غوفمان، يديرون "واجهة اجتماعية" تحفظ لهم الحد الأدنى من الأمان، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة أو العدالة.
في هذا السياق، يصبح الصمت استراتيجية دفاعية ذات طبيعة اجتماعية، تقوم على موازنة دقيقة بين المكاسب المحتملة والمخاطر الشخصية. وهكذا، لا يظهر الصمت كخيار فردي محايد، بل كآلية فاعلة تعيد إنتاج بيئة حاضنة للجريمة والانحراف، من خلال ترسيخ الفراغات البنيوية، وإضعاف الرقابة الجماعية، وتثبيت أنماط التفاعل التي تسمح باستمرار الانتهاك.
إن الفاعل المنحرف لا يستمد قوته من العوامل البنيوية وحدها، كالفقر أو الهامشية أو غيرها، بل يبرع أيضًا في استثمار مناخ التكتّم الجماعي لصالحه. فهو يدرك أن صمت الآخرين يشكل له درعًا غير مباشر، وأن كل محاولة فردية لتفادي المواجهة تساهم – من حيث لا يُراد – في ترسيخ أفعاله. هنا يحضر تصور إدغار موران، الذي يرى أن الخوف ليس مجرد انفعال عابر، بل بنية اجتماعية تؤطر السلوك وتعيد إنتاج منطق الطاعة والتواطؤ؛ فالجماعة، تحت وطأة الخوف، تُفضّل التماهي مع المجرم أو الانسحاب من الفعل العمومي، وهو ما يعزز سلطته الرمزية والمادية.
وهكذا تتكوّن دائرة مغلقة: أفراد يلوذون بالصمت حمايةً لأنفسهم، بينما النتيجة النهائية هي تعزيز موقع المجرم وتطبيع وجوده داخل النسيج الاجتماعي. في هذا التوازن الهش بين الإفصاح والكتمان، وبين المواجهة والتغاضي، يتجاوز الفعل الإجرامي مجرد واقعة مخالفة للقانون ليغدو معادلة اجتماعية، تتغذى من تشظي الحسابات الفردية ومنطق إدارة الانطباع، حيث يحاول كل فرد الحفاظ على "وجهه الاجتماعي" وتفادي انكشافه. النتيجة هي خسارة جماعية فادحة تطال الثقة والأمان الجمعي، تاركة البنية الاجتماعية معلقة بين الخوف والتواطؤ الصامت.
إن الامتناع عن التبليغ لا يعبّر عن مجرد خوف فردي كما يُفهم غالبًا، بل يشكّل آلية اجتماعية معقّدة تُنظّمها موازين القوى وتوزيعات المخاطر بين الأفراد. فعندما يُنظر إلى المجرم على أنه يمتلك أدوات ردع تفوق قدرة الأفراد على مواجهته مباشرة، يصبح الكتمان قاعدة والبوح استثناءً محفوفًا بالمخاطر. وفي هذا السياق، يتحوّل السكوت إلى أداة تكتيكية وقرار واعٍ، يهدف إلى تجنّب المواجهة المباشرة، تحسبًا لما قد يحمله الكلام من تهديد بالفضح أو الانتقام.
بهذا المعنى، يغدو المجرم مركز ثقل رمزي يفرض صمته على الضحايا والشهود وغيرهم، ليس بالعنف المادي فقط، بل أيضًا عبر الترهيب والإغراء أو حتى عبر التفاوض غير المعلن بوصلات"العربدة" الليلية. أما الأفراد، فيجدون أنفسهم أمام معادلة خاسرة: إن تكلموا عرّضوا أنفسهم للخطر، وإن سكتوا ساهموا – بوعي أو بدونه – في حماية المعتدي وإدامة سلطته.
إن خطورة "ثقافة التحفظ إزاء الجريمة" تكمن في أنها تُنشئ نظامًا تواطئيًا غير معلن، يحوّل الجريمة إلى خيار اجتماعي ممكن، ويحوّل المجتمع من فضاء مقاومة إلى بيئة متواطئة. هنا ينجح المجرم في جعل الخوف الجماعي درعًا يحميه، بينما يتآكل الضمير الجمعي تحت ضغط الخوف البنيوي وإكراهات إدارة الانطباع.
لذلك، فإن تجاوز هذه الثقافة لا يتحقق عبر سنّ قوانين رادعة فقط، بل يتطلب إعادة بناء الثقة في المؤسسات عبر آليات ملموسة لحماية الضحايا والشهود. فالقانون المغربي – شأنه شأن باقي التشريعات المقارنة – أقرّ إطارًا خاصًا لحماية المبلّغين والشهود، إدراكًا منه أن الإفصاح لا يمكن أن يصبح قاعدة إلا إذا شعر الأفراد أن القانون يقف إلى جانبهم فعليًا ويوفر لهم درعًا واقعيًا ضد الانتقام والتهميش. عندها فقط يتحول الكلام إلى فعل جماعي محرر من دوامة الخوف، ويُعاد ترتيب المعايير الاجتماعية بحيث يصبح التبليغ عن الانتهاكات واجبًا مدنيًا، فيما يُحاصر منطق التكتم ليبقى مجرد استثناء هشّ لا يرقى إلى مستوى القاعدة.