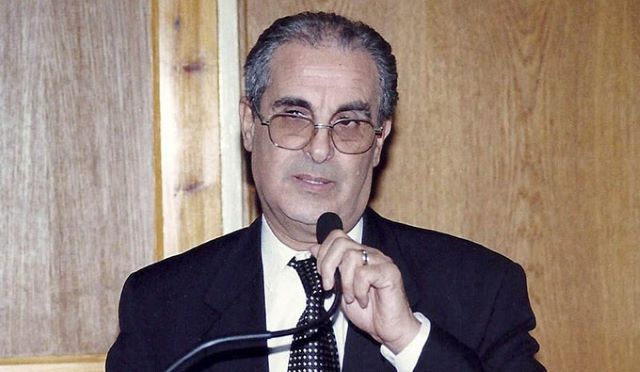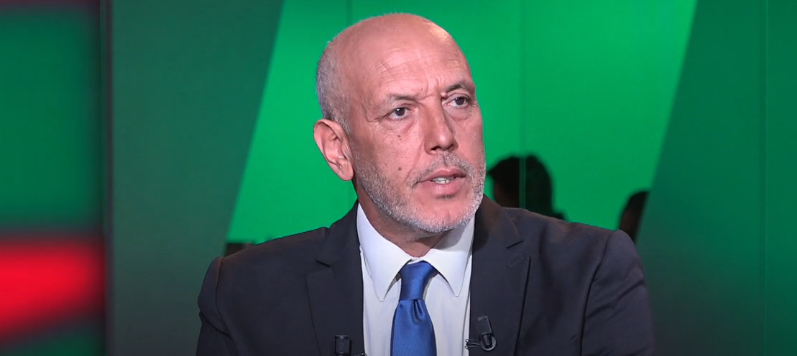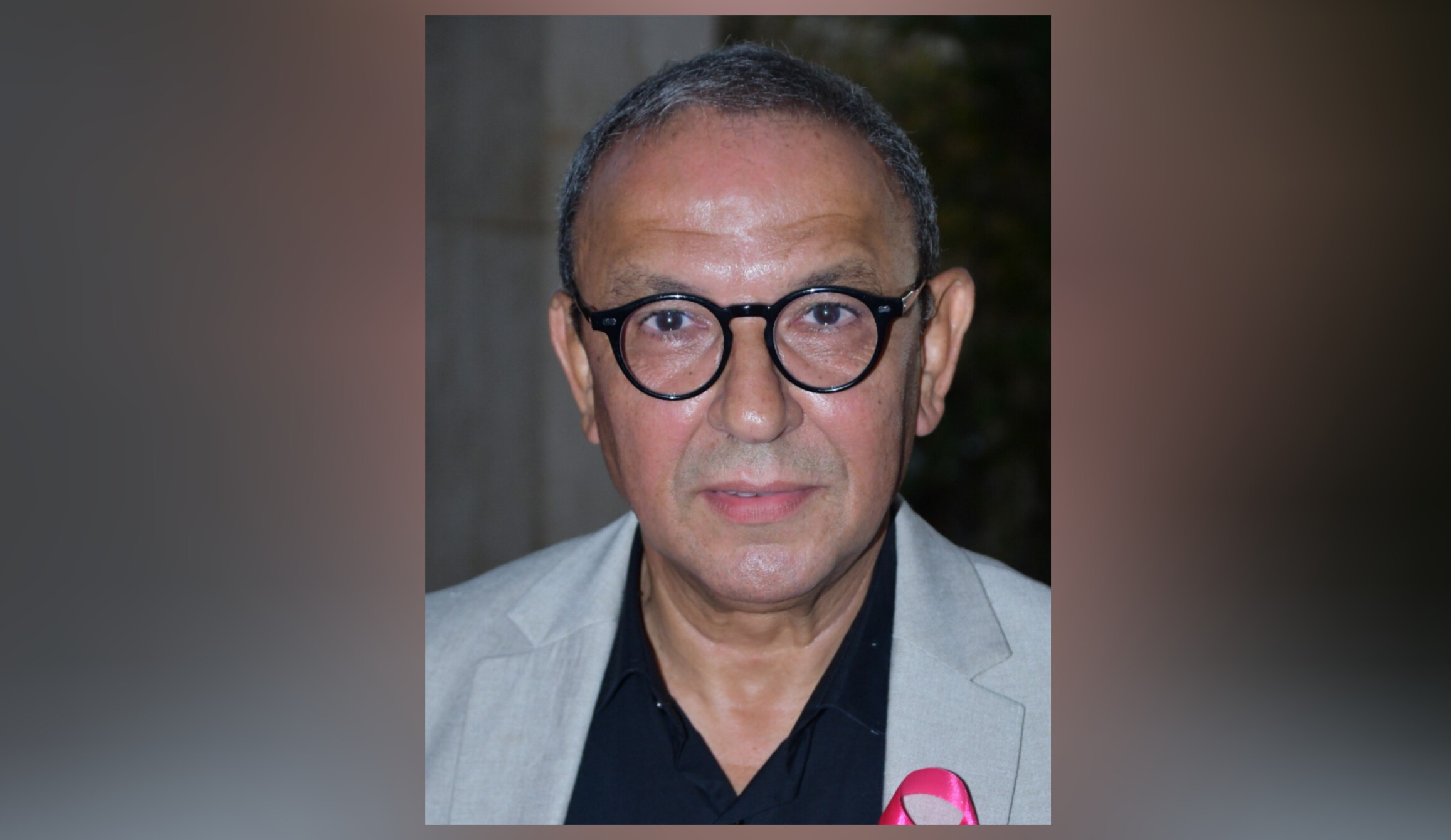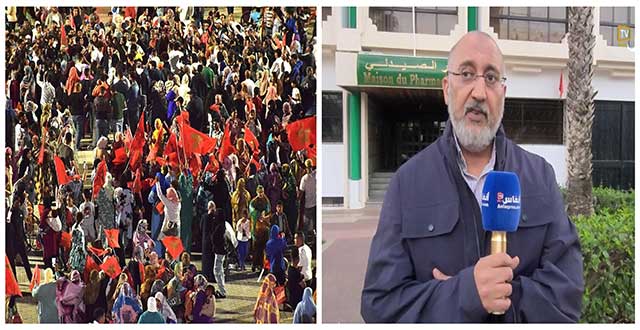لن تجدَ ولو عالِماً واحِداً يعيش في الحاضر ومُتخصِّص، تخصُّصاً علمياً، في الأمور الدينية، أو فقيهاً واحِداً، عندما تُطرَح عليهما واحِدةً من القضايا المتعلِّقة بالدين، التي هي في حاجةٍ إلى حُكمٍ أو رأي أو تفسير أو توضيح…، فإنه لن يقولَ لك : "طِبقاً للبحث الذي أجريتُه، أنا شخصياً، أو البحث الذي أجراه أو قام به الفلان الفلاني… بل يقول لك قال فلانُ عن فلانٍ عن فلان… إلى أن يصل إلى أحد الصحابة الذي عايش الرسول (ص). أو يقول لك قال الشافعي أو قال أحمد بن حنبل أو قال مالِك أو قال الحنفي أو قال ابن تيمية… أو قال أحد علماء وفقهاء الدين، القدامى…
هذا هو ما أُسمِّيه، أنا شخصيا، "فن الأجوبة الجاهزة والضارِبة في عُمقِ القِدَم". وهذا الوضعُ يدغعُني لأطرح على نفسي سؤالين مُهمَّين، وهما : 1.لماذا قلتُ إنها "أجوبةٌ جاهزةّ"؟ و 2.لماذا هذه الأجوبة ضارِبة في عمق القدم؟
جواباً على السؤال الأول، أي "لماذا قلتُ إنها أجوبةٌ جاهزةّ"؟، أقول إنها "جاهِزة" لأن القائل (عالِمُ أو فقيه)، عوض أن ينطلق من بحثٍ ميداني قام به هو نفسُه أو قام به أحد أندادِه من العلماء والفقهاء، فإنه يعود إلى التراث الذي تركه السلف وعمِل ويعمَل به الخَلَفُ. بل وحتى ما يُسمِّيه علماءُ وفقهاءُ الدين "بحث"، من منظور علمي، فهو، فقط وحصرياً، تنقِيبٌ une investigation في تراث السلف، أي فيما قاله السلف في الموضوع، وليس، على الإطلاق، تجديد للأفكار والآراء، علماً أن البحثَ العلمي، إن لم يأتِ. بجديدٍ، فهو ليس بحث! أليس هذا فنٌّ يبرع فيه علماءُ وفقهاءُ الدين؟
والغريب في الأمر أن العالِمَ أو الفقيهَ يكتفي بإعطائك رأيَ التراثِ في الموضوع، ولن تسمعه يُدلي برأيه الشخصي في نفس الموضوع، أي هل هو مُتَّفق مع هذا الرأي، وهل هو يُعارِضه أو يريد أن يُغيِّرَه… لا، إنه يكتفي بنقلِ لك ما قاله السلفُ في الموضوع، بدون تحليلٍ أو نقدٍ... لماذا؟
لأن العالِمَ أو الفقيهَ يثق ثقةً عمياءَ في محتوى التراث وفي العنعنة. وثقتُه هذه في محتوى التراث وفي العنعنة راجعٌ إلى كون أجيالٍ كاملة من علماءَ وفقهاءَ الدين، القدامى، كانوا يُعتبرون من طرف الأجيال التي تَلَتْهم، من "كِبار" العلماء والفقهاء في عَصرهم. و"كِبار" قد تصل إلى درجة التقديس. حينها، يصبح "كِبار" العلماء والفقهاء معصومين من الخطأ، أي يقولون الحقَّ وكلَّ الحق.
وهذه كارثة عظمى تجعل أقوالَ "كِبارِ" العلماء والفقهاء وأحكامَهم وآراءَهم… صالحة لكل زمان ومكان. وهذا هو واقع حياة المسلمين، إذ أن "كِبار" العلماء والفقهاء شبعوا موتاُ في قبورهم، منذ ما يزيد عن عشرة قرون، لكن تأثيرَهم على حياة هؤلاء المسلمين، في الحاضر، لا يزال مستمراً. وهذا الوضعُ هو الذي جعلني أُعَنوِن هذه المقالة ب"فن الأجوبة الجاهزة والضارِبة في عُمقِ القِدَم". فماذا يمكن أن نستنتِجَه من هذا الوضع؟
قبل الجواب على هذا السؤال، أريد أن أوضِّح، في مقالتي هذه، أنني لا أتحدَّثُ عن الثوابت الدينية القطعية، المنصوص عليها في القرآن الكريم. بل أتحدَّث عن الإنتاج الفكري الذي خلَّفه لنا السلفُ، والذي هو إنتاج بشري، أي قابلٌ للنقد والتغيير.
أما ما يمكن استنتاجُه مما سبق، هو أن المجتمعات الإسلامية بقِيت على حالِها، منذ وفاة الرسول (ص) إلى يومنا هذا. بمعنى أن واقعها بقي على حاله، أي كما كان حالٌه في الماضي. وبعبارة أخرى، المجتمعات الإسلامية لم تخضع، كباقي المجتمعات البشرية، لأي تطوُّرٍ، لا على المستوى الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي والصناعي…
وهذا الوضع مُخالف لمسيرة التاريخ، التي تبيِّن، بوضوح، أن المُجتمعات البشرية، بصفة عامة، والمجتمعات الإسلامية، بصفة خاصة تطوَّرت وأُدخِلت عليها تغييرات جذرية، وعلى جميع مستويات الحياة اليومية، بالمقارنة مع ما كانت عليه نفسُ المجتمعات الإسلامية، في الماضي، أي بعد وفاة الرسول (ص). إذن، بالنسبة لعلماء وفقهاء الدين، القُدامى والحاليين الذين ساروا على نهجِهم، المجتمعات الإسلامية غير قابلة للتغيير، وبالتالي، ما كان ساريَ المفعول من أحكامٍ، في الماضي، يمكن تطبيقُه على أوضاعِ الحاضر. وهذا غير صحيح، على الإطلاق. لأنه لكل زمان ناسُه ولكل زمان، إنتاجه الفكري البشري. ولكل زمان معارِضون لهذا الإنتاج الفكري البشري. والإنتاج الفكري البشري الديني لا يُسثَتنى من هذه المعارضة.
و حتي لا تكونَ هناك معارضةٌ، يختبئ علماء وفقهاء الدين وراء تُرَّهات لا تُغني ولا تُسمِن من جوع، فيقولون لك "أجمعتِ الأمة" أو "أجمع العلماء" أو يقولون لك و"حُزَّاقُ الأئمة". ومعروفٌ أن الإجماعَ، كما يزعم علماءّ وفقهاءُ الدين لا وجودَ له، على الإطلاق، في مشهد الإنتاج الفكري الديني البشري. لماذا؟
لأن مزاعيمَ "أجمعتِ الأمة" و "أجمع العلماء" لا أساسَ لهما من الصحة! إن كان الأمرُ هكذا، فليَقُلْ لنا علماء وفقهاء الدين لماذا تعدَّدت المذاهب والطوائف والفِرق؟ أليس هناك اختلافٌ في الأفكار والآراء والرؤى؟ كل فئة من العلماء والفقهاء تنفرد بفهمِها للنصوص الدينية!
والآن، حان الوقتُ للجواب على السؤال الثاني، أي "لماذا هذه الأجوبة ضارِبة في عمق القدم"؟ الجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى تعميق في التحليل. لماذا؟
لأنه بعد وفاة النبي والرسول، محمد (ص)، مباشرةً، ولم يتم دفنُه بعد، بدأت السياسة تختلط بالدين. إذ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار مَن سيكون خليفةً للرسول (ص). فالتحق بهم المهاجرون بقيادة أبي بكر وعمر بن الخطاب. وفي نفس السقيفة، تمَّت بيعةُ أبي بكر الصديق كأول الخلفاء الراشدين الأربعة.
وقد بلغ هذا الخلطُ أوجَه في عَصري الأمويين والعباسيين. وفي نفس العصرين، كثر الإنتاج الفكري الديني وتعدَّدت مشاربُه واختلافاتُه. وقد دامت الخلافة الأموية ما يُناهز قرنا من الزمان بعد وفاة الرسول (ص) وانتهاء الخلافة الراشِدة. أما الخلافة العباسية، فقد استمرّت لفترة تفوق خمسة قرون من الزمان.
فهل يُعقل أن بتمَّ تطبيق نفس الأحكام الدينية التي كانت سائدةً في المجتمعات الإسلامية في عصرَي الأمويين والعباسيين على المجتمعات الإسلامية الحاضرة؟ وهنا، أذكِّر بأن مقالتي لا تتحدَّث عن الأمور الدينية القطعية، المنصوص عليها في القرآن الكريم. بل أتحدَّث عن الأنتاج الفكري الذي خلَّفه لنا السلف، وأصبح تراثاً صالِحا لكل زمان ومكان.
ما أختم به هذه المقالة، هو أن أي عالمٍ أو فقيه، عندما تُطرَحُ عليهما قضية من القضايا الدينية التي تحتاج إلى اجتهاد فكري، فإنهما، بكيفيةٍ تلقائية، يعودان إلى التراث الديني القديم ليُدليا بجواب كان جاهزاً منذ قرون مضت. أليس هذا فنٌّ يبرع فيه علماء وفقهاء الدين الحاليون؟ فهل عنوان هذه المقالة، أي "فن الأجوبة الجاهزة والضارِبة في عُمقِ القِدَم", في محلِّه أم لا؟