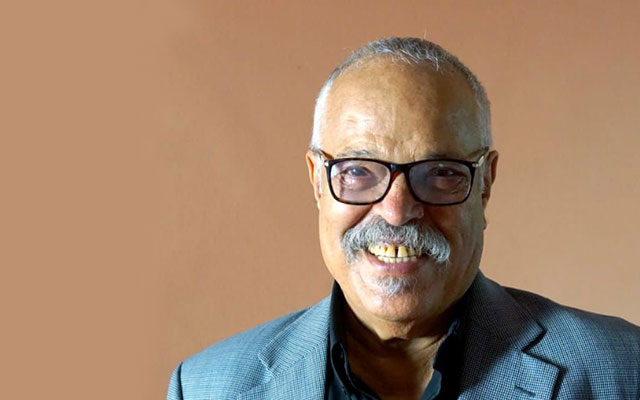في سياق ما يمكن نعته بما بعد "بؤس التاريخ"، وسعي ثلة من المؤرخين المغاربة إلى إخراج الكتابة التاريخية المغربية من الفقر النظري والمنهجي الذي تعيشه، احتضنت مدينة شفشاون خلال منتصف شهر دجنبر 2023 دورة تكوينية تحت عنوان:" من أجل معرفة تاريخية مغربية بنفَس تجديدي"، من تأطير الأستاذين محمد حبيدة والطيب بياض.
تعميما للفائدة يتقاسم موقع " أنفاس بريس" مع قراءه محاضرة الأستاذ محمد حبيدة(جامعة ابن طفيل،اللقنيطرة)، التي قدمها خلال هذا اللقاء.
التاريخ من الميادين المعرفية القليلة التي تجد نفسها مجبرة للدفاع عن نفسها، وتبرير تخصصها، وإبراز مكانتها بين العلوم الإنسانية والاجتماعية المجاورة. والسبب في ذلك هو أن حائطه قصير، لأنه على خلاف هذه العلوم، كل مثقف كان بإمكانه وما يزال أن يتحدث في التاريخ ويكتب حوله ورقات ومقالات ومؤلفات. وإلى اليوم، في العديد من الثقافات عبر العالم، لا يتحكم المؤرخ وحده في تخصصه، حيث يخضع تناول التاريخ لاستعمالات غير أكاديمية، مدرسية أو إيديولوجية أو إعلامية كما يظهر جليا للجميع. هذا ما يفسر كثرة الخطابات حول تاريخ التاريخ، ومناهج البحث التاريخي، والكتابة التاريخية، التي تسعى جلها إلى تحصين عمل المؤرخ وإكسابه القيمة المعرفية التي يصبو إليها. يتضح ذلك في نماذج عديدة، من "مهمة المؤرخ" (فيلام فون هامبولد: 1821) إلى "ما يستطيعه التاريخ" (باتريك بوشرون: 2016)، مرورا بِ "مدخل إلى الدراسات التاريخية" (شارل فيكتور لونغلوا وشارل سينيوبوس: 1898)، و"صنعة المؤرخ" (مارك بلوك: 1949)، و"معارك من أجل التاريخ" (لوسيان فيفر: 1956)، و"ما هو التاريخ" (إدوارد كار: 1961)، و"كيف يُكتب التاريخ" (بول فينْ: 1971)، و"التاريخ الجديد" (جاك لوغوف: 1978)، و"مضمون الشكل: الخطاب السردي والتمثل التاريخي" (هايدن وايت: 1987)، وغيرها من المؤلفات التي نبّهت المؤرخين إلى تحصين تخصصهم، أو مراجعة أدوات عملهم، أو إعادة صياغة مقولاتهم ومفاهيمهم.
وتبقى الخطابات المنهجية التي أنتجها المؤرخون ابتداءً من السبعينيات من القرن الماضي، زمن العلوم الإنسانية الجميل، مؤسِّسةً في هذا المجال، خاصة تلك التي اهتمت بالبعد الأدبي في الكتابة التاريخية. في طليعة هذه الدراسات:
- "كيف يُكتب التاريخ" (1971) لبول فينْ الذي يُعد من المؤرخين الأوائل الذين تحرروا من التحليل البنيوي والماركسي واقتربوا أكثر من رؤية ماكس فيبر السوسيولوجية والثقافية.
- "صناعة التاريخ" (1974)، هذا الكتاب الجماعي الذي أشرف عليه جاك لوغوف وبيار نورا، والذي انتظم في ثلاثة مجلدات: مشكلات جديدة، ومقاربات جديدة، وموضوعات جديدة.
- "الكتابة التاريخية" لميشال دوسيرتو (1975) الذي نود التركيز عليه للنظر في محطات عمل المؤرخ وتجلياتها.
لنتوقف إذًا عند هذا الكتاب الأخير الذي يطرح ما يسميه صاحبه بِ "العملية الإسطوغرافية"، فيربطها بثلاث
محطات رئيسية:
أولا، ابتكار الموضوع انطلاقا من الموقع الاجتماعي أو السياسي أو المؤسساتي الذي ينتمي إليه الباحث.
ثانيا، الأرشيف وما يستلزمه من ممارسة على مستوى المعالجة والتفسير.
ثالثا، الكتابة أو الخطاب، أي توليد النص الأدبي.
هذه المحطات، التي استعادها الفيلسوف بول ريكور كما هي، ليست منفصلة عن بعضها البعض، بل هي لحظات منهجية متداخلة. يقول: "لا يستشير أحد الأرشيف من دون مشروع تفسير، من دون فرضية فهم، ولا يبذل أحد جهده في تفسير مجرى أحداث من دون اللجوء إلى استعمال صيغة أدبية مناسبة ذات طابع سردي أو بلاغي".
أولا: ابتكار الموضوع انطلاقا من الموقع الاجتماعي أو السياسي أو المؤسساتي الذي ينتمي إليه الباحث
بمعنى أن اختيار الموضوع يتحكم فيه:
- الانتماء الاجتماعي. هذا ما يفسر نزوع عدد من الباحثين إلى الاهتمام بمونوغرافيات ذات صلة بجماعات بشرية (قبائل مثلا) أو بحواضر أو بمؤسسات دينية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالانتماء الاجتماعي أو الديني، والتي يغيب فيها، في معظم الحالات، التوجه المؤسساتي القائم على تيارات بحثية معلومة.
- الانتماء السياسي. في هذا الإطار، كان الانتماء إلى اليسار قد حفّز الكثير من الباحثين، في أوروبا على وجه الخصوص، على اقتحام موضوعات ذات نفحة ثورية. هذا ما نلمسه، على سبيل المثال لا الحصر في أعمال الفرنسيِّين جورج لوفيفر وألبير سوبول وفرانسوا فوريه حول الثورة الفرنسية، والبريطاني إدوارد بالمير تومسون (نشأة الطبقة العمالية)، والإيطالي رينزو دي فليتشي (التجربة الثورية الإيطالية لعام 1798).
- الموقع المؤسساتي. ويشكل هذا الموقع، المرتبط بتوجهات البحث داخل الجامعة، حلقة رئيسية في عملية البحث، لأن له صلة بتطور المناهج والرؤى المعرفية، وبدرجة الانفتاح على ما يُنجز في الجامعات الأجنبية، الأوروبية والأمريكية والهندية. في ميدان التاريخ، لا سبيل إلى تطوير البحث التاريخي إلا بفتح نوافذ عريضة على نتائج الأبحاث والدراسات التي تصدر عن هذه الجامعات، والدفع بالطلاب إلى اقتحام التواريخ الأخرى قبل البحث في التاريخ المحلي أو القومي، لأن التواريخ الأخرى، الأوروبية أو الآسيوية، تمكِّن أولا من وضع تاريخ الذات في المرآة، وتتيح ثانيا الاطلاع على المناهج التي كُتبت بها هذه التواريخ، مثل منهج الحوليات في فرنسا، والتاريخ من أسفل في بريطانيا، والتاريخ المجهري في إيطاليا، والسوبالتيرن ستاديز (دراسات التابع) في الهند. هذا بالإضافة إلى عامل اللغة، الفرنسية أو الإنجليزية وغيرهما، الذي يساهم في إضفاء لمسة نوعية على الموضوع المدروس، بالقياس إلى الدراسات المتقوقعة حول لغة واحدة.
ثانيا: اقتحام الأرشيفات أو المستندات
هذه المحطة هي التي تُدخِل الباحث في العملية الإسطوغرافية، حيث يجتهد في التحقق من الوثائق، ويسعى إلى نقدها، وتحليلها. هذا ما جعل بول ريكور ينعت المؤرخ بِ "محلّلٍ للوثائق". في الأصل، ارتبطت مهمة المؤرخ بتحليل الوثائق، وقد تمأْسَست هذه المهمة في القرن التاسع عشر، لما نادى المؤرخون الألمان، وفي مقدمتهم فيلام فون هامبولد وليوبولود فون رانكه، بضرورة الاستناد إلى الوثائق لكتابة التاريخ، في سياق التصدي إلى غير المؤرخين الذين كانوا يستسهلون هذه الكتابة ويخُطّون أوراقا بنفحات انطباعية أو فلسفية، حيث تمهْنن التاريخ (صار مهنة) وتأسْتذ (صار له أساتذة). واستمرت هذه الرؤية الوثائقية مع المؤرخين الفرنسيين الذي قعّدوا لها، فرفعوا الشعار الشهير "لا تاريخ بدون وثائق" كما جاء بقلم شارل فيكتور لانغلوا وشارل سينيوبوس.
لكن الوثائق تنطوي على مآزق حقيقية، لأن قيمتها تبقى نسبية. فهي تُفْهِمُنا الماضي فهما غير مباشر، وبالتالي لا تمكِّن من إدراك هذا الماضي إلا بصورة جزئية، حتى وإن أُحصيت بالآلاف. ثم إن كثرتها، خاصة فيما يتصل بالتاريخ المعاصر، قد تحاصر فكر المؤرخ وتسجنه في قوالب ضيقة، فيعجز عن تقديم تفسير يُذكر. ولذلك، في المحصلة، إما أن تتفوَّق الوثائق على الباحث، إذا كان أعزلا، مجرَّدا من أدوات التحليل المفاهيمية، فلا يقول إلا ما تقوله هذه الوثائق، وإما أن يكون مسلّحا بما يكفي من هذه الأدوات، فيواجهها بالسؤال ويتفوَّق عليها. وفي هذا التفوُّق "يثأَر فكرُ [المؤرخ] من الوثيقة بشكل كبير" كما يقول مارك بلوك.
ثالثا: الصياغة الأدبية
في هذه المحطة يجري الانتقال من البحث التاريخي باعتباره ممارسة على مستوى معالجة الوثائق وتحليلها إلى التاريخ بوصفه توليدا للنص. بعبارة أخرى، تكون الكتابة، أي الخطاب، نتيجةً لهذه الممارسة. إنها المحطة التي يعبر عنها دوسيرتو تعبيرا سينمائيا: "الإخراج الأدبي". في عملية الإخراج هذه، يعمل المؤرخ على إعادة الحياة للموتى، "على النحو الذي يجعل هؤلاء، بواسطة اللغة والمفاهيم، يخرجون من قبورهم ويستعيدون موقعهم ووظيفتهم الرمزية".
ولا يسع المتتبع لقول دوسيرتو إلا أن يتنبَّه لهذه الوساطة المتمثلة في اللغة والمفاهيم، لأن بناء النص يستلزم إتقانا لغويا وتدبيرا أسلوبيا وتحكما في المقولات والمفاهيم لبلوغ سرد يجمع بين السلاسة الأدبية والصرامة الأكاديمية. وهذه الأخيرة، أي الصرامة الأكاديمية، هي التي تميز العمل الإسطوغرافي كونه يستند أساسا إلى الممارسة على النحو الذي تظهر به في المحطة الثانية، أي تحليل الوثائق والتبيُّن من الوقائع والاستعانة بالمراجع. ومن جهة ثانية، بفضل المفاهيم الرائجة في العلوم الإنسانية والاجتماعية المجاورة، يستطيع الباحث في التاريخ توسيع دائرة الفهم وبلوغ مستوى التأويل، فيتميَّز نتيجة لذلك عن الإخباري و"ينسلخ من الوثيقة"، وبالتالي يستطيع التحدُّث عن الأمد الطويل والطبقة الاجتماعية والبنية والعقلية والذاكرة وغيرها.
من هذه الزاوية، ترتبط عملية بناء النص بالتمرين الخطابي، بالكتابة، بإعادة الكتابة، بالصياغة اللسانية وتحسين هذه الصياغة، ببلورة مقولات ومفاهيم جديدة وباستعادة مقولات ومفاهيم قديمة، بالتعليق على كتابات ودراسات، وبالتعليق على التعليق، وكأن الأمر لا يعدو أن يكون كتابة على كتابة. إنها "تشكيلة خطابية" وفق قول ميشال فوكو. وعملية الكتابة وإعادة الكتابة هذه هي التي تفسر التجديد الحاصل باستمرار في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية.
لهذا يبقى التاريخ مادةً أدبية أولا وقبل كل شيء، مهما كانت الجهود الإسطوغرافية التي بذلها المؤرخون منذ القرن التاسع عشر في مختلف جامعات العالم لاكتساب العِلمية. في كتابه "الزمان والسرد"، يعود بول ريكور إلى قضية "عِلمية التاريخ" التي طرحت منذ القرن المذكور أو ما يسميه بِ "جهود المؤرخين للارتقاء بحقلهم إلى مستوى العلم"، ويناقش هذه القضية على ضوء أفكار الفيلسوف ويليام هيربيرت دْرايْ، الواردة في كتابه "القوانين والتفسيرات في التاريخ" (1957)، ليخلص معه إلى أن "التفسير في التاريخ لا يحتاج إلى قانون ليكون تفسيرا"، على الرغم من أن التفسير التاريخي يفترض التحليل السببي. وتكمن صعوبة "قانونية" التاريخ وارتباط فهمه بالتأويل إلى أن الحياة البشرية في الأصل، في تدفقها الاجتماعي والثقافي، استقرت في "تشكيلات متنوعة"، وفي "معايير" ذات صلة بما عبَّر عنه نوربير إلياس بِ "المظهر"، وما وصفه ماكس فيبر بِ "النموذج"، مما يدفع إلى القول إن "التأويل هو مسألة تفكير" ومسألة "معنى". إذا كان عمل المؤرخ يقضي باستحداث موضوعٍ وتشييده واستشكاله، على النحو الذي أبانت عنه المدرسة المنهجية، وبالطريقة التي تجدّد بها مع مدرسة الحوليات بفضل الاحتكاك بالعلوم الاجتماعية، فإن السرد يظل هو ذلك "الوسيط الضروري لصنع مؤلَّفٍ في التاريخ". فيرناند بروديل نفسه، الذي ابتكر مفهوم الزمن الطويل وطبّقه على "الحوض المتوسط" محوِّلا الاهتمام من شخص ملِك إسبانيا فيليبّي الثاني إلى مجال جغرافي في شخص هذا الحوض، ارتبط بطريقة أو بأخرى بما سماه بول ريكور بهذه "الهوية السردية"، على الرغم من المسافة التي اتخذها بالقياس إلى السردية التقليدية ذات الصلة بالأحداث السياسية والدبلوماسية. فقد ظهر الحوضُ المتوسط، في مؤلَّفه هذا، وهو "يعيش آخر أمجاده في القرن السادس عشر قبل أن تتحول الأمور باتجاه المحيط الأطلنتي وأمريكا، تلك المرحلة التي خرج فيها الحوض المتوسط من التاريخ الكبير".
لهذه الاعتبارات مجتمعة، يصعب القول بِ "عِلمية التاريخ" لثلاثة أسباب رئيسية.
أولا ارتباط التاريخ بالأرشيف وما يتضمنه هذا الأخير من نقائص بالضرورة؛
وثانيا ارتباطه بإقناع القارئ وما يتطلبه هذا الإكراه من تأويل؛
وثالثا ارتباطه بالسرد وضرورة إنتاج المعنى.
لقد بيَّن المؤرخ الأمريكي هايْدن وايْت، في كتابه "محتوى الشكل"، كيف يمثل السرد الحلقة الجوهرية في كل العملية الإسطوغرافية، لأنه في الوقت نفسه طريقة تتم بواسطتها بلورةُ التأويل التاريخي، ونمط خطابي تُفهم من خلاله القضايا التاريخية. هذه الفكرة كان قد عبَّر عنها بول ريكور، منذ عام 1952، تعبيرا فلسفيا لما قال إن التاريخ ينتمي إلى "إبستيمولوجية مختلطة"، "لأنه (أي التاريخ) ليس بعلمٍ صرفٍ محكوم عليه بالتخلي عن السرد، وليس بسردٍ صرفٍ بعيدٍ عن قواعد العلم". فالتاريخ في الأصل، أي في العصور القديمة، كان عليه أن يجد قواعد للتحقق من الأقوال، وأن يحافظ في الوقت ذاته على سمته الأدبية (هيرودوت). وخلال القرون الوسطى، اعتُبر التاريخ فرعا من فروع البلاغة، في إطار ما كان يسمى بِ "التريفيوم" أو المسلك الثلاثي الذي ضم النحو والبلاغة والجدل. وفي العصر الحديث، مع موجة التنوير بالخصوص، لما وقع في قبضة الفلاسفة الذين عملوا على تحريره من هيمنة الكنيسة وربطوه بتعاقب الإرادات البشرية، كان على المؤرخين، في سياق انتظام العلوم الإنسانية والاجتماعية انتظاما تخصُّصيّا، الذي ميز القرن التاسع عشر، أن يحصنوا ميدانهم المعرفي بالدعوة إلى ضرورة الاستناد إلى الوثائق لكتابة التاريخ، ضمن الحركة الوضعانية التي عرفها هذا القرن. وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين، وبفعل الاحتكاك مع علم الاجتماع ورائده إميل دوركايم، تجدّدت المعرفة التاريخية، لاسيما في فرنسا، بفضل جهود جيل من المؤرخين الشباب الذين أسسوا لتيار جديد حمل اسم الحوليات أو الأنال، فاتسعت دائرة المصادر لتشمل ليس فقط الوثائق المكتوبة وإنما كل ما من شأنه إضاءة الماضي وإقامة الجسور بين الماضي والحاضر، فتحولت اهتمامات الباحثين من البحث في تاريخ الأحداث إلى البحث في تاريخ البنيات. وهذا التغيُّر على مستوى المصدر والرؤية هو الذي مكّن من ظهور أبحاث جديدة همّت التاريخ الاجتماعي والثقافي.
هذا على المستوى النظري، أما على الميدان فشيء آخر. ما يظهر عمليا، هو توقف الباحثين عند المحطة الثانية، الأكاديمية الصرفة، المرتبطة بالمصادر والمراجع، أي مرحلة التوصيف، وعجزهم عن ولوج المرحلة الثالثة. بهذا الصدد، يقول المؤرخ الفرنسي ذي الأصل البولندي، إيفان جابلونكه في كتابه "التاريخ أدب معاصر": "في معظم الأحيان، لا يبلور [الباحثون] كتابةً، بل مجرد تقنيةٍ، أي تجميع للمصادر، توضيب للاستشهادات، وضع للإحالات في أسفل الصفحة، مع ترتيب كل هذه الأمور في تصميم ينتظم في مقدمة وفصول وخاتمة. ولذلك، لا ينتج المؤرخ نصاً، بل اللاَّنص: موضوع في الاختصاص، شكل بحثي صرف، لا روح له ولا لغة...".
من هذا المنظور، يؤكد إيفان جابلونكه، في هذا الكتاب النقدي القوي الموجَّه إلى المؤرخين وجميع المشتغلين في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، على تحديث هذه العلوم، بتوليد دراسات تجمع بين البحث العلمي والإبداع الأدبي. يقول، ولا أَفْضل بالنسبة إليّ من هذا القول لختم هذه الورقة:
"أدت مهنَنَة المعارف منذ القرن التاسع عشر إلى تقدم على مستوى المنهج، ولكن إلى تراجع من حيث الشكل والإحساس والنشوة... المشكلة هي أن إغفال الشكل وازدراء الكتابة يشكلان عقبات في وجه المعرفة برمتها، لأن عمليات التقدم الإبيستيمولوجي الكبرى (هيرودوت، شيشرون، بايْل، ميشليه، نيتشه، فوكو) كانت أيضا ثورات أدبية. بدون كتابة تبقى المعرفة ناقصةً، يتيمةً من حيث الشكل. هذا ما يدفعني إلى القول بأن الأدب لا يُضعف منهج العلوم الاجتماعية، بل يُقوِّيه، ويُعززه...
"كيف السبيل لجعل البحث لا يرتبط فقط بالاستشهاد والتعليق، ولكن بالإبداع أيضا؟... العودة إلى آداب القرن السابع عشر الجميلة خطأٌ، وتحويل التاريخ إلى رواية كبيرة على طريقة القرن التاسع عشر وهمٌ، والتشبث بالاختصاص الأكاديمي المفرط المعمول به اليوم استسهالٌ. بالإمكان الانفلات في آن واحد من أدبٍ بلا منهج ومن منهجٍ بلا أدب، لممارسة منهجٍ داخل الأدب...
"لكن التوفيق بين العلوم الاجتماعية والإبداع الأدبي قد يبعث على الخلط. ولذلك، إذا عرَّفنا، بنوع من الكسل، التاريخَ انطلاقا من "الوقائع" والأدب من خلال "القصة"، فقد يبدوان متنافرين. وإذا حكمنا على التاريخ بوصفه عملا جادّا وعلى الأدب باعتباره هواية، فإن الأول يكون مهنةً بينما الثاني يصير وقتاً ثالثا. لكن إذا اعتبرنا التاريخ تنقيبا والمؤرخ منقِّبا يمكن عندئذ استخلاص النتائج الأدبية من منهجه، منها: استعمال الضمير المتكلم للإشارة إلى موقع الكلام، وحكي البحث المنجَز، والاغتراف من هاجس السؤال، والانتقال بين الحاضر والماضي ذهابا وإيابا، واختلاق تصورات منهجية لتعميق فهم الواقع، ووضع الأصبع على المكان الملائم بين المسافة والإحساس، وإيجاد الكلمات المناسبة، والاهتمام بلغة الناس أحياءً وأمواتًا. هذه القواعد هي محركات العمل الأدبي، أي الأدوات المعرفية والأدبية التي تدفع الباحث إلى الكتابة وهو حريص على الرفع من صرامة البحث وعمق المقاربة. هنا تكمن نقطة الالتقاء بين التاريخ والأدب. فالتاريخ قبل أن يكون تخصصا جامعيا، كان سفرا في الزمان وفي المكان، وتنقيبا قائما على الاستدلال. والأدب، من دون الحاجة إلى التبعية للخيال، هو عملٌ حول اللغة، بناءٌ سردي، صوتٌ متفرد، انفعالٌ عاطفي، حالةٌ، وتيرةٌ، هروبٌ إلى مكان آخر، وأيضا قاعدةٌ صاغتها المؤسسات. لحسن الحظ، تتقاطع هذه التعريفات: التاريخ أدبٌ معاصر. فالمنطق الذي ننتج بفضله المعارف وننقلها إلى الآخرين هو قلبُ الكتابة النابض، ونبضُ النص. بهذه الطريقة، يمكننا ابتكار أشكال جديدة من العلوم الاجتماعية تتلاءم مع القرن الحادي والعشرين".
محمد حبيدة، جامعة ابن طفيل القنيطرة
بيبليوغرافيا باللغة العربية
- حبيدة (محمد)، المدارس التاريخية: برلين، السوربون، استراسبورغ. من المنهج إلى التناهج، الرباط، دار الأمان، 2018.
- ريكور (بول)، الزمان والسرد: الحبكة والسرد التاريخي، ج 1، ترجمة سعيد الغانمي وفلاح رحيم، مراجعة جورج زيناتي، بيروت، دار الكتاب الجديد، 2006.
- ريكور (بول)، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي، بيروت، دار الكتاب الجديد، 2009.
- فوكو (ميشال)، حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، بيروت/الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1987.
- وايت (هايدن)، محتوى الشكل. الخطاب السردي والتمثيل التاريخي، ترجمة نايف الياسين، المنامة، هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2017.
ا باللغات الأوروبية
- CERTEAU (M. De). L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975.
- DELACROIX (Ch.) et autres collaborateurs, Historiographies: Concepts et débats, 2 vol., Paris, Gallimard, 2010.
- JABLONKA (I.), L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil, 2e édition 2017.
- VEYNE (P.), Comment on écrit l’histoire. Essai d’Epistémologie, Paris, Seuil, 1971.
- WHITE (H.), The content of the form: narrative discourse and historical representation, Baltimore/London, John Hopkins University Press, 1987.