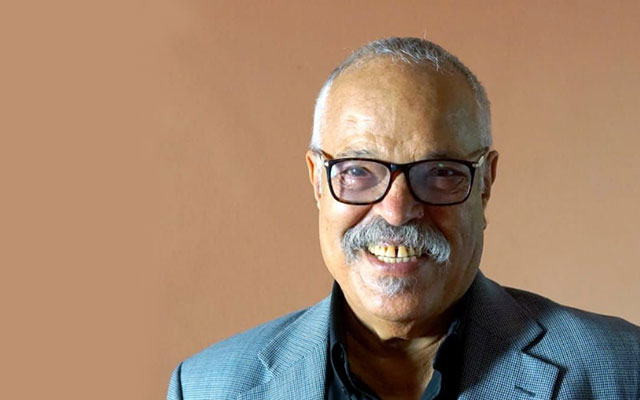في المسار الديمقراطي، يعتبر احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية أبرز مؤشرات تبني السلطة السياسية للخيار الديمقراطي. لقد بات هذا الأمر من المبادئ المؤسسة ومن بديهيات كل صيغ الأنظمة التمثيلية، منذ عصبة أمم آيروكواس التي استلهمت منها الثورات الكبرى وحتى الآن .تحول هذا الفهم، أو كاد، إلى حقيقة مطلقة في نظام مبني، نظريا، على رفض الإطلاقية، حتى أصبح فرضية، لدى الحاملين للمشاريع الديمقراطية، لا تحتمل أي نقاش وأية مساءلة وأي تناول نقدي مهما كانت الظروف والتحولات والمخاوف.
إن سقوط الفكر الديمقراطي في هكذا نمطية لهو، في اعتقادنا، أحد أبرز ملامح تراجع العمق الفكري في الممارسة السياسية في بلادنا وفي العالم من حولنا، منذ انتقال إدارة قضايا العالم والدول والشعوب من شأن لحقول المعرفة العلمية والتحليل العميق والتفكير الاستراتيجي، إلى مجال حصري على الحسابات السياسية و الجيوسياسية التي لا ترى سوى مصالح اللوبيات.
من واجبنا طرح العديد من الأسئلة على الدولة والحكومة والنخب وهي تغيب العديد من المعطيات والإكراهات والوقائع الناطقة باللون الأحمر، وكأن كل ما يفيد انتقالنا نحو الديمقراطية هو أجندة انتخابات 2021، دون اكتراث بقلق اجتماعي تحدث في الريف وجرادة والوطن، ودون أخذ تداعيات وباء عالمي على محمل الجد، ودون انتباه لاستعداد الناس، المعلن، عن معاقبة الفاعلين السياسيين، عبر هجر صناديق الاقتراع بشكل مفزع، ودون تعاط مع أرقام الفقر والهشاشة والعطالة ودون انكباب علم الاجتماع على نسب الطلاق والنزاعات العائلية والعنوسة والجرائم والإدمان والسكيزوفرينيا والعديد من الظواهر التي تصادر كل فرص نهوض المجتمع في اتجاه التقدم، أمام أنظار وصمت الجميع.
المثقفون، الذين قلبهم على البلاد والتنمية وحقوق الناس وقيمة الإنسان في معادلات العالم، يتحدثون في مثل هذه المنعطفات والمصالحات تعقد في هكذا أزمات، والإبداع في الأدب والفن والفلسفة والسياسة والعلاقات الدولية يرقى عندما يكون الناس، كما هم الآن، في حاجة إلى جرعات قوية من الأمل.
لقد اختزلت أحزابنا السياسية القضايا العميقة للمجتمع والمعضلات العالقة والطارئة للبلاد على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والقيمية، اختزلت كل ذلك في سباقها المحموم نحو الأغلبيات في المؤسسات المنتخبة حتى صار اهتمامها هو كل شيء، إلا أوجاع وانتظارات المواطنين بكل فئاتهم.
ورغم ما أكدته جائحة كوفيد -19 من اختلالات بنيوية في النموذج التنموي المعتمد مدة عقود وفي مقاربة الاستثمار ومن عدم قدرة الميزانية العامة على تحمل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم ومن هشاشة منظومتنا الاجتماعية، رغم كل هذا، لم يخرج اهتمام النخب السياسية عن النقاش التقنوي حول العتبات والتقسيم والقاسم وهلمجرا.. أشياء لا تشكل أدنى اهتمام، الآن، لدى جل المغاربة.
ملك البلاد، حدد أولويات البلاد في تأمين الوحدة الترابية وإنتاج الثروة وإنجاز متطلبات العدالة الاجتماعية وبناء منظومة اجتماعية كفيلة بضمان التعاضدية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل واعتبر هذا الورش الوطني والتنموي والاجتماعي مطروحا للإنجاز خلال الخمس سنوات المقبلة. الأمر، كما يبدو واضحا، تعزيز لمركزية الحقوق الترابية للمغرب في جدول أعمال الدولة وإعلان عن تصدر القضية الاجتماعية جدول أعمال الانتقال نحو الديمقراطية.
سنكون في حاجة، طبعا، إلى ذروة الوحدة الوطنية وتعبئة الموارد والكثير من الإيثار. وسنكون في حاجة إلى نخب تنسى الامتيازات ليتسنى انتقالنا إلى لحظة تاريخية تتجاوز إعلان النوايا والمبادئ وتبلغ تصورا يجمع ما بين مصالح كل الفئات و المصالح العليا للوطن.
إنه لمن دواعي الامتعاض أن تبقى نخبنا أسيرة منطق كلاسيكي، يظن أن الواجب الدستوري والسياسي والأخلاقي تجاه الوطن والناس، يقتصر على عقد اجتماعات القيادات وإصدار البلاغات وترقب العد العكسي للانتخابات. تعقيدات مراحل الانتقال وتطورات ملف الصحراء وضعف الناتج الداخلي الخام والوضع الاجتماعي العام، أمور تستدعي قوى فكرية وسياسية واجتماعية واقتراحية ذات رؤى وآراء ثورية لتستطيع أن تكون جديرة بالتوافق مع المؤسسة الملكية وبثقة الناس من جديد. المغرب الذي أنجب أبراهام السرفاتي وعزيز بلال وعبد الرحيم بوعبيد، وكاريزمات سياسية من العيار الثقيل أتقنت فنون التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي. والمغرب الذي من أبنائه البررة عبد اللطيف الجواهري ومصطفى التراب وإدريس جطو، و كفاءات تكنوقراطية خبرت جيدا دروب السياسة وتدبير الشأن العام. هذا المغرب قادر على التنقيب عن المؤهلات والمؤهلين الجديرين بإدارة المرحلة.
لا أحد نسي ما أحدثه ضعف المشاركة الشعبية في انتخابات شتنبر 2007 من إرباك وما أدى إليه من قرارات، ما زالت تداعياتها السلبية ترخي بظلالها حتى الآن. لذلك فإن سؤال لماذا نذهب قدما نحو مأزق آخر في ظرف أصعب وأخطر دون إعمال العقل الاستراتيجى والاتفاق على أن مصلحة البلاد تفرض، هنا والآن، حكومة ائتلاف وطني من كفاءات كل القوى التي تجمع بين الميولات الليبرالية والنزوع نحو دولة الرعاية الاجتماعية، سيكون السؤال مشروعا خاصة أنه لم يبذل أي جهد لتهييء ظروف إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وبالقيمة الحيوية للمشاركة الشعبية في الاستحقاقات.
سيجد القائمون على احترام الدستور، دون شك، المخرج حتى يتخذ قرار استثنائي يتناسب ووضع استثنائي لمواجهة تحديات استثنائية، تحديات لن تمهلنا كثيرا ولن تقبل البطء والتردد وهواجس المصالح الضيقة، بكل تأكيد.
لو كانت القوى المحسوبة على التوجه الديمقراطي وتلك المتبنية للخيار الليبيرالي جاهزة لإقناع الناخبين بالمشاركة المكثفة وبتصويت يحررنا من سياق ونتائج 25 نونبر 2011، لكنا نتحدث عن أية تحالفات تخدم الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية وطموحات المغاربة في عيش كريم. والحالة ليست كذلك، فلنتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدعوة لحكومة ائتلاف وطني، استرجاع عافية اقتصادنا في أمس الحاجة إليها والتأسيس والتأصيل لنموذج تنموي ينتج الثروة ويجد آليات توزيعها العادل في أمس الحاجة إليها وقضية وحدتنا الترابية في أمس الحاجة إليها وصيانة وحدتنا الوطنية في أمس الحاجة إليها ومجابهة الوباء وانعكاساته المنهكة للغاية في أمس الحاجة إليها.
أكيد أن هذا الرأي سيبدو نشازا أمام مسار المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية. وأكيد أن هناك من سيشهر ورقة الانتخابات الأمريكية ومراقبة الاتحاد الأوروبي لانتقالنا الديمقراطي... إلا أن ما يجب أن يسترعي اهتمامنا أكثر هو عدم ترك فرص التعايش مع العزوف ومع خريطة أتت بها مفاجآت التاريخ تدوم طويلا.
تلكم هي القضية.