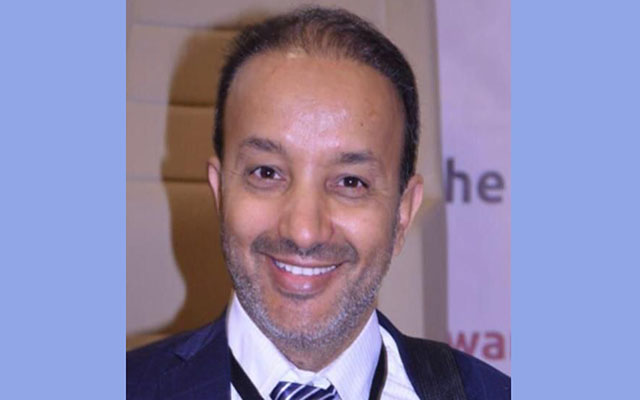من تجليات انحطاط الممارسة السياسية في بلادنا ليس فقط فساد النخب، وترهل البرامج وغياب الأحزاب، ولكن أيضا ضحالة النقاش السياسي بين الفاعلين. آخر الخرجات في هذا المضمار تقييم الكفاءات الشخصية للفاعل السياسي بدرجة التكوين الدراسي، والتسليم بان الحصول على درجة الدكتوراه، على سبيل المثال، مؤهل رئيسي لصدارة المنصة السياسية، ومقابلها لا أهلية لمن لا شهادة له. ومن هنا السؤال: متى كان الدبلوم شرطا لممارسة السياسية؟
للجواب عن هذا السؤال يكفي أن نستعرض أسماء السياسيين الذين تعاقبوا على تحمل المسؤوليات التنفيذية، الحكومية والحزبية والنقابية والمدنية لنجد أسماء عديدة كانت بلا دبلومات عالية، ومع ذلك نجدهم بارعين في الوفاء لمهامهم المتعينة، فيما نجد الكثير من خريجي المدارس العليا الوطنية والأجنبية بلا لسان خطابي، وبلا كاريزما، وبلا حس وطني، وبلا قدرة على التدبير التنظيمي. بل إن بعض هؤلاء الدكاترة والخبراء قد نجدهم يتورطون في ملفات ريع أو فساد أو فشل في التسيير...
نفس المثال ينطبق على الساحة العالمية، ولنكتف على سبيل التمثيل بدول من آسيا أو أمريكا الجنوبية، حيث نجد العمال والحرفيين والموظفين البسطاء يترأسون الحكومات والنقابات والهيئات غير الحكومية، ويؤسسون لمنعطفات كبرى في تاريخ بلدانهم، ولا أحد هناك طرح سؤال الدبلومات لأن العبرة بنتائج التدبير لا بالشهادات.
وإذن فالوقت قد حان لوقف هذا الحديث المغرق في الشعبوية، والذي يعطي الإمتياز لمن (ولما) لا امتياز له على أرض الواقع، حيث الامتياز الحقيقي هو للكفاءة الشخصية، وللخبرة الميدانية، ولعلو الحس المواطناتي، وقبل هذا وذاك للوفاء لانتظارات المواطنين، وللتجاوب مع مطالبهم في الحق في العيش الكريم. أما الباقي فتتولاه نظم المؤسسات الحزبية والنقابية والمدنية ولجانها وبنياتها وخبرائها. ألسنا المطالبين بدولة المؤسسات؟ وهو المطلب الذي توارى مع المطالب الأخرى الحيوية إثر هيمنة الخطاب الشعبوي، وضعف النخب مقابل استئساد الأصوليين.
ولأن الطبيعة لا تقبل الفراغ فهؤلاء (الأصوليون) هم الذين يهددون بحجز المغرب تشريعيا طيلة السنوات الخمسة القادمة. فقط لأننا صرنا بلا بوصلة، ولذلك صرنا نهدر الزمن النفسي والسياسي بجدل فارغ حول من له الشهادات، ومن بلا شهادات.. إنها واحدة من علامات بؤس خطابنا السياسي !.