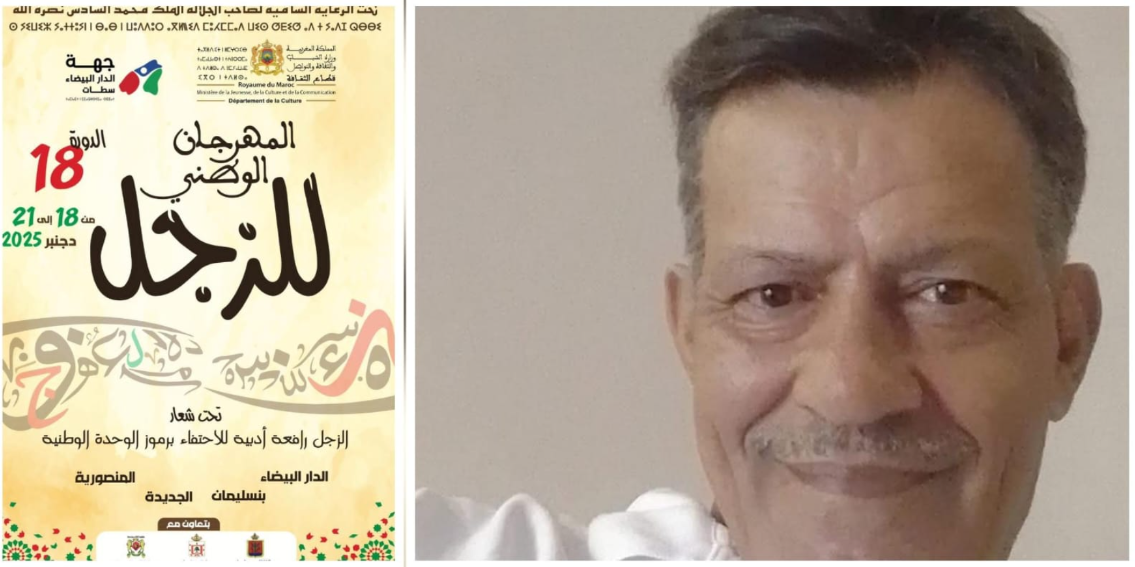طل نائب التنظيم العالمي للإخوان المسلمين المغربي أحمد الريسوني، بعد هذه المدة من اعتقال توفيق بوعشرين، باطرون مؤسسة ميديا 21، ليقول من الآخر: «النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل».
خلاصة الفقيه المقاصدي مشبوهة، بحكم الوسائل التي انتهت إليها فتواه، فقد استعمل في كل الحجج التي برر بها رصاصته تجاه الضحايا والمحكمة لم تقل كلمتها النهائية بعد، تماما كما هو حال المتهم توفيق بوعشرين، آلية سماع بعيد وآخر مجروح وقياس معيب.
تدهشك هنا جرأة الرجل وهو يؤكد هذه الخلاصة، لذلك فالعملية برمتها، تخطيطا وتنفيذا وأشخاصا، قادمة من دهاليز مؤامرة مخدومة؟! فماذا عن ضحايا لم يكن في عداد المشتكيات المستقدمات لاغتصاب المتهم فوجدن أنفسهن أمام فضيحة مصورة بالصوت والصورة، أكدن صحة وقائعها بالدقيقة والثانية، لم يجدن بدا من تجرع سم تشتيت عائلاتهن، ووضع زوج ودود في عين إعصار. لا يمكن لمن ينصت لصدى أذنه أن يشعر بإحساس الغير بالغبن والخسارة الكبرى في مسير حياة توقف فجأة، بفعل صدمة مدوية يستحيل أن يتقمص فيها دور ممثل لقصة مؤامرة خيالية وخالية من شعور بالذنب، ناهيك عن شماعة الاعتقال المخدوم والممل والممجوج والمقرف والهزيل والهزلي والمقزز في هذه القضية المؤسفة العادية الأركان، سواء للمتهم، أو المشتكيات والضحايا، في انتظار انبلاج الحقيقة قضائيا. فلماذا هذا التهويل والتخوين والتشكيك المسبق؟
أحمد الريسوني استعان بصبر لا حدود له، فقد تابع أطوار القضية عبر وسائل الإعلام، واستمع إلى تعليقات الناس واستنتاجاتهم، وتأمل فيما قرأ وسمع، واستنتج أن «أول ما لفت انتباه الناس وصدمهم هو الأخبار المتلاحقة حول طريقة الاعتقال وما رافقها من أعمال لوجيستية واستباقية واحتياطية، سريعة ومباغتة ومنسقة، تشبه تلك التي تكون في العمليات العسكرية الخطيرة».
استدعاء هذا القاموس الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، لم يتحدث عنه حتى «مخبولو» الفايس بوك، ولم تستعمله أية وسيلة إعلامية بما فيها منشور المتهم، فهو حمام بركان ظل يغلي في جوف الرجل وهو يتأمل ويتريث، قذفه هكذا بدون مسوغ، ليعري حقيقة تريثه وتأمله المجرد، بل وفضح الزاوية التي كان يطل منها على أحداث القضية.
وزيادة في تنسيب المعجم والهوى، اختار الرجل حوار «الجار» الذي وجد فيه هواه، ولذلك يخبرنا أن «من أوائل ما سمعته من تعليقات، تعليق ساخر لأحد الجيران حين قال لي: يبدو أنهم قد عثروا على أسامة بن لادن في الدار البيضاء، فقلت له: أظن أنه أبو بكر البغدادي، الذي تحدثت بعض المصادر بأنه قد تسلل مؤخرا إلى شمال إفريقيا».
هذا التهويل لإجراء قضائي وأمني مسنود انتهى الجدل فيه مع البيانات الأولى للمؤسسة الأمنية والقضائية، لم يتزحزح الشك فيه في دواخل الريسوني، ولذلك استعان بحكم المتصوفين ليخرج بوجد وشطح صوفي مغرق في البله قائلا: «وبناء على قول حكماء الصوفية «ألسنة الخلق أقلام الحق»، فقد أنصت كثيرا – وما زلت أنصت – إلى عامة الناس، رجالا ونساء شيبا وشبابا، فلم أجد إلا من يجزم أن القضية «مخدومة» وفيها «إن»، ولم أجد أحدا يصدق الروايات الرسمية أو يحملها على محمل الجد».
وبعد هذا السير على حبال الفقه والتصوف والمقاصد ينتهي ابن العرائش إلى ملفوظ الإجماع المغربي، ليضع النقط والوقف على حروف التشكيك المترامي الأطراف، ويزرع فوضى خلاقة في الأحداث والسياق، ليعتبر أن القضية برمتها فيها «إن».
ألم يكن حريا بالمفتي أن يتحرك بضع كيلومترات للإنصات للضحايا لاستكمال رصيده من التريث والصبر؟
عار أن يذهب المفتي لحكم قاطع، بينما فتواه لم تبرح أذنه وهوى تتبعه.
عار أن تتحول المؤسسات والقوانين لتأويل بالسماع.
عار أن يبقى المفتي في مقامه الوثير ومجزرة تدمير سمعة المشتكيات والضحايا متواصلة.
عار أن يتم نفي فرضية الصدق عن مواطنات مشتكيات، لأنهن عورات في وجه ذكر، محتمل الخطأ في سلوكه.
عار أن يكون هذا الخطاب ولغته الحبلى بالاتهام في هذا التوقيت من عمر القضية.
عار أن يتحالف هوى القبيلة مع هوى نفس لامتصاص دم فريسة وما بقي في شرايينها دون شبع.
لكن السؤال المحير هو أن يتحول الاصطفاف، الذي أطلق مع بداية المحاكمة، لدى فقيه إلى لغة حربية. فأي علة حركت كل هذا الوقار والسكون المفترض؟