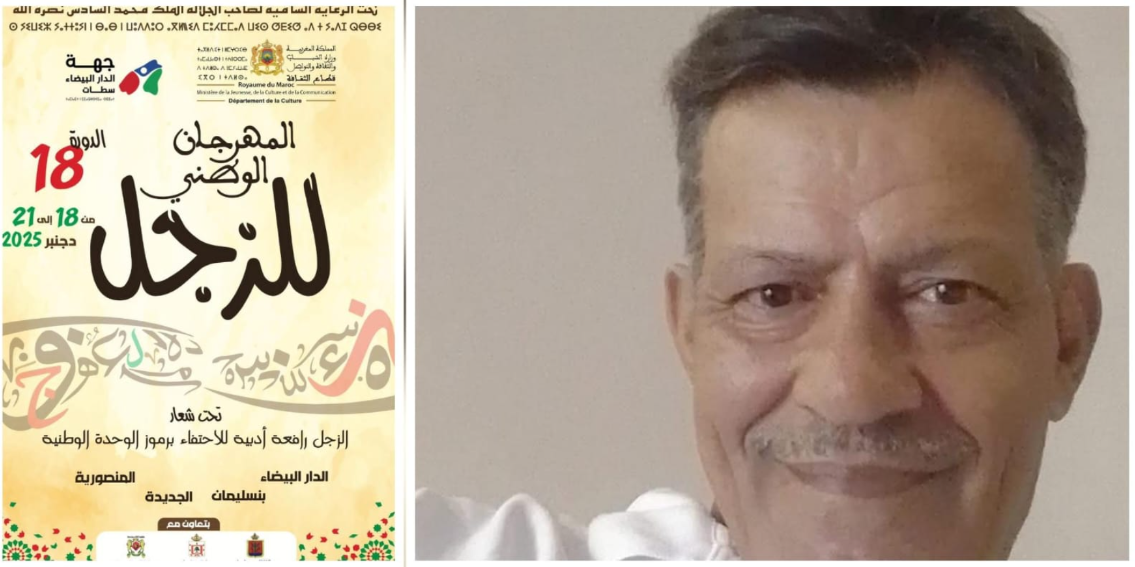لا يمكن الحديث عن جودة المخيمات الصيفية دون أن نضع أيدينا عارية، على الجرح المفتوح: وضعية أطر المخيمات. هؤلاء الذين يُطلب منهم أن يكونوا مربّين، منشّطين، حراس قيم، مسعفين نفسيين، ومبدعين… بلا أجر.
نعم، نشتغل بمنطق التطوّع حين يتعلق الأمر بالأجر، ونستدعي منطق الوظيفة العمومية حين يتعلق الأمر بالمحاسبة. مفارقة مغربية خالصة: العمل بالمجان، والمساءلة بمنطق وضعية المعلم عند يتعلق الأمر بالمسؤوليةالقانونية.
فلا ميزانية مخصصة للأجور، ولا تعويضات تحفظ الحد الأدنى من الكرامة المهنية، ومع ذلك نرفع سقف التوقعات ونطالب بجودة التأطير. كيف ننتج الجودة من الهشاشة؟ كيف نطلب الاستقرار التربوي من أطر تشتغل تحت ضغط الحاجة، والإرهاق، وانعدام الاعتراف؟
النتيجة معروفة سلفا: نزيف الكفاءات. الأطر الجيدة تغادر، أو تنسحب بصمت، أو تشتغل بنصف طاقتها، لا لضعف الالتزام، بل لأن الالتزام وحده لا يطعم خبزا ولا يداوي احتراقا.
ثم ننتقل إلى ملف الابتكار والإبداع، فنكتشف فراغا آخر. لا منح للتميز، لا تحفيز على المبادرات الخلاقة، لا دعم للمشاريع التربوية النوعية داخل المخيمات. الجميع متساوٍ في الإهمال.
في دول تحترم الطفولة، يُكافأ المبدع، ويُحتفى بالمبتكر، وتُموّل الأفكار التي تُحدث الفرق. أما عندنا، فالإبداع ترف غير مدرج في الميزانية، وكأن المخيم فضاء حراسة فقط، لا مختبر تربية وبناء شخصية... وأرقام يتشدق بها الوزير تحت قبة البرلمان في مقاربة كمية قاتلة لا نوعية متجددة.
وإذا انتقلنا إلى الجامعات الشبابية، فالصورة أكثر قتامة. لا منح تحفيزية للمشاركين، لا منح للتميز، لا تكفّل شامل، بل بعض الجمعيات تلزم الشباب برسم تسميه رمزيا للمشاركة، وعلى المشارك أن يتدبر تكلفة النقل...
لن نتحدث... عن مخيمات مؤداة عنها من لدن الأسر، مع اختلاف الأسعار، حسب الواقع الجمعوي.
وأحيانا حتى شروط كرامة إنسانية في الإيواء تختلف من جمعية وأخرى حسب درجة الولاء لا العطاء.
شباب يُطلب منهم أن يفكروا في فضاءات الجامعات الصيفية والربيعية وحتى الخريفية، أن يناقشوا، أن يقترحوا، أن يتكوّنوا… ولا مراقبة عن قرب لأجواء الجامعات ولا لجودة المكونين وجدية المسار...والشباب غير المحظوظ منشغل بسؤال: كيف ننام؟ كيف نأكل؟ كيف نتحمّل؟
ففي نماذج دولية متقدمة، يحصل الشباب المشاركون في الدورات التكوينية على منح مشاركة، وتُخصص جوائز للتميز، لأن الاستثمار في الشباب ليس شعارا بل سياسة عمومية. وهناك حيث يُؤدى مدربو ومديرو وأطر المخيمات بأجور محترمة، ترتفع الجودة تلقائيًا، لأن الكرامة المهنية تصنع الأداء الجيد.
الجودة لا تُفرض بالبلاغات، بل تُشترى بالاختيارات.
واليوم، ومع الانطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من العرض التخييمي عبر منصة الوزارة، تحت مسمى “التعبير عن الاهتمام”، نعود إلى المسرحية الرقمية المألوفة. مسار طويل، معقّد، متاهة تقنية، تنتهي — كالمعتاد — بالعودة إلى الملف الورقي.
وكأن المنصة الرقمية مجرد ديكور حداثي، لا أداة يقين قانوني. نرقمن الشك، ثم نؤكده بالورق.
لكن السؤال الحقيقي، الذي يهمّنا الآن، أبسط وأخطر:
ما مآل مخرجات المناظرة الوطنية للتخييم؟
مناظرة استنزفت أموالًا عمومية، وأُنجزت في ظروف مخملية، أشرفت عليها شركة وفّرت كل شيء… إلا ما يهم بعد ذلك: التنفيذ.
وأقولها بوضوح:
المناظرة ليست ترفًا فكريًا.
المناظرة ليست حملة تواصلية.
المناظرة ليست صناعة إعلامية لتلميع الصورة.
المناظرة محطة تشخيص، تفكير جماعي، اقتراح بدائل، وصياغة حلول. وبعدها، تصبح الكرة في ملعب القطاع الوصي، لا في قاعة الفندق.
المشاركون لم يحضروا للسياحة، ولا للنياحة، ولا لتكريس طقس بروتوكولي يخدم صحبة إعلامية عابرة. حضروا لأنهم صدّقوا أن ما سيُقال سيتحوّل إلى سياسات.
انتظرنا — على الأقل — مقاربة تنفيذية، أو مشاريع قوانين، أو مراسيم تنظيمية، ترى النور قبل انطلاق الموسم التخييمي.
لكننا اليوم على أبواب موسم جديد، دون وفاء بوعد فتح مراكز تخييم جديدة، ودون وضوح في مصير تلك التي “أُخضعت للصيانة”.
التوصيات؟ في رفّ النسيان.
لأن الهدف، يبدو، قد تحقق: صخب إعلامي.
صور رسمية.
ولائم خمسة نجوم... وكثير من الوهم..
أما أموال الطفولة، فتُستثمر في الطموح السياسي، لا في فضاءات الطفولة، ولا في برامجها، ولا في أطرها.
والسؤال الذي سيبقى معلقًا، مهما تغيّرت المنصات والشعارات: هل نريد مخيمات تُشبه الأطفال… أم تُشبه صور الوزراء؟
نعم، نشتغل بمنطق التطوّع حين يتعلق الأمر بالأجر، ونستدعي منطق الوظيفة العمومية حين يتعلق الأمر بالمحاسبة. مفارقة مغربية خالصة: العمل بالمجان، والمساءلة بمنطق وضعية المعلم عند يتعلق الأمر بالمسؤوليةالقانونية.
فلا ميزانية مخصصة للأجور، ولا تعويضات تحفظ الحد الأدنى من الكرامة المهنية، ومع ذلك نرفع سقف التوقعات ونطالب بجودة التأطير. كيف ننتج الجودة من الهشاشة؟ كيف نطلب الاستقرار التربوي من أطر تشتغل تحت ضغط الحاجة، والإرهاق، وانعدام الاعتراف؟
النتيجة معروفة سلفا: نزيف الكفاءات. الأطر الجيدة تغادر، أو تنسحب بصمت، أو تشتغل بنصف طاقتها، لا لضعف الالتزام، بل لأن الالتزام وحده لا يطعم خبزا ولا يداوي احتراقا.
ثم ننتقل إلى ملف الابتكار والإبداع، فنكتشف فراغا آخر. لا منح للتميز، لا تحفيز على المبادرات الخلاقة، لا دعم للمشاريع التربوية النوعية داخل المخيمات. الجميع متساوٍ في الإهمال.
في دول تحترم الطفولة، يُكافأ المبدع، ويُحتفى بالمبتكر، وتُموّل الأفكار التي تُحدث الفرق. أما عندنا، فالإبداع ترف غير مدرج في الميزانية، وكأن المخيم فضاء حراسة فقط، لا مختبر تربية وبناء شخصية... وأرقام يتشدق بها الوزير تحت قبة البرلمان في مقاربة كمية قاتلة لا نوعية متجددة.
وإذا انتقلنا إلى الجامعات الشبابية، فالصورة أكثر قتامة. لا منح تحفيزية للمشاركين، لا منح للتميز، لا تكفّل شامل، بل بعض الجمعيات تلزم الشباب برسم تسميه رمزيا للمشاركة، وعلى المشارك أن يتدبر تكلفة النقل...
لن نتحدث... عن مخيمات مؤداة عنها من لدن الأسر، مع اختلاف الأسعار، حسب الواقع الجمعوي.
وأحيانا حتى شروط كرامة إنسانية في الإيواء تختلف من جمعية وأخرى حسب درجة الولاء لا العطاء.
شباب يُطلب منهم أن يفكروا في فضاءات الجامعات الصيفية والربيعية وحتى الخريفية، أن يناقشوا، أن يقترحوا، أن يتكوّنوا… ولا مراقبة عن قرب لأجواء الجامعات ولا لجودة المكونين وجدية المسار...والشباب غير المحظوظ منشغل بسؤال: كيف ننام؟ كيف نأكل؟ كيف نتحمّل؟
ففي نماذج دولية متقدمة، يحصل الشباب المشاركون في الدورات التكوينية على منح مشاركة، وتُخصص جوائز للتميز، لأن الاستثمار في الشباب ليس شعارا بل سياسة عمومية. وهناك حيث يُؤدى مدربو ومديرو وأطر المخيمات بأجور محترمة، ترتفع الجودة تلقائيًا، لأن الكرامة المهنية تصنع الأداء الجيد.
الجودة لا تُفرض بالبلاغات، بل تُشترى بالاختيارات.
واليوم، ومع الانطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من العرض التخييمي عبر منصة الوزارة، تحت مسمى “التعبير عن الاهتمام”، نعود إلى المسرحية الرقمية المألوفة. مسار طويل، معقّد، متاهة تقنية، تنتهي — كالمعتاد — بالعودة إلى الملف الورقي.
وكأن المنصة الرقمية مجرد ديكور حداثي، لا أداة يقين قانوني. نرقمن الشك، ثم نؤكده بالورق.
لكن السؤال الحقيقي، الذي يهمّنا الآن، أبسط وأخطر:
ما مآل مخرجات المناظرة الوطنية للتخييم؟
مناظرة استنزفت أموالًا عمومية، وأُنجزت في ظروف مخملية، أشرفت عليها شركة وفّرت كل شيء… إلا ما يهم بعد ذلك: التنفيذ.
وأقولها بوضوح:
المناظرة ليست ترفًا فكريًا.
المناظرة ليست حملة تواصلية.
المناظرة ليست صناعة إعلامية لتلميع الصورة.
المناظرة محطة تشخيص، تفكير جماعي، اقتراح بدائل، وصياغة حلول. وبعدها، تصبح الكرة في ملعب القطاع الوصي، لا في قاعة الفندق.
المشاركون لم يحضروا للسياحة، ولا للنياحة، ولا لتكريس طقس بروتوكولي يخدم صحبة إعلامية عابرة. حضروا لأنهم صدّقوا أن ما سيُقال سيتحوّل إلى سياسات.
انتظرنا — على الأقل — مقاربة تنفيذية، أو مشاريع قوانين، أو مراسيم تنظيمية، ترى النور قبل انطلاق الموسم التخييمي.
لكننا اليوم على أبواب موسم جديد، دون وفاء بوعد فتح مراكز تخييم جديدة، ودون وضوح في مصير تلك التي “أُخضعت للصيانة”.
التوصيات؟ في رفّ النسيان.
لأن الهدف، يبدو، قد تحقق: صخب إعلامي.
صور رسمية.
ولائم خمسة نجوم... وكثير من الوهم..
أما أموال الطفولة، فتُستثمر في الطموح السياسي، لا في فضاءات الطفولة، ولا في برامجها، ولا في أطرها.
والسؤال الذي سيبقى معلقًا، مهما تغيّرت المنصات والشعارات: هل نريد مخيمات تُشبه الأطفال… أم تُشبه صور الوزراء؟
خالد أخازي، كاتب وإعلامي