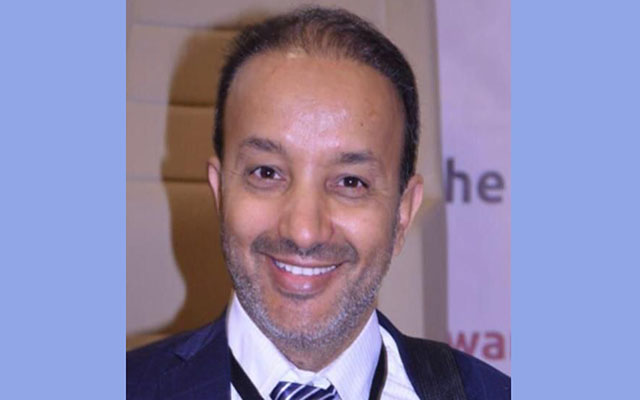في الحاجة إلى تأهيل ديناميات الحماية الاجتماعية والعمل النقابي والدفاع المدني، عنوان عريض ومكثف ، سنضطر لترديده على امتداد عهد ما بعد دساتير سنوات الرصاص، ذلك العهد الذي لا يريد أن يمضي قدما، بتوقف مسلسلات التجاوز وإجهاض كل التراكمات التي من شأنها القطع مع الانتهاكات والخروقات الجسيمة وغيرها، سنظل نردد هذا المطلب تجاه الدولة وتجاه أنفسنا، في إطار نقد الذات دون جلدها، فنحن في وضع حساس جدا، تحاصرنا هشاشة الأفق والقوة والتواصل البيني، دون الحديث عن انهيار قيم الديموقراطية الداخلية، واستئساد البيروقراطية النقابية والأريستوقراطية العمالية، واقعا وتمثلات، وتحول العمل الجماهيري، في جميع واجهاته وتداعياته الاجتماعية والنقابية والجمعوية والقطاعية والفئوية، واتخذ منحى الابتزاز الانتخابي والسياسوي أو الارتزاق المادي والنفعوي، طبعا علينا أن نقارب هذا التشخيص السريع بنسبية عالية جدا، ولكن بكثير من الجدية والمسؤولية، فرغم أن سؤال « من يؤطر من؟» يطوق طموحنا، منذ سنوات، فإنه حان الوقت لتقييم مسار استراتيجية النضال الديموقراطي، باعتبار أن سلوك الدولة الاجتماعي والأمني هيكلي، ولا يمكن أن يتجلى واضحا في السياسات العمومية، بقدر ما يهمنا الانكباب علي الاختلالات التي تنخر الشرط الذاتي لكل الهيئات والتنظيمات، وصحيح أن الاستعمار والقمع المنهج والاضطهاد السياسي أنهك قوى التحرر والديموقراطية والتقدم عالميا ووطنيا، لكن هذا لا يبرر تراخينا وخفوت وهجنا الكفاحي، حتى لا نقول «القتالي»، فهل الأمر يتعلق، فقط، بتحريفية شابت الخطوط السياسية والخيارات الاستراتيجية / الفكرية أو المذهبية؟ أم أن هناك تسويات وتعاقدات فوقية لا زالت تقيد المعنيين بتدبير القضايا المصيرية للوطن، منذ حركة التحرير الوطني، إلى الانخراط المدني في مطلبيات الديموقراطية التشاركية وتعثرات مطلب الديموقراطية التمثيلية وما رافقها من تدليس وتزوير للإرادة الشعبية، وتشكيك في هويتنا الجدلية والمتعددة، وتخوين لمعتقداتنا وقدراتنا وإهدار لطاقاتنا وطمس لبوصلتنا، يبدو أنه ينبغي استخلاص الدروس من الأخطاء المقترفة من قبل القيادات، التي كانت وطنية قولا وواقعا، ولكن لم تفلح في أن تتمثل الفكر الديموقراطي وثقافة الاختلاف والتعددية والتنافس الشريف، ولم يكن يميزها، عن الحاكمين سوى فقدان السلطة والقوة ودعم «الخارج»، وبذلك يمكن الإقرار بأن تاريخنا السياسي، تعايش قسرا مع الواقع المرير، الذي عنوانه سنوات الجمر ومقتضيات الحكم الفردي المطلق، التي هربت الحلم الاستقلالي وأجهضت اللحظات الديموقراطية في المهد، مما أفقدنا حلقات كثيرة، مهيكلة ومؤسسة، وسهل عمليات إضعاف المواقع والمواقف، فانخرطنا في مسلسلات الإنقاذ والتسويات، والتي ضاعفت من هشاشة الديناميات والمبادرات، حيث استثمرها النظام السياسي لفائدته بدل الوطن أو الدولة علي الأقل، مما يستدعي ضرورة العمل على تأهيل الذات، بعد فتح نقاش عمومي، لتقييم العلاقات وتقويم الإعاقات، من خلال تقييم مسار تفعيل التعاقدات، وحتى التسويات، اعتبارا من وثائق الاستقلال، وثائق متعددة ونوعية، وتوصيات المناظرات وكذا التسويات التي تحولت إلى صفقات، باسم التراضي والتوافقات، ولعل أهم ما ينبغي التركيز عليه، هو تحليل مقتضيات تصريح فاتح غشت وتوافق فاتح محرم الشهيرين، المهيكلين لما يسمى باستتباب السلم الاجتماعي، والمتعارض مع قانون الصراع الاجتماعي والنضال النقابي والسلمي المشروع، ولما لا؟ البيئة التي وفرها لتسهيل التناوب التوافقي حول تدبير الشأن العمومي، وما نتج عنه من قرارات حكومات المجاز والظل والواجهة، وما تقييم أهمية دور الأحزاب في هذا المجال، ومدى نجاعته وجودته، سوى لكون النقابات تابعة لها وخاضعة لناموس الذيلية والالحاقية، المضرة بالحرية والاستقلالية في الاقتراح والقرار، فلا يمكن بتاتا تجاهل مصادر قرار شن الإضرابات العمالية المغلفة أو المؤطرة، إن صح التقدير، للانتفاضات الشعبية، وكل ذلك من باب النقد والمحاسبة، على الأقل في علاقة ذلك بالكلفة وحجم التضحيات، ومن باب رصد مؤشرات التكرار، تكرار الانتهاكات الدولتية والأخطاء الذاتية، فماذا حققنا، بعد كل هذه المسارات والاخفاقات والتعثرات؟ بل ما الذي لم يتحقق رغم كل التضحيات؟ أسئلة وغيرها كثير، نطرحها على أنفسنا في ظلال الاحتفال بذكرى تحرير وثائق المطالبة بالتحرير، وما يقتضيه الأمر من احتفاء بالمغاربة الذي ضحوا بالحياة المقدسة كحق مطلق، مع التشديد، أسفا وتحفظا وحسرة، على التوجسات والهواجس التي تنتاب جيلنا المخضرم، وتؤرق راحة انشغالاته، والتي تفاقمت إلى حد فوبيا مزمنة، تسكن بين ثنايا ثنائية الانعتاق من أجل الحياة والاعتقاد في سبيل الممات، أي وفاة الوطنية و الروح النضالية وإعدام الكرامة الإنسانية، فإذا كاتن ثورتنا موؤودة فلا خلاص إلا بالثورة على كينونتا وعلى البيئة المنتجة لتراخينا عوض تاريخنا.
آخر الأخبار
- عبد الرفيع حمضي: الديمقراطية في زمن الشك
![]()
- فرنسا تمنع إعلان استقلال القبائل وتثير جدلاً واسعاً
![]()
- ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا داميا على سوق عيد الميلاد وتعتقل ثلاثة مغاربة
![]()
- ورشة تكوينية بالصويرة حول التغطية الإعلامية للانتخابات
![]()
- لعروسي: أحمد سكونتي.. حين تستعيد اليونسكو معنى الثقافة
![]()
- البطولة الإحترافية ممثلة في كأس أمم إفريقيا بستة لاعبين
![]()
- بوشيخي يصدر "تفكيك السلفية.. تحولاتها وتحوراتها من مجالس العلم إلى جبهات القتال"
![]()
- توقيف 14 شخصًا في شغب رياضي بالدار البيضاء
![]()
- وزارة الشباب والثقافة تنفي "تهجير" كتب ووثائق المكتبة العامة بتطوان
![]()
- الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية تطلق ماستر مبتكرًا لتعزيز قدرات العمل الاجتماعي
![]()
كتاب الرأي
-
عبد الرفيع حمضي: الديمقراطية في زمن الشك ...
السبت 13 ديسمبر 2025 -
لعروسي: أحمد سكونتي.. حين تستعيد اليونسكو معنى الثقافة ...
السبت 13 ديسمبر 2025 -
مهدي لحلو: مسألة إعادة القبول والهجرة العكسية والموقف الرسمي للمغرب ...
السبت 13 ديسمبر 2025 -
عبد الإلاه القصير: من الصحراء المغربية إلى القفطان المغربي.. ...
السبت 13 ديسمبر 2025 -
يوسف غريب: من تقسيم الصحراء إلى تقسيم القفطان وبينهما نظام ...
السبت 13 ديسمبر 2025 -
منير لكماني: ثروة معلقة ...
السبت 13 ديسمبر 2025 -
الغالي محمد علي: الإعاقة وتحديات الرقمنة والذكاء الإصطناعي.. آفاق المكاسب ...
السبت 13 ديسمبر 2025
حاليا في الأكشاك
الأكثر مشاهدة
-
الدار البيضاء.. 14 فنانًا يشارك بمعرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات ...
الاثنين 8 ديسمبر 2025 -
المقاتل المغربي أسامة عسلي يُتوج بطلا للعالم في وزن 77 ...
الاثنين 8 ديسمبر 2025 -
بسبب شبهات منافسة غير مشروعة في سوق الأعلاف.. مجلس المنافسة ...
الاثنين 8 ديسمبر 2025 -
بني ملال.. حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية يجددون مكتبهم النقابي ...
الاثنين 8 ديسمبر 2025 -
نصف قرن على مأساة طرد المغاربة من الجزائر.. ذاكرة ضد ...
الاثنين 8 ديسمبر 2025 -
قبيلة تجكانت تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية وتنتخب منسقها داخل ...
الاثنين 8 ديسمبر 2025
استطلاع للرأي
Copyright © 2014 - 2025 ( Ariri Abderrahim ) - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية. Tous droits réservés.