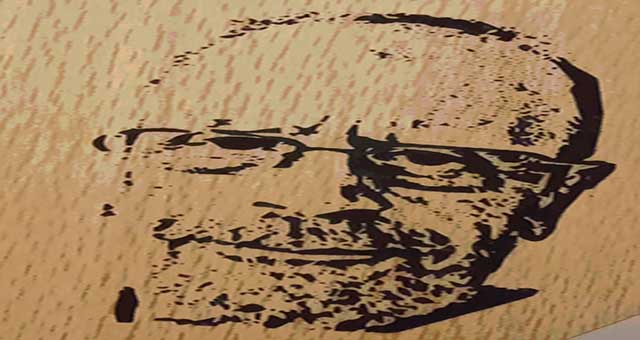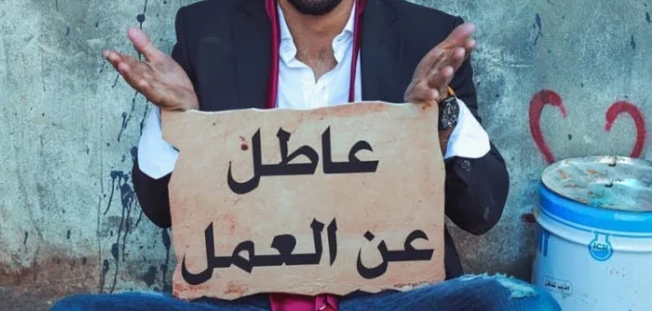بدأت العطلة الصيفية، بدأت المخيمات الصيفية، التي لم تعد كافية للأعداد المتزايدة الراغبة في ذلك في القطاع العمومي وحتى لدى الشبه عمومي والخاص، وستظل هناك قضايا معلقة لن نتنازل عنها ولن نحيد مهما فرضت الجهات المسيطرة اليوم على القرارات المتعلقة بذلك.
ان النضال الذي راكمته الجمعيات المولودة من رحم الحركة الوطنية، في زمن كان فيه بناء المغرب الجديد هدف وفعل يومي ونضالي وتضحية مليئة بالآمال والجهد والبدائل في افق الخروج من الاستعمار والتعبية والتخلف؛ وحققت به ومن خلاله مكتسبات كبيرة في ميدان المخيمات الصيفية وبالأساس الاعتراف بمكانة هذه المؤسسة في التنشئة الاجتماعية، العمل على تعبئة لتعميم حق التخييم على كل الأطفال، لا يمكن أن نحيد عنه نحن كهيئات تربوية ولا كأجيال تعاقبت في العقود السابقة خدمة لهذه الأهداف.
لقد عرفت المخيمات في توجها نحو مأسستها وتحديث تنظيماتها، بإسناد الإشراف عليها وتسييرها إلى قطاع حكومي راكم باعا طويلا وتجربة ودراية بالملف دعمه بأربع مناظرات التأم فيها كل المتدخلون وتظافرت جهودهم للرفع من مستوى الأداء سواء للقطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص، هذا الأخير الذي أصبح اليوم يمثل أكثر من تدخل القطاع العام في الموضوع عددا ونوعا وتحديات.
إن العارفين بالأمور يعلمون حالة تدني المخيمات وتجهيزاتها والتي تتوضح في محدودية الفضاءات الخاصة بالتخييم التي كلما زادت واحدا الا وأقفلت آخر والتي تدور حول الخمسين مخيما تقريبا أغلبها تأسس منذ فترة الاستعمار والجدد منها محدودة ،و ضعف مستوى بل واندثار وتآكل وتقادم تجهيزات وأدوات التخييم في مراكز الدولة بالخصوص معروف لدى القاصي والداني ،ولن نتوقف كثيرا عند وصفه فقد كتب الكثير في الموضوع على صفحات الجرائد وفي التقارير الرسمية والجمعوية ومنه المأساوي ومنه المكرر ،ولكن فقط لكي نسجل اليوم هذه الاشكالية التي هي جزء من ملف المخيمات الذي تجب مراجعته ككل.
سنعرض لثلاثة نقط فقط في هذا العرض لنذكر بها وباننا لن نتخلى عنها ولو انها فرضت علينا فرضا وتبثها البعض أنها الأصل ولن نحيد عنها، وعمل الضغط الرسمي في تحضير المواسم وتدبيرها عليها كمسلمات، بل ومن المستحدثين من يعتبرها عادية وأصلية.
الإطار القانوني:
في غشت 2021، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.186 المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي خاص بهذه المراكز، يحدد الشروط الأساسية لتحسين خدماتها وضمان جودتها، واعتماد آليات تؤطر كيفية استفادة الهيئات المعنية بأنشطة التخييم من هذه الخدمات.
غير أن هذا المرسوم أثار ويثير عدة ملاحظات جوهرية، أولها تجاهله الكامل للمخيم كمؤسسة مجتمعية تتجاوز الإطار الوزاري، إذ لم يتطرق إلى المخيمات التي تُنشأ بمبادرات من الشؤون الاجتماعية لبعض القطاعات الحكومية أو المؤسسات الشبه عمومية، أو تلك التي تنبع من استثمارات خاصة، سواء داخل مدارس أو بنايات مخصصة أو غير مخصصة لهذا الغرض. هذا الإقصاء قد يؤدي إلى خلل بنيوي داخل منظومة التخييم، إذ خلق حالات استثنائية داخل قطاع اجتماعي حيوي وواعد.
كما أغفل المرسوم الإشارة إلى العلاقة القانونية والتنظيمية بين الوزارة والجامعة الوطنية للتخييم، والتي يُفترض أن تكون شريكًا أساسيًا في تدبير القطاع، لا مجرد وسيط عرفي بين الجمعيات والوزارة، وان يرقى بها الى مستوى جامعة – متخصصة في المخيمات فقط ولا تمثل الجمعيات-، وأن يتجاوز بالفعل روح المزايدة في تغيير اسم اللجنة الى هيأة ثم جامعة، كأن ذلك ما يسمح لها بالرقي الى مستوى الجامعات الرياضية التي يؤطرها قانون يسند لها مهامها ووظائفها.
إن هذا المرسوم يبرز الحاجة إلى معالجة دقيقة لمفاهيم أساسية، على رأسها التمييز القانوني والتنظيمي بين المخيمات التربوية والمصطافات السياحية، وذلك ضمن رؤية شاملة تراعي مختلف المعايير والضوابط لضمان تكاملية العمل التخييمي وجودته، ضمن تمييزات أخرى بالنسبة للاستقبال بالإقامة المستمرة او فقط طول النهار فقط..
بالإضافة إلى ذلك، لم يتناول المرسوم منظومة تكوين الأطر والمشرفين على التنشيط التربوي، لا من حيث تأكيد المساطر الحالية، ولا بتحديد الجهة التي ينبغي أن تسند إليها هذه المهمة مستقبلًا، كما لم يضبط المفاهيم والمنطلقات التي يجب أن يقوم عليها التكوين.
وتخلص المعطيات إلى أن المدخل الرئيسي لتطوير قطاع التخييم يمر عبر إعادة فتح ورش التشريع، وتحديث الترسانة القانونية والإدارية والتنظيمية ذات الصلة. فإذا كان المرسوم الحالي خطوة أولى في هذا الاتجاه، فإن العودة إلى إحياء مشروع القانون "المؤجل" ستشكل فرصة سانحة لمختلف المتدخلين من أجل المساهمة في تقنين هذا النشاط الحيوي الذي ينفرد قطاع الشباب بتأطيره، وذلك عبر التركيز على جوانب جوهرية مثل تكوين الأطر، وتطوير المناهج، وتجويد المراقبة على مخيمات القطاع الخاص، ليصبح قطاع التخييم مؤطرًا بشكل شمولي تحت إشراف القطاع الحكومي بصفته الوصية.
ان هذا المرسوم يتسم ب:
"ينظم" مراكز تحت نفوذه ورثها من قبل الاستقلال وبعده عنما كان يشتغل ب"العمل المباشر" حيث ينظم مخيمات لأبناء بعض المناطق التي ليس بها انتشار للجمعيات التخييمية، وكأنه "مذكرة " صادرة عن مؤسسة إدارية او تجارية او صناعية تنظيم مخيما خاصا بأبناء مستخدميها، وضمت الجمعيات العاملة الى تلك التنظيمات؟
غياب الإطار القانوني للمؤسسات المجتمعية:
المرسوم لم يُعرِّف المؤسسات المجتمعية أو ينظم علاقاتها الداخلية والخارجية، ولا يحدد معايير إنشائها أو تدبيرها حيث تُدار هذه المؤسسات بشروط عرفية معترف بها من قبل السلطات، دون وجود قانون يضمن حقوقها وواجبات الأطراف المتدخلة.
إهمال دور "الجامعة" كمنظم:
لم يتطرق المرسوم لدور "الجامعة" المفترض كشريك منظم (وليس وسيطًا) بين الجمعيات والوزارة، أو كيفية إضفاء الصفة القانونية عليها، حيث يُفترض أن تكون هذه الجامعة منسقًا ومؤطرًا للمخيمات بدعم قانوني، وليس مجرد كيانًا تعويضيًا لضعف أداء المصالح التقنية، ينظم على شكل جمعية يخضع لقانون الجمعيات ويؤطر ويتحكم في الجمعيات التي من المفروض ان ينسق بينها، وتصدر له المصالح الوزارية ما لا تريد القيام به.
تقصير في تنظيم تكوين العاملين:
لم يحدد المرسوم شروط تأهيل أو تشغيل العاملين في التنشيط التربوي، ولا منظومة تكوينهم أو ضوابط حراسة القاصرين، واقتصر على الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الوزارة دون تطوير آليات التكوين، بل ودخلت الوزارة والجامعة في مسلسل تكوينات "تجريبية" بدون مرجعيات قانونية اللهم الا مبادرات شخصية غير رسمية.
إغفال حقوق وواجبات المستفيدين والأولياء:
ولم ينظم المرسوم العلاقة بين أولياء الأمور والجمعيات المنظمة أو مسؤوليات الأطراف في حال الإخلال بالاتفاقيات وركز فقط على الجانب التجاري للتأمين دون ضوابط قانونية كافية.
اننا في الحاجة إلى قانون شامل للوقت الحر ينظم:
شروط إنشاء المراكز وفتحها وتدبيرها وحقوق المستفيدين.
أدوار الدولة والجمعيات والقطاع الخاص.
المعايير الصحية والأمنية والتأطير التربوي.
يكون الهدف منه: ضمان عطل منظمة وعادلة لكل الأطفال والشباب، بغض النظر عن الخلفيات الاجتماعية أو الجغرافية، مع تحديد واضح للمسؤوليات القانونية لجميع الأطراف.
إن غياب إطار دستوري خاص بالشباب والعمل الجمعوي تتفرع عنه كل محاور الحياة الشبابية والجمعوية وتنسق افقيا اختيارات متفق عليها ومعترف بها ضمن خطط معلومة النتائج على المستويات الحكومية والمدنية.
لن نتخلى عن المطالبة بإطار دستوري قانوني يعترف للمخيم بمشروعيته المجتمعية ويحدد معايير اعتماد الجمعيات والهيئات المؤهلة لتنظيم المخيمات ويضبط علاقتها مع الآخرين بما في ذلك القطاع الحكومي المشرف على القطاع ويضمن اشراف الدولة على كافة نشاطات قضاء العطل الجماعية لجماعات الأطفال والشباب وينظم إعادة توزيع قانوني للمهام بين "الدولة التنظيمية" المسؤولة عن التشريع والمراقبة وتطبيق مختلف الأنشطة، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و"الدولة الإنتاجية" التي تنتقل من العمل المباشر الى الاشراف ومواكبة الخدمات أي الانتقال إلى دور المُحكِّم والمُنظِّم والمنسق مع الفاعلين وأصحاب الحقوق.
لقد بدأت بلادنا تعرف «إنشاء» مخيمات "حرة" خارج الإطار القانوني لفتح المخيمات الذي يعود قانونا فقط للقطاع الحكومي المكلف بالشباب.، وروج مسؤولون مختلفون بإلحاح لمقولة " يا ربي غير نتكافاو معا هدشي لي عندنا"؟
فهناك فراغ قانوني يطرح على مستوى مخيمات الأطفال غير تلك التي تحت تدبير القطاع الحكومي إياه، والمؤسف أن الوضعية تزداد تأزما وتعميقا نظرا لتكاثر الجهات المنظمة له، ويطرح على مراكز الاصطياف التي تنظم تحت رعاية ومسؤولية كثير من القطاعات لصالح أبناء مستخدميها، ولدى القطاع الخاص الذي ينظم مخيمات أو مراكز اصطياف أو حتى تحت ستار مراكز وحصص دعم لغوي وتعليمي.
إن كل هذه الأنواع تعمل في حصص يومية أو أسبوعية أو أكثر مع مجموعات أطفال وشباب بدون ترخيص مسبق يضبط معايير فتح تلك الفضاءات لتلك الأنواع من الأنشطة ويحدد شكل المسؤوليات الملقاة على المشرفين في تأمين استقبال ورعاية وتغذية منظمة ومشروطة وضوابط تحدد مؤهلاتهم ويرسم الإطار القانوني لحماية المستفيدين والمشرفين بتأمين من الأخطار التي قد يتسبب الغير لهم بها، وتلك التي يسببونها للغير.
والشكل المنتشر، اليوم، هو مبادرات تجارية محضة في الغالب عن طريق مؤسسات تعليمية خاصة (ابتدائية أو تعليم أولي أو رياض الأطفال)، والتي تشتغل شهرا إضافيا لا يحتسب للآباء ضمن السنة الدراسية، وإما عن طريق مقاولات «تنشيط» تتكفل بتنظيم مصطافات للأطفال و/ أو الشباب أو تنشيط تجمعات، وقد بلغ إشعاعها أو استقطابها دولا أجنبية ويستعمل وسائل تنشيط أقرب للتنشيط السياحي التجاري الصرف منه للتنشيط التربوي، وتنامت ظاهرة فصول الصيف هذه لتخبئ ورائها مخيمات بدون روح.
لقد توالدت مخيمات الأطفال لدى قطاعات شبه حكومية كفضاءات وتنظيم لقلة الفضاءات العمومية المخصصة للتخييم لدى الدولة وتوفر الإمكانيات لديه وكتقليد لجهات أخرى؛ تمكنت من ذلك بفضل تنظيماتها الاجتماعية التي تشرف على أنشطة متنوعة لصالح المنتسبين وعائلاتهم وأبنائهم، ولكنه غير خاضع لسلطة القطاع الحكومي المشرف على الشباب المؤهل دستوريا للإشراف على هذه الأنشطة، لقد بدأ الانفلات من هذا الإشراف لضعف إمكانيات القطاع الحكومي المكلف من حيث ممارسة وصايته القانونية، وانشغال أغلب أطره بالتدبير المباشر على المخيمات التي تعقد في كنفه، وتناسلت مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسات شبه العمومية والخاصة واستعملت بعض هذه المراكز كمخيمات للأطفال بنفس الصيغة التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة بدون مراقبة ولا معايير ولا ضوابط
لن نتخلى عن المطالبة بتوسيع مهمة الاشراف على "المخيمات" كيفما كانت الجهة المنظمة لها، انسجاما مع موقفنا بانها خدمة عمومية في كل الفضاءات والوظائف والمؤسسات وبانها حق وليس امتياز.
مدة التخييم:
لقد فرضت عقلية احتساب الأرقام وتضخيمها حل تقليص ايام التخييم إلى أن بلغت عشرة أيام ضدا على كل المواقف البيداغوجية التي استمرت لقرن من الزمان، ولن نستغرب مقترح البعض بمخيمات الثلاثة إيام، وقد اطلعنا على دعاية لمخيم بيوم واحد!
عرفت بلادنا اضطرابا خطيرا في مدة التخييم القانونية تمثل أساسا في إقرار تراجع مدة التخييم كحل «سهل» للرفع من عدد المستفيدين، وذلك بالتخفيض المستمر من 21 يوما المعروف عالميا تربويا وصحيا كحد معقول للاستفادة من تغيير الجو والسفر ومن برنامج مغاير للبرنامج العائلي داخل الأسر.
وقد بدأ هذ "التناقص" منذ ثمانيات القرن الماضي بتخفيض مدة التخييم الى17/18 يوم فقط من أجل الاستفادة من متبقيات ميزانية التخييم في نشاطات أخرى، ثم بعد ذلك بحجة عطل الأعياد (الفطر والاضحى) وتزامن شهر رمضان ضمن العطلة الصيفية! ثم بحجة تناقص مياه العيون الطبيعية التي تكون غالبا مصدر تزويد مخيمات الغابات بمياه الشرب أساسا، ولقد بلغت أخيرا عشرة أيام وثمانية فعلية باحتساب يومي السفر للذهاب الى المخيم والعودة منه فلن يتأقلم الأطفال مع طبيعة المخيم كطقس ومؤسسة وبرنامج حتى يستدعون الى الرحيل!
لن نتخلى عن المطالبة بالعودة الى ثلاثة أسابيع كحد لمخيم تربوي وتعميمه على كل المخيمات وضمان إنجازه في ظروف مقننة ومعترف بها، بدون مزايدة ولا تهرب. وعلى الجهات المعنية البحث علة فضاءات أخرى وتأسيس مخيمات وليس من اللازم ان تكون طبق أصل المخيمات الموروثة عن الاستعمار،
وتبقى تحت مسؤولية الدولة والجهات الأخرى المعنية والراغبة في ذلك البحث عن مراكز جديدة وتوسيع القائم منها لرفع الحمولات الاجمالية استجابة لرغبات وحاجات العائلات والأطفال والسوق.
التغذية والمطعمة
"التريتور" في المخيمات
لقد تصدّر موضوع التغذية واجهة النقاش العمومي، وأثار جدلاً واسعاً تجاوز العمل التربوي والتنشيطي التي يفترض أن تكون جوهر العمل التخييمي، وسرعان ما أصبحت المعركة تدور حول تقديم الوجبات، في ظل هيمنة "النقالة" والمستنسخين على الساحة، ممن ينقلون الأنشطة والشعارات دون إيمان أو عمق، مفرغين المخيم من مضمونه التربوي ومحولين برامجه إلى عروض سطحية بلا توازن.
لقد غطت قضية نظام التغذية والمطعمة على المشاريع التربوية والتنشيطية التي كانت تتبارى فيها المنظمات والهيئات العاملة والتنافس الدائر كان حول النشاط الجاد في مقابل الميوعة، قبل اغراق المخيمات بالذين يركبون على أهداف وشعارات الفاعلين الملتزمين بدون الإيمان بها ويفرغونها من كل مدلول بنقل أنشطة والعمل على إخراجها في "برامج" بدون لون ولا طعم باي شكل وبدون توازن مع أنشطة أخرى وترجيح أنشطة الفرجة والزعيق على أنشطة المشاركة، بارتزاق واضح يخضع لرغبات المنظمين تجارا كانوا أو ممثلي إدارات لا علاقة تربوية لهم بموضوع التخييم.
ومع أن اعتماد تقديم الوجبات بشكل فردي في أوانٍ خاصة شكّل مكسباً من حيث الجانب الصحي والتربوي، إذ قلص من "التنافس" على الطعام وسلوكيات الهيمنة، إلا أن التجربة كشفت عن جملة من الاختلالات، فمسؤولية تدبير التغذية تقع أساساً على الجمعية المنظمة، من اختيار الوجبات والمواد، إلى الإشراف على التحضير والتوزيع، وهو ما ينبغي أن يُدرج في إطار رؤية تربوية شاملة لحياة جماعية متكاملة، تتيح للأطفال التعلم بالممارسة والتشارك، بدءاً من جلب المواد وتنظيفها، مرورا بإعداد المطعم وتزيينه، وصولاً إلى توزيع الوجبات وتنظيف المكان.
ان تحضير التغذية تحت مسؤولية الجمعية المخيمة وتدبيرها لاختيار البرنامج والاكلة والمواد والسهر على التحضير والطهي والتقديم، تحت أنظار جهاز مختص وبعد مناقصات قانونية وتموين ميسر، يدخل ضمن رؤيا تربوية لحياة جماعية يعيشها الأطفال في كل مناحيها من سفر وإقامة واستقرار ونوم وأنشطة واستراحات وجولات ...، فهذا النوع من العطلة "الجماعية المنظمة" ليست كالجولات والأسفار السياحية الجماعية التي تتعامل مع التغذية فقط باختيار مطعم ووجبة غير مكلفة للمنظم، بل هو شكل من الحياة وجزء من الحياة التي يجب أن يعيشه المشاركون (الأطفال) ويتعودوا عليه ويتعلموا منه كذلك قواعد المشاركة وتقاسم المسؤوليات والتعاون وحسن الاختيار بالقيام ببعض الاعمال من المساعدة في جلب وتنظيم مواد التغذية مع المقتصد المحلي، والمساعدة في تحضير الأطعمة بتنقية الخضر، وتنظيم المطعم وتزيينه، والسهر على استقبال الأصدقاء وتوزيع الأطعمة وتنظيف المطعم ... وكل ذلك في إطار جماعي تربوي إبداعي تشاركي وليس "كورفي" لا غرض منه، أولا حاجة لنا فيه كما يدعي البعض، كما أن التغاضي عن سلبيات التكدس والتحلق غير المريح حول مائدة لا هي دائرية ولا ثمانية في الغالب بها صحن دائري، والتسابق نحو الفوز بما هو مقدم في الصحن الجماعي وتعمد السرعة في الأكل للفوز بأكبر كمية ..، لا هو تربوي ولا يستحق الترويج له.
هذا الجانب من الحياة اليومية في المخيم ليس عبئاً ولا "كورفي" عديم الفائدة، بل جزء من مشروع تربوي جماعي يكرّس قيم التعاون وتقاسم المسؤولية والعيش المشترك، ويجنّب الأطفال السلوكيات السلبية الناتجة عن التكدس حول موائد غير مناسبة، والتهالك على الأكل بشكل يفتقر إلى الذوق أو التهذيب.
من جهة أخرى، فإن الاعتماد على خدمات "التريتور" أو المتعهد الخارجي جعل التغذية تخضع لمنطق التوحيد والربح، حيث صارت الوجبات متشابهة عبر أنحاء البلاد، وفُقد ذلك التنوع المحلي الذي كان يميز برامج التغذية التقليدية، والمبنية على توازن غذائي وخصوصيات جهوية. كما لم تُفعَّل البرامج الغذائية الرسمية المصادق عليها، إذ لم تُعتمد في الصفقات ولم تُوزع على الجمعيات، ولم تُؤطر من قبل لجان مراقبة مختصة، ما فتح المجال أمام تجاوزات عديدة.
كما أن الشكل الحالي لتقديم الخبز، عبر توزيع خبزة أو كوميرة" كاملة أو نصفها كحصة فردية، يفتقر إلى الذوق والفعالية، ويُنتج فائضاً يُرمى أو يُجمَع لأغراض تجارية. في حين يمكن اللجوء إلى تقديم الخبز مقطّعاً، بما يسمح باستهلاك مدروس يقلل من الهدر ويحفظ الكرامة.
حتى موائد الأكل البلاستيكية المعتمدة حالياً، فهي غير ملائمة للأطفال، لا من حيث بيئتها التربوية ولا من حيث شروط السلامة أو الراحة (ولكم ان تتجولوا وراء المطاعم والإدارات وتحصوا العدد الهائل من الموائد المكسرة والتي تستعمل لأغراض أخرى). بخلاف الموائد الخشبية القديمة التي كانت تسمح بجلوس متوازن وتقديم وجبات بشكل لائق وعملي، كما كانت تدوم أكثر وتُستثمر في أغراض تربوية متعددة، خلافاً للمائدة البلاستيكية القابلة للتلف والتي تضر بالبيئة.
إن تغيير نمط الحياة العادية بحياة أخرى بضوابط وتشارك وتعاون هو المقصود من العيش المشترك والحياة الجماعية التي تقدمها مؤسسة المخيم.
لقد قدمت الحركة الجمعوية عدة إجابات حول الكثير من المشاكل المثارة والتجديدات والبدائل المقترحة، ونادت بضرورة الحوار الجدي منذ التوقف الاضطراري للجائحة التي ضربت بلادنا وبعد ذلك بعدة صيغ، والاعلان عن ذلك اليوم بعد الموسم الحالي يمكن ان يعتبر احتمالا إذا استوفى شروط الانفتاح والشمولية في معالجة المشاكل والغموض المحيط بمستقبل هذه المؤسسة التي لن نحيد عن المكاسب التي حققتها طيلة العقود السابقة.