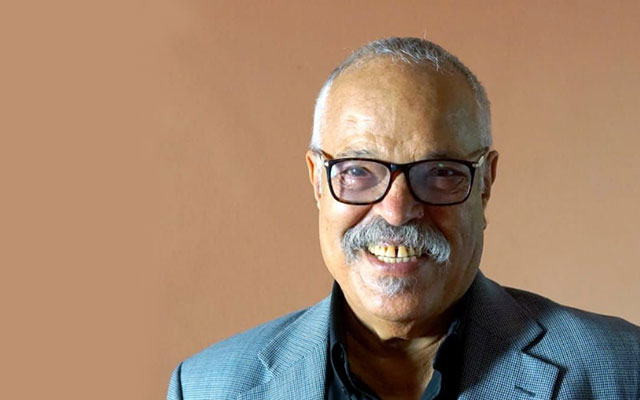في زمن لم تعد فيه الثروات الطبيعية وحدها معيار قوة الدول، ولم يعد فيه النمو الاقتصادي يُقاس فقط بالأرقام الجافة، يبرز الاقتصاد الثقافي بوصفه أحد أكثر المفاهيم حداثة وعمقًا في التفكير التنموي المعاصر. إنه اقتصاد يقوم على الإنسان، على خياله، على ذاكرته الجماعية، وعلى قدرته على تحويل المعنى إلى قيمة، والرمز إلى مورد، والثقافة إلى طاقة إنتاجية. وفي بلد مثل المغرب، حيث تتقاطع الحضارات وتتعدد اللغات وتتجذر التقاليد، لا يبدو الاقتصاد الثقافي خيارًا ثانويًا، بل أفقًا استراتيجيًا للتنمية الشمولية.
الاقتصاد الثقافي، في جوهره، ليس مجرد استثمار في الفن أو دعم للمهرجانات أو حماية للتراث، كما يُختزل أحيانًا في الخطاب الرسمي. إنه نموذج اقتصادي جديد يعترف بأن الإبداع البشري مورد نادر، وأن الهوية الثقافية ليست عبئًا ماضويًا، بل رأسمال رمزي قابل للتحويل إلى قيمة اقتصادية واجتماعية. في هذا التصور، تصبح الموسيقى، والسينما، والمسرح، والحرف التقليدية، والنشر، والأزياء، وفنون الطبخ، وحتى الحكاية الشعبية، قطاعات إنتاج حقيقية، قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي في الآن نفسه.
ما يميز الاقتصاد الثقافي عن النماذج الاقتصادية الكلاسيكية هو أنه لا يقوم على منطق الاستنزاف، بل على منطق التجدد. فالثقافة لا تنفد بالاستهلاك، بل تتكاثر به. كل عرض مسرحي يولد معنى جديدًا، وكل فيلم يعيد طرح الأسئلة، وكل أغنية تفتح أفقًا شعوريًا آخر. هنا، لا تكون التنمية مجرد تراكم مادي، بل مسارًا إنسانيًا يوازن بين النمو الاقتصادي والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
في السياق المغربي، يكتسب هذا المفهوم بعدًا خاصًا. فالمغرب ليس بلدًا فقيرًا ثقافيًا ينتظر الاستيراد، بل بلد غني بتنوعه الأمازيغي والعربي والأفريقي والأندلسي والحساني واليهودي، وبتراثه المادي واللامادي الممتد من القصبة إلى الزاوية، ومن الملحون إلى كناوة، ومن الحرف التقليدية إلى فنون الطبخ. غير أن هذا الغنى ظل، لعقود طويلة، خارج الحسابات الاقتصادية الكبرى، يُحتفى به رمزيًا، ويُهمَّش تنمويًا.
تحويل الاقتصاد الثقافي إلى رافعة للتنمية الشمولية يقتضي أولًا تحرير الثقافة من النظرة الفولكلورية التي تحصرها في الترفيه أو الزينة السياحية. فالثقافة ليست ديكورًا للدولة، بل بنية تحتية غير مرئية للتنمية. إنها التي تصنع الذوق العام، وتؤثر في السلوك الاقتصادي، وتغذي روح المبادرة والابتكار. عندما تستثمر الدولة في الثقافة، فهي لا تمول أنشطة معزولة، بل تبني شروط الإبداع، وتُنمّي رأسمالًا بشريًا قادرًا على الخلق والتجديد.
كما أن الاقتصاد الثقافي، بخلاف القطاعات الثقيلة، يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص الشغل للشباب والنساء، خاصة في المجالات التي لا تتطلب استثمارات ضخمة، بل مهارات إبداعية وتكوينًا ملائمًا. شاب يحمل آلة موسيقية، أو كاميرا، أو قلمًا، أو مهارة حرفية، يمكن أن يتحول إلى فاعل اقتصادي إذا توفرت له البيئة القانونية، والحماية الاجتماعية، وقنوات التوزيع، والاعتراف المجتمعي. هنا، تصبح الثقافة أداة لمحاربة البطالة، لا عبر الإحسان، بل عبر تمكين الأفراد من تحويل موهبتهم إلى مصدر عيش كريم.
ولا يمكن الحديث عن التنمية الشمولية دون التطرق إلى البعد المجالي. فالاقتصاد الثقافي يمتلك قدرة استثنائية على تنشيط المجالات المهمشة، لأن الثقافة غالبًا ما تكون متجذرة في الهامش أكثر من المركز. قرية تحمل تقليدًا موسيقيًا أو حرفيًا يمكن أن تتحول إلى قطب جذب ثقافي وسياحي، إذا أُحسن تثمين هذا التراث وربطه بسلاسل إنتاج وتسويق عادلة. هكذا، لا تبقى التنمية حكرًا على المدن الكبرى، بل تنتشر عبر الجغرافيا الثقافية للبلد.
غير أن هذا التحول لا يمكن أن يتم دون إرادة سياسية واضحة تعتبر الثقافة استثمارًا لا كلفة. فغياب الإطار التشريعي الحامي للمبدعين، وهشاشة الوضع الاجتماعي للفنانين، وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، كلها عوامل تُفرغ الخطاب حول الاقتصاد الثقافي من مضمونه. الاقتصاد الثقافي لا يزدهر بالخطابات، بل بالسياسات العمومية المندمجة، وبالميزانيات، وبإدماجه في التخطيط الاقتصادي والتنموي، على قدم المساواة مع باقي القطاعات.
ثم إن التحول الرقمي يفتح أمام الاقتصاد الثقافي آفاقًا غير مسبوقة. فالمنصات الرقمية لم تعد مجرد أدوات ترويج، بل فضاءات إنتاج وتوزيع واستهلاك جديدة، تسمح للمنتوج الثقافي المغربي بالوصول إلى العالم، دون وسائط تقليدية خانقة. هنا، يصبح الإبداع المحلي جزءًا من الاقتصاد العالمي، وتتحول الثقافة إلى قوة ناعمة تعزز صورة المغرب، وتجذب الاستثمار، وتعيد تعريف مكانته في محيطه الإقليمي والدولي.
في العمق، الاقتصاد الثقافي ليس مجرد سياسة قطاعية، بل اختيار حضاري. إنه اعتراف بأن التنمية لا تُختزل في الطرق والمصانع، بل في الإنسان القادر على الحلم، وعلى التعبير، وعلى إنتاج المعنى. في المغرب، حيث يتقاطع التاريخ مع الحاضر، يمكن للاقتصاد الثقافي أن يكون الجسر الذي يربط الهوية بالتنمية، والذاكرة بالمستقبل، والإبداع بالعدالة الاجتماعية.
هكذا، لا يعود السؤال: هل نملك ثقافة؟ بل: كيف نحول ثقافتنا إلى قوة تنموية شاملة، دون أن نفقد روحها، ودون أن نحولها إلى سلعة بلا معنى؟
والجواب، في جوهره، يكمن في الإيمان بأن الثقافة ليست ترفًا، بل شرطًا من شروط التنمية الحقيقية.