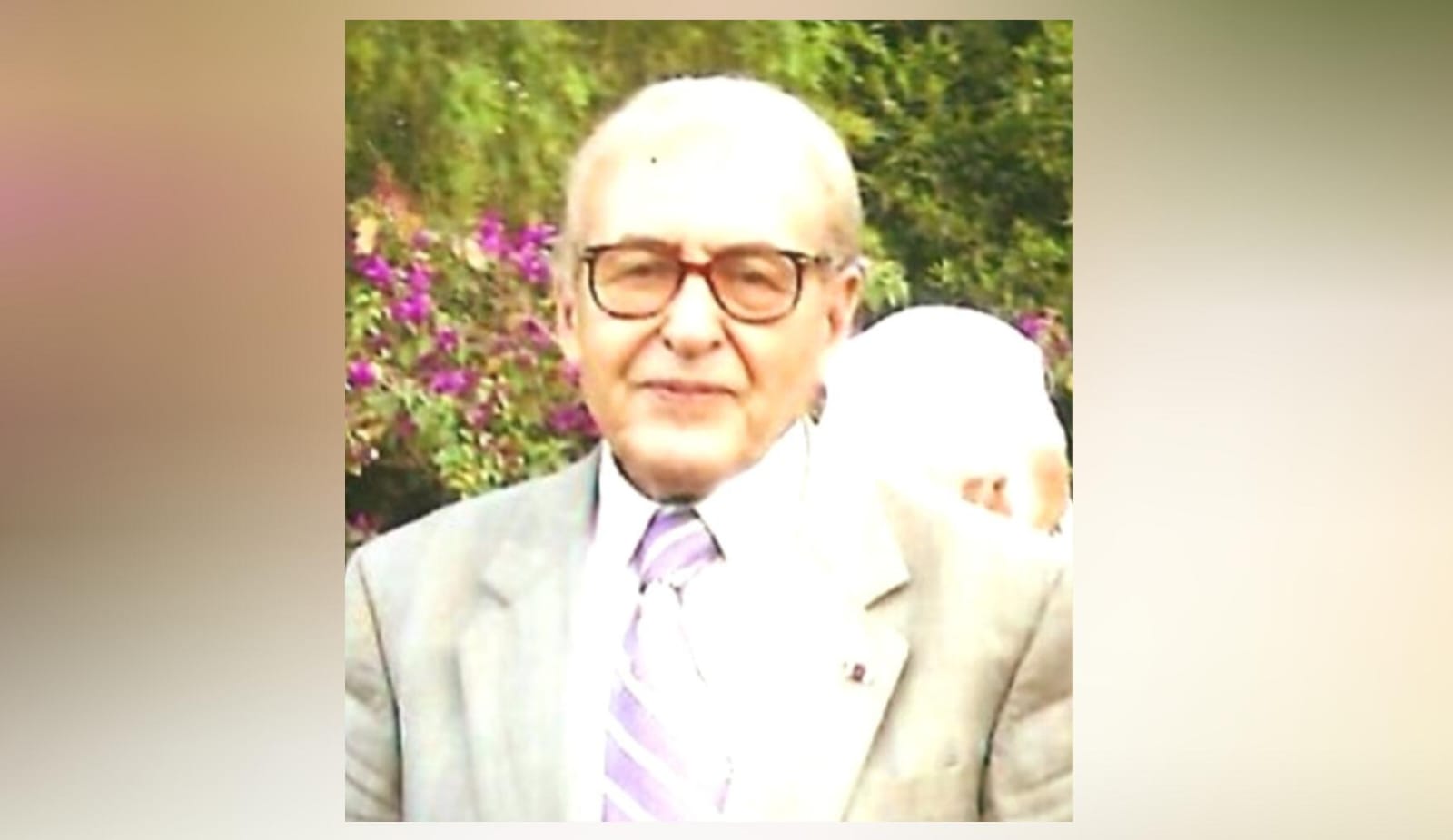ليست الوطنية في المغرب شعارًا يُرفع في لحظة حماس ثم يُطوى عند أول خلاف. الوطنية تُقاس في التفاصيل الصغيرة: كيف نتكلم عن بلدنا حين ينجح؟ وكيف ننتقده حين يتعثر؟ هل يكون النقد محاولة إصلاح من داخل البيت، أم يتحول إلى خطاب لا يعيش إلا على جلد الوطن، وكأن المغرب لا يصلح إلا أن يكون “خصمًا” دائمًا؟
المشكلة أن النقاش العمومي يُزَجّ به أحيانًا في زاوية ثنائية مُضلِّلة: إن قلتَ إن السيادة خط أحمر اتُّهمت بأنك ضد الحرية، وإن دافعت عن حرية التعبير قيل إنك ضد الوطن. والحقيقة أبسط وأعمق: الأوطان لا تتقوى إلا بالنقد، والدول التي تُضيّق على المعارضة تُضعف نفسها قبل غيرها. لكن بين النقد وبين تحويل السيادة إلى مادة تهكّم مسافة أخلاقية واضحة. ليس مثلُ من يطالب بالعدالة من داخل البيت مثلَ من يتعامل مع الوحدة والاستقرار كعُقد ينبغي تفكيكها، ومع الوطن كخصم لا كأصلٍ يجب صونه.
ومن هنا يصبح سؤال الانتماء حاضرًا بقوة، في الشارع كما في المنصات. التظاهر لنصرة قضية خارجية تضامنٌ مشروع في أصله، والاعتراض على خيارات الدولة في السياسة الخارجية حقٌّ سياسي كذلك. غير أن الإشكال يبدأ حين تنقلب لغة الاحتجاج من مساءلة القرار إلى نزع الشرعية عن الدولة نفسها، وحين تُستبدل الحجة بشعار يؤسس لولاء رمزي يتجاوز حدود الوطن. فهتاف مثل: "يا مطبّع يا ملعون… غزة في العيون " لا يكتفي برفض التطبيع؛ إنه يضع الدولة ورموزها في خانة اللعنة، وينقل الخلاف من ساحة السياسة إلى محكمة أخلاقية جاهزة، تُقدَّم فيها قضية خارجية بوصفها المعيار الأعلى للانتماء، بينما يُدفع الوطن إلى مرتبة ثانوية. عند هذه النقطة لا يعود السؤال: كيف نختلف حول سياسة عمومية؟ بل يصير: ما المرجع الأول في الوعي الجمعي… الدولة الوطنية أم سردية مستعارة تُستعمل لمواجهة الداخل؟
هذا السؤال له جذور قديمة. فالمغرب منذ الاستقلال عرف تيارات فكرية وسياسية متعددة، وهذا في ذاته علامة حياة. المعضلة لم تكن يومًا في تنوع الأفكار، بل في اختلال البوصلة حين صار “المرجع الأعلى” خارج الوطن. تربى جزء من خطابنا السياسي والثقافي على شعورٍ مزمن بالدونية: تمجيدٌ تلقائي لما يأتي من الخارج، وتبخيسٌ متكرر للذات المغربية، وكأن القيمة لا تُنال إلا بالانتساب إلى “مركز” آخر. وبين محاولات الانقلاب في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، التي سعت لاستنساخ تجارب مشرقية، وما رافقها من تداخلات إقليمية وموجات التأثر بأيديولوجيات مستوردة لم تصمد حتى في بيئاتها الأصلية، ظل سؤال الانتماء يتعرض للتشويش: هل المغرب بيتٌ نهائي نُصلح داخله ونحميه، أم محطة داخل مشاريع عابرة للحدود؟
اليوم لم يختف هذا التشويش، لكنه عاد في صورة أكثر التفافًا. فما زالت داخل المشهد تيارات وتنظيمات تعلن، صراحة أو ضمنًا، تبعيتها الأيديولوجية للمشرق، وتستمد من خارجه لغتها ومعاييرها وشرعيتها الرمزية. وبعد أن خبت نماذج كثيرة كانت تغذي هذا الخطاب وتمنحه وهجًا، بقيت “ورقة فلسطين” لدى بعضهم أداة تعبئة جاهزة: تُرفع القضية بما لها من عدالة إنسانية إلى مرتبة “الاختبار الداخلي”، ويُحوَّل التضامن من موقف أخلاقي إلى معيار ولاء، ثم تُستعمل هذه الحصانة الأخلاقية لتوسيع الخصومة مع الدولة الوطنية ومؤسساتها، لا لمساءلة قرار بعينه ولا لنقد سياسة محددة.
والفضاء الرقمي لم يخلق هذا الميل من العدم، لكنه سرّع إيقاعه ورفع حدّته لأنه يستطيع مخاطبة العامة وتقمّص عدة أدوار واللعب على المشاعر والعواطف؛ فصار الخطاب يُقدَّم في قوالب خاطفة تُراهن على التجييش والاستقطاب أكثر منه على البرهنة والنقاش، ويقف وراءه جيشٌ من المؤثرين الافتراضيين. ولعل تسريب منصة تويتر لمناطق إدارة الحسابات المحرِّضة كشف بالملموس خيوط اللعبة ومحرّكيها والعواصم الداعمة لها؛ فكل نجاحٍ كان من المفروض الاحتفاء به يتحول إلى ذريعة لتأجيج الغضب وتحوير النقاش عنه. والنتيجة ليست نقدًا يدفع إلى الإصلاح، بل مناخًا عدميًا يدرّب الجمهور على فقدان الثقة في الوطن قبل التفكير في إصلاحه.
ولنلمس الظاهرة عن قرب، يكفي أن نكتب تدوينة تُشيد بإنجاز وطني أو تدافع عن السيادة؛ سنفاجأ أحيانًا بهجومٍ لا يفسّره مجرد اختلاف رأي. وإذا تأملنا الحسابات المهاجِمة وجدنا، في حالات كثيرة، بصمة متقاربة: صورًا لزعماء دول وتنظيمات متطرفة، وتداولًا مكثفًا لأخبار منابر معادية، مقابل غيابٍ يكاد يكون تامًّا لرموز السيادة الوطنية، حتى يصعب أن تميّز صاحبها مغربيًا بسهولة. وحين تتكرر هذه التشابهات بهذا القدر، يصعب اعتبارها صدفة بريئة؛ إنها توحي باصطفافٍ مشحون، مؤدلج، وموجَّه، وبسلوكٍ يتكرر مع هذا النمط، يطغى عليه سبُّ الوطن وتبخيسُ رموزه، وتبريرُ الإساءة إلى السيادة، وتحويلُ الثوابت والهوية الوطنية إلى مادة تهكّم، والتعاملُ مع الانتماء كأنه خطأ يجب الاعتذار عنه. ويزداد الأمر سوءًا حين يُغلَّف هذا المسار بشعارات “حقوقية” أو “اجتماعية”، ثم ينزلق إلى لغة متطرفة تقذف الوطن باللعن أو تُقدِّم انتماءً آخر كبديل؛ وكأن المطلوب ليس إصلاح الاختلالات، بل تفريغ معنى الوطن من محتواه وتطبيع القطيعة معه.
لهذا يجب التمييز بين حقّ الاحتجاج وبين اختطاف الاحتجاج. فالمطالب الاجتماعية مشروعة، والضغط الشعبي قد يكون أحيانًا رافعةً ضرورية لإصلاح الأعطاب. لكن حين يُركَب على هذا الضغط يبدأ الأمر بمطلبٍ معيشيٍّ واضح، ثم يُعاد تشكيله تدريجيًا في اتجاهٍ آخر، حتى يتحوّل من وسيلةٍ للضغط على السياسات إلى خطابٍ يزرع الكراهية ويُسقط الثقة في البلد نفسه؛ فيتبدّل السؤال من: "كيف نُصلح؟ " إلى: "كيف نُقنع الناس أن لا شيء يستحق الثقة؟".
وتزداد خطورة هذا المسار حين يُختار له توقيتٌ بالغ الحساسية. فحين يكون المغرب تحت أنظار القارة والعالم وهو يستضيف كأس أمم إفريقيا، فإن أي خطابٍ يسعى إلى تثبيت صورة بلدٍ مضطرب لا يبقى شأنًا داخليًا صرفًا؛ بل يُلتقط أيضًا كرسالة إلى الخارج. في مثل هذه اللحظات، لا تعود الهتافات المتطرفة ومحاولات التشويه واستهداف الثقة في المؤسسات مجرد " تعبير"، بل تتحوّل إلى فعلٍ سياسي بكلفةٍ مباشرة: على سمعة الدولة، وعلى مصالح الناس، وعلى مناخ الثقة الذي تتغذّى منه الاستثمارات والفرص. وهنا يحقّ لنا أن نتساءل: من الذي يُحرّك هذه الخيوط؟
ومن الإنصاف القول إن جزءًا من هذا المشهد ليس وليد اللحظة. لقد راكمنا لعقود تقزيمًا للهوية الوطنية وإضعافًا للحس الوطني: مدرسةً وإعلامًا وسياسةً تتعامل مع الذات المغربية بمنطق التبخيس، وتفتح المجال لمرجعيات مستوردة كي تُقدّم الوطن كملحق داخل سرديات غيره. طبيعي أن تنشأ داخل هذا المناخ أجيال قابلة للاستلاب: ترى نفسها ضيفة في بيتها، وتبحث عن “هوية جاهزة” خارج حدودها. عندها يظهر الولاء للخارج في اللغة وفي التبرير وفي الرموز، وكأنه تعويضٌ نفسي عن فراغ الانتماء، أو عن وطنٍ لم يُعلَّم صاحبه كيف يسكنه باعتزاز ومسؤولية.
وفي خضمّ هذا الوضع الشاذ بالذات، برزت الحركة الأمازيغية—في أحد أبعادها العميقة—كردّ فعلٍ واعٍ على اختلال البوصلة: على الانبهار بالمشرق حتى صار “مركزًا” للشرعية والهوية، وعلى احتقار المغرب كأنه هامش بلا تاريخ. لم تكن المسألة رفضًا للآخر، بل رفضًا لآليةٍ تُنكر على الوطن حقه في سرديته: تُنسب مظاهر النبوغ والحضارة المغربية إلى الخارج، ويُقدَّم ما راكمه المغاربة عبر قرون كأنه فرعٌ لا أصل، أو صدى لا صوت.
لذلك ناضلت الحركة الأمازيغية لتدق ناقوس الخطر مبكرًا: إذا فقدنا سرديتنا فقدنا انتماءنا، وإذا فقدنا الانتماء فقدنا تاريخنا ومعناه. وقد أثبت الزمن وجاهة هذا التحذير؛ إذ صار مألوفًا أن ترى ضحايا الأيديولوجيات المستوردة يهاجمون ويسخرون من أي إنجاز مغربي، ويشككون في كل نجاح، بل ويستفزهم كل اكتشاف أو قراءة تُثبت عراقة الوطن وعمق جذوره، لا لضعف الدليل، بل لأن الاعتراف بذلك يهدم “السردية الجاهزة” التي تعوّدوا أن يروا بها المغرب.
إن معركة الهوية شرطٌ أساسيٌّ للاستقرار والتنمية. فالبلد الذي يستهين بذاته ويُقزِّم تاريخه يسهل اختراقه، أمّا حين يُؤصِّل لعراقته فإنه يقف شامخًا في وجه أيّ أيديولوجياتٍ دخيلة. والوطنية ليست سياسةً فقط؛ بل عمادها مواطنٌ يحسّ بالانتماء إلى أرضه، وحينها تُفتح شروط النهضة: مواطنٌ يحترم وطنه، ولا يغشّ في عمله، ويصون المرفق العام بدل تخريبه. فالتنمية لا يصنعها من يتغذّى على احتقار وطنه وتمجيد أوطانٍ بعيدة، بل من يشعر أنه ابنُ هذه التربة؛ وإن انتقد فلأنه يريد الأفضل، لا لأنه يساوم بقضايا بعيدة أو يجعلها ذريعةً للطعن في بيته.
ولهذا فالكلام موجَّه، قبل غيره، إلى الشباب. لا أحد يطلب من “جيل الغد” ادّعاء الكمال، ولا التصفيق لكل شيء. المطلوب ألّا يكون الشاب أداةً في يد من يصنعون الكراهية ويغذّون اليأس والاغتراب الهويّاتي؛ وأن يحوّل غضبه المشروع إلى سؤالٍ واقتراحٍ ومسارٍ إصلاحي، لا إلى سبٍّ مجانيٍّ للوطن. فالدفاع عن قيمة المغرب امتدادٌ لدفاع أجدادنا، عبر آلاف السنين، عن هذه الأرض. والسيادة ليست مجرّد شعارٍ يُرفع في المناسبات؛ بل هي خبز الناس وأمنهم وكرامتهم ومستقبلهم. وحبُّ الوطن يمكن أن يُترجم عملاً وتفوّقًا وغيرةً عليه؛ هو لمعانُ عيونِ الشباب وهم يحتفلون بانتصار المنتخب ويهتفون وهم يرفعون رايته، كما ينبغي أن يكون في كل الميادين. تلك الروح وتلك اللُّحمة وذلك الوهج يجب أن يجمعنا، في مختلف الظروف والقطاعات والأزمنة، لتستمر هذه الأمة المغربية العريقة المتفرّدة بين الأمم.
والوطنية ليست صراخًا ولا مزايدةً في التخوين. هي وضوحٌ في الانتماء حين تُختبر القضايا السيادية، وجرأةٌ في مواجهة الفساد حين يظهر، وأخلاقٌ تمنعنا من تحويل بلدنا إلى خصمٍ دائم. والسؤال الذي يستحق أن يرافقنا جميعًا: هل خطابنا يبني جسورًا أم يحفر خنادق؟ لأن الحقيقة التي تلخّص كل شيء بسيطة: هناك من يسكن الوطن، وهناك من يسكنه الوطن. الأول قد يبيع البيت لأول نداء، أما الثاني فيعرف أن البيت لا يُساوَم عليه لأنه إذا سقط، سيسقط على الجميع.