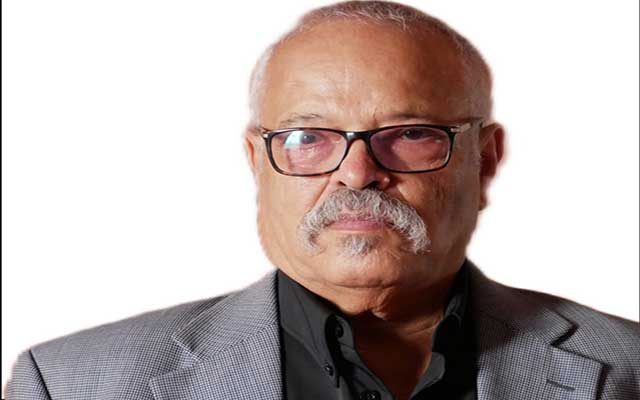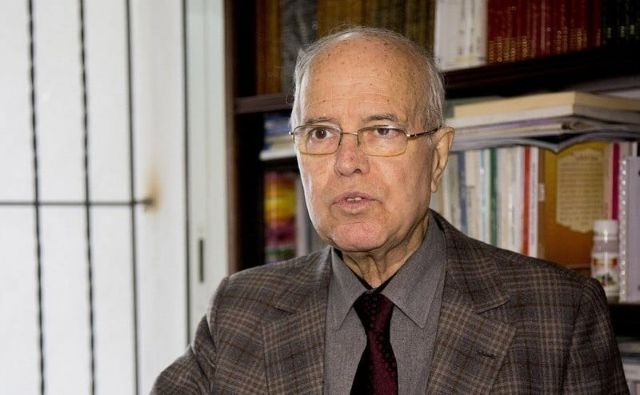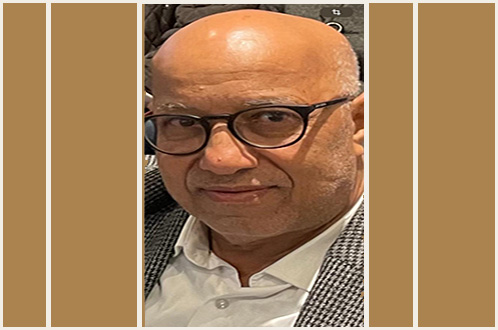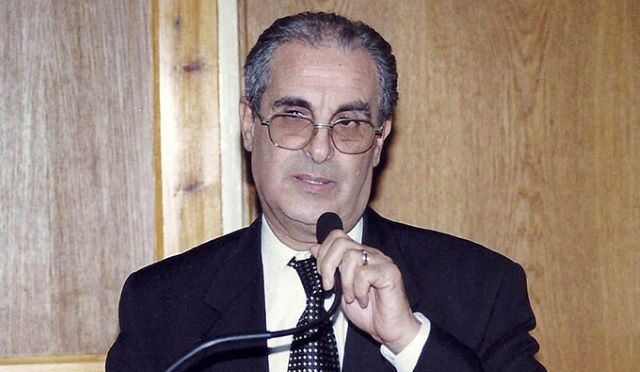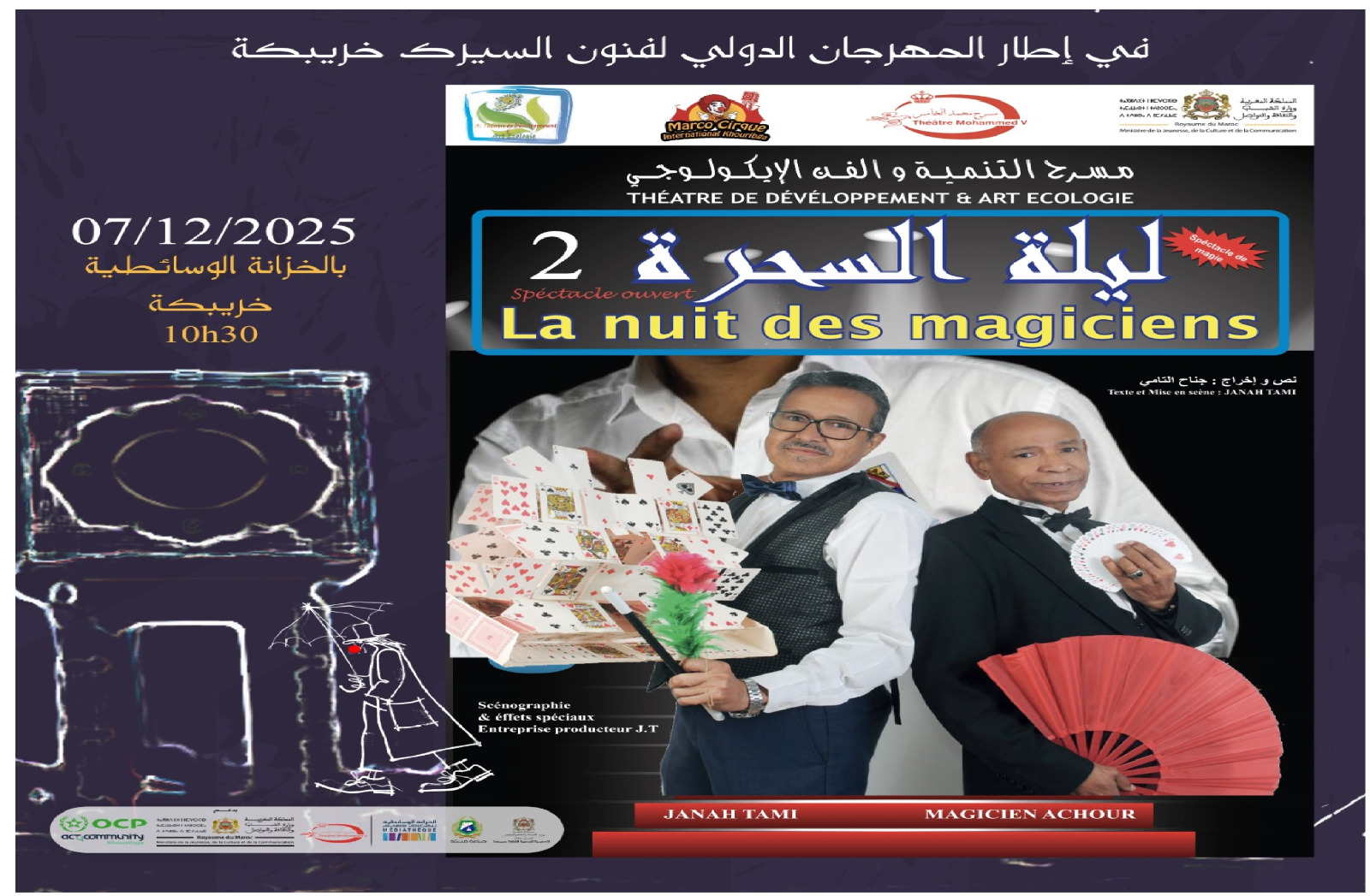قد يبدو الحلم، للوهلة الأولى، فعلاً فرديًا، ليليًا، نفسيًا، ينفلت من التاريخ. غير أن فالتر بنيامين يقلب هذا التصوّر رأسًا على عقب. فالحلم، عنده، ليس نشاطًا نفسيًا صرف، بل يمكن أن يتخذ طابعًا جماعيًا، وقد يصوغ الوعي التاريخي أكثر مما يعبّر عنه. إذا كان الحلم الفردي يُغري بالتحليل النفسي، فإن الحلم الجماعي، في مشروعه الفلسفي، يفتح على "تحليل جدلي للتاريخ، والحداثة، والسلعة، واليوتوبيا المخدِّرة".
في مشروعه الكبير، غير المكتمل، "مشروع الأروقة والممرات " (Das Passagen-Werk)، يعرض بنيامين باريس القرن التاسع عشر بوصفها مسرحًا لحلم جماعي، لا يقلّ كثافة عن حلم النوم. وقد خصّص لذلك بحثا بعنوان: "باريس، عاصمة القرن التاسع عشر"، كتبه أوّلا باللغة الألمانية سنة 1935، ثم قدّم نسخةً فرنسيةً منه عام 1939، وقد نُشرت في كتاب "باريس، عاصمة القرن التاسع عشر، كتاب الأروقة والممرات"، (باريس، سيرف، 1989).
نقرأ في مقدمة هذا البحث: "يهدف بحثنا إلى إظهار كيف تدخل أشكال الحياة الجديدة والابتكارات القائمة على أسس اقتصادية وتقنية –وهي التي ندين بها للقرن الماضي-كيف تدخل في عالم الأحلام الخيالية. فهذه الابتكارات تخضع لتلك "الإضاءة" ليس فقط على نحو نظري، عبر نقلة إيديولوجية، بل في فورية الحضور الحسّي. إنّها تتجلّى بوصفها أوهاماً خيالية. على هذا النّحو تظهر "الأروقة والممرات" باعتبارها التطبيق الأول للبناء بالحديد، كما تظهر المعارض العالمية التي يكتسي ارتباطها بصناعات الترفيه دلالة خاصة، وفي الإطار نفسه من الظواهر، تأتي تجربة "المتجوّل" الذي يستسلم لأوهام السوق."
تم بناء غالبية الأروقة والممرّات في باريس خلال الخمس عشرة سنة التي تلت عام 1822. وكان الشّرط الأول لتطوّرها هو ذروة تجارة الأقمشة. حيث ظهرت مخازن الأقمشة الجديدة، وهي أوّل المؤسسات التي احتوت بشكل دائم على مخازن كبيرة للبضائع في المبنى. "هذه المخازن كانت تمهّد الطريق لظهور المتاجر الكبيرة...ولتجهيزها، وُظِّف الفنّ خدمة للتجارة، وبدأ مفهوم المهندس، الذي يعود إلى حروب الثورة الفرنسية، يترسّخ، وكانت تلك بداية التنافس بين البنّاء والمزخرِف، بين مدرسة البوليتكنيك ومدرسة الفنون الجميلة".
كانت الممرات المسقوفة، والمعارض العالمية، والمتاجر الزجاجية، والديكورات الحديدية، كلها علامات لتشييد حلم رأسمالي جديد، حلم بالحداثة، بالتقدم، بالرفاه، بالزمن المتسارع. يقول بنيامين: "باريس هي عاصمة القرن التاسع عشر، لأن أحلام هذا القرن قد لُفّت في شوارعها بالحديد والزجاج." لكنّ هذا الحلم، في نظره، ليس طوباوية، بل هو حلم رأسمالي، خادع، يغلف الكابوس بورق ذهبي: "أصبحت الاروقة والممرات المسقوفة التي وُجدت في الأصل لأغراض تجارية، في رؤية فورييه، مساكنً سكنية. فـ"الفالانستير" هو مدينة مكوّنة من أروقة وممرات. وفي "مدينة الممرات هذه"، يكتسي البناء الهندسي طابعًا خياليًا ساحرًا. إنها حلمٌ سيأسر أنظار الباريسيين حتى وقت متأخر من النصف الثاني للقرن. فحتى عام 1869، ما زالت "الشوارع-المعارض" الفورييرية تشكل النموذج لطوباوية مويلان "باريس في عام 2000"، حيث تتبنى المدينة هيكلاً يجعل منها، بمتاجرها وشققها، السيناريو المثالي للتجوال الحضري."
لم تكن هذه الأحلام محض خيالات، بل بناءات مادية للخيال: السلعة لم تكن موضوعًا، بل مشهدًا، والمدينة لم تكن مكانًا، بل فضاءً حلميًا مُمسرَحًا يسبح في لاوعي اجتماعي ملؤه الوهم. إنها ليست أحلام نوم، بل أوهام جماعية، هي أحلام الحداثة من تقدم، وعلم، ونور، وتقنية، وهي أحلام الاستهلاك: المعارض الكبرى، الممرات المسقوفة، البضائع المعروضة كأصنام، أحلام اليوتوبيا البرجوازية: عالم بلا صراعات، بلا طبقات، عالم تغلّفه واجهات زجاجية جميلة.
هنا تكمن عبقرية بنيامين في قلب المعادلة: الحلم ليس نقيض الرأسمالية، بل أحد أجهزتها الرمزية. فالرأسمالية لا تكتفي بإنتاج البضائع، بل تُنتج الرغبات التي تجعل من هذه البضائع موضوعًا لحلم لا نهائي. وربما ما سيقوله بودريار فيما بعد من كوننا "لم نعد نحلم، بل نحن نستهلك الحلم كما نستهلك الأجساد والمعاني"، لا يبعد كثيرا عما يراه بنيامين هنا، أو لنقل، عل الأقل إنه مستلهم منه.
في هذا المعنى، كل واجهة متجر، كل إعلان، كل معرض عالمي، هو مسرح حُلُمي، وظيفته تعويم الرغبة في فضاء استهلاكي أبدي. "المعارض العالمية هي أماكن الحج لسلعة الفيتيش. "أوروبا تحركت لترى السلع"، كما قال "تين" عام 1855. سبقت هذه المعارضَ العالميةَ معارضُ وطنية للصناعة، كان أولها عام 1798 في ساحة "الشان دو مارس". وقد ولدت هذه الفكرة من الرغبة في "تسلية الطبقات العاملة وجعلها مناسبة لعيد تحرّر العمّال". وسيشكل هؤلاء أول زبائنها. أما الإطار الترفيهي للصناعة فلم يكن قد تشكّل بعد. لقد كان الاحتفال الشعبي هو من وفّر هذا الإطار...المعارض العالمية تُمجِّد القيمة التبادلية للسلع، وتخلق إطاراً تتراجع فيه قيمتها الاستعمالية إلى المرتبة الثانية. لقد كانت هذه المعارض مدرسةً تتعلم فيها الجماهير-التي حُرِمت قسراً من الاستهلاك – تقدير القيمة التبادلية للسلع إلى حدّ التماهي معها: "ممنوع لمس المعروضات". وهكذا تفتح هذه المعارض أبواباً لعالم خيالي يدخله الإنسان ليجد نفسه منغمساً في الترفيه".
يعود بنيامين في هذا البحث إلى بودلير -شاعر باريس الحديث-لا لتمجيد خياله، بل ليُظهر كيف أنّ الشعر نفسه يصبح مجالاً لصراع بين الحلم واليقظة. فشعر بودلير يصوّر العابر، السرعة، الزحام، لكنه يلمّح في الوقت ذاته إلى سُكر الحواس الذي يجعل الإنسان معلقًا في زمن حلمي مشوَّه. يقول بنيامين: "للمرة الأولى عند بودلير، أصبحت باريس موضوعًا للشعر الغنائي. هذه الشعرية المحلية تناقض كل شعر ريفي. النظرة التي تغوص بها العبقرية الرمزية في المدينة تخون بالحري شعورًا بالاغتراب العميق. تلك هي نظرة المتجوّل الذي يحجب أسلوب حياته وراء سراب مريح ضيق سكان مدننا المستقبليين. يبحث المتجوّل عن ملاذ في الزحام. الجماهير هي الحجاب الذي تتحرك من خلاله المدينة المألوفة للمتجول كخيال مرعب. هذا الخيال، حيث تظهر تارةً كمنظر طبيعي وتارةً أخرى كغرفة، يبدو أنه ألهم لاحقًا ديكور المتاجر الكبيرة، التي جعلت بذلك حتى التجوال في خدمة مبيعاتها. وعلى أي حال، فإن المتاجر الكبيرة ستعتبر الملاذ الأخير للتجوال".
في شخصية المتجوّل، يتعرف الذكاء على السوق. "إنه يذهب هناك، معتقدًا أنه يتجول فقط، وفي الواقع، هو يذهب بالفعل ليجد مشتريًا". يُمثِّلُ المتجول كشافًا في السوق. بهذه الصفة، يكون في الوقت نفسه مُستكشِفًا للجماهير. فالحشد يُولِّدُ في مَن يَستسلِمُ له نشوةً مصحوبةً بأوهامٍ غريبة، حتى إنه ليَطمَحُ -عند رؤية المارّينَ يُحتَمَلونَ في الزحام -إلى تصنيفهم وفهمِ أعماقِ أرواحِهم بمجرد نظرةٍ خاطفةٍ إلى مَظاهرِهم". المتجوّل يبحث دائما عن "الجديد": "آخر قصيدة في "أزهار الشر": "الرحلة". يا أيها الموتُ، أيها القبطانُ القديم، حان الوقت! فلنرفعَ المرساة!" آخر رحلةٍ للمتجوّل: الموت. وهدفه: الجديدُ. فالجديدُ صفةٌ مستقلةٌ عن القيمة الاستعمالية للسلعة وهو أصلُ ذلك الوهمِ الذي لا تكلُّ الموضةُ من التلويح به".
يبيّن بنيامين كيف جسّدت السلع التي كانت تعرض في هذه الممرات المسقوفة صورة حلميةimage onirique. كانت توهم بالكمال، كانت براقة، بالرغم من أنها جوفاء. كما كانت محفزة للرغبة، لكن بدون زمن، كانت مغرية، لكنها وهمية. منفصلة عن شروط إنتاجها، تظهر بلا عمال، بلا عرق، بلا قبح. كانت مثل الحلم، كانت صورة بلا أرض، بلا جذور، تخفي علاقات الإنتاج الحقيقية. لهذا يقول بنيامين "إن المهمة ليست أن نفسر هذه الأحلام، بل أن نوقظ الحالمين، وأن نقرأ في حلمهم أعراض المرض". فوحدها "اليقظة، وحدها الصدمة، يمكن أن تقطع هذا الحلم الجماعي، وتعيد للوعي وظيفته التاريخية."
لكن هذا البهاء والروعة اللذين يتوشح بهما مجتمع الإنتاج السلعي، والوهم الزائف بالأمن الذي يحيط به نفسه، ليسا بمنأى عن التهديدات، فقد ذكَّره بذلك سقوط الإمبراطورية الثانية ثم كومونة باريس. "وفي الحقبة نفسها، كشف له بلانكي - أشدّ أعداء هذا المجتمع رهبةً - في آخر كتاباته، الملامحَ المرعبة لهذه الأحلام الخيالية. فالإنسانية تظهر هناك بمظهر المخلوق الملعون. كل ما قد تأمل فيه من جديد سينكشف كواقعٍ كان موجوداً منذ الأزل، وهذا الجديد سيكون عاجزاً عن تقديم حلٍّ تحرّري لها، كما أن موضة جديدة ليس في استطاعتها تجديد المجتمع. إن التأمل الكوني عند بلانكي يحمل في طياته هذا الدرس: ستظل الإنسانية أسيرة قلقٍ أسطوري طالما احتفظت الأحلام الخيالية الجماعية بمكانتها فيها".
ذلك أن هذه "الأحلام" -كما بيّن بنيامين-هي في جوهرها حلم رأسمالي نائم عن الحقيقة، فالقرن لم يعرف "كيف يجيب على الإمكاناتِ التقنيةِ الجديدةِ بنظامٍ اجتماعيّ جديد". لقد كان هذا الحلم الجماعي في باريس القرن التاسع عشر يغطي على التناقضات الطبقية، ويجعل الناس "يحلمون" بمستقبل مشرق، بينما هم يسيرون نحو الكارثة (كما حدث في الكومونة، أو لاحقًا في الحروب الإمبريالية).
هنا تأتي وظيفة الناقد، والمثقف، والفنان عند بنيامين: لن يكون عليه أن "يحلم حلمًا آخر"، بل أن يوقظ الوعي التاريخي داخل الحلم. ذلك أن الحلم، في حد ذاته، ليس موضع إدانة عند بنيامين. ما ينتقده هو التوظيف الإيديولوجي للحلم، حين يصبح أداة لطمس الصراع وتخدير الوعي. وهو يستعير من فرويد فكرة "عمل الحلم " (travail du rêve) ليقترح بالمقابل ما يسميه: "العمل التاريخي لليقظة"، ذلك العمل الذي سيكون عليه "تحليل هذه الأحلام الجماعية كما يحلّل المحلّل النّفسي الحلم الفردي ليرى الرموز، ويكشف الكبت، ويدعو إلى قطيعة واعية مع الوهم. فالتاريخ، كما يقول بنيامين "ليس كومة من الأحداث الماضية، بل هو الحلم الذي لم نستفق منه بعد."
في هذا الصدد، ينتقد بنيامين اليوتوبيا البرجوازية التي تحوّل التقدّم إلى أسطورة، وتُضفي على التاريخ طابعًا خطّيًا، حُلميًا، لا يعترف بالقطيعة أو بالكارثة. وهذا ما دفعه إلى القول إن القرن التاسع عشر كان نائمًا وسط يقظته، وكان حلمه الأكبر هو كونه ينسى أنه يحلم، كما ينسى أننا "لا يمكننا أن ننقذ التاريخ إلا على يد الذين يستفيقون من حلمه".
عن موقع" الجسرة "