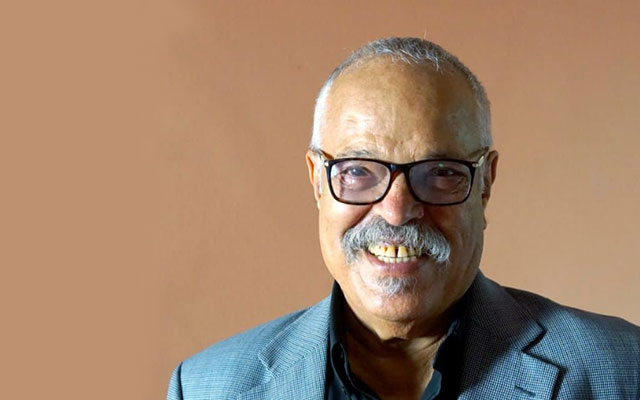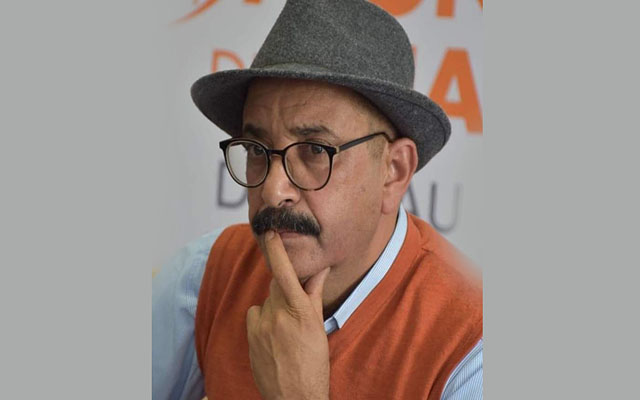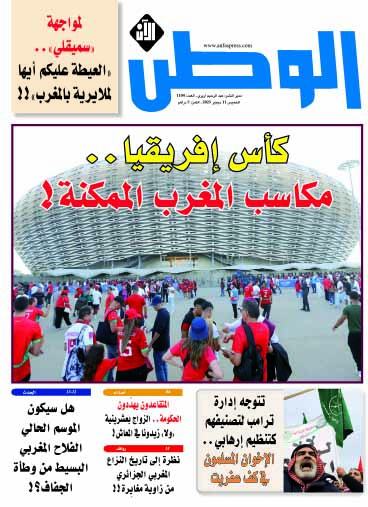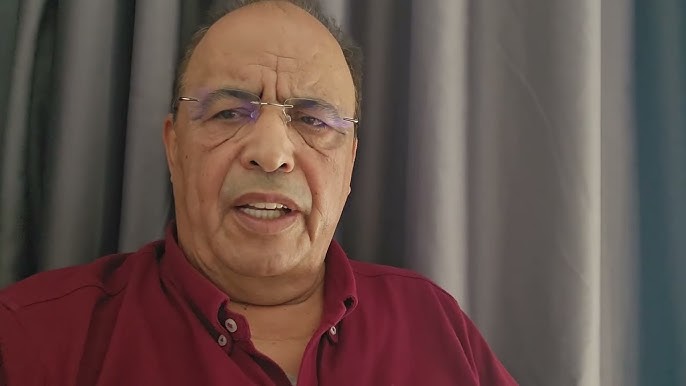حين سار مئاتٌ من سكّان آيت بوكماز نحو مركز الإقليم، في مسيرة سلمية، على الأقدام، كانت مطالبهم بسيطة ومعدودة وواضحة، ويمكن أن تندرج ضمن الحقوق البدائية لأيّ إنسانٍ على وجه هذه الأرض، مدرسة، طبيب، وطريق، ولنُقل بالجملة "فكّ العزلة"، غير أنّ هذه العبارة البليغة "فكّ العزلة" لا ينبغي أن تقف عند حدود المطالب، ولا أن تؤخذ مأخذ الاحتجاج الاجتماعي فقط، ولا أن تعتبر مجرّد مشكلةٍ تقنيّة يمكن أن نتجاوزها بالاستجابة إلى المطالب المذكورة. إنّ ما وقع لا يُختزل في مجرّد احتجاج اجتماعي، بل يعدُّ فعلًا رمزيًّا بالغ الدلالة، ينبغي أن يهزّ خرائطَ المعنى أكثر مما يُحرّك خرائطَ الطُّرق. حين خرج السكّان من صمتهم، ومشوا نحو مركز الجماعة، لم يكونوا يطالبون بالخدمات فقط، بل كانوا يسألون سؤالًا أعمق: هل نحن محسوبون فعلًا في ضمن خريطة الوطن؟ كانت ساكنة آيت بوكماز تسير، وتحت أقدامها يعادُ طرح سؤال الاعتراف كما صاغته الفلسفات المعاصرة.
إنّ الاعتراف، كما بيّن أكسيل هونيث، ليس امتيازًا، بل هو شرط تكويني للهوية الإنسانية. أن نُرى، أن يُنصَت إلينا، أن يُعتَبر صوتنا ذا معنى — كل ذلك ليس ترفًا رمزيًّا، بل ضرورة وجودية. فالذات لا تتحقّق إلا عبر منظومة اعتراف ثلاثية: الحبّ، والحقّ، والتقدير الاجتماعي. وحين يجد الإنسان نفسه خارج هذه المنظومة لا تتعطّل خدماته فحسب، بل تنهار قابليته لأن يرى نفسَه جديرًا بالحياة المشتركة. ليس الاعتراف مجاملةًَ رمزية، بل هو شرط تكوينيّ لكلّ تحقُّقٍ إنساني. هكذا يفهم أكسيل هونيث العلاقة بين الذات والغير، بين الفرد والمجتمع. فالإنسان لا يَتملّك هويتَه إلا من خلال اعتراف الغير به، لأنّ الذات لا تُبنى في عزلة، بل في علاقات متبادلة يتجلّى فيها الوجود ويُقاس فيها المعنى. علاقات ميّز فيها هونيث ثلاث دوائر للاعتراف، تمثّل كلّ واحدةٍ منها مستوى من مستويات تحقق الذات: الاعتراف العاطفي (الحبّ): وهو ما يحصل في دوائر القرب كالعائلة والروابط الحميمية، حيث يشعر الإنسان بأنه محبوب لذاته، لا لإنجازه. هنا تُبنى الثقة في النفس، ويُزرَع الإحساس الأوّل بالأمان الوجودي. الاعتراف القانوني (الحقّ): أن يُعتبَر الفرد فاعلًا قانونيًّا، له حقوق متساوية. هذا الاعتراف لا يمنح الحماية فقط، بل يرسّخ احترام الذات، لأنّه يُشعر الإنسان بأنه يُعامَل على قدم المساواة، لا بوصفه مواطناً من درجة ثانية. الاعتراف الاجتماعي (التقدير): وهو أن يُنظَر إلى الفرد كعنصرٍ فاعل وذي قيمة في الحياة العامة. أن يُعترَف له بمساهمته، حتى وإن لم تكن مرئية أو قابلة للقياس السّريع المباشر.
وحين تنعدم هذه الأشكال الثلاثة أو تختل، تنهار صورة الإنسان عن نفسه، ويشعر بأنه منقوص، غير مرئيّ، أو زائد عن الحاجة. ليس لأنه يفتقر إلى الموارد الماديّة فقط، بل لأنه يُعامَل كمن لا يستحق أن يُرى أصلًا. وهنا تمامًا تتموضع حالة آيت بوكماز: جماعة سكّانية حُرِمت من الاعتراف بجميع دوائره. لا من يحبّها في خطاب الوطن، ولا من يمنحها حقوقها الإدارية، ولا من يرى في وجودها قيمة تُستحقّ التقدير. وهذا ما يجعل المعاناة هناك ليست فقط غيابَ طريق، بل انهيارًا في البنية الرمزية للاعتراف.
أن تعيش في وطنٍ لا يراك، هو نوع من الإقامة في اللاوجود. هو أن تخرج من دائرة الاعتراف إلى هامش الإقصاء. ولعل أخطر أشكال الإقصاء هي تلك التي لا تُمارَس بالعنف المباشر، بل بالهندسة الصامتة للغفلة. حين يُعاد إنتاج الفضاء الوطني بطريقة تجعل بعض مناطقه غير مرئية، غير معتبرة، غير مدرجة أصلًا في حسابات السّياسات العمومية.
وهذا ما نبّه إليه فوكو، حين أشار إلى أنّ السلطة كثيرًا ما تتخفى في ما يبدو غير سياسي، وما فصّله هنري لوفيفر حين قال إنّ الفضاء لا يُعطى، بل يُنتج: يُنتج بخطابٍ، ونظرةٍ، وتخطيط.
إنّ آيت بوكماز ليست "منطقة نائية" كما يُقال، بل منطقة أُنتِجت نائية في نظر المركز. وما من طريق يصلها، لا لأنّ الأرض وعرةٌ فقط، بل لأن الاعتراف بها كموضعٍ ضروريّ لم يحصل. فالعزلة هنا ليست عارضًا جغرافيًّا، بل بنية رمزية تُنتج التهميش عبر تصنيفات مجالية: حيث يُنظر إلى بعض المناطق كزائدة عن الحاجة، كمجرد عبء على الموازنات، أو حديقة خلفية للصُّور السياحية. وحين قرّر سكّان آيت بوكماز أن يسيروا، لم يكونوا يتحركون فيزيائيًّا فحسب، بل كانوا يخلخلون الخرائط الإدراكية التي ثَبَّتتهم في موقع الصمت والسكون. كان المشي إعلانًا جسديًّا عن حضورٍ طال كتمُه،
كانوا يقولون: نحن هنا، ولسنا هامشًا، بل جزءاً من هذا الوطن، فقط لم تدرجونا في الحساب.
بهذا المعنى، لم تكن مسيرتهم نحو المركز رحلةً في الجغرافيا، بل رحلة في استعادة الذات. أن تُحمَل الأرجُل على المسير، حين لا تحملُك الطريقُ، هو في حدّ ذاته ممارسةٌ سياسيةٌ فذّة، تذكِّر الدولةَ بأنّ الطريق يمكن أن يسير أيضًا نحو الجبل، ما دام الجبلُ نفسُه قد سار نحو الطّريق.
ولأنّ لا بدّ دائماً من حدثٍ لتنكشف القشرة عن اللّب، وتبرز هشاشة الواقع تحت صلابة الخطاب، شأنَ ما كشفت كورونا عن هشاشة "واقع العمل"، وكشف الزّلزال عن هشاشة "التنمية"، كان لا بدّ من "مسيرة" لتنكشف هشاشة "العدالة المجالية"، وندرك أنّ الفضاء المجالي ليس مشتركًا كما يُروَّج، بل هو موزّع وفق موازين خفيّة تُقصي بعض الجماعات، لا لأنّها غريبة، بل لأنها لم تُعتَبر.
وهنا يتجاوز سؤال الاعتراف نطاق الفرد كما صاغه هونيث، فما نحن بإزائه هو حرمان جماعيّ من الاعتراف، لا لسبب إلا لكون الجماعة بعيدة، قليلة العدد، و"غير استراتيجية". وهي نظرةٌ تُعيدنا إلى ما وصفه زيغمونت باومان بـ"النفايات البشرية":
حين تصير بعض الفئات، أو المواقع، مقيمة داخل الجغرافيا لكنها خارج المعنى،
حاضرة من حيث هي رقم، أو صورة، أو عبء إداري، لكنها غائبة من حيث هي موضعٌ يستحق الرؤية، والاستثمار، والاحترام.
إنّ مسيرة آيت بوكماز كانت محاولة لانتزاع الاعتراف من صمته، لقد سار السكّان لا لأنهم يطلبون صدقة، بل لأنهم يطالبون بحقّ في الحضور، في أن يُقال لهم: مكانكم محسوب، وغيابكم غير مقبول، ومدرستكم ليست ترفًا، وطريقكم ليس صدفة. فالعدالة المجالية لا تبدأ من شقّ الطُّرق، بل من تصحيح النظرة. ولا تُقاس فقط بعدد الكيلومترات، بل بمدى إدراج الجماعة ضمن خريطة العناية. والوطن، إن لم يكن اعترافًا بالكلّ، فهو تفضيلٌ مموَّه، أو بيتٌ بباب واحد.
لقد مشى أهل آيت بوكماز لأنهم يرفضون أن يعيشوا كصدى بعيدٍ لقرارات المركز، ولأنهم – ببساطة – أرادوا أن يُرى مشيهم بوصفه عودةً إلى الخريطة، لا فقط عودةً إلى الإدارة، لهذا كان كافياً أن يستقبل مسؤولٌ ممثّلين عنهم، لتعود المسيرة أدراجها، ليس لأنّها حقّقت المطالب، بل لأنّها أعلنت عمّا هو أعمق: عن الرغبة في كسر التوزيع الرمزي للمجال، والاحتجاج على هندسةٍ تجعل من البعض زوائدَ مجالية لا قيمة لها. وما لم يتحوّل هذا الاعتراف إلى سياسةٍ، تُدرج كلَّ جماعة ضمن خريطة الكرامة، ستظلّ المسافاتُ تُقاس بمدى القرب من السلطة، لا بعدد الكيلومترات.