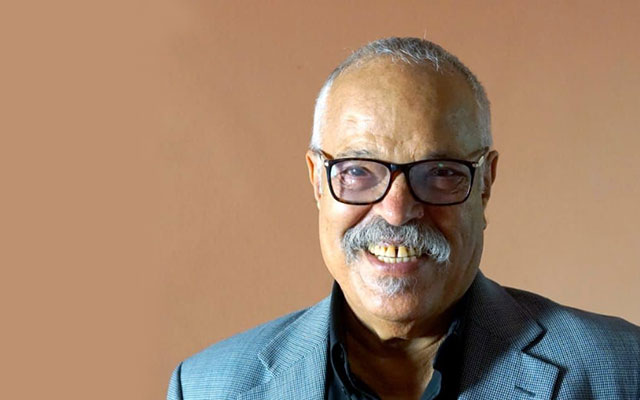في المغرب، لا شيء يُخطّط له أكثر من التصنيع، ولا شيء يتبخر أسرع من وعوده. فكم من مخطط صناعي وُضع بتوقيع وزراء وازنين، وصُوّر في عروض PowerPoint براقة، ووُعد المغاربة فيه بأن يصبح بلدهم "منصة صناعية عالمية"، فقط ليكتشفوا بعد ذلك أن المستفيد الوحيد من هذه المخططات هم مكاتب الدراسات، التي تخصصت في تحويل ميزانيات الدولة إلى تقارير مملة مليئة بالكليشيهات الإنشائية، وعاجزة عن إنتاج "تصنيع حقيقي".
أما الواقع، فهو وادٍ آخر تمامًا. البيئة التصنيعية في المغرب ما تزال تعشش فيها طفيليات بيروقراطية وذهنية مقاومة للتغيير، لا تَكره شيئًا قدر كرهها للكفاءة. كل سياسة صناعية جديدة تُوأد قبل أن تولد، لأن المكون البشري – وأقصد هنا المهندس – لم يُمنح بعد شروط النهوض. بل أصبح هو نفسه ضحية منظومة لا تُريد له أن ينهض.
لنبدأ من الجذر: تكوين المهندس المغربي. أكثر خريجي الهندسة اليوم يأتون من مدارس خاصة حديثة النشأة، لا تملك من الاعتماد سوى اسم على لافتة، ولا من الجودة سوى شهادات تُمنح بسخاء. التكوين نظري إلى درجة تجعل الطالب يعرف كيف يصمم جسرًا على الورق، لكنه يتلعثم أمام مفك في الورش.
وإن سألته عن الخبرة الميدانية؟ لا يتجاوز معدل التداريب الطويلة 12% من البرامج، في بلدٍ ما تزال فيه معظم المصانع تشتغل بنفس أدوات السبعينيات، بينما يُدرّس الأستاذ مادة "الروبوتيك" بلوح طبشوري وكتاب منسوخ.
ثم، حتى لو افترضنا وجود كفاءات استثنائية – وما أكثرها – أين سيذهب هذا المهندس؟ في اقتصاد تُهيمن عليه الفلاحة والسياحة، ويُحتفى فيه بمراكز النداء كـ"استثمار أجنبي مباشر"، بينما تُمارس الصناعة بحياء. نُشيد ببعض مصانع التركيب كأننا اخترعنا العجلة، وننسى أن هذه المصانع تستهلك المهندس المغربي دون أن تطوّره. فالمهندس هناك ليس عقلًا مفكرًا، بل مُشغّل آلات يُكرر ما يُطلب منه دون إبداع أو تطوير.
أما الإنفاق على البحث والتطوير، فهو فضيحة وطنية: 0,8% فقط من الناتج المحلي تُصرف على البحث، ومعظمها من القطاع العام، بينما القطاع الخاص يفضل أن "يتوكل على الله" ويستثمر في العقار أو في استيراد مواد مصنعة جاهزة للبيع "بلا صداع الرأس". في المقابل، دول مثل إسبانيا تصرف أكثر من 1,4% من ناتجها، وتُسجل سنويًا ما يفوق 12 ألف براءة اختراع. أما نحن، ففي أحسن الأحوال نُسجل مائة... مع احتمال أن تكون نصفها طلبات مكررة!
لكن المهزلة لا تنتهي هنا. المهندس المغربي، رغم كل ما سبق، يُصدّر بكفاءة عالية. فرنسا وكندا تستقطبانه كما تستقطبان الفوسفاط، لكن مجانًا. أكثر من 20 ألف مهندس مغربي في الخارج، يعملون في مشاريع عملاقة، بينما في وطنهم يُطلب منهم أن يصمموا مراحيض مدارس أو يختموا على وثائق في مكاتب بلدية. هذه الهجرة تكلفنا أكثر من 1,5% من الناتج الوطني سنويًا، ومع ذلك نُواصل تكوينهم... من أجل غيرنا. هذا الاستنزاف المنظم للعقول يعد، حسب منظري اقتصاد التنمية، من بين أكبر معيقات التقدم للبلدان النامية.
وإن بقي أحدهم في الوطن، فغالبًا ما ينتهي به المطاف في قطاع لا علاقة له بتخصصه: البنوك، الإدارات، العقار. الهندسة عندنا لا تُمارَس، بل تُركَن في السيرة الذاتية. 60% من المهندسين المغاربة يعملون خارج نطاقهم، وقلّة من يجرؤ على البوح بمرارة المسار.
أما البيئة الجامعية، فحدّث ولا حرج. فقط 15% من الأساتذة لهم علاقة من قريب أو بعيد بالصناعة. المشاريع الصناعية غائبة تمامًا عن البرامج، والمدارس لا تتعامل مع المقاولات إلا في حفلات نهاية السنة. النتيجة؟ خريج لا يفهم السوق، وسوق لا تعرف الخريج، ونقاش دائم عن "الفجوة بين التكوين والتشغيل" وكأنها ظاهرة طبيعية مثل المد والجزر.
أما عن الأساتذة، فحدّث ولا حرج. كثيرٌ منهم لا علاقة له لا بالصناعة ولا حتى بما يُصنّف كمستجدات علمية. يُدرّس موادّ لم يمارسها قط، ويشرح مفاهيم لم يتعامل معها خارج قاعة المحاضرات. يعيش في جزيرة أكاديمية منعزلة، لا تربطه بالمقاولة سوى الشكوى من "قلة التعاون". بعضهم يدرّس الهندسة الصناعية ولم يسبق له أن زار مصنعًا، ويُدرّس هندسة البرمجيات وهو لا يميّز بين GitHub وGitana. أما التقنيات الحديثة – من الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى الخوارزميات التنبؤية – فهي عندهم مجرد عناوين تُدرج في المراجع دون أن تلامس المنهاج.
في ظل هذا الانفصال المزمن بين ما يُدرّس وما يُطلب في السوق، يصبح الطالب ضحية مرتين: فهو يتعلم خارج الزمن، ويُحاسب كأنه ابن وادي السيليكون.
حتى حين نحاول أن نحاكي كوريا الجنوبية أو ألمانيا في التصنيع، ننسى أن هذه الدول خصصت آلاف الدولارات سنويًا لكل طالب، بينما نحن نُموّل الطالب المهندس بأقل من 1,200 دولار في السنة. بالمقابل، تنفق الدول الصناعية أكثر من 15 ألف دولار سنويًا على كل مهندس، وتُنتج حائزين على نوبل، بينما نُنتج نحن "متخصصين" لم يساهموا طيلة دراستهم في مشروع تصنيع يتيم.
نحن لا نفتقد الكفاءات، بل نفتقد الشجاعة. لا ينقصنا المهندسون، بل الإرادة السياسية لإخراجهم من الظل. لا نحتاج لمخطط صناعي جديد، بل نحتاج لمن يعترف بأن المنظومة الحالية لا تصنع سوى العجز، والمهندس فيها ليس فاعلاً بل ضحية.
وإلى أن نُغيّر هذه المعادلة... سيبقى المهندس المغربي هو المواطن الوحيد الذي يُهندس لنهوض... بلدان لا يحمل جنسيتها.
د.نبيل عادل
أستاذ باحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية
عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية