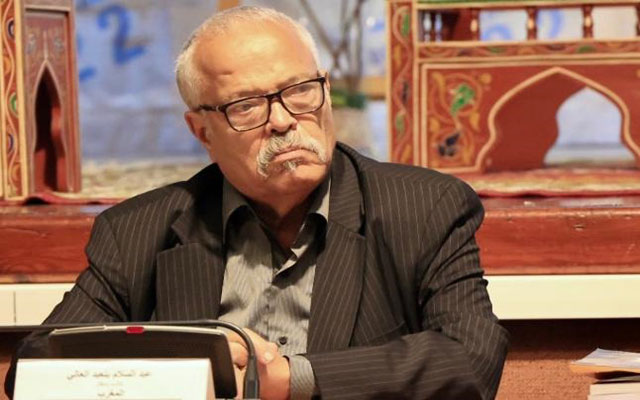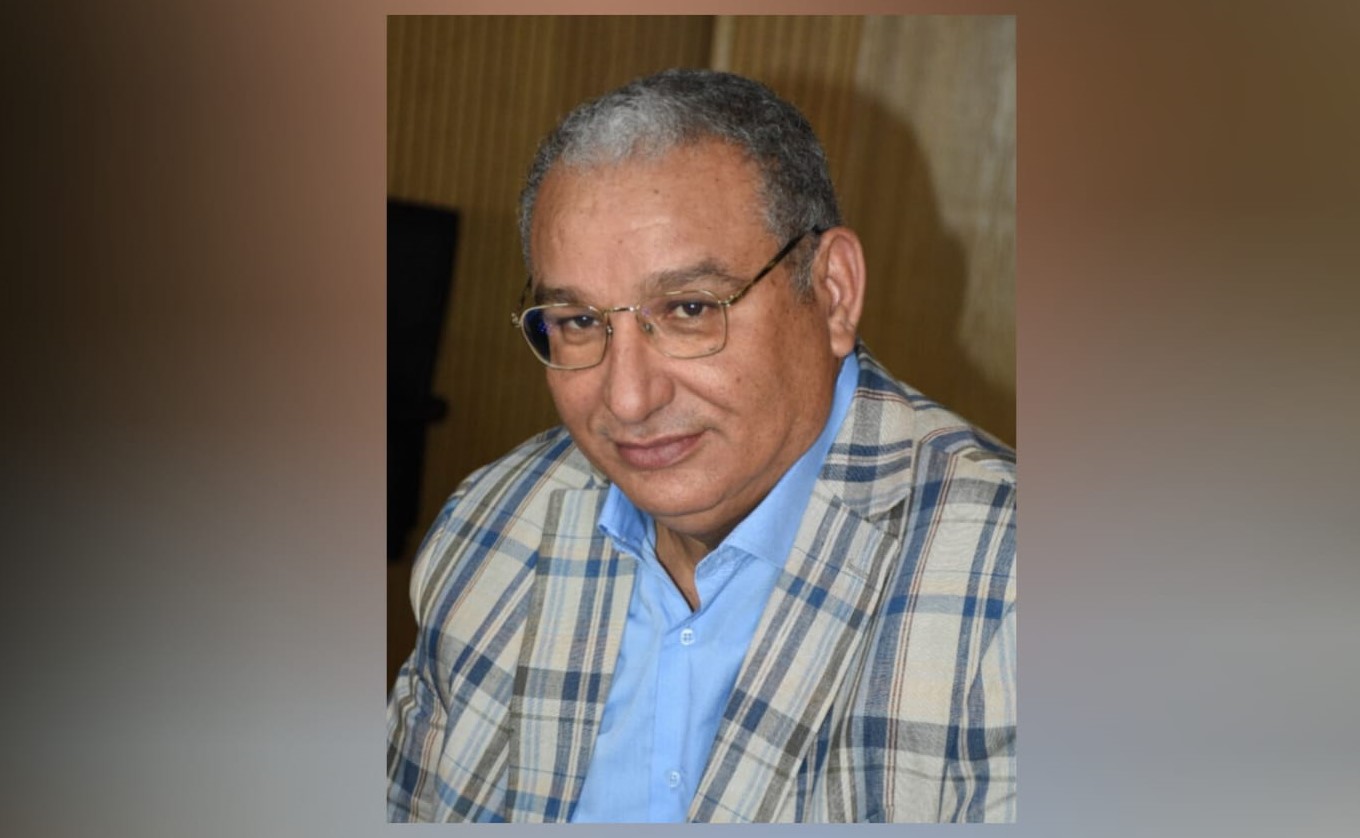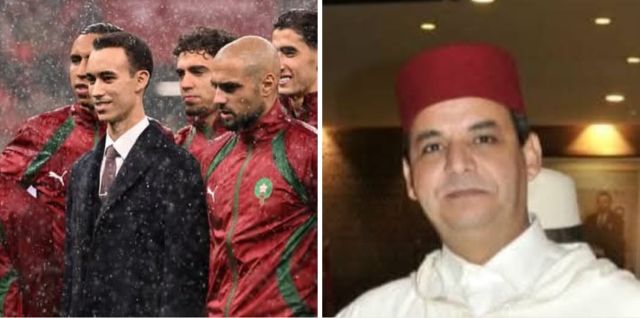"التسامح نقيض الضيافة: فعندما أكون "متسامحا"، أقيد استقبالي للآخر، أحتفظ بالسلطة وأسيطر على مساحتي الخاصة" - جاك دريدا
"لنستعد رمز الباب: لكي تكون هناك ضيافة، لا بد من وجود باب. لكن إذا وجد باب، فلا ضيافة بعد ذلك، ولا وجود لبيت ضيافة بحق. لا يوجد بيت بلا باب أو نافذة، لكن بمجرد وجود باب ونوافذ، فهذا يعني أن أحدا ما يملك المفتاح، وبالتالي عليه أن يتحكم في شروط الضيافة. لا بد من وجود عتبة، لكن إذا وجدت عتبة، فلا ضيافة بعد ذلك. هذا هو الفرق، هذه هي الفجوة بين ضيافة الدعوة وضيافة الزيارة. في الزيارة، لا يوجد باب. أي كان، يمكن أن يأتي في أي لحظة ويمر دون حاجة إلى مفتاح الباب. لا مراقبة جمارك في الزيارة، أما في الدعوة، فهناك جمارك، كما أن هناك شرطة رقابة" - جاك دريدا
تولد مفهوم التسامح خلال حركة الإصلاح الديني الأوروبية، ليعبر عن تغير في الذهنية نتج من علاقة الاعتراف المتبادل بين القوى التي استمرت تتصارع طوال القرن السادس عشر داخل الدين الواحد. وقد انتقل إلى الفكر العربي المعاصر فحاول دعاة الإصلاح أن يوظفوه. بعضهم ذهب إلى الإشادة به واعتباره مفتاح التحديث الفكري والسياسي (فرح أنطون)، وبعضهم الآخر ذهب إلى القيام ضده واعتباره مدعاة إلى زرع الشتات و"النيل من وحدة الأمة" (جمال الدين الأفغاني).
رواسب
ظل هذا المفهوم حاملا رواسب الإشكالية الدينية التي نشأ في حضنها، والتي جعلت منه، قبل كل شيء، نداء "للمحبة والرحمة والإحسان للناس بعامة". فرغم التوسع الذي عرفته دلالاته، ورغم محاولات سعيه كي يرتقي إلى مستوى المفهوم الفلسفي، إلا أنه ظل متسما بهذا الطابع الديني، مرتبطا بمفاهيم المحبة والإحسان، الأمر الذي حال دون فعاليته حتى عند من يعتبرون أنفسهم ناحتيه ومولديه. ويكفي، دليلا على ذلك، أن ننتبه إلى ما يعرفه الغرب المعاصر، سواء في علاقته بمستعمراته السابقة، أو بالأقليات المتعايشة معه من مظاهر اللاتسامح، كي لا نقول التعصب والعنصرية، حيث يشكل عدم الاعتراف بالآخر، وبالخصوصيات الثقافية صفات ملازمة لكثير من المواقف، حتى تلك التي تدعي اليسارية.
لم يلبث مفهوم التسامح أن شحن بحمولات تجاوزت الحقل الديني لتطال المجال السياسي والاجتماعي والثقافي، فانتهى إلى التسليم بـ"الحق في الاختلاف" في الاعتقاد والرأي، والاعتراف للفرد-المواطن بالحق في التعبير، داخل الفضاء المدني، عن الآراء الدينية والسياسية والفلسفية التي يختارها، وليغدو ركيزة من ركائز الحداثة السياسية والفكرية. الأمر الذي دعا إلى ضرورة محاولة إرسائه على أسس فلسفية حتى لا يظل فحسب مجرد استجابة لواجب ديني، أو مجرد امتثال لإلزام أخلاقي، أو مجرد حاجة تفرضها الضرورات السياسية والقانونية، كي ينتقل من معنى التكرم والسخاء إلى الاعتراف بالحق، بل إلى احترامه.ا
لكي يرتفع التسامح إلى مستوى المفهوم الفلسفي، ولكي ينتقل من مجرد الدلالة على التحمل والتقبل لواقع مفروض، إلى مستوى الحق والمشروعية، لزم نحت مفهوم يقوم على أسس عقلانية تسمح بحد أدنى من الإجماع. وقد تبين أن التسامح ليس هو عدم اكتراث بالآخر، بل تقبل كيفيات مغايرة في التفكير والسلوك مع غض الطرف عما يجعلها تخالفنا بحيث نبدي نوعا من "التساهل" (هذا هو اللفظ الذي عبر به منذ بداية القرن الماضي فرح أنطون عن المفهوم) و"التنازل"، كي لا نقول "التغاضي"، إزاء الآخر، متحملين (كما يقول الاشتقاق اللاتيني للكلمة تحمل: supporter= tolerare :) اختلافاته وفروقه.
مفهوم الاختلاف
إذا كان الكل يجمع اليوم على أن التسامح هو قبول الاختلاف، إلا أن الخلاف يبدأ عند تحديد مفهوم الاختلاف ذاته. ذلك أننا نستطيع أن نميز بين مفهومين عن الاختلاف يقابلان مفهومين عن التسامح:
- هناك التسامح الذي يتقبل الآخر لأنه لا يبالي به In-différent، ويقبل الاختلاف بعدم أخذه في الاعتبار.
- وهناك التسامح كانفتاح على الآخر في اختلافه، واقتراب منه في ابتعاده.
لا تسامح إلا إذا سلمنا بأن الاختلاف، قبل أن يعني الآخر، يعني الذات، وقبل أن يكون حركة توجهنا نحو الآخر، هو حركة تبعدنا عن ذواتنا، فتحول بينها وبين التعصب لرأي، والتشبث بمنظور، والتعلق بنموذج، وتمنعها من أن تضع نفسها جهة الحقيقة والخير والجمال، وتضع الآخر حيث تراه هي في الضفة المخالفة. على هذا النحو يغدو التسامح تسامحا مع الذات قبل أن يكون تسامحا مع الآخر، وسيتنافى من ثمة مع كل وثوقية وتعصب و"انشغال" بالذات.
لا ينبغي أن يفهم من هذا الرد لمسألة التسامح إلى الذات وإحالتها عليها، دعوة إلى إحياء الحمولة اللاهوتية والأخلاقية التي تولد في حضنها المفهوم. فالأمر لا يتعلق بدعوة أخلاقية إلى نكران الذات وإلغائها، ولا بموقف أنطولوجي ينفي الهوية. فلسنا هنا أمام دعوة أخلاقية ترفع فضيلة الإيثار شعارا لها، كما أننا لا نرمي بلوغ حد لا نقول عنده أنا أو نحن. فليست الغاية أن يدفعنا قبول الاختلاف إلى محو الهوية، ليس الهدف نفي الوعي بالذات والشعور بالتمايز، وإنما الوصول إلى حيث لا تبقى قيمة كبرى للجهر بالأنا وإشهار الهوية وإبرازها في مقابل التنوع الذي نكون عليه.
التسامح هو ما بفضله نبتعد، أنا والآخر، عن أنفسنا بهدف التقائنا معا وتقبل كل منا لاختلافاته، ودخولنا في حوار ننفصل بواسطته عن ذواتنا وننفلت من الوثوقية ونتحرر من عبودية الحقيقة.
العتبة
هذا المعنى للتسامح دفع دريدا إلى التخلي حتى عن مفهوم الهجرة ذاته، والاقتصار على مفهوم الاختلاف، الذي يسمح لنا بتوظيف مفهوم "العتبة" من حيث إنها لا تعني الحدود التي يمر منها الأجانب، بل من حيث إنها تعمل داخل المجتمع والثقافة ذاتهما. إنها عتبات الآخرية التي لا تختزل بالضرورة في "غرابة" الغريب.
وعلى رغم ذلك، فقد لاحظ دريدا أن التسامح، مهما قلنا ومهما تحفظنا، يجيء دوما من جانب "الأقوى حجة"، فهو دوما تأكيد لسيادة. فكأن المتسامح يقول: سأغض الطرف عن كثير من الأمور وسأفسح لك المجال في بيتي، إلا أن عليك أن تتذكر دائما أنك في بيتي.
في هذا المعنى، فالتسامح نقيض الضيافة، أو هو "ما يضع حدا لها". فإذا أنا قرنت الضيافة بالتسامح وجعلت هذا شرط تلك، فمعنى ذلك أنني متمسك بالحفاظ على سيادتي ونفوذي وكل ما يتعلق بأرضي وبيتي وديانتي ولغتي وثقافتي... أنا أهب الضيافة وأفتح بيتي متسامحا، شريطة أن يلتزم الغريب معايير حياتي، إن لم يكن ثقافتي ولغتي وتشريعاتي. معنى ذلك أنني لا أتحمل "الضيف"، لا أتحمل الغريب والآخر، إلا في حدود معينة، إلا وفق شروط. فالتسامح ضيافة متخوفة، ضيافة متحفظة، ضيافة سيد لمسود، ضيافة حذرة غيورة على سيادتها، ضيافة مشروطة، فهو إذن ليس ضيافة.
لا تكون الضيافة ضيافة إلا إذا كانت منفتحة على ما لا يمكن توقعه، إلا إذا كانت منفتحة على غرابة الغريب، إلا إذا كانت متقبلة للضيف وما يضيفه. إنها لا تكون ضيافة إلا إذا كانت زيارة، وليس تلبية لدعوة واستجابة لطلب. فإذا كان التسامح ضيافة مقننة، ضابطة لقواعد الاستقبال، معقمة ضد فيروسات الآخر، مسلحة ضد ما فيه من غرابة، فإن الضيافة "الخالصة" انفتاح على ممكنات، ومخاطرة. إنها متطلعة لما في الغريب من غرابة.
لا يمكن مفهوم الضيافة أن يكون بندا من بنود القانون، إلا أن هذه الضيافة تظل مع ذلك، ورغم ما يبدو في الأمر من مفارقة، "هي الشرط الأساس لما هو سياسي ولما هو حقوقي" على حد تعبير دريدا. لذا فإن الفيلسوف الفرنسي ذا الأصول الجزائرية يدعونا إلى أن نعيد مساءلة مفهوم التسامح من جديد، لا اعتراضا عليه بل وفاء له. ذلك أن هذا المفهوم ربما لم يعد كافيا لتسليحنا بما يلزم لمقاومة العنف الهائج الذي يكتسح العالم، والذي يتخذ أشكالا متعددة ليس أقلها شأنا شكلها الرمزي. فلو نحن أعرنا انتباها إلى ما يجري من حولنا لتبين لنا أن زلزالا عنيفا قد أخذ يقوض الأوضاع التي اتخذ فيها التسامح شكله الأول منذ قرون.
لا مفر لنا إذن من أن نفتح مفهوم التسامح على مفهوم يضم معانيه ويتخطاها، وهذا المفهوم هو مفهوم الضيافة. فالسياسة والحقوق، بل الأخلاق ذاتها لا يمكن أن تكون بلا ضيافة. والتسامح، أي الضيافة المشروطة، لا بد أن يقترن اليوم بالضيافة اللامشروطة، ويقبل الضيف وما يضيفه، بل ويجعلنا لا نتبين من هو الضيف ومن هو المضيف كما قال الشاعر.
عن مجلة "المجلة"