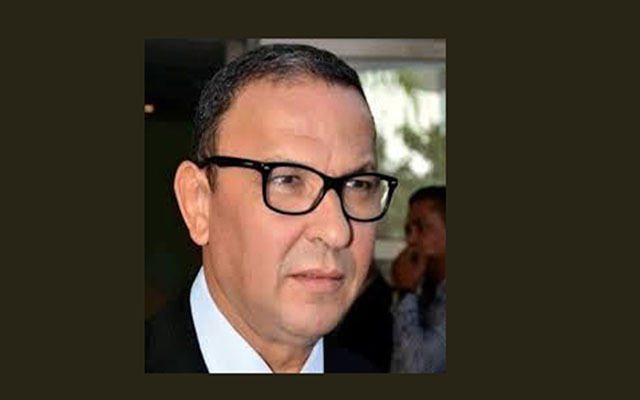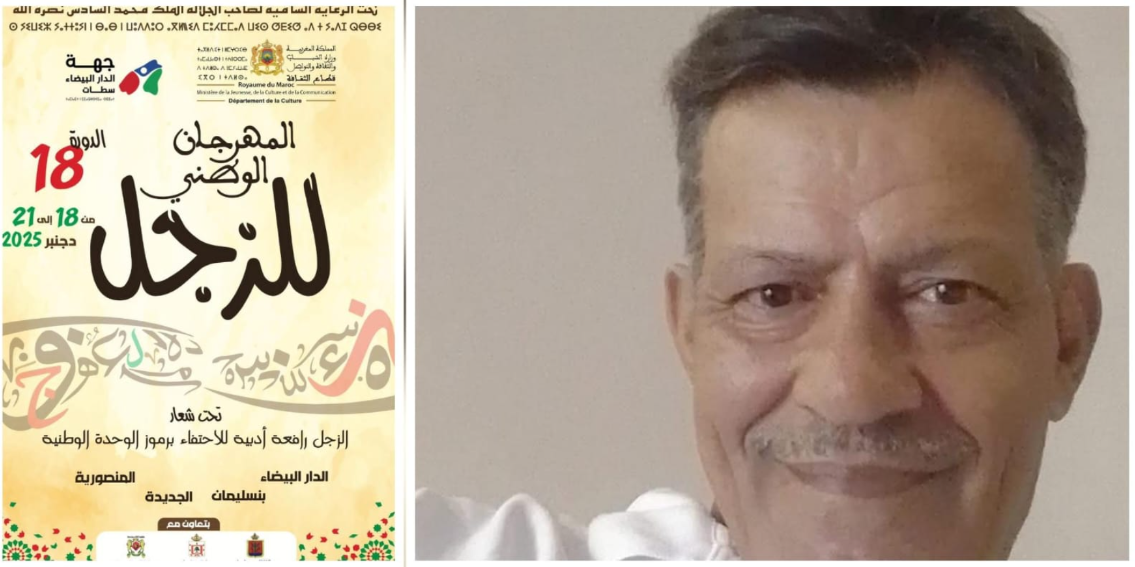هذا السؤال طرح على الإنسان في مسيرته الوجودية في هذه الحياة، منذ أن تشكل في جماعة، بدائية أو منظمة، وأصبح هذا الوجود والتعايش الجماعي، مصدراً للأذى من الإنسان لأخيه الإنسان، عن طريق الجريمة منذ قابيل وهابيل.
وتعددت الخيارات الإنسانية في المجتمعات المختلفة، وعبر الأحقاب التاريخية، حيث أعياها البحث المضني الهادف إلى إيجاد وسيلة مثلى للحد من الجريمة كإمكانية، أو منعها بالمرة كغاية مثلى.
وطرح هذا السؤال اليوم في بلادنا أصبح ضرورة، يفرضها الارتفاع المهول، لعدد السجناء بنسبة تتصاعد سنة عن سنة، مع ما يطرحه هذا الواقع من إشكالات اقتصادية واجتماعية وحقوقية ومالية .... وما يخلفه من قلق لدى الرأي العام، والمسؤولين على مختلف المستويات، حيث أثار أحد رؤساء الغرف البرلمانية، بمجلس النواب إشكالية هذا الاكتضاض وأرجع أسبابها إلى أن قضاة المادة الجنائية، يلجأون إلى إصدار أحكام يعقوبات قاسية، تعكسها المدد المرتفعة للعقوبة.
ومباشرة بعد إثارة هذه القضية، أمام البرلمان، سارع وزير العدل والحريات مباشرة إلى القيام بزيارة إلى الجهة القضائية المذكورة، مما يؤكد حقيقة ما أشار إليه رئيس الفريق المذكور، ودرجة الصدى الذي خلفه لدى المسؤول الأول عن بلورة السياسة الجنائية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تصريحات المندوب العام لإدارة السجون، المنشورة في الصحافة الوطنية، خلال الفترة المذكورة اعتبرت أن إشكالية الارتفاع المهول للسجناء، لا يمكن حلها فقط عن طريق بناء السجون، أو ترشيد تدبير التسيير الإداري والتنظيمي داخلها، بل إن ما يزيد من تعقيد الوضعية، هو الأحكام القضائية القاسية التي يصدرها القضاة والمبالغة في الاعتقال الاحتياطي، وكأنه يعتبر - والحالة هذه أن العقوبات المرتفعة، والاعتقال الاحتياطي - وحدهما - هي أحد العوامل الأساسية، في تعقيد الأوضاع داخل السجون، مع ما يترتب عن ذلك، من انعكاسات سلبية على الحالة الحقوقية العامة، التي تتجاوز آثارها حدود البلد، لتمس سمعته في المحافل الحقوقية الدولية.
وبناء عليه، فقد أصبحت العقوبة القاسية وإجراءات الاعتقال الاحتياطي، موضوعاً مطروحاً بشكل حاد، يتطلب الدراسة العميقة، الفلسفتها، والغاية منها، وشروط تحديدها وتنفيذها.
فالوضع في السجن، سواء كان اعتقالاً احتياطياً مؤقتاً كتدبير، أو حبساً، أو سجناً لمدة محددة بحكم أو قرار، أصبح يطرح مشكلة اكتضاض السجون، وما ترتبه هذه الحالة من عواقب وإفرازات حقوقية واقتصادية، وإنسانية ....
وما دام القانون، هو وسيلة لتنظيم الحياة في المجتمع في الأحوال العادية أو الاستثنائية، وما دامت الدولة هي المسؤولة عن تدبير الحياة الاجتماعية، وتأمين الطمأنينة والاستقرار، والحفاظ على إنسانية الإنسان، فإن الاكتضاض داخل السجون، أصبح ظاهرة خطيرة يجب معالجتها، بعد الإحاطة بأسبابها المباشرة، وغير المباشرة، بمسؤولية وموضوعية، بعيداً عن إلقاء اللوم على هذه الجهة أو تلك.
إن الواقع الاجتماعي المعيش لدى الطبقات الفقيرة الموسوم بالخصاص والهشاشة، والمحدودية القاسية للإمكانيات المادية لتوفير الحدود الدنيا لاستمرار الحياة، قد تجعل بعض ساكنة السجون من الشباب الذين يكتوون بقساوة هذه الظروف، لا يهابون من عواقب ارتكابهم للأفعال الإجرامية، لعلمهم أن المال الذي هو السجن، لن يكون أكثر سوءاً من الحياة التي يعيشونها داخل البيت أو في الحياة العامة المطبوعة بالخصاص في الوعي وفي ضرورات الحياة في مستوياتها الدنيا.
فالظاهرة أكبر من أن تعود مسؤوليتها لجهة محددة، أو سبب واحد، وأعقد من أن يعالجها طرف واحد، بحيث إنها تشمل الجانب التشريعي والقضائي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي، والحضاري ....
فبالنسبة للتشريع، يمكن ملاحظة أن القانون الجنائي المغربي الذي يحدد أركان الجريمة ومدة العقوبة قد مر على وضعه أكثر من نصف قرن شهدت المجتمعات ومنها المغرب تحولات عميقة على جميع المستويات، فكان من الضروري أن تنعكس هذه التحولات على التشريع عامة والجنائي بصفة خاصة، مادام القانون وسيلة لتنظيم الحياة وترتيب العلاقات والأوضاع المختلفة، وتدارك أعطاب المجتمع ومعالجة مظاهر الخلل فيه.
فبالنسبة للتشريع الجنائي الموضوعي أو الإجرائي، لا بد من توافر تفاعل وتكامل بينهما في معالجة القضايا الجنائية على مختلف مستوياتها، وخاصة وجوب تحديد العقوبة، بمعايير موضوعية، لا تجعل سلطة القضاء التقديرية مغلولة، و لا تبسطها كل البسط، بل ينبغي أن تكون بين ذلك قواماً .
مع الإشارة إلى أن ضرورة التطور، تفرض إعادة النظر في كثير من فصول القانون الجنائي، التي أصبحت متجاوزة لا منطقاً ولا واقعاً ، ولتأكيد هذه الضرورة، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الفصول 507 وما يليه من القانون الجنائي، حيث يمكن أن تصل مثلاً عقوبة الفصل 509 من القانون الجنائي إلى عشرين سنة، الشخصين، سرقا دجاجة ليلاً !
فلا يعقل والحالة هذه، أن تستمر مثل هذه المقتضيات الموروثة عن مرحلة سادت لكنها اليوم بادت وأصبحت لها مضاعفات سلبية في توزيع العدل بين الناس.
وعطفاً على ما ذكر، فإن عملية وضع العقوبة، وتنفيذها، لم تفعل المقتضيات الإيجابية التي وردت في قانون المسطرة الجنائية على شكل بدائل مختلفة لتنفيذ العقوبة على الطريقة التقليدية ، التي أصبحت متجاوزة في كثير من الأوضاع، وبالنسبة للعديد من المحالين على القضاء ، في تجاهل أو إهمال المقتضيات تفريد العقوبة.
وهنا يمكن التساؤل عن الغاية من وضع العقوبة، هل الغاية هي إلحاق الأذى والألم، أم أن العقوبة هي وسيلة علاجية، لعضو في المجتمع فقد رشده وخرج على قواعد التعايش داخل المجتمع، وينبغي إعادته إلى جادة الصواب من حالة الشرود الطارئة عليه ؟؟
وهل السجن مكان لعقاب المجرم، أم مؤسسة لإصلاحه، وإعادة إدماجه في المجتمع ؟؟
فاستقراء التشريع، يفيد أن القانون يكتفي بوضع القواعد والأحكام والأنظمة التي تتحرك في إطارها العقوبة، ولا يحدد أهداف العقوبة ومقاصدها بصفة صريحة ودقيقة، لأن غايته المساواة النظرية المجردة، ولو كانت - عملياً - بعيدة عن المساواة الفعلية.
إن إشكالية العقوبة والاعتقال مطروحة بإلحاح على المجتمع برمته، وانعكاساتها وآثارها متعددة الأبعاد الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية ... ومعالجتها تقتضي تدخل كل الفعاليات الرسمية والشعبية، بقصد الإحاطة الشمولية، في تفاعل خلاق بين النظرية الحقوقية والتجربة الميدانية في استحضار الطبيعة المجتمع المغربي وخصوصياته، وبنياته الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والنفسية... لتحديد مقاصد العقوبة ووسائل الوصول لهذه الغاية، والمناسبة مواتية، حيث إن حواراً وطنياً يواصل في السنين الأخيرة، بدوافع حقوقية واقتصادية، واجتماعية، بغاية إيجاد بدائل للواقع الذي تنعكس آثاره السلبية على كل مناحي الحياة، والأكيد أن مسؤولية مواجهة هذا الواقع، كان من بوادر التعامل معه، ولو في إطار التشريع، حيث تم وضع قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي يعتبر - رغم ما قيل عنه . خطوة مبدئية في مسار تدبير إشكالية العقوبة، سعياً للحد من مضاعفاتها الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، والأمر مرهون بمسطرة تطبيق هذا الاختيار، ترقباً لتفاعلاته ومساطره مع الواقع الموضوعي المعقد، الذي لن تخفف من عناده إلا المتابعة الدائمة التشعباته وإفرازاته لتدارك النقائص وتكريس الإيجابيات.