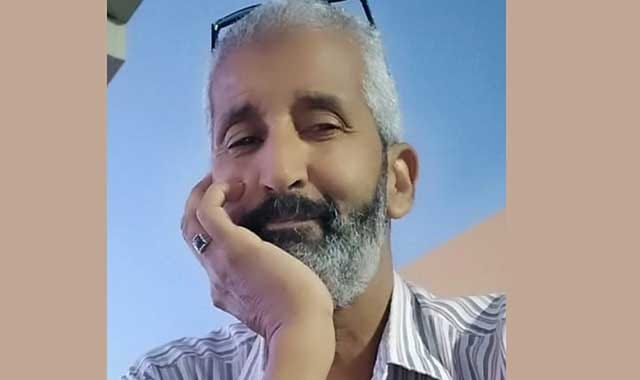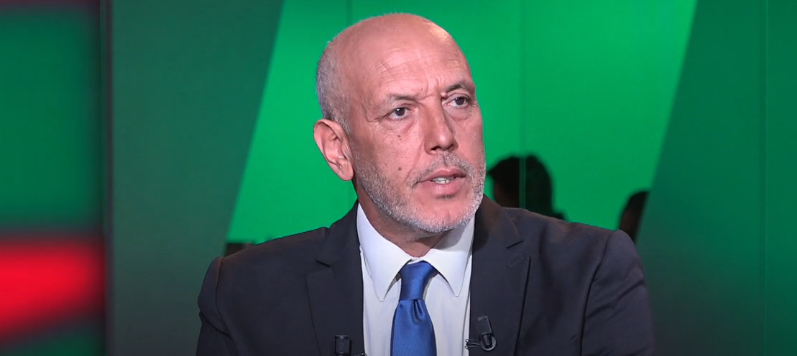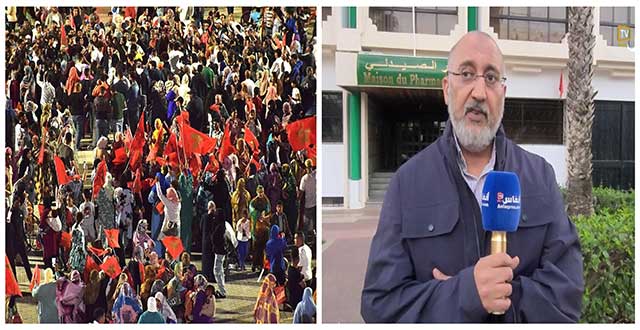لا يمكن النظر إلى مشروع تعديل مدونة الأسرة بالأمر الهين، بل ورش شائك وصعب المراس، كونه من المعادلات الصعبة التي شغلت الرأى العام المغربي والعربي، نظرا لما أصبحت تفرضه قيم الحداثة من ضغوطات على المجتمعات التقليدانية وبحثها المضنى عن صورة لها قد تلائم قيمها فتسمح لها بالتأقلم مع الوضع الجديد وما تفرضه من ضوابط العولمة، لكن تستمر بعض الهيئات المدنية المنفتحة على الغرب إما بشكل تلقائي أو بقناعة نسبية، تنزل قيما غريبة بالتقسيط في البداية لتفاجئي على حين غفلة أنها تسرع الخطى لفرض رؤى غريبة لا تتناسب مع قيم المجتمع المغربي، لذلك اتخذ طرح تعديل مدونة الأسرة حدة في النقاش المجتمعي بشكل غير مسبوقة سواء على الساحة الثقافية أو على مواقع التواصل، انقسم فيه المجتمع بين طرف يصفق لجرأة التعديل خصوصا بعد بصمة المجلس العلمي، بينما الطرف الآخر يعتبر هذه الجرعة زائدة كونها غير منسجمة في جانبها الديني العقدي، نظرا لكون تلك التعديلات تنسف القيم بل وتفكك الأسرة كخلية أساسية في مفهوم الأمة.
فإلى أي حد يمكن اعتبار هدا النقاش صحي؟
في ظل أي شروط يمكن للبنية الفكرية للمجتمع المغربي استيعاب هدا القفزة النوعية؟
لقد شكل مشروع تعديل مدونة الأسرة في المغرب نقطة انطلاق لنقاشات عميقة ومعقدة حول الهوية والقيم الاجتماعية، هو بالمناسبة نقاش صحي رغم قوة الانتفاضة هذه، لأنه يفصح عن وجود تباين واضح في الآراء ومساحة زمنية بين فئات المجتمع وهذا طبيعي في الصراع بين القيم التقليدية والحداثة.
إن فتح مجال الحوار يزكي حركية النقاش كمنصة لتبادل الآراء والأفكار، مما يسهم في تعزيز ثقافة الجدال الايجابي في المجتمع ويرفع من الوعي الاجتماعي، لتعطي وزنا قويا للقضايا المجتمعية والأسرية على وجه الخصوص، مما يساعد في فهم التحديات التي تواجههم ويسمح بإعادة تقييم القيم والتقاليد لتكون فرصة تحديث بعض المفاهيم التي لم تعد تتناسب مع سيرورة المجتمع وتعرقل تطوره.
لقد اتضح أن دائرة النقاش حول تعديل مدونة الأسرة لم تتم إدارته بشكل صحي عقلاني يراعي اختلاف الرؤى داخل المجتمع، بل أجج الحوار بين جميع الأطراف، لتصبح حجم التحديات التي تواجه المجتمعات التقليدية في هده الفترة بالذات لم تعكس الفهم الأعمق للبنية الفكرية للمجتمع المغربي.
فالنقاش الحاد يسمح بانقسام المجتمع، حيث يتخذ البعض مواقف متطرفة تكرس الانقسامات بدلاً من الحوار البناء، لا غرابة في اعتقاد البعض أن تلك التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى فقدان الهوية الثقافية والدينية، مما يخلق قلقاً اجتماعيا، لأن الضغط على هذا الفئات بهذه التغيرات السريعة والغير مهضومة يؤدي إلى إرباكها، خاصةً في ظل عدم وجود دعم متزن وكافٍ لتسهيل عملية الانتقال.
لذلك أن القراءة المتزنة لهذه الانتفاضة عن طريق استنطاق المسكوت عنه في مواقف وخطابات الفئات المعارضة تفرض أن الشرط في أي مقترح هو فهم واستيعاب البنية الفكرية للمجتمع، علما أن الإشكال في كون النسبة الغالبة في المجتمع لا تقبل لا التفاوض لا المساس بالمقدس ولا تفكيك قيم اكتسبتها بالفطرة ولا يجرؤ أحد مناقشة تفاصيلها.
فاستعراض وصفة المناصفة أو المساواة بمنسوب قوي وبفارق زمني غير مهضوم، لم يكن بشكل منهجي يراعي هده البنية الفكرية التقليدية، خصوصا في فترة انتقالية طال أمدها، إذ استمرت مجموعة من التغييرات والنقلات دون استيعاب. وأن اتخذت أحيانا شكل مغالطات، نتيجة غياب دوائر و هيئات مدنية فاعلة تتبنى القرب لتصحيح مسار تلك النقاشات السائدة، سواء على مستوى العقدي أو الحقوقي. فطرح حقوق المرأة بهذه الجرأة والتي لم تطرح في منظومة حقوقية شاملة، لذلك تم اعتبارها على أنها هجوم على مقومات الرجل العربي، وبالتالي فإن كثافة الأسئلة التي يطرحها المجتمع لم تراوح مكانها.
رغم أن الحقيقة تكشف أن أطرافا، سواء في الدولة، أو في هيئات سياسية تحاول التظاهر على أنها اقتنعت بالقيم الجديدة أو فقط تبدي تعاطفا، حتى لا تصنف في خانة الدوائر الرجعية؟!
فلماذا لم تناقش قيم الأسرة في الحضن الذي ولدت فيه؟
وما الغاية من مقترح تقييم عمل المرأة العاملة في المنزل بمقابل مادي؟
ولماذا لم تجرؤ الديانة اليهودية مناقشة منظومة الإرث رغم التفاوت بين أطراف الاسرة؟
ألا يمكن أن تؤثر هذه المقترحات على تفكك الأسرة كمنظومة موحدة؟
لذلك يبقى المسؤول عن هذا الضجيج الذي يبدو في غالبيته سياسيا إن لم نقل سياسويا، هو المؤسسة الفقهية. مادامت لم تجرؤ على اقتحام باب الاجتهاد وايجاد حلول لمنظومة الأسرة، دون الحاجة لبلقنة تجارب مجتمعات أخرى. بالكاد تدور في حلقات مفرغة ولا يمكن اعتبارها نموذجا ناجحا في مجال التكاتف الأسري.
فما هي العوامل التي أدت إلى حدوث هذا الضجيج السياسوي اذا صح التعبير؟
وكيف تحقيق حوار بناء حول موضوع شائك؟
ولماذا غاب أهل الحل والعارفين بالخبايا؟