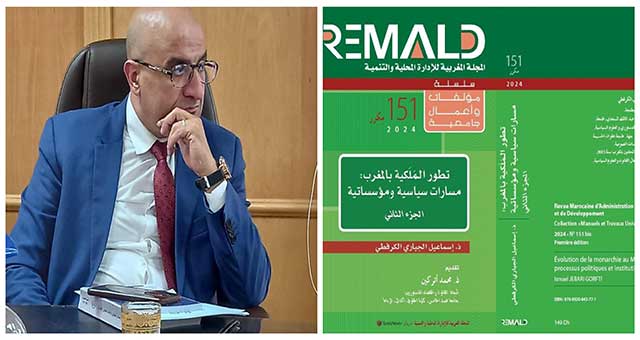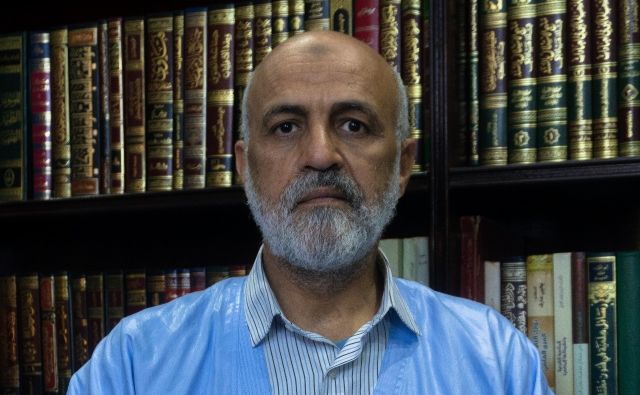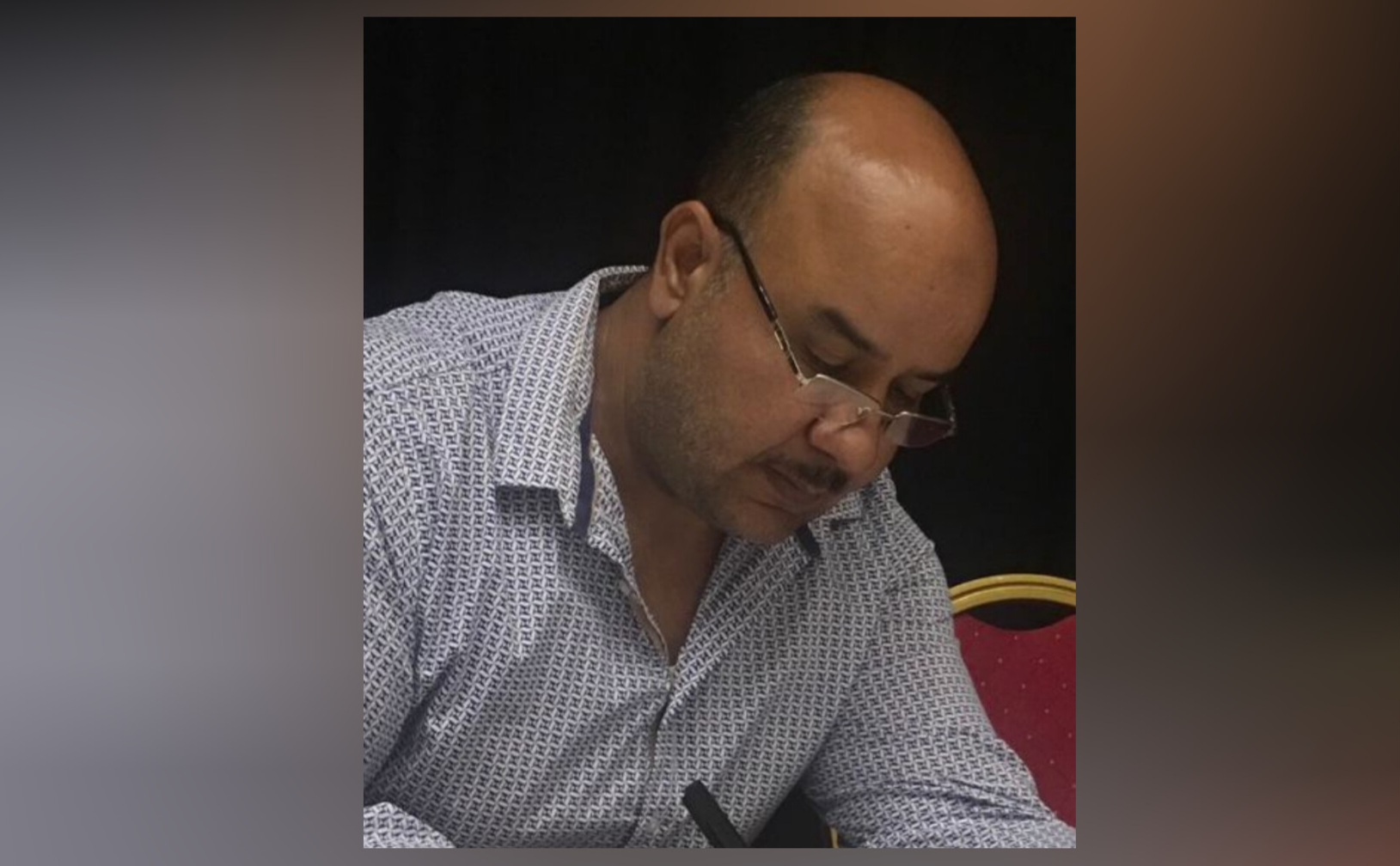وضع محمد أتركين، أستاذ القانون والقضاء الدستوريين، تقديما لكتاب "تطور الملكية بالمغرب.. مسارات سياسية ومؤسساتية" لصاحبه اسماعيل الجباري الكرفطي، جاء فيه:
إن المَلَكية الثالثة، تأخذ بعدا جديدا (الطريق نحو الملكية البرلمانية)، وهي مَلكية، تجد هويتها في الفصل الأول من الدستور، وأيضا من قراءة تكاملية لأحكامه، التي تعلي شأن الفرد واختياراته، بهندسة مقرة لمبدأ فصل السلط، وبنشوء مركز لسلطة الانتخاب مزاحم لسلطة التعيين.. لكن، هل الوصول إلى الملكية البرلمانية متوقف على هندسة دستورية مقلصة من حضور الملك وصلاحياته داخل النص الدستوري؟ وهل التدريب التدريجي على (الملكية المقيدة)، العاملة وفق قواعد مكتوبة محددة، سيقود في النهاية إلى (الملكية البرلمانية) أم أن سؤال (الملكية البرلمانية) يتطلب مقدمات ومحددات أخرى، لا تمر بالضرورة عبر الوثيقة الدستورية؟
تسائل الأحزاب السياسية وجاهزيتها، وجود ثقافة للمؤسسات، ودرجة الثقة فيها، ومدى إمكانية اشتغال نسق في غياب فاعله المركزي المشكل دوره الديني، كما وظيفته التحكيمية، وإشرافه على مؤسسات القضاء والعنف المشروع، محط قبول الجميع..؟إنها الأسئلة المقلقة، التي لا نجد لها جوابا في دعوات (الملكية البرلمانية) و(الملكية البرلمانية الآن).. وهي التي ربما قادت، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لوضع الدستور، جوابا على السؤال ذاته، للقول إن (الطبقة السياسية غير ناضجة للدخول في مرحلة الملكية البرلمانية).
وبالرجوع لكتاب المحامي الجباري، الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية، نجده يتحدث عن دستور 2011، وكيف أنه جاء كإجابة مؤسساتية على التوترات التي طبعت العلاقة بين الفرد والسلطة قبل الدسترة، من خلال تطور الفكرة الدستورية قبل 1962 تاريخ أول دستور للمملكة، وإشكالية الصراع الذي عرفه المغرب بين الفرد والسلطة، وما ترتب عن ذلك من هيمنة السلطة على البناء المؤسساتي وغياب الفرد داخل المنظومة الدستورية.
على هذا الأساس، فإن تحديد مسار الانتقال الدستوري والتعبيرات المؤسساتية للفرد يقتضي تحليل المحددات الكبرى للانتقال الدستوري والتحول النوعي من شرعية النظام السياسي إلى شرعية النظام الدستوري، عبر تحليل ومقاربة بناء القيم المشتركة وتناول التعبيرات المؤسساتية للأفراد والأسس المرجعية لعلاقة الفرد بالسلطة في البنية الدستورية.
من هنا، فإنه تقتضي مقاربة المحددات الكبرى لتدبير الانتقال الدستوري من خلال رصد أثر التحول الديموقراطي على علاقة الفرد بالسلطة في البناء الدستوري، وحدود التحول النوعي من شرعية النظام السياسي إلى شرعية النظام الدستوري ، كما سنتناول الأبعاد المؤسساتية الجديدة لتعبيرات الأفراد والمحددات المرجعية لعلاقة الفرد والسلطة في البناء الدستوري.
إن آلية التأويل أصبحت الآن في إطار هاته التحولات النوعية المرتبطة بتحول الخطاب الدستوري من خطاب غلى السلطة، إلى خطاب إلى الفرد- آلية جوهرية انثل قرار الفرد خارج المجال العام المؤسساتي (التعبيرات خارج النظام، احتجاجات، عرائض، ملتمسات..)، والفرد داخل المجال العام المؤسساتي من خلال الآليات التمثيلية: الأحزاب، المجتمع المدني، البرلمان، المعارضة.
هذا التحول في علاقة السلطة والفرد عزز من الطابع التمثيلي للمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات ومؤسسات الحكامة، كما عزز علاقتهما بالتأويلين الرئاسي والبرلماني للدستور.
في هذا الباب فإن السياسات التشريعية والقضائية والتنفيذية أصبحت الآن في إطار هذا التحول النوعي الجديد على مستوى البنية الدستورية وهندستها تقوم على أساس محدد مرجعي وهو الفرد باعتباره مصدر السلط وملكا للسيادة.
كما أن ممارسة الفرد للحريات داخل المؤسسات (في الأحزاب، الجمعيات) يجعلنا أمام تحول نوعي لمبدأ التمثيلية للفرد على مستوى تأثيره في القرار العام على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي، المعزز بآلية دستورية ضامنة وهو القضاء الدستوري الذي يمثل الفرد.
أيضا الفرد والبناء الدستوري من خلال المبادرة وصياغة الوثيقة الدستورية جعلنا أمام هيمنة السلطة في بناء التعاقدات وصياغة الوثيقة الدستورية عبر التحكم في السلطة التأسيسية والسلطة الفرعية وسلطة التعديل، هذا الواقع كان في البنية الدستورية ما قبل دستور 2011 لكن هذا الوضع تحول إلى حالة دستورية جديدة تقوم على أساس أثر الفرد في بناء وتأسيس الوثيقة الدستورية.
في هذا التوتر الدستوري بين خطابين، طرح إشكال جديد بعد دستور 2011 هو من يصنع الدستور؟ السلطة أم الفرد؟ إن تحديد السياقات السياسية و التاريخية في بناء ووضع الدستور من حيث تدخل الأفراد والسلطة في وضعه وما ترتب عنة ذلك من صراعات وآليات مؤسساتية وقانونية على مستوى التأسيس والمحددات والمنطلقات يوضح لنا طبيعة الفرد والسلطة في بنية الدستور في مساراتها من جذور إلى تطور الفكرة الدستورية.
إن المَلَكية الثالثة، تأخذ بعدا جديدا (الطريق نحو الملكية البرلمانية)، وهي مَلكية، تجد هويتها في الفصل الأول من الدستور، وأيضا من قراءة تكاملية لأحكامه، التي تعلي شأن الفرد واختياراته، بهندسة مقرة لمبدأ فصل السلط، وبنشوء مركز لسلطة الانتخاب مزاحم لسلطة التعيين.. لكن، هل الوصول إلى الملكية البرلمانية متوقف على هندسة دستورية مقلصة من حضور الملك وصلاحياته داخل النص الدستوري؟ وهل التدريب التدريجي على (الملكية المقيدة)، العاملة وفق قواعد مكتوبة محددة، سيقود في النهاية إلى (الملكية البرلمانية) أم أن سؤال (الملكية البرلمانية) يتطلب مقدمات ومحددات أخرى، لا تمر بالضرورة عبر الوثيقة الدستورية؟
تسائل الأحزاب السياسية وجاهزيتها، وجود ثقافة للمؤسسات، ودرجة الثقة فيها، ومدى إمكانية اشتغال نسق في غياب فاعله المركزي المشكل دوره الديني، كما وظيفته التحكيمية، وإشرافه على مؤسسات القضاء والعنف المشروع، محط قبول الجميع..؟إنها الأسئلة المقلقة، التي لا نجد لها جوابا في دعوات (الملكية البرلمانية) و(الملكية البرلمانية الآن).. وهي التي ربما قادت، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لوضع الدستور، جوابا على السؤال ذاته، للقول إن (الطبقة السياسية غير ناضجة للدخول في مرحلة الملكية البرلمانية).
وبالرجوع لكتاب المحامي الجباري، الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية، نجده يتحدث عن دستور 2011، وكيف أنه جاء كإجابة مؤسساتية على التوترات التي طبعت العلاقة بين الفرد والسلطة قبل الدسترة، من خلال تطور الفكرة الدستورية قبل 1962 تاريخ أول دستور للمملكة، وإشكالية الصراع الذي عرفه المغرب بين الفرد والسلطة، وما ترتب عن ذلك من هيمنة السلطة على البناء المؤسساتي وغياب الفرد داخل المنظومة الدستورية.
على هذا الأساس، فإن تحديد مسار الانتقال الدستوري والتعبيرات المؤسساتية للفرد يقتضي تحليل المحددات الكبرى للانتقال الدستوري والتحول النوعي من شرعية النظام السياسي إلى شرعية النظام الدستوري، عبر تحليل ومقاربة بناء القيم المشتركة وتناول التعبيرات المؤسساتية للأفراد والأسس المرجعية لعلاقة الفرد بالسلطة في البنية الدستورية.
من هنا، فإنه تقتضي مقاربة المحددات الكبرى لتدبير الانتقال الدستوري من خلال رصد أثر التحول الديموقراطي على علاقة الفرد بالسلطة في البناء الدستوري، وحدود التحول النوعي من شرعية النظام السياسي إلى شرعية النظام الدستوري ، كما سنتناول الأبعاد المؤسساتية الجديدة لتعبيرات الأفراد والمحددات المرجعية لعلاقة الفرد والسلطة في البناء الدستوري.
إن آلية التأويل أصبحت الآن في إطار هاته التحولات النوعية المرتبطة بتحول الخطاب الدستوري من خطاب غلى السلطة، إلى خطاب إلى الفرد- آلية جوهرية انثل قرار الفرد خارج المجال العام المؤسساتي (التعبيرات خارج النظام، احتجاجات، عرائض، ملتمسات..)، والفرد داخل المجال العام المؤسساتي من خلال الآليات التمثيلية: الأحزاب، المجتمع المدني، البرلمان، المعارضة.
هذا التحول في علاقة السلطة والفرد عزز من الطابع التمثيلي للمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات ومؤسسات الحكامة، كما عزز علاقتهما بالتأويلين الرئاسي والبرلماني للدستور.
في هذا الباب فإن السياسات التشريعية والقضائية والتنفيذية أصبحت الآن في إطار هذا التحول النوعي الجديد على مستوى البنية الدستورية وهندستها تقوم على أساس محدد مرجعي وهو الفرد باعتباره مصدر السلط وملكا للسيادة.
كما أن ممارسة الفرد للحريات داخل المؤسسات (في الأحزاب، الجمعيات) يجعلنا أمام تحول نوعي لمبدأ التمثيلية للفرد على مستوى تأثيره في القرار العام على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي، المعزز بآلية دستورية ضامنة وهو القضاء الدستوري الذي يمثل الفرد.
أيضا الفرد والبناء الدستوري من خلال المبادرة وصياغة الوثيقة الدستورية جعلنا أمام هيمنة السلطة في بناء التعاقدات وصياغة الوثيقة الدستورية عبر التحكم في السلطة التأسيسية والسلطة الفرعية وسلطة التعديل، هذا الواقع كان في البنية الدستورية ما قبل دستور 2011 لكن هذا الوضع تحول إلى حالة دستورية جديدة تقوم على أساس أثر الفرد في بناء وتأسيس الوثيقة الدستورية.
في هذا التوتر الدستوري بين خطابين، طرح إشكال جديد بعد دستور 2011 هو من يصنع الدستور؟ السلطة أم الفرد؟ إن تحديد السياقات السياسية و التاريخية في بناء ووضع الدستور من حيث تدخل الأفراد والسلطة في وضعه وما ترتب عنة ذلك من صراعات وآليات مؤسساتية وقانونية على مستوى التأسيس والمحددات والمنطلقات يوضح لنا طبيعة الفرد والسلطة في بنية الدستور في مساراتها من جذور إلى تطور الفكرة الدستورية.