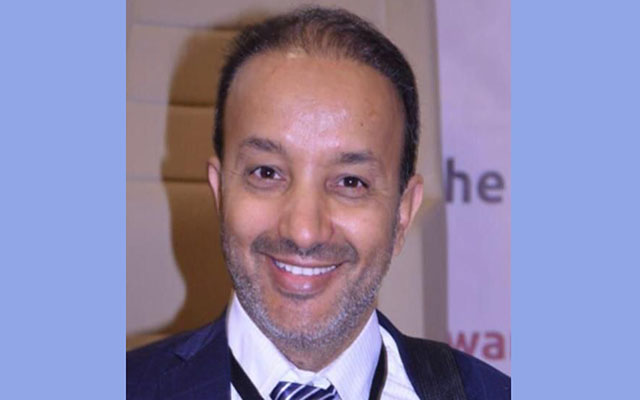إذا كان الأمازيغ يتحكمون في القرار السياسي والحكومي والترابي والعسكري والقضائي، أي في القرار الاستراتيجي للبلاد، هل يبقى من حق أي جمعية أو فرد أو شبكة الادعاء أن الأمازيغ «محكورون» و«مقصيون» و«مبعدون» و«مهمشون»؟
منذ استقلال المغرب تعاقب على العرش ثلاثة ملوك: الراحلان محمد الخامس والحسن الثاني، وحاليا محمد السادس. كل ملك كان يرتكز في بداية حكمه على سندين مهمين: الجيش وجهاز الداخلية. ففي عهد محمد الخامس، وما أن استقل المغرب، لاحظنا كيف لعب الجيش دورا محوريا (رغم أنه جيش حديث النشأة وقليل العدد والعتاد آنذاك)، علما أن البلاد مرت بمراحل حرجة بسبب الاصطدام بين القصر والحركة الوطنية. وبعد مجيء الحسن الثاني لم يتردد القصر في المناداة على الجيش للقيام بمهام مدنية في الحكومة وفي الإدارة الترابية، بل والقيام بتكليف ليوتنان كولونيل الدمناتي عام 1964 بإدارة مدرسة استكمال تكوين الأطر بالقنيطرة الخاصة برجال السلطة (والتي مازالت تحت إدارة مسؤول عسكري إلى اليوم). وهذا ما يفسر، لماذا تتقاسم وزارة الداخلية والجيش معطى واحدا، ألا وهو كونهما الوتدين الرئيسيين اللذين يتم الاعتماد عليهما لإدارة شؤون البلاد. تلازم نفس المنحى سنجده مع بداية حكم محمد السادس، حيث أن معظم نشاطاته الأولى كانت تتم بحضور كبار ضباط الجيش، وخطابه التنظيري الأول وجهه يوم 9 أكتوبر 1999 لرجال السلطة. والإنعام الأكبر طال كبار الضباط (جنيرالات وكولونيل ماجور) عام 2002 ليتوج بالإنعام على العمال والولاة في عيد العرش لعام 2008، بالموافقة على إصدار ظهير جديد لرجال السلطة، اعتبره هؤلاء ثورة (مادية ومعنوية) في مسارهم المهني.
هذا التلازم بين الجيش والداخلية، اللذين ينهضان كأوتاد للقصر، تم تقعيده منذ البصمة التي تركتها شخصيتين أمازيغتين بارزتين في وزارة الداخلية والجيش، وهما: الكولونيل مبارك البكاي (أول رئيس حكومة مغربية بعد الاستقلال)، والجنيرال محمد أوفقير الذي كانت له اليد الطولى في إدارة شؤون الدولة على عهد الحسن الثاني.
وإذا كان الجيش والداخلية هما دعامتا القصر، فإن ذلك يقود ميكانيكيا إلى القول إن الأمازيغ هم الدعامة الرئيسية له، بالنظر إلى أن الحوض الجغرافي والإثني الذي ينهل منه المخزن أطره العسكرية والأمنية والسياسية والترابية هو الحوض الأمازيغي بالأساس. أي أن الذي يمسك بمقاليد القرار الاستراتيجي بالبلاد هم أبناء الأمازيغ. وتزداد الصورة وضوحا، إذا استحضرنا الذراع القضائي أيضا، بالنظر إلى أن القضاء سلطة موضوعة مباشرة تحت المعطف الملكي، حيث نجد أن معظم مسؤولي المحاكم والنيابة العامة بالمغرب ينحدرون بدورهم من أصول أمازيغية.
تأسيسا على ما تقدم، يحق طرح السؤال التالي: إذا كان الأمازيغ يتحكمون في القرار الأمني والترابي والعسكري والقضائي، أي في القرار الاستراتيجي للبلاد، هل يبقى من حق أي جمعية أو فرد أو شبكة الادعاء أن الأمازيغ «محكورون» و«مقصيون» و«مبعدون» و"مهمشون".
إذا كانت سياسة البلاد الاقتصادية والمالية والمجالية تبصم ببصمة صناع القرار المنحدرين من أصول أمازيغية، هل يبقى مشروعا القول إن المناطق الأمازيغية تعاني من التهميش الإرادي بدعوى أنها أمازيغية؟ (علما أننا لم نتحدث عن تحكم الرأسمال السوسي والريفي في مقاليد الشركات والتجارة). وإذا كان الأمر كذلك، فما السر وراء هذا الـ «تسونامي» من البلاغات الصادرة عن عدة جمعيات أمازيغية المتضمنة للخطابات الجنائزية من قبيل: «إبادة الشعب الأمازيغي من قبل العرب المحتلين»! والإسلام الدخيل على بلاد تامزغا! و«ضرورة تدخل المنتظم الأممي لحماية «الأقلية الأمازيغية»!؟
الجواب عن هذه الأسئلة يحصره المراقبون في ثلاث خانات:
أولا: إما أن الخطاب يندرج في إطار المزايدة ومساومة السلطة المركزية لتوزيع المزيد من الموارد الرمزية والمادية على نشطاء الجمعيات الأمازيغية الراديكالية، خاصة وأن الموجة الأولى من المناضلين الأمازيغيين تحولوا إلى مدبرين (gestionaires) بعد أن أصبحوا في الحكم، وبالتالي أصبح هاجس هؤلاء هو إنجاح حرف تيفيناغ أو إيجاد الكتاب المدرسي الأمازيغي أو تحديد دفتر تحملات القناة الأمازيغية أكثر منه هاجس إيديولوجي تعبوي. ويستند أصحاب هذا الطرح إلى منطق الحركات الاجتماعية، حيث يصعب إرضاء كل الزعماء بتمتيعهم بالمناصب، وبالتالي تقع الانشقاقات والاحتجاجات والمزايدات.
ثانيا: وإما أن هذا الخطاب هو نتيجة للإفراط في تقمص دور الضحية (la victimisation) والإحساس بأن الأمازيغ مظلومون و«محكورون». ويستدل أنصار هذا التيار بالنزعة السائدة في بعض المدن الأمريكية لدى الحركات الخاصة بالأمريكيين السود، والتي تفرط بدورها في تقمص دور الضحية حتى يتجنب السود أي تحمل للمسؤولية والانخراط في بناء المجتمع.
ثالثا: وإما أن هذا «التهييج» أمر مخدوم من طرف بعض أقطاب الأحزاب الذين يستعملون الورقة الأمازيغية بعد أن تم لفظهم من النسق السياسي، وبالتالي أضحت هذه المطالب بمثابة ورقة للانتقام أو للتشويش، حيث يلاحظ المتتبع أن العديد من التظلمات والمطالب (اجتماعية أو معيشية) أصبحت تصرف أمازيغيا، لدرجة أن الباحث سعيد بنيس، أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة محمد الخامس أوضح لـ "الوطن الآن" أن بحوثه التي أجراها بمنطقة تادلة أزيلال أفضت إلى الوقوف على مفارقة بارزة، ألا وهي أن أغلب أسر هذه المنطقة لا ترغب في تعليم أبنائها الأمازيغية بالمدارس (رغم أن هذه المنطقة تنتمي للحوض الأمازيغي)، بل تود تعليمها اللغة الإيطالية لكونها لغة وظيفية تساعد على اندماج الأبناء في حالة ما إذا ظفروا بتذكرة العبور نحو إيطاليا بالنظر إلى أن هذا البلد يضم نسبة عالية جدا من المهاجرين المنتمين لجهة بني ملال خنيفرة. أما الأطروحة الشيقة للباحث محمد بنهلال التي نال بها شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع بمارسيليا تحت عنوان «كوليج أزرو: تشكيل نخبة بربرية مدنية وعسكرية بالمغرب» وصدرت في كتاب عام 2005 عن دار النشر karthala بباريز، فيجد فيها القارئ توثيقا مدققا لمسار النخب الأمازيغية التي اعتمد عليها الحكم بالمغرب بشكل تجعل المرء يتخلى عن أطروحة «ريمي لوفو» حول «الفلاح المغربي حامي العرش» ليتبنى أطروحة بنهلال حول: «الأمازيغي هو حامي العرش»، خاصة لما تعود الذاكرة بالمراقب إلى البداية الأولى للاستقلال ليكتشف أنه من أًصل 320 قائدا عينهم الملك في عام 1960 هناك 250 رجل سلطة أمازيغي تخرجوا من «كوليج أزرو»، الذي لم يكن يدرس فيه في عهد الاستعمار سوى أبناء الأمازيغ المنتمين للمنطقة الممتدة من صفرو إلى الراشيدية مرورا بمكناس وإفران والحاجب وخنيفرة.
أما إذا أضفنا إليهم أبناء الأمازيغ المنحدرين من سوس والريف الذين درسوا في المعاهد العتيقة أو مدارس الحركة الوطنية أو بمعهد مولاي يوسف بالرباط ومولاي ادريس بفاس «فستكتمل الباهية».. علما أن رجل السلطة هو ممثل الملك في تراب نفوذه. فهل الملك يمنح ثقته لمن لا ولاء ولا وفاء له؟
سؤال مطروح على طاولة الأصوات الراديكالية التي تسعى إلى الانتشاء بحدوث تفكك وطني، اللهم إلا إذا انتبهت الأجهزة العمومية إلى المخاطر المحتملة، وفتحت حوارا وحافظت على الجسور مع هذه الجمعيات لإقناعها بأن المغرب بني على أشكال هوياتية عديدة، ولتذكيرها بأن المغرب منذ معركة وادي المخازن لم يعش أي ارتعاشة قومية كتلك التي عاشها أثناء عام 1975 لدى تنظيم المسيرة الخضراء، وهي الارتعاشة التي تدل على أن الاندماج بين المغاربة تشكل كوعي عبر آلاف السنين.. وبدل أن يرفع سقف المطالب إلى مستوى العبث، تبقى الأصوات الراديكالية مطالبة بالجواب على سؤال: ماذا قدمت هذه النخب الأمازيغية لتنمية مناطقها بدل الاستمرار في ترديد الخطاب الجنائزي؟