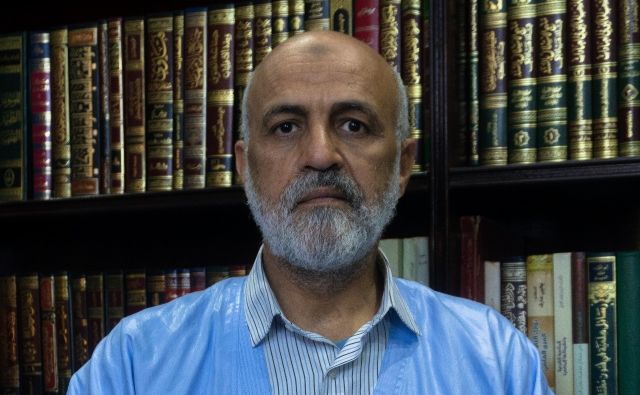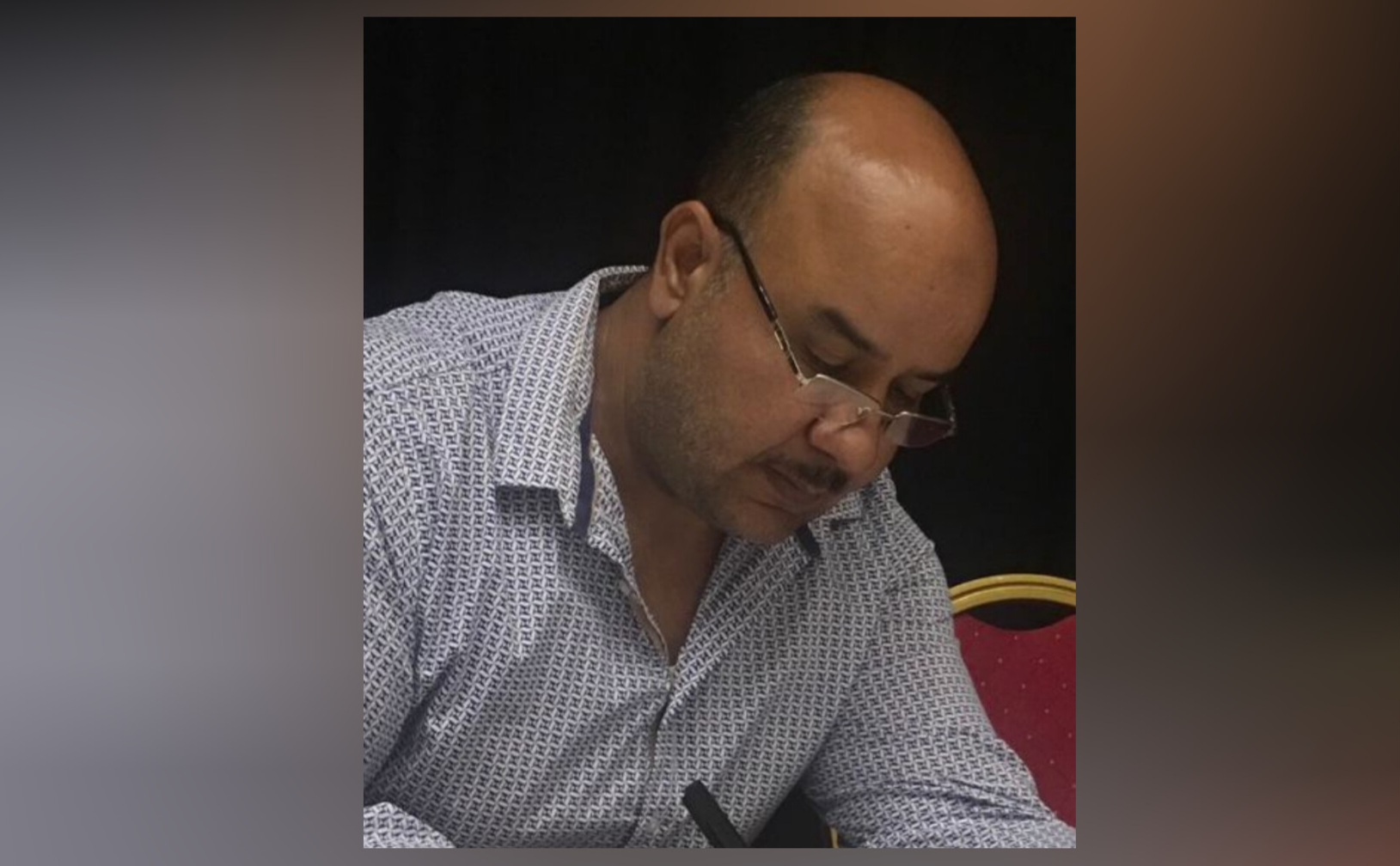في كل بلدان العالم، أساس وجود التكوين المهني هو التجاوب المباشر مع احتياجات سوق العمل ومدها بالموارد والكفاءات في كل فروع اقتصادياتها الوطنية، وأن المقاولات طرفا وشريكا وفاعلا في تطوير النظم التكوينية ضمن استراتيجياتها الخاصة في تتبع المواصفات الناشئة للمهن ومد المؤسسات التكوينية بنماذج مصغرة من اختراعاتها لتكون أساسا لاستكمال المراس المهني وتيسير طرق استيعاب ميكانزمات اشتغال المعدات والأجهزة.
ولم يكن عبثا في بلادنا، أن تستحدث السلطات الاستعمارية أول مركز للتكوين المهني بحي المحيط بالرباط، لصيانة وإصلاح المحركات ذات الوقتين، لإشباع حاجاتها من اليد العاملة المؤهلة في تتبع الحالة الميكانيكية للدراجات النارية العسكرية.
لذا لا يمكن فهم الوظائف الحقيقية للتكوين المهني إلا ضمن هذه المقاربة وأن إلحاقه بوزارة التربية الوطنية، قد يشكل مزيدا من التعثرات، لحقل من العمل لا يستقر له حال مع التطورات التكنولوجية والاختراعات المتسارعة في أيامنا هذه.
ما العمل، لكي تسترد منظومة التكوين المهني قوتها وفاعليتها في خدمة الأهداف الاستراتيجية، لتنمية قدرات الناس وتمكينهم من المشاركة الواسعة في عمليات البناء الاقتصادي؟
هنا نقترح أحد عشر إجراء، تستهدف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، باعتباره الأداة الرئيسية لدى المملكة في الاختصاص، بتلقين المهن والتدريب عليها وضمان التكوين المستمر للقوى العاملة في الاستمرار على المحافظة على فرص عملها إزاء التطورات المتسارعة في الوظائف ومواصفات المهن في سوق العمل:
1- ضبط وتقنين عمل المديريات المركزية، لتجاوز التداخل والهيمنة فيما بينها على الاختصاصات. ولجعلها قادرة على التتبع والتقويم الداخلي للسياسات التكوينية ومدى احتياجاتها للتنفيذ على مستوى المؤسسات التكوينية. مع الإلحاح لتجاوز هذه المديريات لعقليات اختزال مهامها في التفتيش.
2- الإقرار للمؤسسات التكوينية بسلطاتها البيداغوجية، على القرارات التي تهم تقويم وتزكية المسارات التكوينية للمتدربين.
3- الاستثمار القوي في المعدات والأجهزة للمحارف والقاعات المختصة، لضمان تكوين رفيع للمتدربين يتجاوب مع تحديات امتلاكهم لأسس تدريبة متينة، تيسر لهم القبول بسوق العمل.
4- مراعاة شروط التوجيه المهني، للمتدربين عبر توفير معطيات قابلة لقياس قدراتهم على مدى المسار التعليمي العام للتلاميذ، ومساعدتهم في تقويم اختياراتهم المستقبلية، بما يستحضر عوامل النجاح في المسار المهني.
5- اتخاذ قرارات جريئة وعاجلة، بالحذف النهائي للشعب التي بلغت درجتها القصوى في إشباع سوق العمل وعدم استردادها بتعديلات طفيفة في المقررات أو تغيرات التسميات دون المضامين التكوينية، لتحقق الحكامة في التصرف في الإمكانيات المتاحة.
6- ومن حيث أن المكون هو حجر الزاوية في العمليات التكوينية وجودة مخارجها، وجب تحسين شروط وظروف عمله، وضمان تسليحه عبر مساره المهني بالمعارف والمستجدات في النظم البيداغوجية والتقنية وعدم التشويش على هذه الوظائف، بمهام تنزاح عن صلب أدائه التعليمي.
7- الانفتاح على مبادرات المكونين في تهيء مقررات التكوين وعدم الالتفاف عليها من طرف مسؤولين مركزيين، بإيراد أسمائهم بمداخل التقديم لها، مع تخصيص حوافز سنوية لتجويد مضامين التكوين.
8- اعتبارا لمعطى أن المؤسسات التكوينية هي المسرح الفعلي لعمليات التكوين، وجب إعادة الاعتبار لوظيفة المكون والإنصات إلى اقتراحاته المستمدة من واقع الانتاج المعرفي وتمكينه من الآليات لتصريف اقتراحاته ذات الطبيعة البيداغوجية، دون مركب نقص.
9- إعادة النظر في المركز الوطني للكفاءات، وذلك بالتعاقد مع الخبرات الأجنبية، والارتقاء بوظائفه في استكمال التكوين والتوجيه والإشراف على البحوث وتنظيم الندوات والدورات في قضايا التكوين وإشكالياته الراهنة، وإحداث مسالك للمكونين لتعميق مداركهم العلمية والمعرفية بالمستجدات.
10- إعادة النظر في العلاقة مع المجموعات المهنية وفروعها والاعتراف، بأنه على المستويات الجهوية والمحلية أن العلاقة منعدمة وأن حلها يقتضي مأسستها عبر حوار وطني مع المؤسسات الحكومية، لتمكين هذه العلاقة من بناء شراكات ناجعة ومربحة مع الفاعلين الاقتصاديين.
11- التفكير في الارتقاء ببعض التخصصات، للمستوى العالي في التحضير للإجازات المهنيةّ، بالأخص في المسالك التي يتوفر فيها المكتب على أطر عليا من درجة مهندسون دولة.
- فؤاد الجعيدي، خبير في مجال التكوين المهني