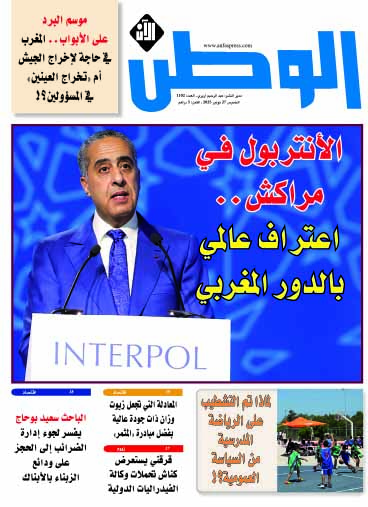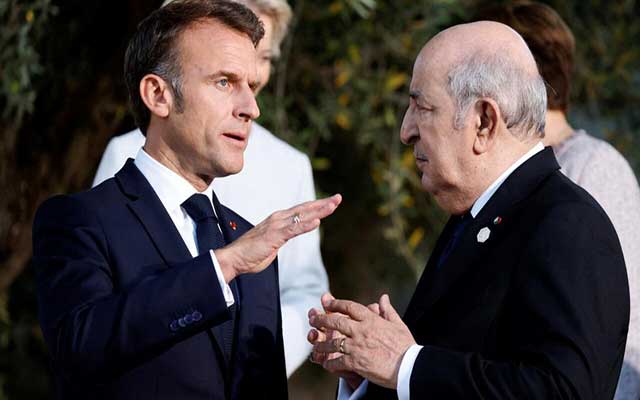يُقال إن علماء وفقهاء الدين، القدامى، أخطأوا لكنهم، في الحقيقة، لم يُخطئوا… فأين يوجد الخلل؟
ما أبدأ به هذه المقالة، هو أن الإنسانَ العاقل، أُمِّيا كان أو مُثقَّفاً، لا يمكن، على الإطلاق، أن ينطلقَ تفكيرُه من فراغ. والمقصود بالفراغ، هنا، هو الفراغ الفكري، أي الدماغ الفارغة من كل معرفة ومن كل تجرٍبةٍ حياتية. لماذا؟
لأن الإنسانَ، ما دام حياً، منذ ولادتِه، أي الطفلُ الحديثُ الوِلادة، لا يتوقَّف عن التَّعلُّم ne cesse pas d'apprendre، وهو طفلٌ ثم مراهقٌ ثم شابٌّ ثم كهلٌ ثم شيخٌ إلى أن يفقدَ الحياة. كما قال ابن خلدون، عالِم الاجتماع sociologue، ومن بعده، كثيرٌ من المربين المُتمرِّسين، الإنسان ابن بيئتِه. والبيئة، هنا يمكن أن تكون الأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو كل هذه المُؤسسات مٌجتمِعة. وبصفة عامة، الإنسان يتعلَّم، أولا وقبل كل شيءٍ، بدون توقُّفٍ، من الحياة الاجتماعية بجميع مشارِبها.
بعد هذا التّوضوح المهم، على الأقل، من الناحية النَّظرية، أنتقِِلُ إلى عنوان هذه، لأبيِّن لماذا علماءُ وفقهاءُ الدين، القدامى، لم يخطئوا، عندما أقبلوا على تفسير الدين (الإسلام) للناس. اعتماداً على التَّوضيحات السابقة، هؤلاء العلماء والفقهاء، لا يمكن أن يكونَ تفسيرُهم للدين إلا صورةً أمينة une image fidèle للأفكار التي كانت سائدةً، في المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه.
وهذا يعني أن الأفكار الوارِدة في تفسيرهم للدين اكتسبوها إما من احتكاكهم مع الآخرين في المجتمع، أي مما كان رائجاً فيه من أفكار دينية، وإما من تأثير بعضهم على البعض الآخر، أي من تناقل هذه الأفكار الدينية من جيلٍ لآخر، وإما بتواطؤ مع الحكام. مع العلم أن منبعَ أو مصدرَ تلك الأفكار هم الصحابة. وعلماء وفقهاء الدين، القدامى، وسار على نهجِهم كثيرٌ من العلماء والفقهاء الحاليين، يعتبرون كلَّ الصحابة عدولاً، أي لا يقولون إلا الحق، أو بعبارةٍ أخري، كلُّهم صادِقون في أقوالِهم. وهذه الثقة المُفرِطة، هي التي جعلت وتجعل كثيراً من الأفكار الدينية تنتقل من جيلٍ إلى آخر بدون تغييرٍ، على الخصوص، في المضمون.
ولهذا، علمياً واجتماعياً، علماء وفقهاء الدين، القدامى، هم أبناء بيئتِم، أي أبناء المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها. وللتوضيح، إن آخرَ رسول ونبي، محمد (ص) هو مَن ساهم في نشر رسالة الإسلام، علما أن هذا النشر دام، بعد وفاة الرسول (ص)، ما يزيد عن 14 قرن من الزمان. وهذه المدة تُعتَبر قصيرة جدا بالمقارنة مع عمر الأرض والإنسان العاقل. فمن الطبيعي أن تكونَ الأفكار الدينية هي السائدة في المجتمعات الإسلامية التي كان يعيش فيها علماءّ وفقهاء الدين القدامى.
وعودةً إلى عنوان هذه المقالة الذي قلتُ في جزءٍ منه أن علماء وفقهاء الدين أخطأوا لكنهم، في الحقيقة، لم يُخطئوا. لم يُخطِئوا لأنهم فسروا الدينَ حسب ما قلتُه أعلاه، أي حينما قلتُ إن أي شخصٍ لا يمكن أن يفسِّرَ الأشياء انطلاقا من فراغٍ فكري، وأن كل مفسِّرٍ هو ابن بيئتِه، أي مجتمعِه. لكن، رغم أن علماءَ وفقهاءَ الدين لم يخطئوا، فإنهم أخطأوا. وهنا، سأجيبُ على الجزء الأخير من عنوان هذه المقالة، أي "فأين يوجد الخلل"؟
يوجد الخللُ في كون علماء وفقهاء الدين، القدامى، حينما أنتجوا أفكارَهم الدينية، كانوا يفكِّرون وكأنهم موجودون خارج الزمان والمكان. بمعنى أن ما أنتجوه من أفكارٍ دينية صالح لكل زمان ومكان. وهذا خطأٌ فادِح لأن كلَّ ما ينتِجه العقل البشري من أفكارٍ، دينية أو دنيوية، هي أفكارٌ نسبية، وبالتالي، قابلة للنقاش. لماذا؟
لأنه، كما قلتُه أعلاه، الإنسان ابن بيئته، أي أن هذا الأنسان ابن مجتمعه. بمعنى أن الإنسانَ، منذ ولادته، وهو يتعلم il apprend. وأول مكان يتعلم فيه الإنسانُ، هو المجتمع، أي الحياة. والإنسان، مثقَّف كان أو غير مثقف، عندما ينتِج الأفكارَ، لا يُنتِجها إلا انطلاقا مما تعلمه. وهذا يعني أن علماءَ وفقهاء الدين، القدامى والحاليين الذين ساروا على نهج هؤلاء القدامى، لا يمكن أن يُفسِّروا الدينَ إلا انطلاقا مما تعلموه، أولا من الحياة، وثانياً، من الثقافة السائدة في المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه. والمجتمع له واقع يُُفرَض على كل الناس. وهذا يعني أن أي مجتمع لا يساير واقعَه، محكومٌ عليه بالجمود، إن لم نقل بالزوال.
وفي الختام، ما أريد أن ألحَّ عليه، هو أن تفسيرَ الدينِ شيءٌ والدين، كما ورد في القرآن الكريم، شيءٌ آخر. بمعنى أن تفسيرَ الدين إنتاجٌ فكري بشري، أي الدين كما فهمه الأولون. وبما أن تفسيرَ الدين إنتاجٌ بشري، فمن المنطقي أن كل جيل له تفسيرٌ خاصٌّ به لهذا الدين. ولهذا فالدين نفسُه، يجب أن يُسايرَ كل تفكير بشري على حِدة. فهل نحن مُتيقِّنون بأن الأجيال القادِمة ستفهم الدينَ، كما فهِمه الأولون. لا شيءَ يضمن ذلك!