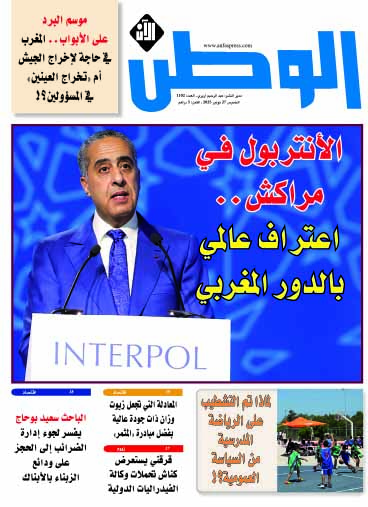على هامش النقاشات الواسعة التي شهدتها المناظرة الوطنية السادسة للتخييم بالرباط، وجدنا أنفسنا أمام زخم من الأسئلة المعلقة أكثر من البحث عن أجوبة جاهزة.
أسئلة تتقاطع فيها العدالة المجالية، والشرعية القانونية، والهوية التربوية، ووضعية المؤطر، ومعنى التطوع، ومستقبل الوقت الحر، لتصنع مشهدا تخييميا معقدا يستدعي إعادة التفكير من جذوره.
فهل يمكن اليوم أن نستمر في توصيف التأطير التربوي داخل المخيمات كعمل تطوعي محض، بينما يمارس الإطار مهاما تُقاس بمنطق المهنة لا بمنطق الهواية؟
وهل يمكن أن نُقنع أنفسنا بأن القانون 06-18 قد حلّ الإشكال، بينما المؤطر يشتغل ساعات تفوق ثلاثة أضعاف ما يسمح به القانون، دون حماية أو تعاقد أو اعتراف؟
ثم ماذا عن العدالة التربوية؟
كيف يمكن لبلد يطمح لرفع نسبة المستفيدين إلى مليون طفل أن يقبل بأن يبقى التخييم خدمة لا تتجاوز 2,6% من أطفال المغرب؟
وإلى متى سيظل توزيع مراكز التخييم يعيد إنتاج اللامساواة المجالية، بين ساحل مكتظ وجبل مُهمَل ووحات مهمشة ومنسية، رغم أن مخيمات الأطلس المتوسط إلى عهد قريب كانت تشكل ذاكرة وطنية حقيقية؟
كيف يمكن لبلد يطمح لرفع نسبة المستفيدين إلى مليون طفل أن يقبل بأن يبقى التخييم خدمة لا تتجاوز 2,6% من أطفال المغرب؟
وإلى متى سيظل توزيع مراكز التخييم يعيد إنتاج اللامساواة المجالية، بين ساحل مكتظ وجبل مُهمَل ووحات مهمشة ومنسية، رغم أن مخيمات الأطلس المتوسط إلى عهد قريب كانت تشكل ذاكرة وطنية حقيقية؟
وماذا عن غذاء الطفل داخل المخيم؟
هل تصل منحة 60 درهم فعلا إلى طبق الطفل؟ وهل نظام "التريتور" هو حل تنظيمي، أم آلية تُفرغ بعض المشاريع التربوية من روحها؟
وهل يمكن إسقاط نموذج غذائي موحد على مشاريع مختلفة: كشفية، تربية شعبية، رقمية، ايكولوجية … دون الإضرار بجوهر التربية؟
هل تصل منحة 60 درهم فعلا إلى طبق الطفل؟ وهل نظام "التريتور" هو حل تنظيمي، أم آلية تُفرغ بعض المشاريع التربوية من روحها؟
وهل يمكن إسقاط نموذج غذائي موحد على مشاريع مختلفة: كشفية، تربية شعبية، رقمية، ايكولوجية … دون الإضرار بجوهر التربية؟
وفي خلفية هذه الأسئلة كلها، يطفو سؤال أخطر:
من يحمي المؤطر التربوي؟
أهو متطوع يُنتظر منه أن يشتغل بلا حدود؟ أم مهني يمارس مسؤولية عمومية دون اعتراف قانوني؟
من يحمي المؤطر التربوي؟
أهو متطوع يُنتظر منه أن يشتغل بلا حدود؟ أم مهني يمارس مسؤولية عمومية دون اعتراف قانوني؟
وكيف يجوز أن نطالبه بواجبات الموظف العمومي عندما يخطئ، دون أن نمنحه حقوق الحدّ الأدنى للعامل التربوي عندما يشتغل؟
ثم ماذا عن الازدواجية القاتلة بين المرسوم المنظم للمخيمات الذي يُغفل الإنسان، والقانون 06-18 الذي يحمي المتطوع… دون أن يجد طريقه إلى التطبيق داخل المخيمات؟
هل نحتاج إلى نقاش جديد حول التطوع؟ أم إلى عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة، والجمعيات، والمؤطرين؟
ثم ماذا عن حل المركبات التربوية والمعهد العالي للتنشيط السوسيو -تربوي ؟
هل سنظل نشتغل بمنطق المخيم الموسمي، أم سننتقل إلى رؤية تجعل من الأنشطة الموازية حقًا تربويًا على مدار السنة؟
هل سنظل نشتغل بمنطق المخيم الموسمي، أم سننتقل إلى رؤية تجعل من الأنشطة الموازية حقًا تربويًا على مدار السنة؟
وهل يمكن فعلا جعل المخيم مدرسة للقيم والمهارات والعيش المشترك، دون بنية قارة وأطر مُمهننة ومسارات تكوين محترفة؟
وأخيرا… ماذا تبقى من وظيفة التخييم كمؤسسة لتربية أجيال الغد، إذا لم نطرح بجرأة سؤال الاعتراف، وسؤال العدالة، وسؤال الاستثمار الحقيقي في الطفولة؟
1- شبكة التخييم وسؤال العدالة المجالية والتربوية
يعيش مغرب اليوم مفارقة تربوية لافتة: فرغم أن التخييم يُعد أحد أقدم أشكال التنشئة الاجتماعية، إلا أنه لا يغطي سوى 2,6% من الأطفال، وهي نسبة هزيلة لا تعكس دولة تؤمن بالعدالة المجالية والتربوية.
ثم تُطرح أسئلة جوهرية:
لماذا مخيم “عطلة للجميع” الذي يحظى بالرعاية السامية، ورغم بلوغه أكثر من مئة عام، ما يزال ملفا قطاعيا لم يرقى إلى سياسة التقائية وهو ما يجعلنا نتساءل كملاحظين عن غياب الوزراء الحكوميين في الجلسة الافتتاحية الذين كانوا من المنتظر أن يوقعوا اتفاقيات تعاون داخل المناظرة؟
لماذا مخيم “عطلة للجميع” الذي يحظى بالرعاية السامية، ورغم بلوغه أكثر من مئة عام، ما يزال ملفا قطاعيا لم يرقى إلى سياسة التقائية وهو ما يجعلنا نتساءل كملاحظين عن غياب الوزراء الحكوميين في الجلسة الافتتاحية الذين كانوا من المنتظر أن يوقعوا اتفاقيات تعاون داخل المناظرة؟
ولماذا يتم إقصاء ملف التخييم عن برامج معظم الأحزاب، هل لكونه خارج دائرة الاهتمام السياسي أم أن الوزارة والمجتمع المدني تخنهم الرؤية الترافعية أمام هذه الأحزاب؟
يُضاف إلى ذلك أن توزيع شبكة المخيمات على التراب الوطني يعكس اختلالا مجاليا صارخا:
بين مخيمات شاطئية محدودة في الساحل الأطلسي والمتوسطي ، وبين مخيمات جبلية—كالأطلس المتوسط—تعيش إهمالًا بنيويًا رغم كونها ذاكرة تربوية وطنية ووحات وجهات طالها النسيان والتهميش ....
بين مخيمات شاطئية محدودة في الساحل الأطلسي والمتوسطي ، وبين مخيمات جبلية—كالأطلس المتوسط—تعيش إهمالًا بنيويًا رغم كونها ذاكرة تربوية وطنية ووحات وجهات طالها النسيان والتهميش ....
هكذا يتحول الحق في العطلة إلى امتياز مجالي أكثر منه خدمة تربوية عمومية.
لكن الإشكال ليس مجاليا فقط، بل بنيويا:
فالتخييم، بدل أن يكون امتدادا مكملا للمدرسة العمومية، صار نشاطا موسميا هشا يُدار بموارد محدودة وجهود متطوعين يشتغلون خارج أي هندسة تربوية أو حماية قانونية.
لكن الإشكال ليس مجاليا فقط، بل بنيويا:
فالتخييم، بدل أن يكون امتدادا مكملا للمدرسة العمومية، صار نشاطا موسميا هشا يُدار بموارد محدودة وجهود متطوعين يشتغلون خارج أي هندسة تربوية أو حماية قانونية.
وهنا تأتي القراءة التقدمية الضرورية:
إن إعلان أن هناك نية رفع نسبة المستفيدين من التخييم إلى 10% - أي مليون طفل سنويا حسب تصريحات الوزير ورئيس الجامعة الوطنية للتخييم - في أفق 2030 يعكس إرادة طموحة ولكن سيكون قفزة في المجهول ما لم تُبنَى على تشخيص تربوي ومجالي صارم.
فالزيادة غير المؤطرة ليست توسعا، بل مجازفة قد تُعيد إنتاج اللامساواة بأشكال جديدة.
لذلك يصبح تنويع شبكة التخييم وجعلها أولوية ترابية ضرورة على مستوى الاقاليم والجهات ، لأن العدالة المجالية شرطٌ للعدالة التربوية.
كما أن تطوير مخيمات موضوعاتية جديدة من الجيل الاول في مناطق تتوفر على مؤهلات طبيعية —كالمخيمات الايكولوجية بمولاي بوسلهام والوليدية؛ اللغات بفاس ، التربية المقاولاتية بالدار البيضاء ، التربية الرقمية والذكاء الاصطناعي بطنجة ، الرياضات المائية والهوائية كالداخلة ، الدولية كهرهورة أو أكادير والحرف التقليدية والمهن العصرية بمكناس...- لم يعد خيارا، بل واجبا لإدماج الطفولة المغربية في رهانات العصر.
والاختيار التقدمي اليوم يفترض أن تتحمل الدولة والحكومة مسؤوليتهما في مأسسة المجال السوسيو-تربوي، عبر خطة وطنية جريئة لتأهيل 80.000 إطار تربوي على الاقل خلال خمس سنوات المقبلة، وربط الاستثمار الحقيقي في الطفولة بالتحول المجتمعي وليس بالمؤشرات الرقمية.
2- إشكالية التغذية والمشروع التربوي.
من بين أكثر الملفات التي فجّرت نقاشا خلال المناظرة الوطنية للتخييم، ملف التغذية ومنحة 60 درهم المخصَّصة يوميا لكل طفل.
وهو ملف يجعلنا نطرح أسئلة جوهرية:
هل تصل المنحة كاملة إلى الطفل؟
أم تمر عبر سلسلة من الوسطاء وتتعرض للتآكل قبل أن تبلغ طبق الطفل؟
أم تمر عبر سلسلة من الوسطاء وتتعرض للتآكل قبل أن تبلغ طبق الطفل؟
هذا السؤال لا يتعلق فقط بالحسابات المالية، بل بالعدالة الغذائية ذاتها، وبكرامة الطفل داخل الفضاء التربوي.
كما أن طريقة الاشتغال بنظام "الممون" (traiteur) تطرح إشكالات جوهرية:
هل النموذج الحالي يضمن جودة حقيقية للتغذية؟ أم أنه مجرد تدبير إداري يعفي الجمعيات لكنه لا يخدم مصلحة الأطفال؟
بل إن بعض الفاعلين يتساءلون إن كان نظام التريتور نفسه سببا في عملية بلقنة المشهد التخييمي التي جعلته متاحا للجميع بنية اضعاف الموقع التفاوضي للمنظمات التربوية التاريخية؟
بل إن بعض الفاعلين يتساءلون إن كان نظام التريتور نفسه سببا في عملية بلقنة المشهد التخييمي التي جعلته متاحا للجميع بنية اضعاف الموقع التفاوضي للمنظمات التربوية التاريخية؟
في عمق الاشكال، يتعلق الأمر بعدم الانسجام بين طبيعة المشاريع التنشيطية وطبيعة النظام الغذائي المفروض.
فمثلا:
*)- المخيم الكشفي المتنقل
لا يمكنه بتاتا أن يشتغل على إيقاع وجبات "التريتور" ولا على نموذج التموين المركزي. هذا النوع من المشاريع يحتاج مطبخا ميدانيا متنقلا، وروحا كشفية، وتنظيما ذاتيا من داخل الجماعات التربوية.
*)- الجمعيات ذات المرجعية التربوية الشعبية
تميل إلى نظام المطبخ المركزي التقليدي الذي كان معمولا به سابقا، لكونه يمثل جزءًا من التربية على المشاركة، النظام الذاتي، المسؤولية، وتقاسم الأدوار داخل المخيم. وهو نموذج يتماشى مع روح “التربية على الحياة الجماعية”.
هنا يظهر سؤال جوهري:هل يمكن أن نُسقِط نموذجا إداريا موحدا على مشاريع تربوية متعددة المرجعيات؟
أم أن ملف التغذية يجب أن يرتبط بالهندسة البيداغوجية للمشروع التربوي نفسه؟
أم أن ملف التغذية يجب أن يرتبط بالهندسة البيداغوجية للمشروع التربوي نفسه؟
إن إصلاح ملف التغذية لا يمر عبر رفع المنحة أو تغيير الممون فقط، بل عبر:
-ربط التغذية بالهوية التربوية لكل مشروع
-إقرار تعددية نماذج التغذية بدل النموذج الواحد
-ضمان رقابة مستقلة على مسار 60 درهم من الممون إلى طبق الطفل
-إعادة الاعتبار لنمط المطبخ المركزي كجزء من التنشيط التربوي وليس مجرد خدمة تقنية.
3- المؤطر التربوي فاعل لا مرئي في المنظومة
لا أحد يجهل أن المؤطر التربوي هو الذي يمنح الحياة للبرامج ويحوّل المخيم إلى فضاء حيّ للتنشئة والمواطنة. ومع ذلك، يعيش هذا الفاعل الحيوي في فراغ قانوني يضعه في منطقة رمادية بين العمل التطوعي والعمل المهني.
فهو يرافق الأطفال 24 ساعة في اليوم طيلة فترة لا تقل عن 12 يومًا متواصلة، دون أي حماية اجتماعية أو تأمين، رغم أنه يؤدي خدمة عمومية وطنية لفائدة الطفولة.
4- القانون 06-18: بين الاعتراف والتنكر
دخل القانون رقم 06-18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي حيز التنفيذ في 5 غشت 2021، ليشكل أول محاولة لسد الفراغ القانوني في مجال التطوع.
وقد نص على جملة من الحقوق الأساسية، منها:
وقد نص على جملة من الحقوق الأساسية، منها:
-إبرام عقد مكتوب بين المتطوع والجهة المنظمة.
-تحديد سقف ساعات التطوع في 48 ساعة أسبوعيًا.
-إلزام الجهة المنظمة بالتأمين ضد الأخطار.
-إنشاء سجل وطني للتطوع.
-فرض غرامات على الجهات المخالفة.
لكن الواقع التربوي داخل المخيمات يتنافى تماما مع روح هذا القانون.
فالمؤطر يشتغل أكثر من 120 ساعة أسبوعيا دون راحة أو عقد أو حماية، مما يجعل “التطوع التربوي” أقرب إلى استغلال قانوني مقنّع تحت غطاء الالتزام الأخلاقي.
كما أن القانون التطوعي التعاقدي 06-18 يؤكد على أن العمل 6 أيام من أصل 7 أيام، وأن عدد الساعات الأسبوعية لا يتجاوز 48 ساعة، بينما الإطار التربوي يلازم الأطفال دون توقف طيلة مدة المرحلة التخييمية، في تجاوز صريح للقانون.
كما أن القانون التطوعي التعاقدي 06-18 يؤكد على أن العمل 6 أيام من أصل 7 أيام، وأن عدد الساعات الأسبوعية لا يتجاوز 48 ساعة، بينما الإطار التربوي يلازم الأطفال دون توقف طيلة مدة المرحلة التخييمية، في تجاوز صريح للقانون.
فمن يتحمل المسؤولية؟ هل هي الوزارة الوصية بصفتها المشرفة والمفوضة؟ أم المنظمات التربوية بصفتها الجهة المتعاقدة؟
وهل يمكن الحديث عن احترام القانون في غياب تطبيقه داخل أهم ورش تطوعي تربوي وطني؟ وهل يمكن أن نجعل من وضعية الاطار التربوي مستقبلا مجالا لمقاضاة الوزارة والجمعيات في المحاكم خصوصا في خضم غياب قانون التطوع التربوي وقانون للتخييم العمومي ؟ ولماذا حينما يخطئ هذا الإطار التربوي مع فئة قاصرة متكفل بها نطبق في حقه نطبق قانون العقوبات الجنائية ونتعامل معه على أساس أنه موظف عمومي ؟
وهل يمكن الحديث عن احترام القانون في غياب تطبيقه داخل أهم ورش تطوعي تربوي وطني؟ وهل يمكن أن نجعل من وضعية الاطار التربوي مستقبلا مجالا لمقاضاة الوزارة والجمعيات في المحاكم خصوصا في خضم غياب قانون التطوع التربوي وقانون للتخييم العمومي ؟ ولماذا حينما يخطئ هذا الإطار التربوي مع فئة قاصرة متكفل بها نطبق في حقه نطبق قانون العقوبات الجنائية ونتعامل معه على أساس أنه موظف عمومي ؟
كما أن المنظمات التربوية والوزارة ليسوا في موقع يخول لهم اليوم رفض أو تجاوز قانون التطوع التعاقدي الصادر عن الجريدة الرسمية، بل عليهم واجب احترامه، مع السعي إلى تأويل تربوي عادل يراعي خصوصية التأطير داخل المخيمات، دون المساس بجوهر الرسالة التطوعية.
5- بين المرسوم والقانون: ازدواجية قاتلة
رغم أن المرسوم رقم 2.21.186 المتعلق بتنظيم مراكز التخييم جاء لتقنين الفضاءات التابعة للوزارة، فإنه ظل أسير مقاربة تقنية ضيقة ركزت على البنايات والإدارة، وأهملت العنصر البشري الذي يعطي للمخيم روحه التربوية.
أما القانون06-18 فقد نظم العلاقة بين المتطوع والجهة المستفيدة في إطار من الكرامة والمسؤولية.
لكن الجمع بين النصين يكشف تناقضا صارخا: فالقانون يحمي المتطوعين، بينما المرسوم يغفلهم تماما، مما يترك آلاف المؤطرين في خانة رمادية و وضعية “اللا قانون”
6- بين الالتزام والإلزام: نحو عقد اجتماعي جديد
يجب أن نُميز بين التطوع كقيمة والاستغلال كواقع.
فالتطوع، كما تؤمن به التربية الشعبية، التزام وطني نابع من الوعي والمسؤولية، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة لإنكار الحقوق أو تجاوز القانون الوحيد المنظم للتطوع.
كيف نطالب المؤطر بالواجب دون أن نمنحه الحق؟
وكيف نكرم التضحية ونغضّ الطرف عن الكرامة؟
فالتطوع، كما تؤمن به التربية الشعبية، التزام وطني نابع من الوعي والمسؤولية، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة لإنكار الحقوق أو تجاوز القانون الوحيد المنظم للتطوع.
كيف نطالب المؤطر بالواجب دون أن نمنحه الحق؟
وكيف نكرم التضحية ونغضّ الطرف عن الكرامة؟
المطلوب اليوم هو اعتراف مؤسساتي يضمن التكوين، الحماية، والمكانة القانونية، ويُعيد للتطوع التربوي معناه النبيل دون أن يكون غطاء للاستغلال.
7ـ نحو مهننة التأطير التربوي مدخل للاستثمار في الطفولة
في خضم تشريحنا لوضعية الاطار التربوي داخل مخيمات اليوم ، نستشرف أن مستقبل التخييم لا بد له أن يمر عبر مهننة التأطير التربوي وبناء مسارات مهنية واضحة، من خلال:
-إحداث المعهد العالي للتنشيط التربوي كمؤسسة وطنية للتكوين على مدى ثلاث سنوات بعد البكالوريا، تمنح دبلومات معترف بها في مجالات التنشيط الثقافي، الرقمي، البيئي والرياضي.
-إدماج الخريجين ضمن المنظومة التربوية عبر عقود محددة الأجل داخل المخيمات والمركبات التربوية وداخل المؤسسات التعليمية.
-اعتماد نظام تكوين مستمر للمؤطرين والجمعيات طيلة السنة بشراكة مع الجامعات والمجالس الجهوية.
بهذه الصيغة، يصبح التأطير التربوي مهنة قائمة بذاتها، لها هوية ومعايير ومخرجات تتماشى مع رؤية الدولة لطفل اليوم والغد.
8- المركبات التربوية: من الفضاء الموسمي إلى المدرسة الدائمة
لتثبيت العدالة التربوية في الممارسة، يجب الانتقال من منطق المخيم الموسمي إلى منطق المركب التربوي القار ايمانا منا في استثمار حقيقي في الطفولة المغربية.
تُحدث هذه المركبات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي ثم المحلي كـ“مدارس للأنشطة الموازية”، تعمل على مدار السنة، وتضم قاعات للتربية الفنية والرقمية والمسرحية، وورشات بيئية وثقافية ورياضية....، بإشراف مربين خريجي المعهد العالي للتنشيط التربوي.
إنها خطوة التقائية بين وزارة الشباب ووزارة التربية الوطنية بهدف مأسسة حقيقية للوقت الحر كحق تربوي، وتحويل الأنشطة الموازية إلى جزء من المنهاج الوطني للحياة المدرسية، لا مجرد ترفيه موسمي.
ستشكل المركبات التربوية غذا إحدى أهم ركائز الإصلاح الحقيقي غير المُفعّل بعد. فهي تتيح الانتقال من مخيم موسمي قصير الأمد إلى تربية ممتدة على مدار السنة.
وتقوم أهميتها على ثلاثة تحولات:
أ- تحول وظيفي: نحو التربية الشاملة
المركب فضاء للتعلّم والفنون والعلوم والأنشطة الرقمية/ البيئية/ الرياضية والمواطنة...، لا مجرد إقامة صيفية. إنه منهاج تربوي سنوي.
ب- تحول مؤسساتي: نحو الشراكة
تحويل المركبات إلى منصات تشاركية تضم الجماعات الترابية، الجامعات، الجمعيات، والفاعلين المحليين والمؤسسات التعليمية.
ج- تحول مجالي: نحو العدالة التربوية
تعميم المركبات في المناطق المهمشة رافعة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية، عبر ضمان خدمات تربوية للأطفال الأكثر حرمانًا
د- المركب كمدرسة للعيش المشترك
في ظل التفاوتات والهويات المتصارعة داخل الحقل الجمعوي، تصبح المركبات فضاءات لصناعة الإنسان المواطن: المتعاون، المتسامح، والمسؤول.
إنها فضاءات تعيد للتخييم معناه الحضاري العميق.
إنها فضاءات تعيد للتخييم معناه الحضاري العميق.
9- المناظرة الوطنية للتخييم: لحظة لإعادة التأسيس
ينبغي أن نجعل من المناظرة الوطنية للتخييم لحظة تأسيسية لصياغة ميثاق وطني جديد ليس فقط للتخييم التربوي، بل لفعل سوسيو- تربوي يقوم على مبادئ العدالة التربوية والمجالية، والاعتراف القانوني بالمؤطر، والمهننة والتكوين المستمر، والمشاركة التشاركية في صياغة السياسات العمومية.
من هنا نتمنى أن لا تتحول المناظرات الوطنية للتخييم إلى مجرد محطات رمزية، يجب أن نجعل من توصياتها أفكارا قابلة للأجرأة والقياس، ورشا تشريعيا عمليا لإخراج قانون خاص بالمخيمات، يدمج البعد التربوي والاجتماعي والحقوقي في رؤية تخضع لقياس النتائج والاثر المجتمعي.
القانون المنتظر ينبغي أن يحدد بوضوح هوية الفاعلين وأدوارهم ومسؤولياتهم، وأن يؤسس لوضعية قانونية واضحة للمؤطرين التربويين باعتبارهم ممارسين لتربية عمومية تحتاج إلى دراسات لقياس أثرها الاجتماعي.
مناظرة نجعل منها تصورا شاملا وقابلا للتحقيق والاجرأة يمكن أن يقوم على ثلاثة مستويات:
*)- تشريعيا:
-تفعيل الفصل 33 من الدستور عبر احداث المجلس الأعلى للشباب والحياة الجمعوية
-تفعيل الفصل 33 من الدستور عبر احداث المجلس الأعلى للشباب والحياة الجمعوية
-مراجعة المرسوم المنظم للمخيمات في ضوء القانون 06-18.
-إصدار قانون التعاقد التربوي ليكون منسجما مع المخيمات
-إصدار قانون منظم للمخيمات التربوية العمومية والخصوصية
*)- مؤسساتيا:
-توضيح حدود مهام واختصاصات الجامعة الوطنية للتخييم.
*)- المركبات التربوية القارة : لجنة مشتركة بين قطاع الشباب وقطاع التربية والوطنية
-توضيح حدود مهام واختصاصات الجامعة الوطنية للتخييم.
*)- المركبات التربوية القارة : لجنة مشتركة بين قطاع الشباب وقطاع التربية والوطنية
*)- الاعتراف باتحاد المنظمات التربوية الوطنية والمنظمات الكشفية كاطار شريك في التفاوض المباشر مع القطاع الوصي وتمتيعهم بمكانة اعتبارية متقدمة لما راكموه من خبرة تاريخية في المجال.
*)- ماليا وبنيويا:
-إحداث صندوق لدعم العدالة التربوية
*)- تربويا
-احداث معهد عالي للتنشيط التربوي.
-المركبات التربوية القارة
*)- تربويا
-احداث معهد عالي للتنشيط التربوي.
-المركبات التربوية القارة
10- نحو عدالة في الاعتراف
إن سؤال العدالة التربوية اليوم هو سؤال الاعتراف بالفاعل الميداني.
في الامس القريب كانت المنح ضئيلة لا تتجاوز 15 درهم للطفل، والبنيات التحتية مهترئة وظروف التخييم صعبة لكن المراحل التخييمية كانت تنجح بفضل نضالية الاطار الميداني القادر على خلق الروح الايجابية والبسمة للطفل من رحم المعاناة.
لا يمكن اليوم ونحن في سنة 2025 أن نطالب المؤطر بروح التطوع ونتجاهل حقوقه، ولا يمكن أن نبني جيلا من المواطنين الأحرار دون أن نصون كرامة من يربّيهم.
لقد آن الأوان لعقد عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المدني، يقوم على قاعدة واضحة:
الالتزام لا يُلغي الحق، والتطوع لا يُبرر الاستغلال.
الالتزام لا يُلغي الحق، والتطوع لا يُبرر الاستغلال.
ان الاطر التربوية هم أساتذة المخيمات وصانعوا نجاحها، فهل نملك الشجاعة لنجعل منهم فاعلا معترفا به قانونا، ومن المخيم مدرسة للكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية؟
إن مستقبل قطاع التخييم رهين بقدرته على معالجة تناقضاته الداخلية، وإعادة الاعتبار للعامل البشري، ودعم العدالة المجالية، ومأسسة الوقت الحر عبر المهننة.
فالانتقال من نموذج يعتمد على تطوع غير محمي إلى نموذج يعترف بالمهن التربوية سيشكّل بداية تحول حقيقي، يرفع جودة الخدمات، ويعيد للتخييم وللفعل التربوي عموما مكانته كمدرسة مجتمعية مفتوحة على القيم والمهارات والحياة.
لا يمكن للجمعيات التربوية التطوعية، مهما بلغ مستوى التزامها، أن تتحمّل وحدها مسؤولية مأسسة الوقت الحر في ظل ندرة الأطر المؤهلة وانسحاب فئة واسعة من نساء ورجال التعليم من المشهد التنشيطي والجمعوي.
إذ إن تحويل التنشيط السوسيو–تربوي إلى مهنة قائمة بذاتها يتطلب إرادة سياسية واضحة من الدولة، واستراتيجية حكومية تضع هذا المجال ضمن أولويات السياسات العمومية المرتبطة بالطفولة والشباب.
فالوقت الحر لم يعد مجرد نشاط تكميلي، بل هو مجال تربوي منتج للقيم والمهارات، ويستدعي تكوينات متخصصة، وتعويضات عادلة، واستفادته من نظريات ومناهج و تجارب دول أخرى رائدة في المجال، وحماية مهنية، واعترافا قانونيا بوظائفه وأدواره.
من جهة أخرى، لا ينبغي للطفل المغربي أن يتحول إلى حقل تجارب للمشاريع المرجعية والإيديولوجية التي تتناقض أحيانا مع أولويات الدولة والمجتمع.
فالمخيمات في الماضي أدّت دورا تكوينيا أساسيا في إعداد نخب الدولة، وآن الأوان اليوم لتتحول إلى فضاءات تنمّي قيم الريادة والمقاولة والابتكار، لتُكوّن بذلك جيلا قادرا على خوض غمار الاقتصاد الجديد.. .
نحن بحاجة إلى أطر احترافية داخل مركبات قارة للغات، للتكنولوجيا، للتربية المالية، وللذكاء الاصطناعي ولتنمية الذكاءات المتعددة في الفنون والعلوم والرياضة والمهارات الناعمة ...، تجيب عن انتظارات الحاضر و المستقبل
الاستثمار في الطفولة يعتبر إصلاحا عاجلا يعيد الاعتبار لسياسة وطنية شاملة للوقت الحر، ويضع الطفولة والشباب في صلب المشروع المجتمعي المنشود.
ولا يزال الفاعلون إلى اليوم، بعد اختتام المناظرة الوطنية السادسة للتخييم، في انتظار صدور التوصيات الرسمية وكيفية تفعيلها خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويظل السؤال الجوهري معلّقا: هل سنستمر في التفكير بمنطق الاستثمار في مخيم موسمي محدود في العدد والزمن والمكان، يفتح أبوابه لأسابيع معدودة ثم ينطفئ أثره؟ أم أننا سننتقل فعلا إلى الاستثمار في الفعل السوسيو-تربوي بوصفه مشروعا مجتمعيا مستداما، يخدم الطفولة والشباب على مدار السنة، ويؤمن بحقهم في وقت حر مُؤَطَّر ومُمَأسس يرقى إلى طموحاتهم وحاجاتهم؟