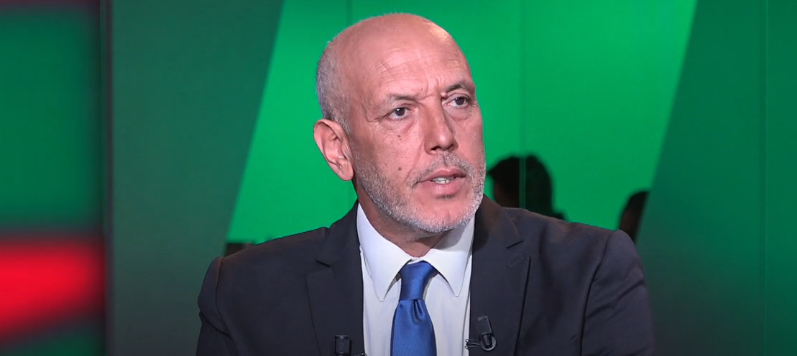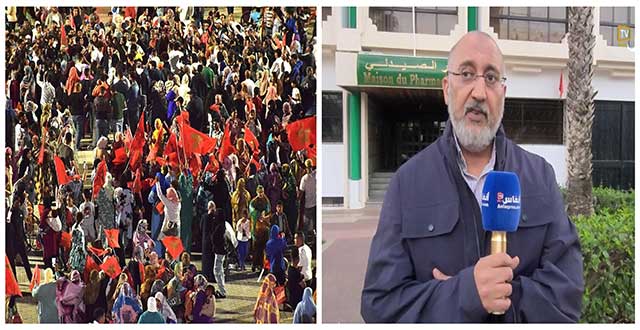مقدمة:
كل شعب لا بد أن يجد لنفسه مرآة في الفنون، أياً كان شكلها: في الشعر والموسيقى، في المسرح والسينما، أو حتى في الطقوس والعادات اليومية. فالتمثّل الفني هو الوجه الرمزي للحياة الجماعية، به تتجلى هوية الأمة وتعبّر عن قلقها وأحلامها وآلامها. والسؤال الذي يفرض نفسه في الحالة المغربية هو: كيف يمثّل الشعب المغربي نفسه فنياً اليوم؟
منذ التسعينيات، ومع أزمات التعليم والثقافة، ومع انحسار المشاريع الفنية الكبرى، بدا وكأن الإنتاج الحديث في المسرح والسينما والأدب قد فقد زخمه. وفي مقابل هذا التراجع، ظلّ التراث الشفوي والموسيقي الشعبي حياً، يطلّ بوجوهه القديمة ليملأ الفراغ: الملحون، العيطة، كناوة، الأمثال الشعبية، وحتى الحلقة. فهل يمكن القول إن المغاربة، لم يجدوا بديلا عن الاكتفاء بالتمسّك بالقديم بوصفه سنداً للهوية؟
أولاً: أزمة التمثّل الحديث
منذ تسعينيات القرن الماضي، ظهرت علامات ضعف واضحة في الإنتاج الفني والثقافي المغربي:
أزمة التعليم: تراجع مستوى التكوين اللغوي والجمالي، ما انعكس على ضعف النصوص المسرحية والقصصية. فبعد عصر الطيب الصديقي، الذي قدّم مسرحيات تمزج التاريخ بالزجل، وتحوّل التراث إلى عمل جماهيري، لم يظهر جيل جديد يحافظ على الزخم نفسه.
غياب الصناعات الثقافية: السينما المغربية أنتجت أسماء مثل نبيل عيوش (علي زاوا) أو فوزي بنسعيدي (يا له من عالم رائع!), لكن تبقى هذه التجارب محدودة، أكثر حضوراً في المهرجانات الدولية منها في الذاكرة الشعبية.
اللجوء إلى النقد الذاتي المفرط: كثير من المثقفين انشغلوا بجلد الذات أكثر من بناء أعمال قوية، فانحسر تأثيرهم على الجمهور العام.
النتيجة: قلة في الأعمال ذات الجودة العالية، وضعف في التمثيل الفني للذات المغربية في مشهد معولم سريع التحوّل.
ثانياً: العودة إلى التراث الشعبي
في مقابل هذا الضعف، ظل التراث الشعبي مصدراً دائماً للتمثيل:
الملحون: قصائد مثل «الشمعة» للحاج الحسين التولالي ما تزال تتردد في الأعراس والملتقيات، تحمل قوة رمزية تجعلها كأنها وُلدت اليوم.
العيطة: أغنية «هضري ما زال خضري» للشيخة خربوشة تحوّلت إلى نشيد احتجاجي خالد، يتردد بوصفه صوت مقاومة لا يموت.
كناوة: مهرجان الصويرة (منذ 1998) فتح الفن الشعبي المحلي على العالمية، حيث عزف فنانو كناوة مع موسيقيي الجاز والبلوز (Randy Weston, Marcus Miller)، فصار "الهجهوج" و"القراقب" آلات كونية.
الأمثال الشعبية: أقوال سيدي عبد الرحمان المجذوب (مثل: «اللِّي بْغَاكْ يْعْطِيكْ، اللِّي كْرَهَكْ يْعْنِيكْ») لم تَعُد تُقال فقط في الأسواق، بل انتقلت إلى «الميمز» والفيديوهات الساخرة في "فيسبوك" و"واتساب".
بهذا المعنى، ليس التراث مجرد بقايا الماضي، بل صار خزاناً يُعاد تدويره في كل مرة يضعف فيها الحاضر.
ثالثاً: بين الاسترجاع وإعادة الاختراع
العودة إلى القديم ليست دائماً علامة فراغ، بل قد تكون علامة إعادة ابتكار:
الملحون لم يبقَ محصوراً في الحلقات، بل صار يُقدَّم على خشبات المسارح، بألحان جديدة ترافقها آلات غربية، مما جذب جيلاً شاباً لم يكن ليستمع إليه في شكله التقليدي.
كناوة خرجت من الزوايا إلى العالمية، فصار الذِكر والسبحات يُقدّمان في قاعات كبرى، من دون أن تفقد الموسيقى جذورها الروحية.
الحلقة الشعبية تحوّلت إلى حلقة رقمية: على "يوتيوب" و"تيك توك" يظهر شباب يجسّدون دور الحكواتي أو الساخر، ويتواصلون مع جمهور أوسع بكثير مما تسمح به ساحات الأسواق.
هنا يصبح التراث طاقة كامنة، لا مجرد ملاذ اضطراري.
رابعاً: أزمة الحاضر كفرصة للمستقبل
أزمة التمثيل الفني الحديث تكشف الحاجة إلى إعادة تأسيس:
لو استثمر المغرب في السينما كما استثمرت مصر مثلاً، لكانت قصص الملحون أو مقاومة الاستعمار أو "أيام السيبة" مادة لأفلام ومسلسلات كبرى.
إعادة إدماج الفنون في المناهج التعليمية يمكن أن يحيي علاقة الأطفال بالموسيقى والمسرح منذ سنّ مبكرة، فيربطون بين التراث والحداثة بشكل طبيعي.
بناء صناعة ثقافية حقيقية (دور نشر، قاعات عرض، دعم مستمر) يجعل من الفن الشعبي والحديث معاً قوة ناعمة للبلد.
سؤال أعمق: أزمة إنتاج ثقافي أم أزمة شعب؟
هنا يطرح سؤال أعمق نفسه: هل يتعلق الأمر فعلاً بأزمة إنتاج ثقافي، أم أننا في الجوهر أمام أزمة شعب مهمل اجتماعياً واقتصادياً؟ إن اختزال المشكل في ضعف المؤسسات الفنية وحدها تبسيط، لأن الثقافة مرآة للمجتمع، فإذا كان المجتمع مهمَّشاً في تعليمه وصحته وكرامته، فمن الطبيعي أن يضعف إنتاجه الفني. هكذا نكون أمام حلقة مفرغة: الإهمال الاجتماعي يولّد فقراً ثقافياً، والفقر الثقافي يكرّس التهميش.
ومع ذلك، تظل الثقافة تقاوم: في الملحون الذي يحكي الحياة بضحكة ودمعة، في العيطة التي تحفظ ذاكرة الاحتجاج، في كناوة التي عبرت إلى العالمية، في الأمثال الشعبية التي وُلدت من حكمة البسطاء، وحتى في النكتة اليومية التي صارت اليوم "ميم" على وسائل التواصل. الشعب المهمل يجد دوماً طريقاً ليقول: «أنا هنا»، ولو بصوت خافت.
خاتمة:
تمثّل الذات في الفنون المغربية اليوم يتأرجح بين أزمة الحاضر وقوة الماضي. فحين يعجز الإنتاج الحديث عن تقديم صورة مقنعة، يعود الشعب إلى ملاذاته القديمة: الملحون، العيطة، كناوة، الأمثال… لكن العودة ليست هروباً فقط، بل أيضاً إبداع متجدد يحوّل الموروث إلى أشكال جديدة من التعبير.
إن السؤال إذن ليس: هل نمثّل أنفسنا بالفن الحديث أم بالتراث القديم؟، بل: كيف نخلق من الاثنين معاً لغة فنية قادرة على تمثيل الذات المغربية في حاضرها ومستقبلها؟