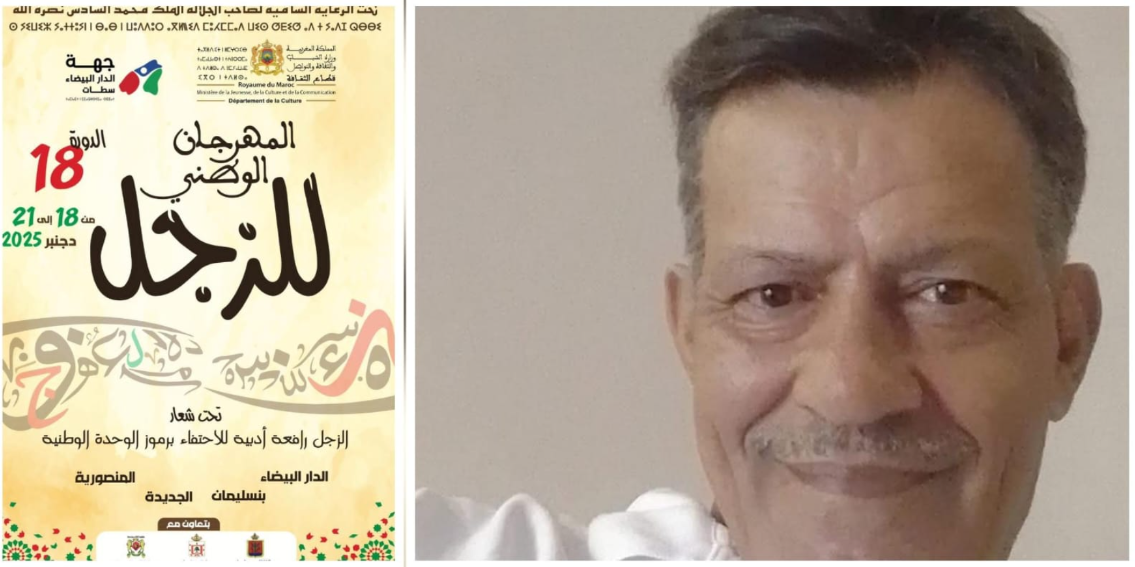منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، اتخذ المغرب مساراً إصلاحياً غير مسبوق في مقاربته لقضايا حقوق الإنسان. لم يكن الأمر مجرّد تحسينات تقنية أو استجابة ظرفية لضغوط دولية، بل تعبيراً عن قناعة استراتيجية، نابعة من رؤية ملكية تعتبر أن كرامة المواطن وحقوقه وحرياته هي ركيزة البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة، وليست مجرّد شعارات سياسية.
رؤية ملكية تؤسس لمنظور شمولي
التحول الحقوقي في المغرب لم يكن عفوياً ولا فئوياً، بل تأسّس على مشروع مجتمعي متكامل صاغ معالمه جلالة الملك، وجعل فيه من حقوق الإنسان، بكل أجيالها (المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية)، محوراً أساسياً في تعاقد الدولة مع المواطن. هذه المقاربة اتسمت بثلاث خصائص جوهرية:
الشمولية: حيث لم تقتصر الإصلاحات على الحقوق الفردية فقط، بل امتدت إلى تعزيز الحقوق الجماعية، وحقوق الفئات الهشة، وحقوق المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمهاجرين.
الشمولية: حيث لم تقتصر الإصلاحات على الحقوق الفردية فقط، بل امتدت إلى تعزيز الحقوق الجماعية، وحقوق الفئات الهشة، وحقوق المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمهاجرين.
التدرج والواقعية: إدراكاً لخصوصيات السياق الوطني والتوازنات المجتمعية، اختار المغرب نهج التدرج في الإصلاح، دون قفز على الواقع، لكن دون التفريط في المبادئ. إصلاح مدونة الأسرة مثلاً لم يأتِ دفعة واحدة، بل عبر توافق مجتمعي ومؤسساتي يعكس التوازن بين الحداثة والأصالة.
المأسسة والاستدامة: من هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن تعزيز استقلال القضاء إلى إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، تتجلّى إرادة سياسية عليا لتحصين المكتسبات داخل مؤسسات دائمة وقادرة على التفاعل والتطور.
من العدالة الانتقالية إلى التمكين الحقوقي
يُعد إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 علامة فارقة في المشهد الحقوقي العربي، حيث اختار المغرب الاعتراف بماضيه، وجبر ضرر الضحايا، وفتح صفحة جديدة تقوم على المصالحة مع الذات. لم يكن هذا مجرّد تصفية حسابات مع الماضي، بل كان تمهيداً لإصلاحات بنيوية شملت النظام القضائي، وحرية الصحافة، والآليات الرقابية، والتنصيص الدستوري على الحريات الأساسية.
دستور 2011 جاء ليترجم هذه الرؤية في نص قانوني أعلى، حيث أكد على سمو الاتفاقيات الدولية، وعلى استقلال القضاء، وعلى المساواة الكاملة بين المواطنين، وعلى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. كما تضمّن التزام الدولة بحماية الحريات، والحق في الوصول إلى المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تجربة رائدة في سياق إقليمي معقد
في محيط إقليمي تهتز فيه الحقوق بفعل الأزمات السياسية والصراعات الداخلية، استطاع المغرب أن يقدّم نموذجاً مغايراً، يجمع بين الاستقرار والانفتاح، ويُوازن بين سيادة القرار الوطني والانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية. وهذا ما أكسب التجربة المغربية احتراماً متزايداً في المنتديات العالمية، باعتبارها مساراً نابعاً من الداخل، لا مفروضاً من الخارج.
لقد عبّر المغرب في أكثر من مناسبة، من خلال خطاباته الرسمية ومواقفه في المحافل الدولية، عن التزامه الثابت بخيار الديمقراطية وحقوق الإنسان، كجزء من هوية الدولة الحديثة، وليس كامتياز ظرفي. وتمثل مشاركة المغرب النشطة في آليات الأمم المتحدة، واستقباله لمقررين خاصين، وتفاعله مع الملاحظات الأممية، دليلاً عملياً على هذا الانخراط المسؤول.
نحو جيل جديد من الحقوق
رغم ما تحقق، فإن المغرب لا يركن إلى الاكتفاء، بل يفتح أوراشاً جديدة تتطلب مزيداً من التقدم، مثل الحريات الفردية، والنهوض بحقوق النساء، وتجديد مدونة الأسرة، وتعزيز حقوق الجيل الثالث (الحق في بيئة سليمة، والتحول الرقمي، وحماية المعطيات الشخصية…). وهي تحديات تُطرح اليوم في سياق وطني يعرف تحولات مجتمعية عميقة، وتطلعات متزايدة من طرف الشباب والنخب الجديدة.
خلاصة
خارطة الطريق الحقوقية التي أسس لها جلالة الملك محمد السادس ليست مجرّد برنامج مرحلي، بل رؤية دولة، ومنهج إصلاحي متدرج، يجعل من الإنسان جوهر السياسات العمومية، ومن الحقوق والحريات مضموناً فعلياً لا رمزياً. إنها تجربة قابلة للتطوير، لكنها تستند إلى أرضية صلبة من التراكمات المؤسساتية والثقافية والسياسية، ما يجعلها جديرة بالتقدير، وجديرة بأن تُستكمل بنفس النفس الإصلاحي والجرأة السياسية.
في زمن التراجعات الحقوقية والانغلاق، يقدّم المغرب نموذجاً في أن الإصلاح لا يعني الفوضى، والانفتاح لا يعني القطيعة مع الذات، بل هو فنّ التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، بين السيادة والانخراط، وبين الاستقرار والتحول.