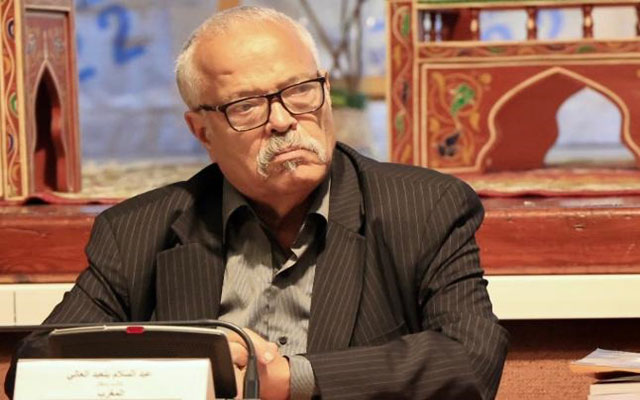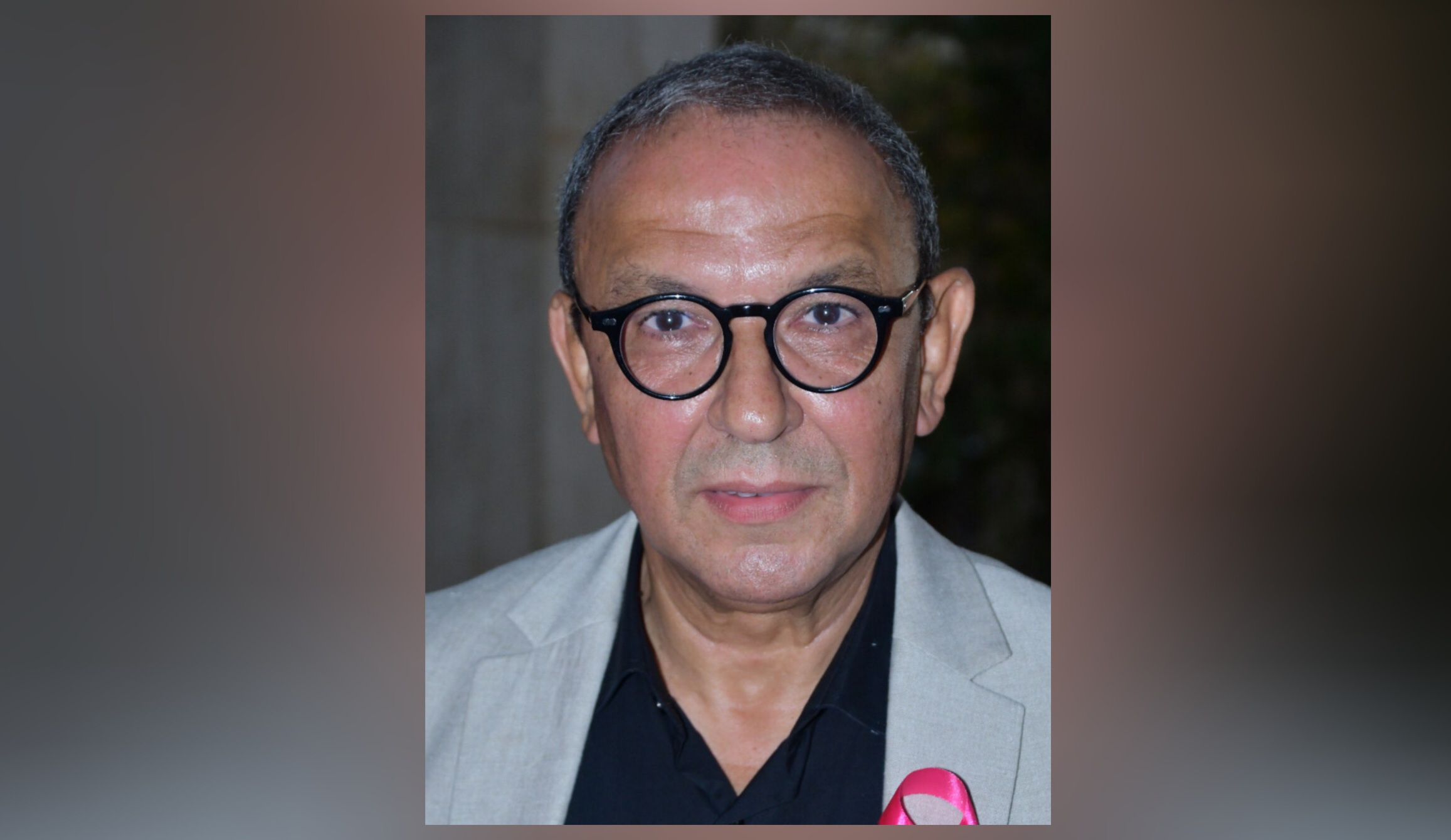فلاسفة ظلوا يعودون إلى كتاباتهم السابقة
في مقال قيم تحت عنوان: "ما سر تجنب الكتاب إعادة قراءة أعمالهم بعد نشرها؟" (المجلة، 18/06/2025) حاول الكاتب مروان ياسين الدليمي أن يتوقف عند تجارب بعض المبدعين العرب والعالميين، كي يستخلص الدواعي التي تجعلهم "بعدَ أن يضعوا النقطة الأخيرة في نصوصهم، يميلون إلى عدم العودة إلى قراءتها مجددا". وهو يرد تلك الدواعي إلى أربعة:
الداعي الأول هو "الإرهاق النفسي والإبداعي الذي يرافق عملية الكتابة"، لذا فإن العودة إلى العمل بعد نشره تكون بمثابة "إعادة نكء جرح قديم"، على حد تعبير إرنست همنغواي، كأن "الرواية تصبح ذكرى مؤلمة وحميمة في آن واحد"، لذا فإن الكاتب "يجد في تركها راحة أكثر من مواجهتها".
السبب الثاني لعدم العودة إلى العمل بعد نشره هو "الخوف من مواجهة العيوب، أو الشعور بأن النص لم يعد ملكا للكاتب".
سبب ثالث هو أن "الرواية تصبح مرآة لحالة الكاتب النفسية في وقت كتابتها، وعندما يتغير الكاتب، يصبح من الصعب عليه مواجهة تلك المرآة دون إحساس بالغربة". لذا فهو يحس بأن العلاقة بالعمل قد انتهت، و"أن العودة إليه قد تعيد إحياء مشاعر لم يعد يرغب في تجربتها".
السبب الأخير هو أن الكاتب يكون قد "توجه نحو كتابة الرواية التالية لبداية مغامرة جديدة"، فلا يرى فائدة في العودة إلى النص القديم لما قد يتولد عن ذلك من تشتت التركيز.
إذا استثنينا هذا السبب الأخير، فإن الدواعي الأخرى التي يبرزها الكاتب، ترجع، في نهاية الأمر، إلى عوامل نفسية، وليس إلى طبيعة الكتابة ومتطلباتها.
ثم لا بد أن نلاحظ أن حديث الكاتب، وكذا الأمثلة والاقتباسات المدرجة، أن كل ذلك مرتبط في هذا المقال بالإبداع الروائي، وليس بباقي الأنواع الأخرى من الكتابة. لذلك نجد أنفسنا، بعد قراءة هذا المقال، نتساءل: هل يصدق ما توصل إليه الكاتب أيضا على النصوص النقدية والفكرية بصفة عامة؟
صيرورة الفكر
لو أعرنا انتباهنا، على سبيل المثل، إلى النصوص الفلسفية الأساسية للَمسنا عند كثير من الفلاسفة العظام عودة لا تكل إلى النص ذاته ليس لتنقيحه فحسب، وإنما لإعادة كتابته أو كتابة قسم كبير منه. يخطر ببالنا، على سبيل المثل، نص "نقد العقل الخالص في استعماله النظري" للفيلسوف إيمانويل كانط. المعروف في تاريخ الفلسفة أن الإحالة إلى هذا النص يجب أن تذكر ما إذا كانت تشير إلى الطبعة الأولى أو إلى الثانية، لأن الطبعتين مختلفتان، ولأن صاحب النص يعترف بهما معا، وإن كان يرى أنه حاول في الطبعة الثانية أن يتفادى كثيرا من الصعوبات، بل من الغموض الذي وسم الطبعة الأولى.
في إمكاننا كذلك الإشارة هنا إلى نص هايدغر الأساس، "الكينونة والزمان"، الذي لم يعد من الممكن الاقتصار على طبعته الأولى في سنة 1927، والذي يلزم لفهمه إلحاقه بنص "الزمان والكينونة"، ذلك النص الذي هو أقل حجما من سابقه، إلا أنه يتخطاه ويفوقه أهمية، وربما صعوبة. لا ينبغي أن ننسى كتابات نيتشه التي لا تكتفي، في بعض الأحيان بأن تعود وتعاود النظر في ما سبق أن أقرته، وإنما تذهب حتى القول بالنقيض.
يشير دولوز في "الأبجدية" إلى حركة الفكر هذه قائلا: "أومن بنوع من صيرورة الفكر، تطور للفكر لا يقتضي فحسب ألا نعود إلى طرح المشكلات عينها، بل أيضا أن المشكلات لا تعود تُطرح بالطريقة نفسها".
هذه العودة أمر نجده كثيرا عند بعض الفلاسفة المعاصرين الذين لا يكفون يكررون ما سبق أن قالوه، وغالبا بالمعنى الخاص الذي يعطونه للتكرار الذي يميزونه عن مجرد الإعادة. فهم يرون أنه، بينما تُطابق الإعادة بين الوجود والحضور فتقتل الاختلاف، وتجمد الكائن، وتبلد الفكر، وتقمع الخيال، وتكلس اللغة، وتخشب الكلام فتكرس التقليد، فإن "التكرار" ليس عودة المطابق، ما دام يحيد بالمكرر نحو منحى آخر، نحو آخر، فيجره نحو ما يخالفه. حتى إننا يمكن أن نذهب إلى القول إنه إن كان بالإمكان الحديث هنا عن هوية للكائن فبفضل التكرار.
هذا ما يؤكده جاك دريدا إذ يقول: "لا تعارضَ بين التكرار وجِدة ما يخالف. فهناك دوما اختلاف يحيد بالتكرار نحو منحى آخر، وذلك بطريقة جانبية مضمرة. أطلق على ذلك لفظ itérabilité أي انبثاق الآخر (من السنسكريتية itara) في عملية الاستعادة والترديد".
وعلى ذكر التكرار، لا بأس من أن نتوقف عند تحديد صاحب "الاختلاف والتكرار" في "الأبجدية" لما يعنيه بقوله "ينبغي أن نجعل النص يمتد" Prolonger le texte. بحيث لا يتعلق الأمر عنده بالعودة إلى ما قيل لمعارضته، بقدر ما يتعلق بعودةٍ تهدف إلى توليد ما قيل والدفع به إلى أن يتخطى ذاته. هنا يغدو الفكر نوعا من "النشأة المستأنفة" إذا جازت لنا استعارة عبارة ابن خلدون في هذا المقام.
كتب دولوز في مقدمة ذلك الكتاب: "الكتابة قضية صيرورة، هي دائما غير مكتملة، دائما في صدد التكون، وهي تتجاوز كل محتوى معيش ومُعَانى. إنها حركة، أي مَعبر حياة يخترق المَعيش والمُعَانى. الكتابة لا تنفصل عن الصيرورة".
عود أبدي
استئناف القول عند الفلاسفة يدل على أن الفكر لا ينطلق من نقطة صفر، إلا أنه لا يعني إحياء لما قيل ووقوفا عنده، وإنما عودا أبديا لا ينفك يربط ما قيل بما سيقال. التكرار هو سبيل الفكر لأن يولد المعاني التي تتوالد، لا لتشكل وحدة متراصة، وإنما لتتناسل بفعل إحالة بعضها إلى بعض، وربما الأفضل أن نتحدث هنا عن الصدى بدل الإحالة. المعنى قد يحدد ما تقدمه، إلا أنه قد يرد إلى/ أو يردد صدى ما هو أبعد منه.
لا يعني ذلك مطلقا أن مرمى الكتابة الارتماء في شتات مبعثر ينفي كل معقولية. فهي لا تتوخى إلغاء الحد وتفتيت النص. إن مرماها فحسب هو أن تجعلهما حركة وليس سكونا، خطا وليس نقطة، هجرة وليس عمارة، تعددا وليس وحدة، اختلافا وليس تطابقا، نسيانا وليس ذاكرة.
من هنا تلك الحركية، وذلك الغليان الذي يتابع خطى الفكر الذي لا يفتأ يرجع القهقرى كي يعيد النظر في مسلماته.
في كتاب "رولان بارت بقلم رولان بارت"، يقيم السيميولوجي الفرنسي مقابلة بين "الكتابة" و"الأثر المكتمل" فيقول: "أن يقع في فخ الافتتان، فيعتقد أنه يَقبل أن يعتبر ما يكتبه "أثرا مكتملا"، فينتقل بذلك من الطابع العرَضي للكتابة إلى "تعالي" البناء الموحد المقدس... بين الكتابة و"العمل المكتمل" تناقض. لا أنفك أستمتع، إلى ما لا نهاية له، بالكتابة من حيث هي إنتاج متواصل، وشتات لا مشروط، وإغراء لا يقوى على إيقافه أي دفاع مشروع عن الذات التي أرمي بها على صفحة الورق. لكن، في مجتمعاتنا، التي تغلب عليها روح المتاجرة، لا مفر من التوصل إلى إنجاز "عمل مكتمل". ينبغي إنجاز سلعة، أي تقديمها في شكل مكتمل. وحينها، فعندما أكتب، على هذا النحو، فإن الكتابة "تتسطح"، وتغدو تحت تهديد "العمل المكتمل" وضغطه، ذلك العمل الذي لا يكون عليها إلا التوصل إلى إنجازه. كيف لي أن أكتب في خضم كل هذه الفخاخ التي تنصبها لي الصورة الجماعية لـ"العمل المكتمل"؟ سأكتب حينها، في طبيعة الحال، بلا تبصر. في كل لحظة من لحظات العمل، وأنا تائه واقع تحت الضغط، لن أملك إلا أن أردد في نفسي العبارة التي تختم مسرحية سارتر "أبواب موصدة": لنواصل".
في المجال الفكري لا تكف الكتابة عن "المواصلة "، عن "النشأة المستأنفة"، وهي لا يمكن أن تعرض نفسها إلا وهي تُكتشف. فهي تَكتشف عندما تَكشِف. إنها توحد بين ما ندعوه مسودة وما ندعوه مبيضة. لنقل إننا نكون في ميدان الكتابة، أمام مختبرات فكرية، و"كتابة مستأنفة" تتحدى أنماط الزمن التقليدية. لا نكون إلا أمام "مسودات"، أو، على الأقل، أمام مبيضات قابلة للتسويد في أي لحظة.
عن: مجلة " المجلة"