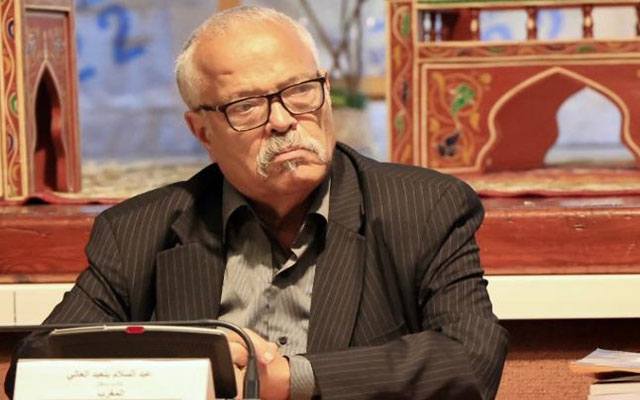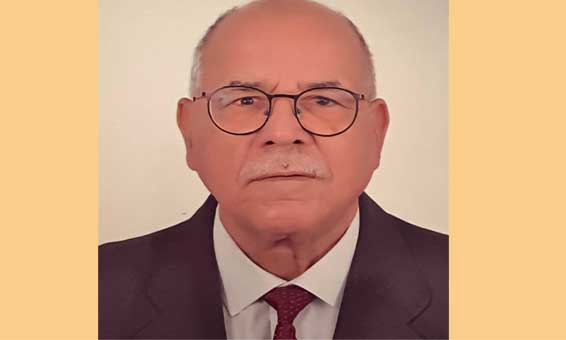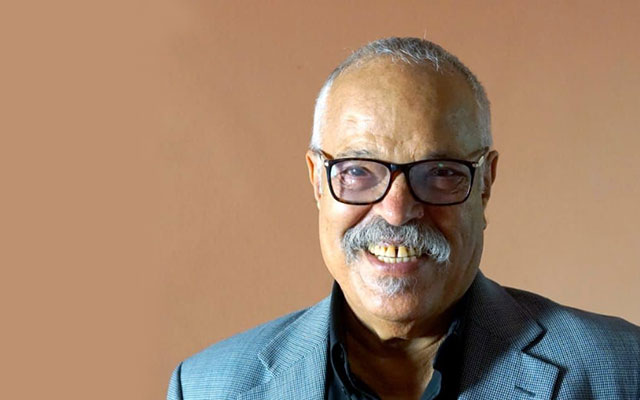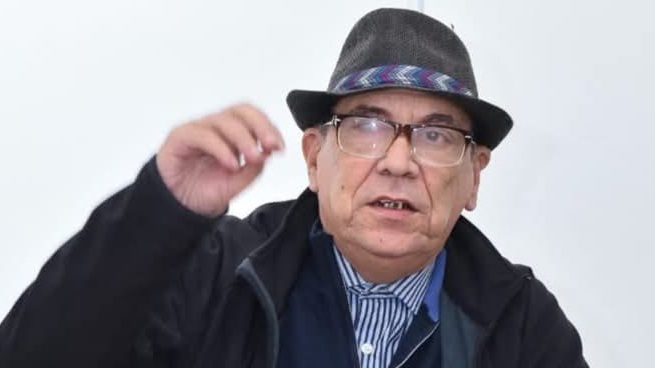تباين في فهمه بين الثقافتين الفردية والجماعية
"يمكن التنكر اللاواعي للاحتياجات الفيزيولوجية، تحت غطاء الموضوعية، والمعنى، والعقلانية الخالصة، أن يتخذ أبعادا مذهلة – كثيرا ما تساءلت عما إذا لم تكن الفلسفة، في نهاية المطاف، قد تمثلت بالكامل في تأويل للجسد وسوء فهم له" (نيتشه).
جسدنا من أقرب الأمور إلينا، إننا "نلتحم" به كما تقول اللغة الفرنسية On fait corps avec lui لذا فهو يبدو لنا أمرا بدهيا، إلا أنه في النهاية، ربما لا شيء يعادل إدراكه صعوبة. فهو ليس أبدا معطى أوليا لا جدال فيه كما قد يتبدى، بل هو نتيجة مركبة للبناء الاجتماعي والثقافي. فكما أنه لا توجد طبيعة إنسانية ثابتة، لا وجود أيضا لطبيعة جسدية ثابتة. بل إن وضع الإنسان ينتج منه وضع جسدي يتغير تبعا لتغير الأماكن والأزمنة في المجتمعات الإنسانية.
كان ينبغي انتظار القرن السابع عشر كي يتخلص الجسد من نفوسه الغاذية والحركية والغضبية، وكي يغدو عند أبي الفلسفة الحديثة آلة، على عكس ما كان عليه الأمر في ما قبله حيث كان جسما تحركه النفوس. الإنسان عند ديكارت فكر وامتداد، فكر وآلة، المشهور عنه أنه فصل الفكر عن الامتداد. إلا أنه سينتهي بأن يقول، بما أن الإنسان فكر وامتداد، فليس هو لا هذا ولا ذاك. هناك في الفكر أشياء مغايرة للفكر، كما في الجسد أشياء مغايرة للجسد. الفرح الذي يظهر في العينين، ليس من الجسد لكنه يظهر في الجسد. هناك إذن تمفصل بين الجسد والفكر حتى عند ديكارت. صحيح أنه ليست هناك وحدة بينهما كما كان الأمر عند القدماء، لكن هناك تمفصل.
لا يعني ذلك أن علاقة الفكر بالجسد عند ديكارت كعلاقة السفينة بربانها كما كان يحلو للقدماء أن يقولوا. الفكر لا يقود الجسد. أنا لا "أسكن" جسدي كربان في سفينته. إلا أنني "ملتحم" بجسدي Je fais corps avec lui، وليس بيننا مسافة. ليس هذا الجسد جسد أي كان، إنه جسدي أنا. بل إنه ليس جسدي فحسب، وإنما هو أنا. بهذا المعنى فأنا لا يمكنني أن أجعل منه موضوعا، شيئا موضوعيا. أنا جسدي.
ثنائية فاصلة
هل سيفرض هذا الموقف الديكارتي الأخير نفسه أم أن العودة إلى الثنائية الفاصلة لن تنفك تعود؟ ما سيفرض نفسه هو كون الجسد هو المكان والزمان اللذان "يتجسد" فيهما العالم عبر وجه متفرد. إنه محور العلاقة بالعالم. من خلاله يستمد الإنسان جوهر حياته، من خلاله ينفتح على الآخرين عبر وساطة منظومات رمزية يتقاسمها مع أفراد مجتمعه. إنه المكان الذي يحتضن فيه الفاعل العالم ويتملكه بتحويله إلى عالم مألوف ومفهوم محمل بمعان وقيم قابلة للمشاركة، باعتباره تجربة يعيشها كل فاعل مندمج داخل منظومة المرجعيات الثقافية نفسها.
وجود الإنسان يعني أن يتفاعل بطريقة معقولة من أجل ذاته ومن أجل الآخرين في المكان والزمان، وأن يحول بيئته من خلال مجموعة من الأفعال، ومن خلال إضفاء دلالة وقيمة على محفزات البيئة المتعددة عبر الفعاليات الإدراكية، والتواصل مع الآخرين من طريق توجيه الكلام إليهم، ومن خلال سجل الحركات والإيماءات، ومجموع الشعائر الجسدية التي تستجيب للانتظارات المشتركة بأسلوب خاص، وكذا مجموع التعبيرات عن الحالة العاطفية من خلال طريقة معينة للوجود واستخدام خاص للوجه واليدين. فالإنسان يجعل من العالم، عبر جسده، مقياسا لتجربته، فيحوله إلى نسيج مألوف ومتماسك، جاهز لحركته وقابل للفهم. عن طريقه لا يفتأ ينتج الدلالات، مرسلا أو متلقيا.
عن طريق الجسد، يدمج الإنسان داخل فضاء اجتماعي وثقافي محدد، فيكون مشدودا إلى إيقاعات العمل والاستراحة، مشروطا بالفضاءات التي يرتادها، لذلك فإنه لا يفتأ يتجرع سموم العادات الغذائية والقواعد الأخلاقية. العادات الغذائية أولا، لأن المطبخ يحدد أجساما وأساليب للعيش وعلائق بالعالم وأنماطا للوجود. نظام التغذية يكرس ميتافيزيقا بكاملها. لم يكن نيتشه مبالغا عندما أكد أنه "نتيجة الغياب المطلق للعقل داخل المطبخ، قد تعثر تقدم الكائن البشري لمدة طويلة". فما نلاحظه من عناية مفرطة بعلوم الأطعمة والمطابخ، وصناعات لتوفير الأغذية الصحية، وجدالات حول ما ينبغي وما لا ينبغي أن يؤكل، كل هذا ليس إلا دليلا على تكريس لميتافيزيقا تؤكد "محورية الجسد".
ذلك أن الالتفات إلى الجسد، والاهتمام بما يعمله وما يتغذى عليه، لا ينبغي أن ينظر إليهما فحسب على أنهما مجرد عناية بالصحة، وإنما بالضبط على أنهما أساسا خلاص للجسد فخلاص للروح. فـ"فنون التغذية" وتمارين الرياضة، هي قبل كل شيء فنون وتمارين، إنها ترويض للجسد و"تربية" له وتثقيف.
تمثلات الجسد
يختلف وضع الجسد باختلاف المجتمع الذي يعيش في أحضانه. ففي المجتمعات التقليدية ذات التركيبة الشمولية والوازع الجماعي، حيث ينظر إلى الإنسان باعتباره جزءا لا يتجزأ من الكل، وحيث يكون الإنسان متماهيا مع الكون والطبيعة والجماعة، لا يكون الجسد موضوعا للتقسيم أو الانفصال. في هذه المجتمعات، تكون التمثلات عن الجسد هي نفسها التمثلات عن الإنسان وعن الشخص. صورة الجسد هي صورة الذات، متشابكة مع العناصر الأولية المكونة للطبيعة والكون، في تماسك لا يمكن فصله. هذه التصورات تعزز الإحساس بالانتماء والمشاركة الفاعلة في شمولية الكائن الحي. ولا تزال هذه التمثلات تلاحظ بوضوح في التقاليد الشعبية للعلاج حتى يومنا هذا.
وإذا كانت المجتمعات ذات الطابع الطائفي، التي يكون فيها معنى الوجود مدينا بالولاء للمجموعة، وللكون، وللطبيعة، لا تتميز بوجود للجسد كعنصر للفردانية، ما دام الفرد نفسه فيها غير متميز عن الآخرين، ولا يشكل تفردا داخل الانسجام التفاضلي للمجموعة، فإن المجتمعات التي تعرف سيادة للنزعات الفردية، تنظر إلى الجسد على أنه رمز للفرد، ومحل اختلافه وتمايزه، ولكن بشكل يحمل في طياته مفارقة. فهو غالبا ما يكون منفصلا عن نفسه بفعل إرث ما قد يسود من رواسب نزعة ثنائية تفصل الجسد عن الروح. في مثل هذه المجتمعات يكثر الحديث عن "تحرير الجسد"، وهي عبارة تعكس طابع تلك الرواسب، متجاهلة أن الوضع البشري هو وضع جسدي، إذ من المستحيل فصل الإنسان عن الجسد الذي يمنحه البعد الحسي والشعور بوجوده في العالم.
ذلك أننا إن قبلنا مؤقتا بعبارة "تحرير الجسد"، التي تبدو نسبية للغاية، يمكننا بسهولة أن نثبت أن المجتمعات التي تسودها النزعات الفردانية ما زالت مؤسسة على نوع من الإقصاء أو الإخفاء للجسد. يتجلى ذلك من خلال العديد من الطقوس المرتبطة بأوضاع الحياة اليومية. فالوضع الذي يفرض على الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية في تلك المجتمعات، والقلق العميق الذي يتولد عن هذا الوضع، وكذلك التهميش الذي يتعرض له "المجنون" أو المسنّون، كلها أمثلة تبرز حدود مفهوم "تحرير الجسد" هذا.
حتى إذا ما كان هناك "جسد محرر"، فإنه غالبا ما يكون جسدا شابا، جميلا، خاليا من العيوب. لذا، فالظاهر أن تحرير الجسد لا يمكنه أن يتحقق بالفعل إلا عندما يختفي هذا القلق المفرط المرتبط بالجسد.
الجسد والمرض
حتى الطب في هذه المجتمعات التي تسودها النزعات الفردية، يبدو أنه سجين تلك الثنائية، فهو يركز اهتمامه على الجسد والمرض أكثر مما يولي اهتمامه للمريض كشخص. ومن هنا ينبع العديد من النقاشات الأخلاقية المعاصرة التي تتعلق بالدور المتزايد للطب داخل الحقل الاجتماعي، وخصوصا تصوره للإنسان. فالطب، الذي يقوم على أنثروبولوجيا تعلي أهمية الجسد، ينظر إلى المرض باعتباره عنصرا غريبا يمكن معالجته، بدلا من النظر إلى المريض بصفته كيانا متكاملا. الطبيب لا يرى مني إلا جسدي، ولا يولي اهتمامه لي "أنا". وقد بين بعض الأنثروبولوجيين ذلك بشيء من التفصيل (د. لوبروتون على وجه الخصوص). هذه النظرة التجزيئية للإنسان، التي كانت ضمنيا أساسا للممارسة الطبية لقرون، أصبحت اليوم واقعا اجتماعيا يثير الكثير من الحساسية. ومع رهان الطب على الجسد، نجد أنه يصطدم اليوم بعودة المكبوت بقوة. فالإنسان يعود كعنصر مفقود في القضايا التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، مثل الموت الرحيم، ومرافقة المرضى والمحتضرين، والتعامل مع المرضى في حالة نباتية مزمنة، والمرضى المعتمدين على الأجهزة للبقاء على قيد الحياة، وحالات التشوهات الناجمة عن العلاجات الطبية، هذه كلها معطيات أنثروبولوجية مضطربة تعكس الأزمة الناجمة عن رواسب الفصل بين الإنسان وجسده.
لا يمكن فهم الجسد كعنصر متحد بالإنسان الذي يمنحه طابعه الفريد إلا في إطار البنيات الاجتماعية ذات الطابع الفرداني التي تكون قد تخلصت من رواسب الثنائية التي تفصل الجسد عن الفكر، حيث يكون الناس منفصلين بعضهم عن بعض، يتمتعون باستقلال ذاتي نسبي في مبادراتهم وقيمهم. في هذا السياق، يصبح الجسد بمثابة حاجز حدودي يحدد حضور الفرد تجاه الآخرين، مثلما يعطيه فرادته، ويعينه كشخص يتمتع باستقلال ذاتي.
عن " مجلة المجلة"