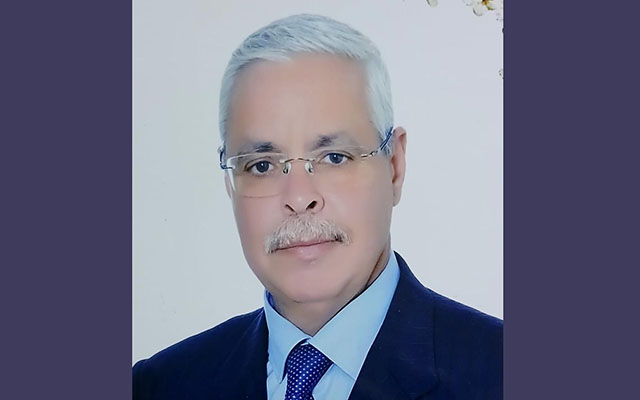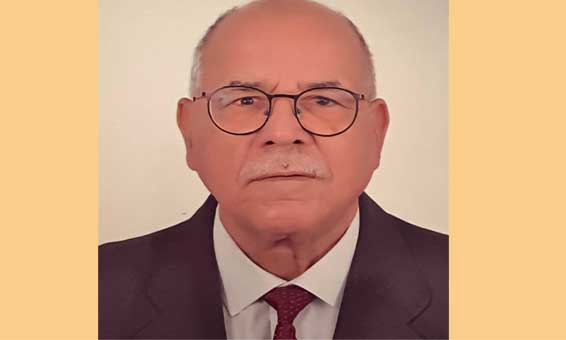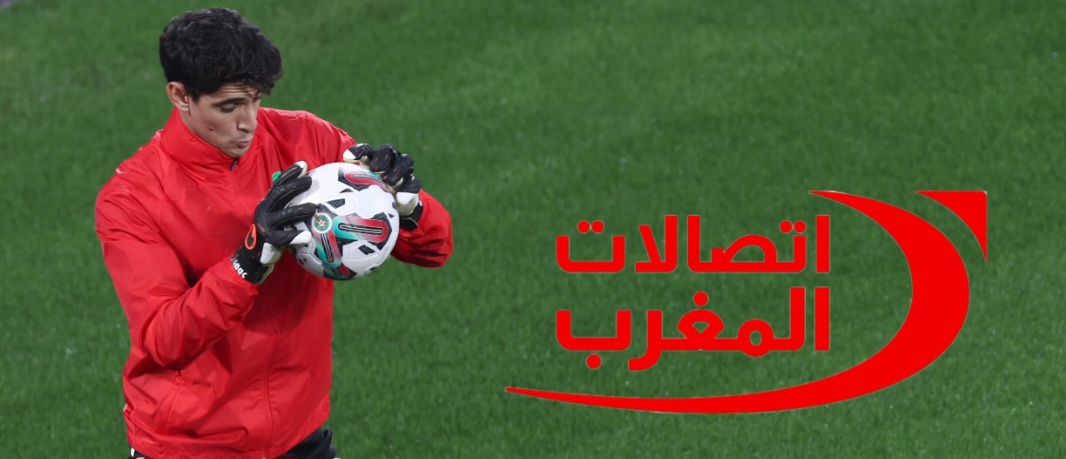تعترف أغلب دول العالم بالإضراب كحق من الحقوق الأساسية الإنسانية، وكوسيلة مشروعة للمطالبة بحقوق الأجراء الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها إزاء سلطة ونفوذ المشغل.
إلا أن هذا الحق المعترف به لايزال من أكثر القضايا التي تثير الجدال والخلاف بين مختلف الأطراف داخل الدول بدون استثناء.
ذلك بالأساس إلى كون الحق في الإضراب كسلاح بيد الأجراء للدفاع عن مصالحهم المهنية ترتبط بشكل معقد بمجالات الإنتاج والاستثمار من جهة، وبموازين القوى السائدة بين أصحاب العمل والاجراء من جهة أخرى.
ورغم الاعتراف بالحق في الإضراب من طرف لجنة الحرية النقابيــة التابعــة لمنظمة العمــل الدوليــة، إلا أنها اعتبرته ليس حقا مطلقا، بمعنى آخر هو يخضع لشروط وقيود وقواعد قانونية، وقد يحظر لظروف استثنائية. وهناك دول نصت عليه في الدستور (فرنسا، إيطاليا، تونس، المغرب...) وأخرى لم تنص عليه بتاتا (لبنان، الكويت، العراق، ليبيا...)، وهناك دول أوروبية وعربية نظمت الإضراب بمراسيم او قوانين عادية، منها تونس التي نظمت هذا الحق بقانون عادي في مجلة الشغل المواد 376 إلى 390، إلا أن المشرع الدستوري المغربي جعل منه منذ سنة 1962 حقا دستوريا تحدد شروطه وكيفيات ممارسته بموجب قانون تنظيمي، وهذا المعطى يكسبه أهمية خاصة وبرفع من شأنه، نظرا إلى كون القوانين التنظيمية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.
وهكذا جاء التنصيص على قانون تنظيمي في أول دستور للمملكة في سنة 1962 وكرسته جميع الدساتير اللاحقة ومنها دستور 2011.
وكما هو معروف القوانين التنظيمية هي القوانين التي اعترف لها الدستور بهذه الصفة أو التسمية، تمييزا لها عن القوانين العادية. ولهذا فإن هذه الفئة من القوانين تخضع لإجراءات خاصة من حيث إعدادها ومناقشتها والتصويت عليها. كما أن إصدارها غير جائز إلا بعد تدخل وجوبي من طرف المحكمة الدستورية، احتراما لتراتبية القوانين أو ما يعرف بهرم Kelsen، نسبة للفقيه النمساوي هانز كلسن.
لكن أمام غياب قانون تنظيمي يحدد مدى ممارسة حق الإضراب ظلت مشروعية الاضراب تستند إلى القانون الأسمى الذي يعبر عن إرادة الامة، والذي تعهدت فيه الدولة بالالتزام بمواثيق المنظمات الدولية وتشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
غير أن المشرع المغربي لم يجرأ فيما مضى على سن قانون للإضراب، ليس لأنه عجز عن ذلك، ولكن لأن وضع مثل هذا القانون تقتضي إرادة وتفاوض جماعي وتوافق بهدف وضع إطار قانوني يضمن لأطراف علاقات الشغل حقوقهم والتزاماتهم، خصوصا وأن موضوع هذا المشروع مرتبط أساسا بالمادة الاجتماعية.
ومن المعلوم ان العلاقة بين الإضراب كظاهرة اجتماعية عفوية والقانون دائما ما كانت معقدة ومتوترة، ذلك أن الإضراب هو عفوي ولا يمكن عند معالجته الوقوف على مجرد القانون، فلابد بالإضافة إلى ذلك أن نأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني، فالإضراب بقدر ما هو ظاهرة اجتماعية تتم ممارستها في ظل علاقات متميزة بانعدام التوازن الاقتصادي أو الاجتماعي الذي أتى الإضراب لجبره، فإن أي تدخل لتقييده أو الحد منه وفق قواعد القانون، فإنه يمكن أن يؤدي للإخلال بالتوازن في علاقات الشغل. لذلك فإن تنظيم الإضراب يستوجب توفير شروط أساسية على المستوىين الاقتصادي والاجتماعي منها العدل والثقة والمسؤولية.
ولهذه الأسباب وغيرها ظل القانون التنظيمي الخاص بالإضراب في خزانة البرلمان منذ 2016، بعد رفضه من قبل الفرق البرلمانية آنذاك.
حاليا يعود تعثر صدور القانون التنظيمي للإضراب إلى انعدام الثقة بين الأطراف، تجلى ذلك في موقف المركزيات النقابية من الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتمرير مشروع القانون لتنظيمي إلى البرلمان، وموقفها ايضا من الصيغة والشروط التي جاء بها مشروع القانون. ولعل من أبرزها: قرار الإعلان عن الإضراب ومسطرة التبليغ حيث وضعت الحكومة قيودا عديدة على ممارسة الإضراب، من خلال مسطرة معقدة تجعل القيام بإضراب شرعي أمرا تقريبا مستحيلا.
ومنها أيضا ربط قرار الإضراب بإجبارية المفاوضة أو الوساطة أو التحكيم كشرط لممارسة حق الإضراب، وهذا بالنسبة للنقابات يعني التضييق على الحق وإفراغه من محتواه، فلا يعقل أن يتم التنصيص الدستوري على حق من الحقوق ليأتي القانون المنظم ويفرغه من محتواه ويجعل ممارسته معقدة.
كما ان الحكومة لم تعتمد على إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها الفصل 288 من القانون الجنائي والذي تطالب النقابات دائما بإلغائه، لأنه بموجبه يتم اعتقال ومحاكمة المسؤولين النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.
مجمل القول، مسألة تقنين وتنظيم الإضراب مهمة على مستوى تنظيم الحقوق والواجبات، لكنها تحتاج في الظرفية الحالية المتسمة بالتضخم والبطالة أن تبادر الحكومة إلى المزيد من التفاوض والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف التوافق وتغليب الرؤية الاجتماعية بدل الاستجابة لضغوط هذا الطرف أو ذاك.
فالمغاربة توافقوا على مدونة الشغل سنة 2004 وتوافقوا على قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة 2014، وغيره من النصوص فلماذا لا يتوافقون على قانون الإضراب؟
ومسك الختام إصدار قانون للإضراب جزء من الحل وليس كل الحل للمشكلات الاجتماعية المعقدة، إذ من الضروري تخليق قانون الشغل، والسهر على تنفيذ بنوده، حتى تسود مبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالقانون.