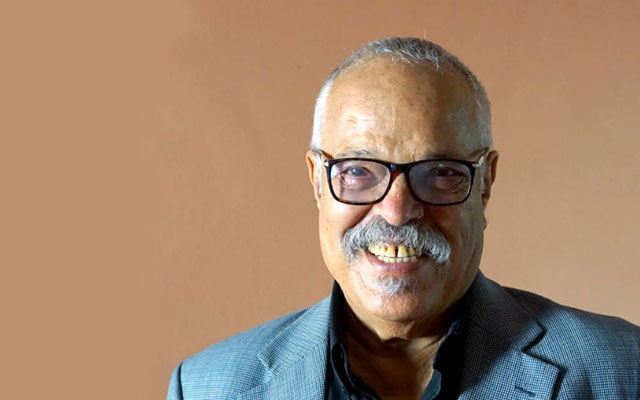يُذكي ورش تأهيل وتطوير المجتمع من بوابة القوانين المنظمة للعلاقات بين الجنسين بشكل عام، وعلى مستوى مدونة الأسرة تحديداً، اشتباكات سياسية وثقافيةٌ ونفسيةٌ صاخبةٌ، حوّلت المُتاح من النقاش إلى نزالات بين أطراف سياسية وحزبية ومؤسسية.
وإذا كانت المنهجية المعتمدة، على “تقليدانيتها”، تروم بالأساس تأطير وتنظيم العملية التشاورية وما يتخللها من مواجهات بين الأطراف المُختلفة، فإنها ذاتها تُسهِمُ في سحب البساط من (تحت) اللجنة المكلفة نفسها وتبسطه أحمدياً أمام أنموذج مكرور من الصراع حول مدونة الأسرة المغربية.
لا يمكن فصل ما يعتور النقاش المفتوح حول مدونة الأسرة من جنوح عن قواعد التبادل والتفكير والسعي إلى بلورة تصور مشترك لمبادئ ناظمة للعلاقات داخل الأسرة في مختلف حالاتها، عن محاولة إحياء رميم مشهد سياسي ومدني، خنقه الكساد السياسي الذي ترزح تحته بلادنا منذ ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، والذي تترجمه أزمة الديمقراطية التمثيلية وأزمة الحياة الحزبية وأزمة تدبير المال العام بأبعادها السياسية والمؤسسية.
وبعيداً عن أي حكم متسرع أو محاكمة للنيات أو تبخيس للمساهمات أو المبادرات، فإن واقع الفعل الجماعي بعناصره السياسية والحزبية والمؤسسية والمدنية عموما، لا يبعث على الثقة، بل يذكي حالة من الارتياب حول دواعي افتعال صراعٍ حول مخرجات ورش مدونة الأسرة؟ فهل ستُوظف أعطاب مدونة الأسرة المغربية لِتُنقذ ” قوانا الحية” و تفرد لها حَيزاً من التتبع والاهتمام الشعبي؟؟
وإن كنت أعتقد في جدوى الانكباب على معالجة أعطاب إنفاذ مقتضيات مدونة 2004 كمدخل لتطويرها، درءا لتأثير تداعيات النسق السياسي والثقافي الذي يهيكل واقعنا ووضعية التقشف السياسي والفكري الذي نرزح تحته، إلا أن معالجة العوارض المتعلقة بالتطبيق القضائي، لن تغني عن الغوص في أصل الإشكالية وامتداداتها، إذ أن الصعوبات التي يواجهها القضاء في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة راجعة إلى أسباب “عضوية” تخص إصلاح القضاء تنظيما وآليات وأدوات وموارد بشرية من جهة، لكنها بالأساس راجعة إلى التردد الذي يطبع هوية مدونة الأسرة، والذي يُخفي بدوره حيرة المنظومة السياسية وعجزها عن حسم سؤال المرجعية الناظمة لمسألة تنظيم العلاقات بين الرجال والنساء بشكل عام، أو كأطراف للأسرة في كافة أشكالها وفي مختلف مناحي مصالحها وحالاتها.
فإذا كانت الشريعة الإسلامية أهم مصدر للتشريع فما لذي يمنعنا من ربطها بمرجعية الواقع والتحولات والمصالح والمقاصد والاجتهاد والتطور؟ وما لذي يدفع المحافظين إلى الهرولة إلى سياسة الأبواب الموصدة أمام كل أبحاث التجديد والتنوير وربط الشريعة بالحياة والتطور، في وجه من يعتبرونهم غير مؤهلين للخوض في فلسفة الشريعة وأحكامها، بإسقاط القدرة والعلمية والكفاءة عن كل المختصين والعلماء والباحثين في غير أصول الفقه والشريعة؟ وما الذي يحث الحداثيين على قبول احتكار المحافظين الدينين للمرجعية الإسلامية في مدونة الأسرة وغيرها والتنفيذ “الطاعوي” لقرار النفي الإرادي والامتناع الذاتي عن المطالبة بالكلمة السواء في الشأن الديني، وحزم الحقائب والهجرة إلى كونية أحادية المنشأ والتطور، متجاهلة للتعدد الثقافي والفكري والقيمي؟
لقد أنتج عقل المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة ما يُفيد استيعابه للتأثير السلبي لماضيه على حاضره، وما يكشف دور الوعي التاريخي في فهم اختيارات وتأويلات السلف للنصوص الدينية، وما يصلح لفصل القيم الإسلامية عن تأثير السياقات الاجتماعية والتاريخية على التشريعات، وما يدفعه لتحرير تعاليم دين الرحمة والعدل والمساواة من قبضة تراث الغلبة والسلطويّة باسم الدين، بين الحاكمين والمحكومين وبين الجنسين رجالاً ونساءً وبين الطبقات اجتماعية والعرقية وغيرها.
وإذ لا أرى الحاجة إلى سرد ما يعرفه الجميع من حالات مثبتة، عطلت بل ونُسِخت فيها بتفعيل أحكام واضحة في القرآن الكريم، على يد صحابة رسول الله (ص) دون أن يُدفع بخروجهم على الجماعة أو فسقهم أو ردتهم، فهل أقدموا على تصحيح أوضاع معينة لأنهم صحابة رسول الله (ص) وأكثرهم استيعاباً للقيم القرآنية ولمقاصد الشريعة، أم لأنهم مالكون لأمر الأمة وقائمون بالثقة والمشروعية على أمرها السياسي وشؤون الدولة أو باللغة المعاصرة، مشرفون على النظام العام وعلى السلطة السياسية، وهذا ما ذهب إليه جملة من الباحثين في التراث وفي فكر وفلسفة المسلمين بعد أن قنطوا من الفشل المتواصل لدعاة التنوير من السلفيين من داخل المنظومة نفسها.
إن كل نظريات النهضة والتجديد، وكل المشاريع التي تنبثق عنها، تجد نفسها وبسرعة أمام منحدرات غير آمنة، يُوظف فيها الدين عقبة أمام الدور الحقيقي والناظم للدين نفسه في المجتمعات، ولصالح أنظمة أو مجموعات وخدمة لتوجهات وأهداف بعينها. و يقول التاريخ إن الفهم و التأويل العملي والواقعي لمختلف درجات الأسانيد من قرآن وسنة و تجارب الصحابة وأهل الذكر خضع بدوره إلى عوامل ثقافية وسياسية واجتماعية بل ومصلحية ونفسية. ألم يُقتَل مفكر الإسلام علي بن طالب كرم الله وجهه بالحق الذي أُريد به باطل؟ ألم يرفع الخوارج في وجهه القرآن الكريم بالتفسير الحرفي الأصم المتجزئ للآية الكريمة، ألم تُعقد أسواق النخاسة وبيع البشر من إماء وعبيد و”خصيان”، وغنائم بشرية من نساء وأطفال ورجال في مواسم الحج وقرب الحرمين وفي حضور صحابة رسول الله (ص).
واختصاراً ألم ترتهن قيم الدين الإسلامي إلى مؤثرات مجتمعية خالصة بجذورها العرقية والطبقية، وأعرافها وموروثاتها، فكان طبيعيا أن تتشكل المفاهيم والأحكام من داخل قوالب هاته المؤثرات، فشُرع للحرة وشُرع للأَمة، وتباينت الأحكام في النازلة نفسها بين الحرة وغير الحرة. فهل يعني هذا أن الدين الذي أنزل على الناس اللذين ولدتهم أمهاتهم أحراراً، واللذين لا فضل لعربيهم على أعجميهم ولا أبيضهم على أسودهم، ولا أسودهم على أبيضهم إلا بالتقوى، يستقيم أن يُشرع باللون والعرق والجنس والطبقة الاجتماعية؟ ثم ألم تُأَوٌلُ القوامة وإلى عهود قريبة جداً بحرمان الإناث من الإرث بشكل عام ومن امتلاك الأرض بشكل خاص، وبقبول تقديم الذكور على الإناث في الحق في تحصيل العلم وممارسة التجارة والسياسة والسلطة، وبالمنع القانوني والأخلاقوي من المشاركة في الحياة العامة من سياسة ومسؤوليات، ألم تُشَغٌل القاصرات في جل الأقطار الإسلامية لضمان الكفاف للقوامين من الذكور آباءً وإخوانا وأزواجا، ألم تُفَسٌرُ القوامة بشرعنة العنف والغلظة وكافة أشكال الممارسات المسيئة للإنسان، أليست “جريمة الشرف” القابعة في تشريعات جل بلدان المشرق العربي استباحة للنفس التي حرم الله إلا بالحق، تطوراً حتمياً لمفهوم القوامة في حاضنة السلطوية الذكورية، ألم تُأًوٌل القوامة بلغة المجتمعات ومباركة السلطة الدينية إلى حالة من اللامساواة بل وإلى حالة من الدونية المُشرعنة بين الجنسين والكثير الكثير من مظاهر غلبة التراث والأعراف وقوانين “ماوجدنا عليه آباءنا ” التي فرضها السياق التاريخي بعناصره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
إن القوامة التي يقصدها ديننا الحنيف هي تكليف أخلاقي وميثاق غليظ تحكمه المروءة والسمو والكرم وحسن الخلق والمودة والرحمة والإيثار، ويرمي إلى معالجة رواسب الحاضنة الحضارية الموروثة والرقي بسلوك الرجل إلى ما فوق تراكمات التجربة البشرية قبل نزول الرسالة المحمدية في علاقته بالطرف الآخر، وتشذيب الانحرافات والترسبات الاجتماعية المترسخة منذ ما قبل الإسلام.
إن المقصود من هذا النزر القليل من الكثير الذي ينز به تاريخنا و تدونه كتبنا بمختلف اهتماماتها شرعية، فقهية، اجتماعية أو سياسية، ليس الوقوف على فكرة تأثير التراث البشري على القيم والمقاصد الدينية، والقوامة أ نموذج ناظم للخلاف القائم بين المختلفين حول التطوير الذي يجب أن يطال العلاقة بين الرجال والنساء في الأسرة أو في المجتمع بصفة عامة ، بل المقصود هو التساؤل حول أسباب امتناع أهل العلوم الشرعية من علم العقيدة وعلم الحديث وعلم الفقه وأصوله وغيرها من التفاعل مع كل ما وثقه التاريخ و الممارسة و ما يقوله المخالفون؟
وعلى الضفة الأخرى، يقترح الحداثيون نظاما علائقياً ينبني على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وينتصر لمرجعية التحولات المجتمعية وكلمة الواقع المعيش مستئنساً بمبادئ كونية والتزامات بالمعاهدات الدولية، إلا أنه يدفع بدون تقعيد واضح إلى خيار القطيعة الاصطلاحية والمفاهيمية، ويدفع بأطروحة أن كل ما يستند إلى السجل المفاهيمي الديني هو بالضرورة مستبطن لحيف جنساني مخل بقواعد المساواة بين الرجال والنساء، والحال أن المقاربة المنتهجة من قِبل الحداثيين والتقدميين تستبطن أسباب إضعافها بل وتسهل عزلها واستهدافها وإمكانية التهييج الإيديولوجي بل والشعبي ضدها وتجعلها صيداً سهلا للسوقية السياسية والاستعداء الايديولوجي والفكري وللاستنكار الشعبي، إذ لا يستقيم بقواعد العلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية ، أن نحاول تغيير مرجعية مجتمع من خارج الروافد المغذية لعقله ولثقافته وفكره، ومن خارج الدوائر الناظمة لمرجعياته ونظم تفكيره وتفاعله، إذ نرى مثلا مطالب بتحييد اللغة والمفاهيم القانونية من أثر الشريعة والاستعاضة عن المفاهيم والمبادئ المؤطرة للعلاقة بين الجنسين بلغة معاصرة محايدة المرجعية، متحررة من الصراع التاريخي والثقافي والمذهبي حولها ، فتنادي بحذف مفاهيم بعينها أو بإسقاطها من اللغة القانونية لارتباطها بسياقات معينة أو بشروط وظروف بائدة، كالقوامة والصداق والمهر والمتعة والعدة وغيرها، واعتبارها مخلة بتصور معين للمساواة بين الرجال والنساء، وحاطة بكرامة النساء!!
وإذا كانت الفكرة بحد ذاتها مشروعة من باب التجديد ومسايرة العصر والتحلل من الترسبات التراثية وبناء مجتمعات مدنية، لكنه تجديد يجب أن ينطلق من لياقة فكرية وعلميّة قادرة على استيعاب واقع ديني وفكري وثقافي، ترعاه أسانيد مقدسة وأصول عتيدة و تؤطره علوم فقهية وشرعية و تدبر اختلافاته صروح مذهبية جامعة مانعة، وتزرع الفتنة عند نواصيه متاريس التراث والأعراف و”ما وجدنا عليه آباءنا وسلفنا والأولون”، إذ يستحيل كما تؤكد مفاهيم وقواعد علم الاجتماع أن تُغَيٌرَ ثقافة من خارج ذاتها، وبغير أدواتها وبمعزل عن عناصرها ومكوناتها وروافدها، كما أن مقاربة التغيير من خارج الدوائر العقدية والثقافية والفكرية القائمة لا يمكن أن تُفضي إلا إلى مقترحات مجتزأة لا تصمد أمام تجذر المرجعية الدينية وموضوعية الحاجة إليها.
إن الحداثة بما هي عملية متسلسلة للتغيير الفردي والجماعي المنبعث من قلب المجتمع، ليضعه على طريق التطور والتجدد والانطلاق ممتطيا الوعي التاريخي وممتشقاً سيف العقل والعلم والتجريب وتحليل الواقع والانطلاق منه، تفرض على الحداثيين والحداثيات منهجاً أكثر تدقيقاً في معركة إحقاق المساواة بين الرجال والنساء ينطلق أولا من تحديد المقصود بالمساواة بين جنسين مختلفين فيزيولوجياً ونفسياً ووظيفيا، يملآن على مستوى الأسرة والمجتمع وظائف ومهمات وأدواراً متباينة ويوظّفان قدرات وكفايات مختلفة ومتباينة، وهو تحديد مفاهيمي مركزي يجيب في اعتقادي على تساؤلات عديدة لعل أحدها هو: هل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية هو أعدل وجوه المساواة بين الرجال والنساء، ما هو شكل المساواة الذي يستدمج الاختلافات المميزة لكل من النساء والرجال وأثرها على الأدوار الموكولة إليهما في الأسرة وفي المجتمع؟. ..
إن للحداثيين والحداثيات في الأقطار ذات الأغلبية المسلمة أدوارًا أكبر وأعقد على طريق إقرار المساواة بين النساء والرجال، تتجاوز مهمة تأمين قنوات نقل المفاهيم والمبادئ من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتعريف بتصوراتها واختياراتها على أهميتها، واعتبارها أقصى المتاح، بل وتتجاوز فكرة ملء مقعد الخصومة مع التراثيين الإسلاميين -إذا صح هذا التعبير- وتتجاوز مرحلة الاستئناس بالتجارب المقارنة بإيجابياتها وسلبياتها إلى ورش نحت مرتكزات مفهوم المساواة الحقة والنافعة بين النساء والرجال من داخل الرقعة الثقافية والدينية والمرجعية الحقوقية الكونية.
وإذا كانت المنهجية المعتمدة، على “تقليدانيتها”، تروم بالأساس تأطير وتنظيم العملية التشاورية وما يتخللها من مواجهات بين الأطراف المُختلفة، فإنها ذاتها تُسهِمُ في سحب البساط من (تحت) اللجنة المكلفة نفسها وتبسطه أحمدياً أمام أنموذج مكرور من الصراع حول مدونة الأسرة المغربية.
لا يمكن فصل ما يعتور النقاش المفتوح حول مدونة الأسرة من جنوح عن قواعد التبادل والتفكير والسعي إلى بلورة تصور مشترك لمبادئ ناظمة للعلاقات داخل الأسرة في مختلف حالاتها، عن محاولة إحياء رميم مشهد سياسي ومدني، خنقه الكساد السياسي الذي ترزح تحته بلادنا منذ ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، والذي تترجمه أزمة الديمقراطية التمثيلية وأزمة الحياة الحزبية وأزمة تدبير المال العام بأبعادها السياسية والمؤسسية.
وبعيداً عن أي حكم متسرع أو محاكمة للنيات أو تبخيس للمساهمات أو المبادرات، فإن واقع الفعل الجماعي بعناصره السياسية والحزبية والمؤسسية والمدنية عموما، لا يبعث على الثقة، بل يذكي حالة من الارتياب حول دواعي افتعال صراعٍ حول مخرجات ورش مدونة الأسرة؟ فهل ستُوظف أعطاب مدونة الأسرة المغربية لِتُنقذ ” قوانا الحية” و تفرد لها حَيزاً من التتبع والاهتمام الشعبي؟؟
وإن كنت أعتقد في جدوى الانكباب على معالجة أعطاب إنفاذ مقتضيات مدونة 2004 كمدخل لتطويرها، درءا لتأثير تداعيات النسق السياسي والثقافي الذي يهيكل واقعنا ووضعية التقشف السياسي والفكري الذي نرزح تحته، إلا أن معالجة العوارض المتعلقة بالتطبيق القضائي، لن تغني عن الغوص في أصل الإشكالية وامتداداتها، إذ أن الصعوبات التي يواجهها القضاء في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة راجعة إلى أسباب “عضوية” تخص إصلاح القضاء تنظيما وآليات وأدوات وموارد بشرية من جهة، لكنها بالأساس راجعة إلى التردد الذي يطبع هوية مدونة الأسرة، والذي يُخفي بدوره حيرة المنظومة السياسية وعجزها عن حسم سؤال المرجعية الناظمة لمسألة تنظيم العلاقات بين الرجال والنساء بشكل عام، أو كأطراف للأسرة في كافة أشكالها وفي مختلف مناحي مصالحها وحالاتها.
فإذا كانت الشريعة الإسلامية أهم مصدر للتشريع فما لذي يمنعنا من ربطها بمرجعية الواقع والتحولات والمصالح والمقاصد والاجتهاد والتطور؟ وما لذي يدفع المحافظين إلى الهرولة إلى سياسة الأبواب الموصدة أمام كل أبحاث التجديد والتنوير وربط الشريعة بالحياة والتطور، في وجه من يعتبرونهم غير مؤهلين للخوض في فلسفة الشريعة وأحكامها، بإسقاط القدرة والعلمية والكفاءة عن كل المختصين والعلماء والباحثين في غير أصول الفقه والشريعة؟ وما الذي يحث الحداثيين على قبول احتكار المحافظين الدينين للمرجعية الإسلامية في مدونة الأسرة وغيرها والتنفيذ “الطاعوي” لقرار النفي الإرادي والامتناع الذاتي عن المطالبة بالكلمة السواء في الشأن الديني، وحزم الحقائب والهجرة إلى كونية أحادية المنشأ والتطور، متجاهلة للتعدد الثقافي والفكري والقيمي؟
لقد أنتج عقل المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة ما يُفيد استيعابه للتأثير السلبي لماضيه على حاضره، وما يكشف دور الوعي التاريخي في فهم اختيارات وتأويلات السلف للنصوص الدينية، وما يصلح لفصل القيم الإسلامية عن تأثير السياقات الاجتماعية والتاريخية على التشريعات، وما يدفعه لتحرير تعاليم دين الرحمة والعدل والمساواة من قبضة تراث الغلبة والسلطويّة باسم الدين، بين الحاكمين والمحكومين وبين الجنسين رجالاً ونساءً وبين الطبقات اجتماعية والعرقية وغيرها.
وإذ لا أرى الحاجة إلى سرد ما يعرفه الجميع من حالات مثبتة، عطلت بل ونُسِخت فيها بتفعيل أحكام واضحة في القرآن الكريم، على يد صحابة رسول الله (ص) دون أن يُدفع بخروجهم على الجماعة أو فسقهم أو ردتهم، فهل أقدموا على تصحيح أوضاع معينة لأنهم صحابة رسول الله (ص) وأكثرهم استيعاباً للقيم القرآنية ولمقاصد الشريعة، أم لأنهم مالكون لأمر الأمة وقائمون بالثقة والمشروعية على أمرها السياسي وشؤون الدولة أو باللغة المعاصرة، مشرفون على النظام العام وعلى السلطة السياسية، وهذا ما ذهب إليه جملة من الباحثين في التراث وفي فكر وفلسفة المسلمين بعد أن قنطوا من الفشل المتواصل لدعاة التنوير من السلفيين من داخل المنظومة نفسها.
إن كل نظريات النهضة والتجديد، وكل المشاريع التي تنبثق عنها، تجد نفسها وبسرعة أمام منحدرات غير آمنة، يُوظف فيها الدين عقبة أمام الدور الحقيقي والناظم للدين نفسه في المجتمعات، ولصالح أنظمة أو مجموعات وخدمة لتوجهات وأهداف بعينها. و يقول التاريخ إن الفهم و التأويل العملي والواقعي لمختلف درجات الأسانيد من قرآن وسنة و تجارب الصحابة وأهل الذكر خضع بدوره إلى عوامل ثقافية وسياسية واجتماعية بل ومصلحية ونفسية. ألم يُقتَل مفكر الإسلام علي بن طالب كرم الله وجهه بالحق الذي أُريد به باطل؟ ألم يرفع الخوارج في وجهه القرآن الكريم بالتفسير الحرفي الأصم المتجزئ للآية الكريمة، ألم تُعقد أسواق النخاسة وبيع البشر من إماء وعبيد و”خصيان”، وغنائم بشرية من نساء وأطفال ورجال في مواسم الحج وقرب الحرمين وفي حضور صحابة رسول الله (ص).
واختصاراً ألم ترتهن قيم الدين الإسلامي إلى مؤثرات مجتمعية خالصة بجذورها العرقية والطبقية، وأعرافها وموروثاتها، فكان طبيعيا أن تتشكل المفاهيم والأحكام من داخل قوالب هاته المؤثرات، فشُرع للحرة وشُرع للأَمة، وتباينت الأحكام في النازلة نفسها بين الحرة وغير الحرة. فهل يعني هذا أن الدين الذي أنزل على الناس اللذين ولدتهم أمهاتهم أحراراً، واللذين لا فضل لعربيهم على أعجميهم ولا أبيضهم على أسودهم، ولا أسودهم على أبيضهم إلا بالتقوى، يستقيم أن يُشرع باللون والعرق والجنس والطبقة الاجتماعية؟ ثم ألم تُأَوٌلُ القوامة وإلى عهود قريبة جداً بحرمان الإناث من الإرث بشكل عام ومن امتلاك الأرض بشكل خاص، وبقبول تقديم الذكور على الإناث في الحق في تحصيل العلم وممارسة التجارة والسياسة والسلطة، وبالمنع القانوني والأخلاقوي من المشاركة في الحياة العامة من سياسة ومسؤوليات، ألم تُشَغٌل القاصرات في جل الأقطار الإسلامية لضمان الكفاف للقوامين من الذكور آباءً وإخوانا وأزواجا، ألم تُفَسٌرُ القوامة بشرعنة العنف والغلظة وكافة أشكال الممارسات المسيئة للإنسان، أليست “جريمة الشرف” القابعة في تشريعات جل بلدان المشرق العربي استباحة للنفس التي حرم الله إلا بالحق، تطوراً حتمياً لمفهوم القوامة في حاضنة السلطوية الذكورية، ألم تُأًوٌل القوامة بلغة المجتمعات ومباركة السلطة الدينية إلى حالة من اللامساواة بل وإلى حالة من الدونية المُشرعنة بين الجنسين والكثير الكثير من مظاهر غلبة التراث والأعراف وقوانين “ماوجدنا عليه آباءنا ” التي فرضها السياق التاريخي بعناصره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
إن القوامة التي يقصدها ديننا الحنيف هي تكليف أخلاقي وميثاق غليظ تحكمه المروءة والسمو والكرم وحسن الخلق والمودة والرحمة والإيثار، ويرمي إلى معالجة رواسب الحاضنة الحضارية الموروثة والرقي بسلوك الرجل إلى ما فوق تراكمات التجربة البشرية قبل نزول الرسالة المحمدية في علاقته بالطرف الآخر، وتشذيب الانحرافات والترسبات الاجتماعية المترسخة منذ ما قبل الإسلام.
إن المقصود من هذا النزر القليل من الكثير الذي ينز به تاريخنا و تدونه كتبنا بمختلف اهتماماتها شرعية، فقهية، اجتماعية أو سياسية، ليس الوقوف على فكرة تأثير التراث البشري على القيم والمقاصد الدينية، والقوامة أ نموذج ناظم للخلاف القائم بين المختلفين حول التطوير الذي يجب أن يطال العلاقة بين الرجال والنساء في الأسرة أو في المجتمع بصفة عامة ، بل المقصود هو التساؤل حول أسباب امتناع أهل العلوم الشرعية من علم العقيدة وعلم الحديث وعلم الفقه وأصوله وغيرها من التفاعل مع كل ما وثقه التاريخ و الممارسة و ما يقوله المخالفون؟
وعلى الضفة الأخرى، يقترح الحداثيون نظاما علائقياً ينبني على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وينتصر لمرجعية التحولات المجتمعية وكلمة الواقع المعيش مستئنساً بمبادئ كونية والتزامات بالمعاهدات الدولية، إلا أنه يدفع بدون تقعيد واضح إلى خيار القطيعة الاصطلاحية والمفاهيمية، ويدفع بأطروحة أن كل ما يستند إلى السجل المفاهيمي الديني هو بالضرورة مستبطن لحيف جنساني مخل بقواعد المساواة بين الرجال والنساء، والحال أن المقاربة المنتهجة من قِبل الحداثيين والتقدميين تستبطن أسباب إضعافها بل وتسهل عزلها واستهدافها وإمكانية التهييج الإيديولوجي بل والشعبي ضدها وتجعلها صيداً سهلا للسوقية السياسية والاستعداء الايديولوجي والفكري وللاستنكار الشعبي، إذ لا يستقيم بقواعد العلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية ، أن نحاول تغيير مرجعية مجتمع من خارج الروافد المغذية لعقله ولثقافته وفكره، ومن خارج الدوائر الناظمة لمرجعياته ونظم تفكيره وتفاعله، إذ نرى مثلا مطالب بتحييد اللغة والمفاهيم القانونية من أثر الشريعة والاستعاضة عن المفاهيم والمبادئ المؤطرة للعلاقة بين الجنسين بلغة معاصرة محايدة المرجعية، متحررة من الصراع التاريخي والثقافي والمذهبي حولها ، فتنادي بحذف مفاهيم بعينها أو بإسقاطها من اللغة القانونية لارتباطها بسياقات معينة أو بشروط وظروف بائدة، كالقوامة والصداق والمهر والمتعة والعدة وغيرها، واعتبارها مخلة بتصور معين للمساواة بين الرجال والنساء، وحاطة بكرامة النساء!!
وإذا كانت الفكرة بحد ذاتها مشروعة من باب التجديد ومسايرة العصر والتحلل من الترسبات التراثية وبناء مجتمعات مدنية، لكنه تجديد يجب أن ينطلق من لياقة فكرية وعلميّة قادرة على استيعاب واقع ديني وفكري وثقافي، ترعاه أسانيد مقدسة وأصول عتيدة و تؤطره علوم فقهية وشرعية و تدبر اختلافاته صروح مذهبية جامعة مانعة، وتزرع الفتنة عند نواصيه متاريس التراث والأعراف و”ما وجدنا عليه آباءنا وسلفنا والأولون”، إذ يستحيل كما تؤكد مفاهيم وقواعد علم الاجتماع أن تُغَيٌرَ ثقافة من خارج ذاتها، وبغير أدواتها وبمعزل عن عناصرها ومكوناتها وروافدها، كما أن مقاربة التغيير من خارج الدوائر العقدية والثقافية والفكرية القائمة لا يمكن أن تُفضي إلا إلى مقترحات مجتزأة لا تصمد أمام تجذر المرجعية الدينية وموضوعية الحاجة إليها.
إن الحداثة بما هي عملية متسلسلة للتغيير الفردي والجماعي المنبعث من قلب المجتمع، ليضعه على طريق التطور والتجدد والانطلاق ممتطيا الوعي التاريخي وممتشقاً سيف العقل والعلم والتجريب وتحليل الواقع والانطلاق منه، تفرض على الحداثيين والحداثيات منهجاً أكثر تدقيقاً في معركة إحقاق المساواة بين الرجال والنساء ينطلق أولا من تحديد المقصود بالمساواة بين جنسين مختلفين فيزيولوجياً ونفسياً ووظيفيا، يملآن على مستوى الأسرة والمجتمع وظائف ومهمات وأدواراً متباينة ويوظّفان قدرات وكفايات مختلفة ومتباينة، وهو تحديد مفاهيمي مركزي يجيب في اعتقادي على تساؤلات عديدة لعل أحدها هو: هل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية هو أعدل وجوه المساواة بين الرجال والنساء، ما هو شكل المساواة الذي يستدمج الاختلافات المميزة لكل من النساء والرجال وأثرها على الأدوار الموكولة إليهما في الأسرة وفي المجتمع؟. ..
إن للحداثيين والحداثيات في الأقطار ذات الأغلبية المسلمة أدوارًا أكبر وأعقد على طريق إقرار المساواة بين النساء والرجال، تتجاوز مهمة تأمين قنوات نقل المفاهيم والمبادئ من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتعريف بتصوراتها واختياراتها على أهميتها، واعتبارها أقصى المتاح، بل وتتجاوز فكرة ملء مقعد الخصومة مع التراثيين الإسلاميين -إذا صح هذا التعبير- وتتجاوز مرحلة الاستئناس بالتجارب المقارنة بإيجابياتها وسلبياتها إلى ورش نحت مرتكزات مفهوم المساواة الحقة والنافعة بين النساء والرجال من داخل الرقعة الثقافية والدينية والمرجعية الحقوقية الكونية.