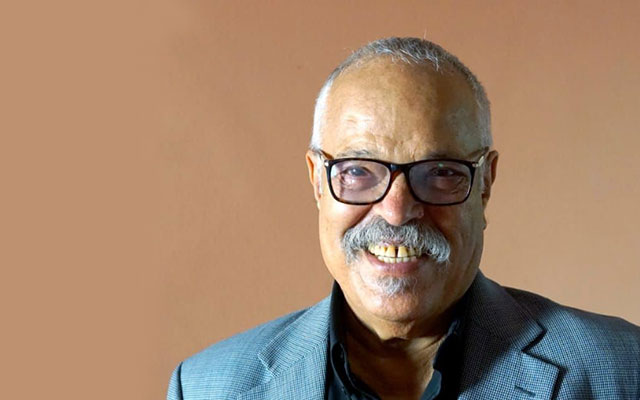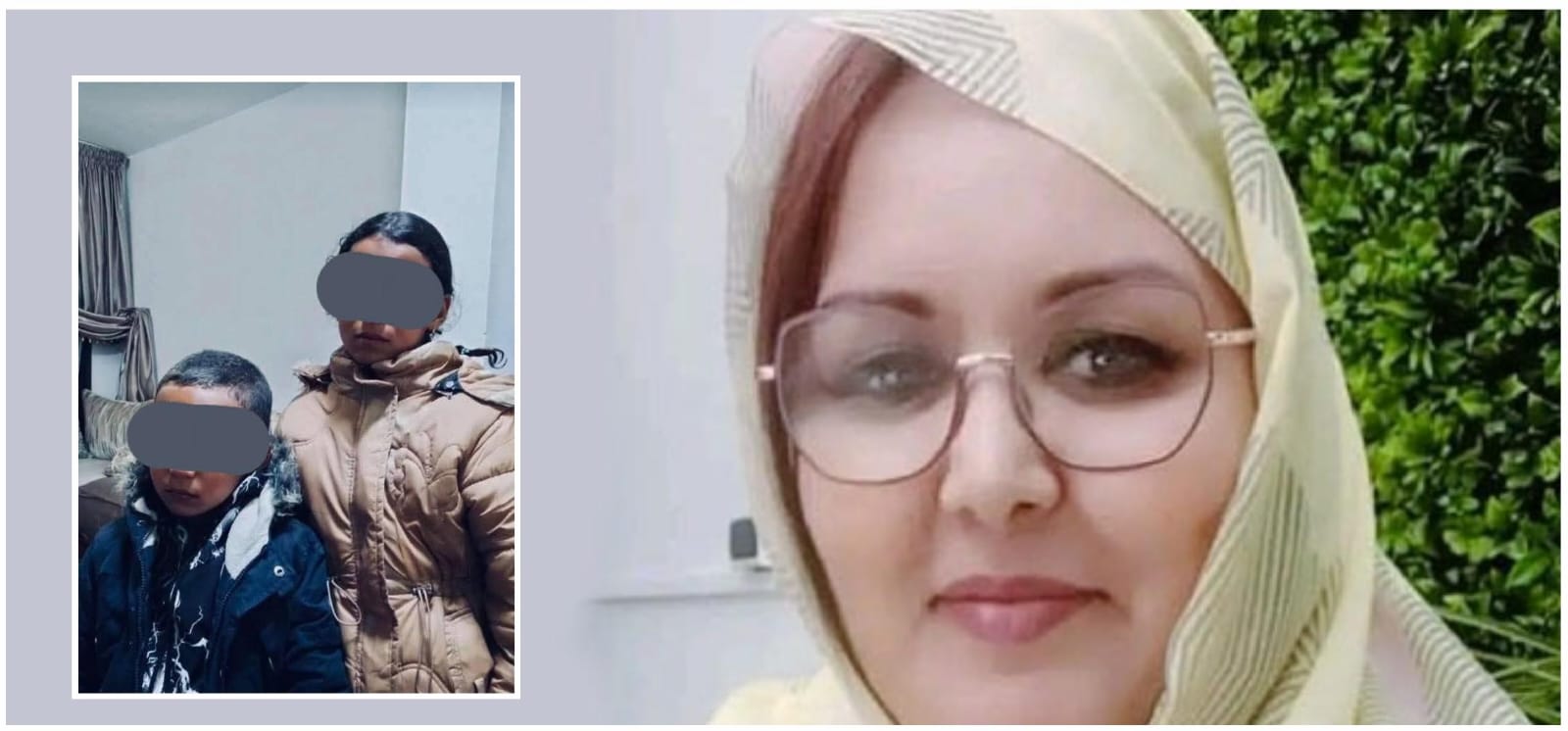عهد الحسن الثاني، لم يكن كله عهدا أسودا أو عهدا يتميز بسنوات الرصاص فقط، بل كان أيضا عهدا تميز ببعض الإشراقات، من أهمها أن المغرب كانت له نخبة سياسية من عيار ثقيل، وكانت لهذه النخبة الجرأة لتقول للملك الراحل: «لسنا مستعدين للتعامل مع حكومتك تضم في عضويتها إدريس البصري». وهذا الرفض الذي أطر له قادة وطنيون أمثال امحمد بوستة وعبد الرحمان اليوسفي، شكل القشة التي قصمت ظهر التناوب الأول الذي فشل عام 1992، واضطر معها المرحوم الحسن الثاني إلى مخاطبة النخب الوطنية بلغة صارمة رفعت من قيمة إدريس البصري بشكل جعلته من « المقدسات». ومع ذلك لم تشفع تلك الصرامة والقداسة الجديدة للوزير البصري في تغيير موقف النخب الوطنية، إلى أن اضطر القصر إلى التنازل وتمت صياغة دستور جديد عام 1996، صودق عليه لأول مرة بالإجماع من طرف أغلبية المكونات اليسارية. هذا التصويت اعتبر آنذاك بمثابة التمهيد الأولي لإنجاح التناوب بعد أن أزيلت التحفظات التي سطرت ضد سياسة البصري الذي أدمج في حكومة التناوب عام 1998 بالشروط التي اتفق عليها أطراف العملية الانتقالية السياسية (أي القصر والوطنيين)، علما أن دستور تلك الفترة لم يكن ذا سقف عال مثلما هو الحال مع دستور 2011.
اليوم ظل المغرب في حدوده الترابية الحقة، ولم يتغير أي شيء، اللهم التغيير الذي عرفه اللاعبون في الحقل السياسي. فالملك الحسن الثاني اختاره الله لجواره، والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي انتقل إلى رحمة الله. واعتلى عرش المغرب ملك جديد التزم بنفس دفتر التحملات الذي توافق عليه المغاربة منذ قرون، بل وزاد عليها ميزة إضافية ألا وهي الالتزام بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجديدة للمملكة. وهو ما لمسه المواطن في أكثر من محطة، عكستها بالأساس محطة الخطاب الملكي ليوم 9 مارس وما تلاه من دستور، لم تكن الطبقة السياسية تحلم بنفسها بالسقف الذي جاء به.
لكن الخطأ ليس في المشرع الدستوري أو في قرار المغاربة الذين صوتوا بأغلبية مطلقة على دستور 2011، بل في الصندوق الانتخابي العجيب الذي تخرج منه نخب سياسية ليست في مستوى الانتظارات والطموحات، وليست في مستوى تحسين صورة رجل السياسة، وليست في مستوى فتح شهية المغاربة العازفين لينخرطوا في العملية الحزبية والانتخابية (محلية كانت أو جهوية أو وطنية).
الدليل على ذلك أن العهد الماضي الذي كان فيه القمع والطيارة والشيفونة وسجون: «تازمامارت ودرب مولاي الشريف وتاكونيت وقلعة مكونة وأكدز»، وسياسة «نخلي داربوك»، تميز بانتصاب نخب سياسية عفيفة اللسان وكان خطابها راقيا وعاليا وكانت لغتها طاهرة صافية. بينما اليوم ومناخ الحريات في المغرب اتسع بشكل كبير، ومعدل الثقة في المؤسسات انتفخ بشكل صاروخي، لا نجد تلك النخب التي بإمكانها أن تجر المغرب نحو الأعلى والحريصة على تجويد خطابها و«تنظيف» قاموسها ولسانها، بل على العكس ابتلينا بنخبة سياسية مارقة و«مرايقية»، نخب متعفنة و«ملهوفة»، نخب لا تخاف من الله فأحرى ان تخاف من الدستور ومن القانون، نخب «مرمدت» مؤسسة الوزير والبرلماني والرئيس، لدرجة أنها أنزلت صورة رجل السياسة إلى الحضيض، ولم يعد المرء يفرق بين «البرلمان» و«البار»، وبين الوزير و«البزناس»، وبين الرئيس و«الفيدور»، وبين السياسي و«الشناق» وبين المسؤول العمومي و«الشفار».
وإذا كان الدستور يلزم كل فرد باحترام كل الأحزاب واحترام كل المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات (من حكومة وبرلمان وجماعات)، فحسب علمي ليس هناك نص دستوري يجبرنا كمغاربة على احترام نخب سياسية لا يتوفر في معظم وزرائها وبرلمانييها ومنتخبي جماعاتها «السميك من التعاقد الأخلاقي» لمواجهة تحديات المغرب، ولا يتوفر معظمهم على «السميك الكاميكازي» الذي يجعلهم لا يغمض لهم جفن حتى تتحسن معيشة الأغلبية الكاسحة من المغاربة، وحتى يتم تعميم الرخاء والرفاه على كافة طبقات المجتمع.
رحمة الله على المغاربة الأصفياء والأتقياء، وبئس للأشقياء الذين كفروا بربهم وبمغربهم!
اليوم ظل المغرب في حدوده الترابية الحقة، ولم يتغير أي شيء، اللهم التغيير الذي عرفه اللاعبون في الحقل السياسي. فالملك الحسن الثاني اختاره الله لجواره، والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي انتقل إلى رحمة الله. واعتلى عرش المغرب ملك جديد التزم بنفس دفتر التحملات الذي توافق عليه المغاربة منذ قرون، بل وزاد عليها ميزة إضافية ألا وهي الالتزام بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجديدة للمملكة. وهو ما لمسه المواطن في أكثر من محطة، عكستها بالأساس محطة الخطاب الملكي ليوم 9 مارس وما تلاه من دستور، لم تكن الطبقة السياسية تحلم بنفسها بالسقف الذي جاء به.
لكن الخطأ ليس في المشرع الدستوري أو في قرار المغاربة الذين صوتوا بأغلبية مطلقة على دستور 2011، بل في الصندوق الانتخابي العجيب الذي تخرج منه نخب سياسية ليست في مستوى الانتظارات والطموحات، وليست في مستوى تحسين صورة رجل السياسة، وليست في مستوى فتح شهية المغاربة العازفين لينخرطوا في العملية الحزبية والانتخابية (محلية كانت أو جهوية أو وطنية).
الدليل على ذلك أن العهد الماضي الذي كان فيه القمع والطيارة والشيفونة وسجون: «تازمامارت ودرب مولاي الشريف وتاكونيت وقلعة مكونة وأكدز»، وسياسة «نخلي داربوك»، تميز بانتصاب نخب سياسية عفيفة اللسان وكان خطابها راقيا وعاليا وكانت لغتها طاهرة صافية. بينما اليوم ومناخ الحريات في المغرب اتسع بشكل كبير، ومعدل الثقة في المؤسسات انتفخ بشكل صاروخي، لا نجد تلك النخب التي بإمكانها أن تجر المغرب نحو الأعلى والحريصة على تجويد خطابها و«تنظيف» قاموسها ولسانها، بل على العكس ابتلينا بنخبة سياسية مارقة و«مرايقية»، نخب متعفنة و«ملهوفة»، نخب لا تخاف من الله فأحرى ان تخاف من الدستور ومن القانون، نخب «مرمدت» مؤسسة الوزير والبرلماني والرئيس، لدرجة أنها أنزلت صورة رجل السياسة إلى الحضيض، ولم يعد المرء يفرق بين «البرلمان» و«البار»، وبين الوزير و«البزناس»، وبين الرئيس و«الفيدور»، وبين السياسي و«الشناق» وبين المسؤول العمومي و«الشفار».
وإذا كان الدستور يلزم كل فرد باحترام كل الأحزاب واحترام كل المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات (من حكومة وبرلمان وجماعات)، فحسب علمي ليس هناك نص دستوري يجبرنا كمغاربة على احترام نخب سياسية لا يتوفر في معظم وزرائها وبرلمانييها ومنتخبي جماعاتها «السميك من التعاقد الأخلاقي» لمواجهة تحديات المغرب، ولا يتوفر معظمهم على «السميك الكاميكازي» الذي يجعلهم لا يغمض لهم جفن حتى تتحسن معيشة الأغلبية الكاسحة من المغاربة، وحتى يتم تعميم الرخاء والرفاه على كافة طبقات المجتمع.
رحمة الله على المغاربة الأصفياء والأتقياء، وبئس للأشقياء الذين كفروا بربهم وبمغربهم!