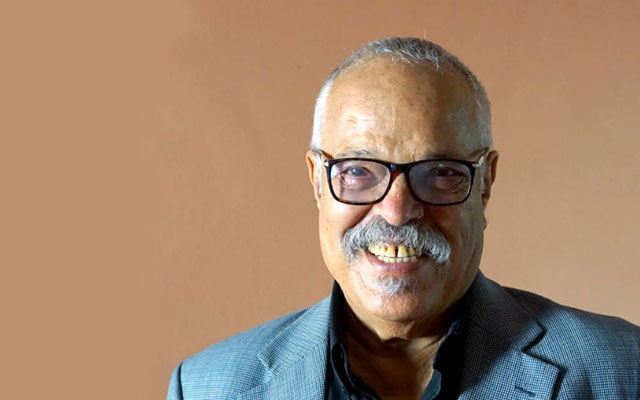في البدء وجب التذكير على أننا لا نراهن كثيرا على فحوى الخطابات فقط، ولكن نراهن على الإجراءات المأمور بها طبقا للصلاحيات القانونية / الدستورية المخولة، وحسبنا نعتبر أن الأوراق المقروءة مؤخرا، بمناسبة ذكرى رمزية التعاقد بين الحركة الوطنية وبين المؤسسة الملكية خلال فترة الحماية، ما هي إلا إحدى المسودات المقترحة، ووقع الإختيار على مسودة مقبولة من جميع المستشارين على سبيل التوافق الإضطراري، خالية من أي تردد أو ارتباك، لكن أيضا خالية من أي إفصاح عن معطيات مفيدة للرأي العام باعتبارها مشروع إجابة عن أسئلة المرحلة المقلقة، وهذا ينسجم مع قناعتنا بكونها شأن حكومي بامتياز، وأن من شأن تدخل الملك تكريس توجساتنا حول عودة الملكية التنفيذية فوق الدستورية، وإن غياب الحديث عن الشؤون الوطنية عامة والشأن الحسيمي على الخصوص ليؤكد ذلك، من هنا ستظل المسودة المتعلقة بانتظارات المواطنين قيد الترقب والتحيين وقد تصرف قرارات وإجراءات بالنظر إلى غنى يومياتنا بالفرص الوطنية والمناسبات الدينية.
ونظرا لأهمية الإفصاح الرسمي الإستباقي للمعلومات كمكون محوري في معظم النظم الحديثة، وبغض النظر عن التسريبات الروتينية التي قد تخدم الصادقة منها الدمقراطية التشاركية ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات الدستور الإيجابية والمنتجة للبناء والتحول الدمقراطيين، لقد قدم الخطاب وتناسلت معه أسئلة جديدة مؤرقة، ولم يخض أغلب الفاعلين في عملية التفكيك أو التأويل أو التفسير، لأسباب مرتبطة ربما لتمثلهم لقاعدة "الساعة لله" وقرروا تفهم الوضع دون فهم الحالة، ولكن في نظرنا ونحن نستحضر الوضعية النفسية و الصحية للبلاد والعباد في ارتباط عضوي مع أزمة الثقة؛ نعتبر أن الدولة والمجتمع مستمران مؤسساتيا في الزمن والمكان، بغض النظر عن الوقائع والمواقع، في استقلال عن الأفكار والأشخاص، في نظرنا أنه مطلوب مواصلة الإجتهاد لبلورة حلول مفترضة في الخطاب بربطها بمقتضيات افتراضية مضمرة ومضمنة في بقية المسودات غير المنتقاة، ويمكن الإستعانة بفلسفة المشرع الدستوري وحكمة المستشار السياسي المفترضتين.
ففي ضوء الخطابات المتوالية وتراكم المؤشرات والرسائل وكذا باستحضار جميع الالتزامات الدولتية، يمكن استشفاف أنها لن ترقى إلى نقد ذاتي متوافق عليه من قبل القوى الحية في البلاد، سوى إذا استطعنا أن ننقض سلوك الدولة الذي تماهى وتمادى في الإشتغال، عن حسن النية، كخادم لتحفيز المد المحافظ وتمكينه من وسائل الوجود والخلود، بافتعال حرب أخلاقوية (فضائح الاغتصاب) على حساب تكافؤ الفرص الوطني والمتكتسبات والتضحيات الوطنية والدمقراطية من جهة، ومن جهة أخرى، فالدولة مصرة في توجهاتها الإستراتيجية على الإشتغال كوكيل للإستثمار الخارجي بدل الوكالة من أجل العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروات، هذا السلوك الذي قد يقوى من نفوذ رجال الأعمال الخارجين عن رقابة الإفتحاص الوطني للمال العام، إلى درجة أن هؤلاء «المقاولين» الكبار، فرضوا نفوذهم ونالوا نصيبهم من مناصب التدبير و« التحكم » الإقتصادوسياسي، وكانت الخوصصة سبيلا إلى خلودهم في السلطة باسم الإستشارة تارة، وباسم التقتوقراطية المغلفة للإنتماء السياسي للحزب الأغلبي الحاكم فعليا، هو مطلب التحرر إذن يعيد طرح نفسه على جدول الأعمال، فاسترجاع خيوط السيادة الوطنية لن ينفع معه التذرع بـ "التزامات الدولة" تجاه الحلفاء والأصدقاء في الخارج، بغض النظر عن الفوائد التي تثقل كاهل « مشروعنا » وتعطل مسار إقلاعنا التنموي، لذلك فالخطاب حول أفريقيا ليس مكرورا أو مبتذلا، فهو جدي وصادق في مراميه، لكنه مجرد عن أي تحفظات أو ضمانات في العلاقة مع جدوى مطلب دمقرطة السياسات العمومية في مجال الأمن والشؤون الخارجية.