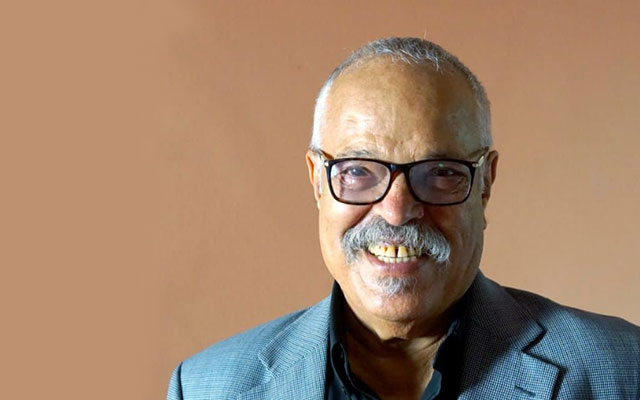سيظل المخزن كاصطلاح توظفه أطراف الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كل من زاويته وخلفياته.. فهو فزاعة بيد البعض لاستمرار التمثلات التقليدانية، ولتكريس تماهي وهجانة أنماط الانتاج، مما يوفر إمكانية استمرارية تداعيات «فوبيا» الاستبداد الشرقي، الذي يتغذى من وصايا الفكر الوهابي. في حين يفيد البعض في تغليف سلوكات التحكم المؤسساتية/ الدولتية، أجهزة وثقافة، في إطار الوصاية الأبوية كمصدر للحكم، وتوظيف ذلك كمبرر للتحلي واحتكار شرعية الفصل والقضاء والتحكيم والإفتاء والإرشاد تحت يافطة الإمامة أو الإمارة.
والحال أن هذه السلوكات تحولت، بالتراكم والتكرار، إلى عقيدة لدى البعض الآخر تسلم، استيلابا ودون انتباه، بأن «أولياء الأمر» يتربعون فوق «الصراع» وفوق «الطبقات»، فتتماهى السلطة الزمنية مع السلطة الدينية في شكل توليفة توحي بالتعادلية والوسطية كخصوصية تميز النظام السياسي، وتؤكد تعايش الشكلانية اللبرالية كمظهر بدون محتوى، اللهم ما يطفو على السطح من تمثل لحرية الملكية، الرأسمال والقوة و الحكم، في ثنائية مرتبكة وغير متناغمة أحيانا، مع الجوهر التقليداني، الذي يستند على الريع والدين والشرف، إلى درجة أن عددا كبيرا من «المعارضين» الذين تخلوا عن أدوات التحليل المادي التاريخي، صاروا أيضا ضحايا التعويم الديماغوجي الذي يختزل، عمدا، الصراع في ثنائية «الشعب والمخزن» ضدا على ما يقتضيه قانون «وحدة وصراع المتناقضات».
فكيف يمكن لعاقل أن يتجاهل أهمية تحليل وتوصيف فسيفساء التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية، وهو يعلم جيدا أنه قوض مرتكزات الاختلاف والتناقض الأساسي بين مالكي وسائل الانتاج ومنتجي الثروة بخدماتهم، والذين لا يملكون سوى قوة عملهم؟ فهل بذلك يبتغون ممارسة التضليل للتهرب من أداء كلفة الاصطفاف الاجتماعي/ الطبقي؟ ألا يضر هذا التعويم، المقصود، بالحركة التلقائية للانتماء للجماعات أو للوطن؟ ألا يدفع هذا «الكسل» في التحليل والتمييز بين مكونات الصراع إلى صعوبة تحديد التناقضات بين المحافظين وحلفائهم الطبيعيين داخل التحالف الطبقي الحاكم وبين حاملي مشروع التغيير الديموقراطي؟
قد يبدو في الوهلة الأولى أن هذه الضبابية قد تفيد في استقطاب، إلى الصفوف، كل خصوم وأعداء أو معارضي الطرف الحاكم، كتكتيك ليس إلا، لكن هنا يغيب أو يتم تجاهل أن هذه الطريق غير سالكة، مادام عمق الصراع بين طرفي تلك الخصومة، يكمن حول السلطة السياسية، وأي سلطة، طبعا ذات الخلفية التنازعية المؤسسة على وللشرعية الدينية .
إنها معركة خاسرة، في ظل هشاشة مقومات الإمساك بالقيادة والتدبير «التشاركي»، فالطلائعية لا تتوفر بالصراخ والمزايدات والشعارات حول من يعشق الوطن أكثر من الغير.. فمن يتبنى استراتيجية النضال الديموقراطي ليس كمن ينشد خلاص «الأمة».. صحيح أن ما يجمع بين طرفي النقيض هو طموحهما «الأممي»، لكن شتان بين غايات الأمميات الاشتراكية والشيوعية وبين أهداف ووسائل مكونات تنظيمات «الأمة» الدينية أو القومية. فهل هذا اقتناع راسخ بينهما أم مجرد حنين لـ «طوباوية» الفوضوية التي لا تعترف لا بالإله ولا بالسيد، أو لـ «أمجاد» السلف الصالح والخلافة الرشيدة؟
من هنا تأتي أهمية الوضوح الفكري الذي يحرر الثقافي من تبعيته لهيمنة السياسي، لأن المراهنة على توصيف الجهات الحاكمة على أنها «مخزن»، دون تمييز بين من يهيمن اقتصاديا وبين من يحكم سياسيا، من شأنه توليد صعوبات ومفارقات، أهمها ضياع امكانية ترتيب الأولويات والتكتيكات والتحالفات، وفرص التفكيك وإعادة التركيب بشكل واقعي وعقلاني.. فليس الغموض سوى إحدى وسائل القمع الايديولوجي التي تشرع للعنف والتعسف في استعمال القوة والسلطة والقانون باسم الشرعية الدينية أو الضرورة «التاريخية» للدولة كجهاز وكطبقة، تماهيا واندماجا، مما يكرس الوهم باستحالة تحولها وتحديثها بعلة أن طبيعتها «مخزنية» تصنع «المخزن» وتعيد إنتاجه وتنميه بصفة مستدامة .
هذا المفهوم الذي سيظل، عبر التمثلات نفسها، يوحي بتماهي الوطن مع النظام السياسي ومع الدولة نفسها، فيتحول «الشعب» أقلية ويظل الاستيلاب عالقا يكرس منطق الغلبة، ونصير جميعا ضحايا الوهم بضرورة التنازل عن مطلب دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع، مادام المنطق الصوري يقتضي أن نتمثل بأن الديموقراطية اللبرالية، كوصفة سحرية هي حكم الأغلبية.
وحسبي أكرر، بحماس فائض، مع القائلين «عاش الشعب» لأن مفهوم الشعب مات، وينبغي أن نعدم معه مفهوم المخزن الذي مازال يعشعش في العقليات.. وما أعظم أن نحرص على حياة الوطن كواقع وليس كأحلام أو رؤيا تؤسس لثورة حمراء متماهية مع قومة خضراء، يتهيأ لبعض راديكاليينا أنها مجرد تاكتيك، والحال أن "اللي فراس الجمل فراس الجمال...".