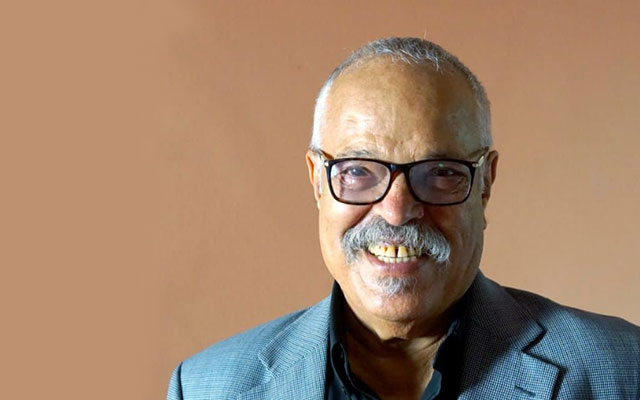إن المثابرة على إقامة الصلوات المكتوبة باتت من الأمور الثقيلة على النفوس، ومما يزيد في ثقلها البعد عن محفزاتها كمجالس الوعظ الديني، والتي تعتبر من أهم مصادر التغذية الروحية، ومحطات أساسية للتزود بالطاقة الإيمانية، لمواجهة الإكراهات المادية والتدافعات المعاشية، ومما يساعد على هذه التربية الجلوس بين يدي العلماء للتعلم والتخلق واكتساب المزيد من الفضائل في أحضان هذه المجالس، وخصوصا خطبة الجمعة لما لها من مهابة وقدسية في قلوب المغاربة، يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سورة الجمعة 9-10، هذا نداء رباني لجني الخير بعيدا عن سوق المال والأعمال بأقل التكاليف مقابل ساعة من نهار، ولعل الراحة النفسية والطمأنينة القلبية أصبحت منتجا نفيسا وترياقا لكل الأدواء تلاقي إقبالا عالميا بأغلى الاثمان.
فهل حقق هذا النداء الرباني غايته ومقصده؟ وهل كان علماؤنا وخطباء المنابر عند الموعد المحدد؟ أم أن صلاة الجمعة وخطبتها زادتا على النفوس ثقلا على ثقل؟
يلاحظ على غالبية المقبلين لأداء صلاة الجمعة عزوفا رغم الحرص على حضورها، فهم بين الخوف من تركها لاعتقادهم بوجوبها، وامتعاضهم من الخواء العلمي والروحي الذي يتلقاه من الخطبة والخطيب كل أسبوع علاوة على ضيق الوقت، إذ لا يكفي للصلاة وتناول وجبة الغذاء ثم الرجوع إلى العمل، روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من ترك ثلاثَ جُمَعٍ تهاوناً من غير عُذر، طبع الله على قلبه) وفي رواية (فهو منافق)، ولا أجازف حين أعترف أنني لا أجد روح وعظمة يوم الجمعة على المنابر، وأن هناك انقطاعا وجدانيا وتنافرا نفسيا بين الخطيب والمخاطبين وحضورا جسديا وغيابا ذهنيا للمصلين مع توافر الشروط الشرعية كاملة، ولعلي لا أجازف أيضا حين أقول ولا أفتي أنه لا جمعة لمن كانت هذه حالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى في هذه النازلة بقوله: (ومن لغى فلا جمعة له)، فاللغو كل كلام أو فعل خارج عن مقاصد إقامة صلاة الجمعة، وعلى هذا الأساس فإن الخطيب يعتبر أول لاغ ومسبب للغو بما يطرحه من مواضيع سئم المصلون منها، أو لا تمت لهم بأدنى هم لمعاشهم اليومي ولا يجدون فيها ضالتهم الدنيوية قبل الأخروية ناهيك عن ركاكة الخطبة ولحن اللسان، أو مواضيع يكرهون الإنصات إليها بتاتا لما يعتريها من كذب وتضليل وزيف للحقائق، خصوصا إذا كانت خطبة معممة أو أمرا مخزنيا، والحال أن الواقع الذي يعيشه الناس صباح مساء يكذب مقاله، فيزداد الخطيب مقتا على مقت وخزيا على خزي بالإعلان عن نفاقه ومحاباته للباطل ومجانبة الحق، ولولا بقية باقية لحرمة المسجد لرجمه الناس بالأحذية ولا يبالون، ولم لا يفعلون؟ وقد رُجم بحصى المسجدِ من هم أعلى شأنا وعلما.
يقولون "فاقد الشيء لا يعطيه" فهل حقيقةً أن وزارة الأوقاف المغربية فاقدة بالمعنى العلمي والأصولي لمقاصد خطبة الجمعة؟ خصوصا إذا علمنا أن وزيرها من مريدي الزوايا الطرقية، وهذه لا يأتي منها إلا كل الضلالات والبدع والمنكرات، وهل تسعى حقيقة إلى تنوير المغاربة بدنيا الصدق والدين الصحيح؟ أم هي تربية المغاربة على النهج المخزني عبر بوق الجمعة؟ علما أنها تملك من الكنوز ما لا يخطر على بال للهدم أو البناء، فإننا لا نكاد نعثر على عالم أو خطيب ذي همة عالية يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، معدودون على رؤوس الأصابع من يقفون على المنابر بالعلم والفصاحة، مستلهمين الأمة بالحق، ولكن في حدود السلوك والمعاملات أما التنديد بالهمجية التي ينهجها المخزن في حق المواطنين فهم بكم عمي، وما مجزرة الأساتذة المتدربين عنا ببعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم) صححه الألباني.
ولقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم إقامة صلاة الجمعة وخطبتها بنفسه، لمكانتها وتأثيرها البليغ في النفوس وكذلك فعل الخلفاء والأمراء من بعده حتى عهد قريب، ذلك لأنها موعد تنتعش فيه القلوب وتحيى فيه النفوس بالتذكرة والموعظة الحسنة، وتجديدا للعهد بين العبد وربه والحاكم وشعبه أمرا بالمعروف بما يرضي الله ويخدم مصلحة الناس في قضاياهم الملحة بالرفع من المستوى العلمي والمعرفي وبسط سبل الرخاء والعيش الكريم، ونهيا عن منكرات وتجاوزات الحكام والوزراء والخائنين لثقة المواطنين، قال تعالى: (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) سورة هود 117.