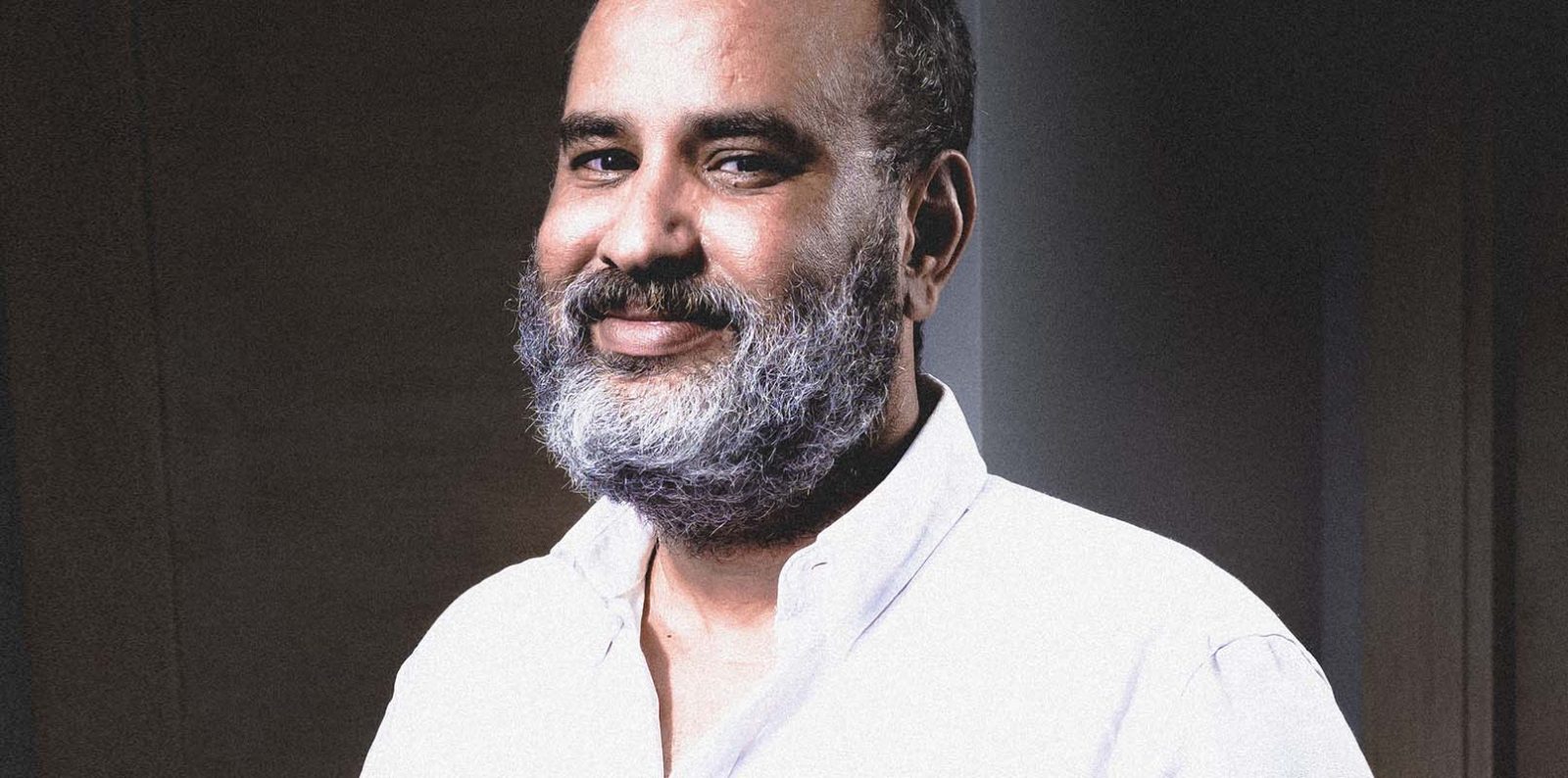أولا: عندما قرر المجلس الدستوري، رفض جزء كبير من التوافق السياسي، بين مختلف الأطراف الواسعة حول مدونة الانتخابات، لم يكن أمام شكلانية دستورية فقط، بل تعداها إلى ما هو أعمق في اللعبة الديمقراطية برمتها…، أي إعطاء فرصة لإعادة التفكير في الزاوية التي يجب أن ندخل منها إلى مغرب ما بعد المسرح الاصطناعي..، مغرب ما بعد الترنيمات الإيجابية والاحتفالية بما تحقق في النص الدستوري، ولم يتحقق في أرضية الواقع.
فقد كشف بالتدقيق، أن النقاش الدائر حول الانتخابات، هو في أحسن حالاته مجرد محاولة عيش ديموقراطية بدون محفزات وجود كبرى!
ثانيا: لا أحد في الدولة، في الغالب منها، ولا الكيانات السياسية، تدرك بأن فتح اللوائح الانتخابية مثلا أو التقييد فيها من جديد، بكل مبررات النجاعة التي تسوقها، لن يتعدى التفكير في العض على الشكل الديمقراطي بنواجذ.. مسروقة!!....
ومبررات الفاعلين الرسميين في ذلك، لا تعدو أن تكون محاولة غير موفقة في الهروب من مبررات أكثر قوة، رفضتها الدولة، في اعتماد البطاقة الوطنية ولا يمكن تعويضها بمحاولات عيش متعددة حول فتح التسجيل الانتخابي من جديد ، بدون مبرر معقول: هل توصلت الدولة بطلبات كثيرة لمغاربة منعوا أو أنهم محرمون من هذا الحق؟
هل يثبت أن المطلوب هو إعادة التسجيل بعد كارثة ما أو توزيع جديد للعمل الديمقراطي بين مكونات المشهد الوطني، يجعل فريقا سياسيا جديدا كان يقاطع قد أعلن مشاركته مثلا؟ …
لا أحد يمكنه أن يجيب بالإيجاب.. وبالتالي فلا أحد يمكنه أن يستخرج من السياسة الوطنية اليوم، ما قد يشجع على بناء الثقة في المستقبل… وفي السياسة الآن!
فالظاهرة التي تهيمن هي تلك التي تنادي بتجريب الفراغ، كحل للإقامة في الحقل السياسي وهي، إما التفرغ للدعوات الجهادية، بإسلام يسير نحو الراديكالية أو التفرغ لهواجس اليومي بعيدا عن السياسة، بمعنى آخر، تجريب طريق موت السياسة ورفض التجربة الديمقراطية كطريق نحو التطرف..
ثالثا:لا أحد يفكر، من مختلف الضفاف السياسية الآن في مركز القرار، يفكر بأن النقاش العمومي بإمكانه إنقاذ الممارسة والانشغال بها، بعد أن ساد الشعور بأنها مسرح اصطناعي، أو أنه الدليل على أن الناس لا يشعرون بأن التصويت هو إثبات جدارة ديمقراطية عبر ممارسة المواطنة، وأنه، باستقراء ما يدور حول احتمالات الفعل الانتخابي، لن يحظوا بأي امتياز ديمقراطي لأنه لن تعطي أية دلالة لتصويتهم، ولهذا لا يهتمون بها بتاتا، أو يتأكد لهم ، بعد التنشيط المدني المفرط الحاصل اليوم، أن الانتخابات لم تعد الشكل الأرقي للالتزام السياسي..!
الشكل الذي اختاره المواطنون في السياسة هو، إما التفرغ للجانبي والهامشي أو التطرف الداعشي..
رابعا: الشكل الراديكالي الكامل الذي تقدمه داعش، ليس زندقة تاريخية أو أمنية، هذا ما يجب أن نتعامل به، بل هو النموذج الحاضر بغياب النماذج الأخرى.. حتى في الديمقراطيات الكبرى نفسها، هناك نقاش من صميم استقراء هذا الغياب، (ففي فرنسا مثلا يتكلم أهل الحل والعقد الديمقراطي والاجتماعي عن الداعشية باعتبارها النموذج الأكثر تبلورا في بناء التجدر، في رفض النموذج الجمهوري..).
خامسا: الحزب الرئيسي، الذي ينهل من المرجعية التي يعلن الآخرون مثله الانتماء إليها، لم يقدم عرضا سياسيا يغري بالمشاركة: العدل والإحسان عادت إلى رفض اللعبة كليا، عندما أعلنت منذ أسبوعين تقريبا أن الحل الداخلي لم يعد مفيدا للغاية، وبالتالي ارتفعت حتى عن السقف الذي سبق لها الإعلان عن العمل من تحته في 20 فبراير …
في الحديث الذي تحدث به رئيس الحكومة، والذي نشرته مواقع عديدة (منها هسبريس) تحيين لكلماته عن «الدكتاتورية» واستعمال الدولة لبسط الدكتاتورية.. وهو ما يخرج الزمن السياسي من اللحظة المعبئة للديمقراطية إلى لحظة «نومانز لاند» يبحث فيها كل عن جواب على هذه الدكتاتورية القادمة!
ولا أحد يعدل تاريخ البلدان المهددة بالدكتاتورية بميزان الاقتراع!
سادسا: الداعشي يقطع الرأس، لكن المفسد السياسي الذي نتعايش معه، للأسف في لحظات الارتباك الديمقراطي، يتركها بين الكتفين ويفسدها ويقطع عنها كهرباء الأفكار النيرة ومياه الروح العصرية.. وهو الجو الذي انخرطنا فيه، بنوع من التعايش المريب، بين انتشار أساليب الماضي الفاسدة، في هذه الفترة السابقة للانتخابات والتطبيع مع مبررات الإغراء عبر الموائد، وذلك بمغربة شعار (الصوت مقابل الغذاء)، في لحظة حصار بائد ضد الناخبين وضد القوى التي ما زالت تؤمن بالسياسة (.. إلى متى؟) في تنظيم العلاقات بين الناس والمؤسسات، وفي تحديد رؤيتهم للعالم.
سابعا: في النظام السياسي، تكون كتابة الدستور، الاكتمال السعيد لمفهوم الحرية، والتي يمكن أن نقول عنها - باستعارة ستيفان دوايي (من جامعة باريس الثامنة، مختبر الدراسات والأبحاث الوارد في كتاب اليقظة الديمقراطية لعلي بنمخلوف) أنها تسبح في "الفُرْشة الدستورية".
ما يحدث أننا نكتب واقعا آخر على هامش الدستور، واقع يتجاوزه إلى.. ما سبقه!
ولهذا يبدو من التدوينات السبع السابقة أننا في محاولة عيش ديمقراطية ليس إلا!