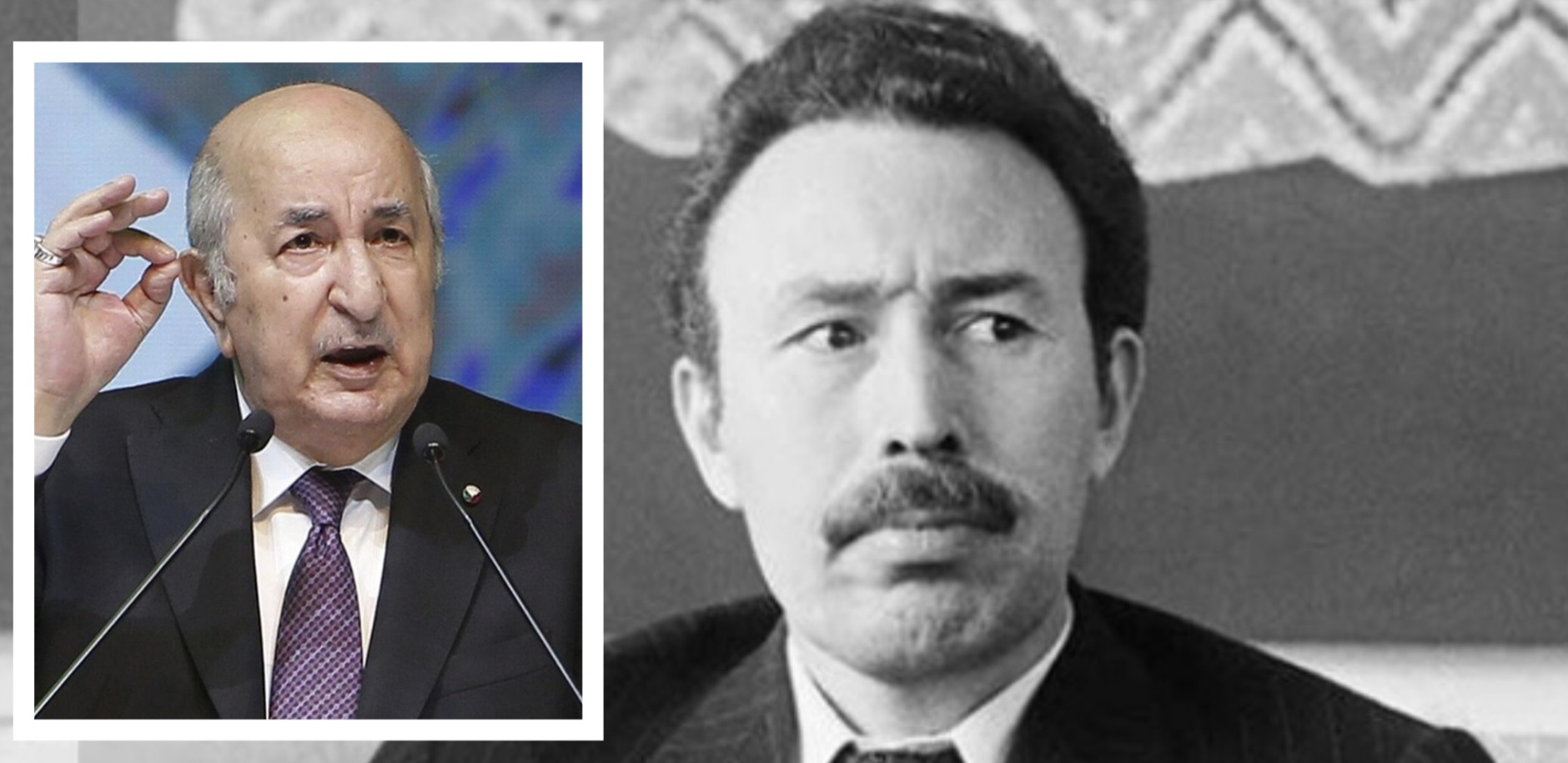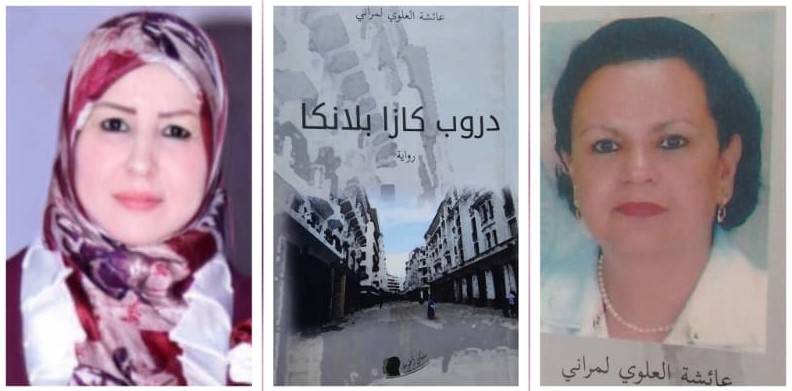يشهد المغرب منذ بداية الألفية الثالثة تحولًا بنيويًا عميقًا في فلسفة التنمية، انتقل فيه من منطق تدبيرٍ عموديٍّ تقوده الدولة المركزية إلى منطق التنمية المندمجة والمجالية التي تضع الإنسان والمجتمع المحلي في قلب الاهتمام.
لقد أدركت الدولة، بعد عقود من السياسات القطاعية المتفرقة، أن التنمية الحقيقية لا تتحقق فقط عبر البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الكبرى، بل عبر الاستثمار في الإنسان باعتباره فاعلًا وشريكًا لا مجرد مستفيد.
هذا التحول لم يكن عفويًا، بل جاء نتيجة تراكم تجارب وطنية ودولية، ووعيٍ متزايد بأن نجاح أي نموذج تنموي رهين بمدى انخراط الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في بلورته وتنفيذه.
وقد تجسدت هذه المقاربة الجديدة من خلال برامج الجيل الجديد للتنمية التي أرست أسس نموذج تشاركي أكثر انفتاحًا ومرونة، من أبرزها:
المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2025 التي انتقلت من منطق الدعم الاجتماعي المباشر إلى منطق الاستثمار في الطفولة والشباب والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي ربطت بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية.
البرامج الجهوية والمجالية للتنمية، التي كرّست دور الجهات والجماعات الترابية باعتبارها فاعلًا رئيسيًا في التنمية الترابية.
وأخيرًا النموذج التنموي الجديد 2021، الذي شكّل محطة تأسيسية لإعادة تعريف التنمية كـ"مشروع مجتمعي مشترك" يقوم على القيمة المضافة للإنسان، وعلى إشراك المجتمع المدني كمكوّن بنيوي في هندسة التنمية.
في هذا الإطار، لم تعد التنمية تُقاس فقط بمؤشرات النمو الاقتصادي أو بالبنيات التحتية المنجزة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدولة والمجتمع على تعبئة الرأسمال البشري والاجتماعي والثقافي، وعلى ترسيخ الثقة والمشاركة والمسؤولية المشتركة.
وبذلك، تحوّل الفعل الجمعوي من مجرد أداة تنفيذية أو قناة للتمويل إلى فاعل استراتيجي في هندسة التحولات الاجتماعية والتنموية مدعوٍّ إلى أن يكون همزة وصل بين الدولة والمجتمع، ومختبرًا محليًا للابتكار الاجتماعي، وضمانة لمواطنة فعّالة تُترجم مبادئ العدالة والكرامة والتنمية المستدامة إلى واقع ملموس.
من الفاعل المساعد إلى الشريك المواطِن
لم يعد يُنظر إلى المجتمع المدني المغربي كمجرّد وسيط اجتماعي أو منفّذ لمشاريع جاهزة تُصاغ في المكاتب المركزية، بل أصبح يُعترف له بدور فاعل استراتيجي في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الترابية والمجالية.
إن هذا التحول يعكس وعيًا جديدًا لدى الدولة والمجتمع معًا، مفاده أن التنمية الحقيقية لا تُبنى من الأعلى، بل من القاعدة وأن نجاح أي برنامج تنموي يظل رهينًا بمدى مشاركة الفاعلين المحليين وقدرتهم على تحويل الاحتياجات المجتمعية إلى حلول واقعية.
في هذا السياق، تتجلى مساهمة المجتمع المدني في مجموعة من الأدوار الحيوية تشخيص الحاجيات المحلية والمجتمعية عبر آليات المشاركة المواطِنة، التي تمكّنه من نقل صوت الساكنة ومطالبها إلى صانع القرار الترابي
تعبئة الفئات الهشة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية من خلال خلق قنوات تواصل وتعاون قائمة على الثقة والمسؤولية المشتركة.
ابتكار حلول اجتماعية واقتصادية جديدة تُجسّد مفهوم "الابتكار الاجتماعي" الذي يُعتبر من ركائز التنمية المعاصرة؛
ممارسة التقييم المواطِن ومتابعة الأثر الاجتماعي للبرامج العمومية، بما يجعل منه قوة اقتراح ومساءلة، تراقب وتصحّح المسار لا أن تكتفي بالتنفيذ.
إنه انتقال جوهري من منطق الإحسان والمواسم والمشاريع الظرفية إلى منطق التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية المُمأسسة، التي تقوم على المشاركة الفعلية لا الرمزية، وعلى مبدأ "الحق في التنمية" باعتباره مسؤولية جماعية.
بهذا المعنى، لم يعد المجتمع المدني مجرد فاعل مساعد أو وسيط إداري، بل شريك مواطِن في هندسة التنمية المحلية يواكب الدولة في التخطيط، ويبتكر في الميدان ويُقيّم السياسات بعيون المواطن ومن هنا تنبع الحاجة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني على أساس الثقة والتكامل والندية في الأدوار لا على أساس التبعية أو التوظيف الظرفي.
الجاهزية: بين التراكم والقصور
لا يمكن إنكار أن المجتمع المدني المغربي راكم خلال العقدين الأخيرين رصيدًا معتبرًا من التجارب والخبرات، خاصة منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 التي فتحت أمام الجمعيات فضاءات جديدة للمشاركة والممارسة وأحدثت وعيًا جماعيًا بدور الفعل الجمعوي في محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الاندماج الاجتماعي وقد مكّن هذا المسار من بروز جيل جديد من الفاعلين الجمعويين واكتساب مهارات في التدبير وتنشيط المشاريع وتوسيع مجالات الاشتغال لتشمل الطفولة، والمرأة، والبيئة، والاقتصاد الاجتماعي، والتربية غير النظامية غير أن هذا التراكم الكمي والنوعي لا يعني بالضرورة جاهزية مؤسساتية كاملة لمواكبة رهانات التنمية الجديدة إذ ما تزال العديد من الجمعيات تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها، أبرزها:
ضعف الحكامة الداخلية والتدبير المالي والإداري، حيث تغيب لدى عدد من الجمعيات آليات المراقبة، والشفافية والتقارير المحاسباتية الدقيقة.
قصور في القدرة على إعداد المشاريع وتتبعها وتقييم أثرها، مما يجعل بعض المبادرات تظل آنية أو معزولة عن دينامية التنمية الترابية.
تأخر في مواكبة التحول الرقمي والابتكار الاجتماعي، وهو ما يحدّ من تفاعلها مع التحولات التكنولوجية ومتطلبات العصر.
غياب تموقع استراتيجي واضح داخل المنظومة الترابية، إذ تظل العلاقة مع الجماعات الترابية أو الفاعلين العموميين قائمة في كثير من الأحيان على منطق الطلب لا الشراكة.
ويُظهر الواقع الميداني أن النسيج الجمعوي المغربي غير متجانس فإلى جانب عدد محدود من الجمعيات المهيكلة والمؤهلة التي تمتلك كفاءات وخططًا استراتيجية قادرة على مواكبة التحولات التنموية، توجد أغلبية واسعة من الجمعيات تشتغل في حدود ضيقة وبإمكانات محدودة، يغلب عليها الطابع العفوي، وتفتقر إلى التأطير المستمر والدعم المؤسسي الكافي.
إن هذه المفارقة بين غنى التجربة وضعف الجاهزية تشكّل أحد التحديات الكبرى أمام المجتمع المدني المغربي في المرحلة الراهنة فهي تعكس الحاجة إلى انتقال نوعي من التراكم الكمي إلى النضج المؤسسي، ومن العمل التطوعي المتقطع إلى الفعل التنموي المنظم والمستدام.
إشكالية الاستقلالية والمصداقية
تُعدّ مسألة الاستقلالية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني المغربي في سعيه نحو أداء أدواره التنموية والتأطيرية بفعالية ومصداقية.
فرغم توسّع فضاءات المشاركة المدنية وتكريس دستور 2011 لمبدأ الديمقراطية التشاركية ما زال جزء من النسيج الجمعوي يواجه إشكالات بنيوية ترتبط بطبيعة علاقته بالسلطة والفاعلين السياسيين تتجلّى هذه الإشكالية في عدة مظاهر، من بينها:
تبعية بعض الجمعيات للمؤسسات الرسمية أو للأحزاب السياسية، إما من خلال التمويل أو التوجيه أو الولاء التنظيمي، وهو ما يُفقدها استقلال القرار والموقف.
تداخل الأدوار بين الفعل الجمعوي والممارسة السياسية، بحيث يُستعمل العمل الجمعوي أحيانًا كامتداد للنشاط الحزبي أو كأداة انتخابية، مما يُضعف الثقة في الفعل المدني ويشوّش على رسالته المجتمعية.
ضعف ثقافة التقييم الذاتي والشفافية، إذ لا تزال بعض الجمعيات تفتقر إلى آليات داخلية للمساءلة والتقويم، وإلى نشر تقارير مالية وأخلاقية تعزز الثقة مع المواطنين والمانحين على السواء.
إنّ هذا الوضع يحول دون قيام المجتمع المدني بدوره كـ قوة اقتراح ونقد وترافع مستقل، ويجعله في حالات عديدة مجرد منفّذ للبرامج العمومية بدل أن يكون شريكًا حقيقيًا في صياغتها ومتابعتها.
فحين تفقد الجمعيات استقلالها، تفقد في الوقت نفسه قدرتها على الترافع باسم المجتمع، وتتحول من فاعل مواطِن إلى وسيط إداري أو امتداد بيروقراطي، مما يفرغ المشاركة المدنية من مضمونها الديمقراطي.
ومن ثَمّ فإن استعادة المصداقية تمرّ عبر تحصين الفعل الجمعوي من التوظيف السياسي أو الإداري وتكريس قيم الاستقلال والشفافية والمسؤولية كمرتكزات للعمل المدني الحديث.
فالمجتمع المدني لا يمكن أن يكتسب مكانته داخل المشروع التنموي الجديد إلا إذا كان حرّ الإرادة، صادق التمثيل، ووفيًّا لقضايا المجتمع أكثر من ارتباطه بمصادر التمويل أو حسابات السياسة.
فرص التحول والتمكين
رغم الصعوبات البنيوية التي ما زالت تعيق أداء المجتمع المدني فإن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموقعه داخل مشروع التنمية الجديد للمغرب فالسياق الوطني يعرف اليوم تحولات عميقة على المستويات المؤسساتية والتقنية والمجتمعية، تفتح أمام الفاعلين المدنيين آفاقًا غير مسبوقة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم أثرها فالنموذج التنموي الجديد قد أعاد الاعتبار لدور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعا صراحة إلى تعبئة الذكاء الجماعي ومختلف أشكال الرأسمال الاجتماعي لخدمة الصالح العام.
كما أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية منحت فضاءات قانونية ومؤسساتية لممارسة الديمقراطية التشاركية عبر آليات مثل العرائض والملتمسات وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مما يتيح للمجتمع المدني الانتقال من منطق الفعل الإحساني إلى منطق التأثير في القرار العمومي المحلي إلى جانب ذلك تفتح دينامية الرقمنة والابتكار الاجتماعي أمام الجمعيات إمكانيات جديدة للتواصل، والتعبئة، وجمع المعطيات، وتقييم الأثر، وإطلاق مبادرات مواطِنة تعتمد حلولًا رقمية ومفتوحة، مما يعزز حضورها داخل الفضاء العمومي الافتراضي والفعلي.
وبذلك، يمكن القول إن الفاعل الجمعوي اليوم أمام منعطف استراتيجي يسمح له بأن يتحول إلى مختبر محلي للمبادرات المواطِنة وإلى وسيط اجتماعي جديد يسهم في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، ويدعم الانتقال نحو نموذج تنموي قائم على المشاركة والابتكار والمسؤولية المشتركة.
شروط الارتقاء والجاهزية
لكي يرتقي المجتمع المدني المغربي إلى مستوى طموحات التنمية الجديدة، فهو مدعوّ إلى مراجعة ذاته وتجديد أدوات اشتغاله بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتطلب ذلك العمل على جملة من التحولات الجوهرية، من أبرزها:
إعادة بناء الكفاءات البشرية والمؤسساتية من خلال التكوين المستمر، وتأهيل القيادات الجمعوية القادرة على فهم رهانات التنمية الترابية والمجالية.
اعتماد الحكامة والشفافية كقيم موجهة لكل الممارسات التدبيرية والمالية، بما يعزز المصداقية والثقة لدى الشركاء والمواطنين.
تطوير آليات التقييم وقياس الأثر الاجتماعي لضمان فعالية المشاريع وربطها بالأهداف التنموية الحقيقية لا بمجرد الأنشطة الظرفية.
العمل في إطار شبكات وتحالفات لتوحيد الجهود والموارد، وتقوية الترافع الجماعي حول القضايا ذات البعد الوطني والمجالي.
ترسيخ الاستقلالية عن أي وصاية سياسية أو إدارية، بما يمكن الفعل الجمعوي من القيام بدوره النقدي والاقتراحي بحرية ومسؤولية.
فمن دون هذه التحولات، سيظل المجتمع المدني فاعلًا محدود الأثر في معادلة التنمية بدل أن يكون شريكًا استراتيجيًا في صياغة مستقبل البلاد.
خاتمة واستشراف
يقف المجتمع المدني المغربي اليوم على عتبة مرحلة مفصلية في مسار التنمية الوطنية فهو أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يستثمر تراكماته المعرفية والتنظيمية ويجدد أدوات اشتغاله ليصبح فاعلًا استراتيجيًا في تنزيل النموذج التنموي الجديد وإما أن يظل أسير حدود موسميته وضعف جاهزيته المؤسسية والتنظيمية.
إنّ الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من “المجتمع المدني المساعد” إلى “المجتمع المدني الفاعل والمبادر” القادر على الجمع بين روح المواطنة وفعالية التدبير، وبين الترافع من أجل الحقوق والمشاركة في تحقيق التنمية.
فالتنمية اليوم لم تعد مجرّد أوراش مادية أو برامج اجتماعية، بل هي مشروع مجتمعي متكامل يقوم على تعبئة الرأسمال البشري والاجتماعي، وعلى إشراك المواطن كقوة اقتراح ومساءلة وتقييم ومن ثَمّ، فإنّ مستقبل المغرب التنموي رهين بمدى قدرة المجتمع المدني على تحويل رصيده التراكمي إلى طاقة اقتراحية مؤثرة، وعلى ترسيخ موقعه كأحد أعمدة الدولة الاجتماعية الحديثة.