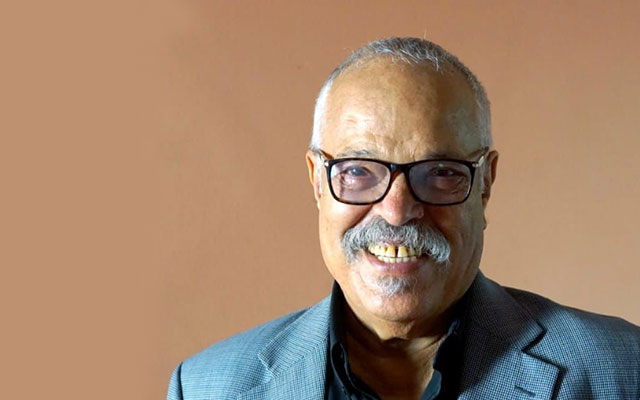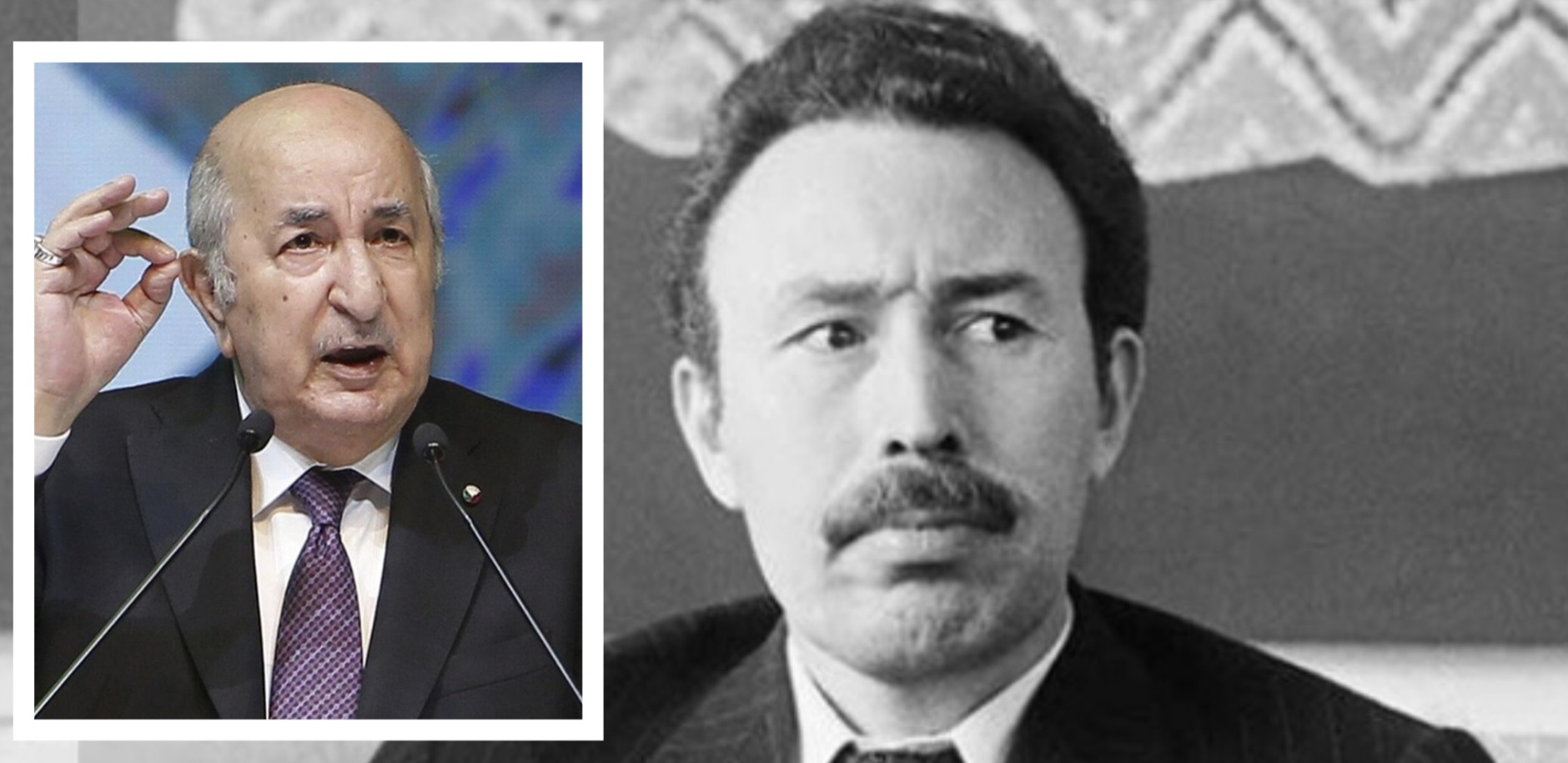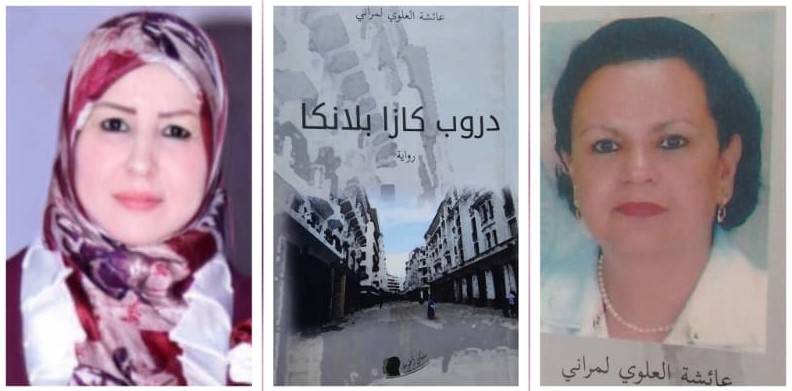بين التزام المؤسسة ونشر الفكر الحر
بعد مضي ما يقرب من الشهر على رفض جان بول سارتر جائزة نوبل للآداب سنة 1964، نشر جيل دولوز مقالا في مجلة "فنون" Arts تحت عنوان "كان معلمي".
لا يهمنا من مقال الفيلسوف الفرنسي حماسته إزاء موقف "معلمه"، ونعته رفض الجائزة بأنه "خبر سار"، كما لا تعنينا أساسا سخريته من أولئك الذين حاولوا "حمل سارتر على التناقض، وتذكيره بأن نجاحه، على كل حال، إنما كان وسيبقى بورجوازيا"، مشيرين إلى "أن رفضه ليس أمرا عاقلا ولا راشدا"، مقترحين عليه "أن يحذو حذو من يقبلون-وهم-يرفضون، حتى لو كلف ذلك وضع المال ضمن أعمال خيرية"، كما أننا لن نقف مطولا عند حماسة دولوز الشديدة لكون معلمه "لم يقبل-وهو-يرفض"، مما دفعه إلى أن يسجل مهللا: "وأخيرا، ها هو من لا يحاول أن يبرر أنها مفارقة لذيذة للكاتب، والمفكر حر، في أن يقبل التشريفات والتمثيلات العمومية".
المفكر الحر
ما يهمنا في نص دولوز أساسا تمييزه بين ما يطلق عليه "المعلم" أو "المفكر الحر"، وما يدعوه "الأستاذ العمومي". يبدأ المقال بهذا التمييز: "ليس معلمونا هم الأساتذة العموميون فحسب، على ما بنا من حاجة ماسة إلى أساتذة. إذ حين نبلغ سن الرجال، يكون معلمونا أولئك الذين يبهروننا بجدة جذرية، أولئك الذين يعرفون كيف يبدعون تقنية فنية أو أدبية، ويجدون طرق التفكير المناسبة لحداثتنا، أعني لصعوباتنا كما لحماستنا المتدفقة".
بينما يكتفي الأساتذة العموميون، بما هم أساتذة، بأن يفتحوا لنا أبواب "المعرفة" الفلسفية، ويحيطونا علما بتياراتها المتشعبة، ومدارسها المتعددة، وقضاياها الشائكة، فإن المعلمين الأحرار يعلموننا كل جديد، يعلموننا طرقا جديدة في التفكير، إنهم أولئك الذين يواكبون كل تحديث، بل يساهمون في إرساء أسس التحديث نفسه. هم معلمون كبار لا بما يعرفونه، بل ربما بما لا يعرفون. إنهم أولئك الذين يهزونك ويدفعونك إلى التفكير معهم والتفكير بهم، فلا تكف عن العودة اللامتناهية إلى نصوصهم التي تخرج منها كل مرة على غير النحو الذي دخلت به.
يسوق دولوز نموذجين عن هؤلاء المعلمين والأساتذة: نموذج سارتر نفسه، ثم نموذج ميرلوبونتي: لا جدال في مقدرة صاحب "فينومينولوجيا الإدراك" و"المرئي واللامرئي" وكفاءته كأستاذ، تلك الكفاءة التي خولته التدريس في الكوليج دو فرانس، لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الذي أداه في تنشئة أجيال من فلاسفة فرنسا، والمكانة التي تبوأها في انفتاحه على هوسرل ومحاورة الماركسيين. لكن، "مهما كانت أعمال ميرلوبونتي لامعة وعميقة، فهي كانت تحمل صبغة الأستاذ، كما كانت تابعة لأعمال سارتر من أوجه عدة".
ربما لم يكن سارتر أستاذا ناجحا، وربما لم يكن اطلاعه على تاريخ الفلسفة في مستوى مجايليه من أساتذة الجامعة الفرنسية، بل إن رفيقة دربه تشهد على عدم اطلاعه الكافي لا على فرويد، ولا على نيتشه. إلا أن كل ذلك لم يحل بينه وبين أن يتصدر الساحة الثقافية الفرنسية، حتى لا نقول الأوروبية وقتئذ. ربما كان ذلك بالضبط لكونه لم يكن أستاذا فحسب، بل كان أكثر من أستاذ: كان "معلما" على يده تم كل تجديد: فـ"ما كان يأتي من سارتر إنما هو الموضوعات الجديدة، وشيء من الأسلوب الجديد، وطريقة جدال جديدة وشرسة في طرح المشاكل".
لا يعني هذا إنقاصا من قيمة "الفيلسوف الأستاذ"، إذ أن الأمر في النهاية كان يتم على نحو ما تم به بين سارتر وميرلوبونتي، فالطلبة كما قال دولوز: "لا يستمعون جيدا إلى أساتذتهم إلا حين يكون لهم أيضا معلمون آخرون". فكأن المعلم هو دائما بمثابة سقراط قبل أكاديمية أفلاطون، وخارجها، وتمهيدا لها.
بين سارتر وميرلوبونتي
يوضح دولوز فكرته هذه من طريق عقد مقارنة بين ما يدعوه وجودية سارتر وما يطلق عليه وجودية ميرلوبونتي: "كان سارتر لا يتردد في أن يشبه وجود الإنسان بالعدم الذي يميز "ثقبا" في العالم: بحيرات صغيرة من العدم، كما كان يقول. في حين أن ميرلوبونتي يعتبر أنها طيات، مجرد طيات وانثناءات. بذلك كانت تتمايز وجودية صلبة وثاقبة عن وجودية أكثر مرونة وأكثر تحفظا".
كان سارتر منبع كل اكتشاف فكري في فرنسا الحرب العالمية الثانية: "ففي خضم فوضى التحرير وآماله، اكتشفنا وأعدنا اكتشاف كل شيء: كافكا، الرواية الأميركية، هوسرل وهايدغر، تصفية الحسابات وتوضيح المواقف الذي لا ينتهي مع الماركسية، الاندفاع نحو رواية جديدة… كل شيء كان يمر عبر سارتر، ليس فقط لأنه كان يملك، بصفة الفيلسوف، عبقرية "الكل الجامع"، بل لأنه كان يعرف كيف يخترع الجديد". "إن العروض الأولى لمسرحية "الذباب"، وظهور "الوجود والعدم"، ومحاضرة "الوجودية نزعة إنسانية"، إنما كانت أحداثا كبرى: كنا نتعلم، من بعد ليال طويلة، كيف هو التماهي بين التفكير والحرية".
يعارض "المعلمون"، في وجه ما، "الأساتذة العموميين". "حتى السوربون تحتاج إلى سوربون مضادة. إن الطلبة لا يستمعون جيدا إلى أساتذتهم إلا حين يكون لهم أيضا معلمون آخرون". لعل من مثل هذا النموذج خارج السياق الفرنسي هو نيتشه، الذي جسد، في الوقت نفسه، الأستاذ مثلما جسد "المعلم". فقد كف عن أن يكون أستاذا، وعن طواعية، من أجل أن يصبح "مفكرا حرا": ذلك شأن سارتر أيضا، لكن، في سياق آخر، وظروف أخرى.
للمعلمين خاصيتان: نوع من الاعتزال الذي لا ينفك يلازمهم، ولكن أيضا شيء من الاضطراب، شيء من فوضى العالم حيث ينبجسون، ومن خلاله يتكلمون. "يحتاج المفكر الحر إلى عالم ينطوي على حد أدنى من الفوضى، حتى وإن كان أملا ثوريا، بذرة من ثورة دائمة. ثمة، لدى سارتر، شيء مثل تعلق خاص بالتحرير، بالآمال الخائبة لهذه اللحظة".
فوضى بيداغوجية
لا ينبغي أن نفهم من كلمة "فوضى" هنا تذكيرا بالنزعة الفوضوية التي نعت بها سارتر، وإنما هي هنا أقرب إلى الفوضى "البيداغوجية"، أعني عدم تقيد "المعلم" بقواعد تعليمية مدرسية أقرب إلى روح "الكتب المدرسية" التي تحرص على الإلمام المستوفي بتاريخ الفلسفة، فتحول الفلسفة إلى "معرفة"، وتتعامل مع أعلامها ومتونها بنوع من التقديس، فتغلق على نفسها أبواب الانفتاح والتجديد.
في حواره مع كلير بارني في ما بعد، سيعود دولوز للدور الذي لعبه سارتر فيقول: "في فترة تحرير باريس، ظللنا سجناء تاريخ الفلسفة. كنا نكتفي باقتحام هيغل وهوسرل وهايدغر. كنا، ككلاب صغيرة، نتهافت وراء نزعة سكولائية مدرسية أدهى من تلك التي عرفتها القرون الوسطى. ومن حسن الحظ أن كان هناك سارتر. كان سارتر يمثل "خارجنا"، كان بحق مجرى الهواء في الفناء الخلفي. من بين كل الاحتمالات التي تتمخض عنها السوربون، كان هو من يشكل التوليفة الوحيدة التي تمدنا بالقدرة على تحمل الترتيب الجديد للأمور. لم يكف سارتر عن أن يكون كل هذا، ليس أنموذجا، ولا منهجا أو مثالا يحتذى، ولكن نفحة هواء نقي، مجرى هواء، حتى ولو كان آتيا من مقهى فلور. إنه مثقف كان يغير بكيفية متميزة، وضعية المثقف".
سارتر يغادر مطعم "لوريونتال" في باريس يوم منحه جائزة نوبل للأدب، التي رفضها لاحقا
لا ينبغي أن نفهم هذا التغيير في معناه السياسي فحسب، وأعني علاقة الفيلسوف بالسلطات باختلاف أشكالها ومراكزها، وإنما تغيير العلاقة بالفلسفة، وعلاقة الفلسفة ذاتها بالدولة. ذلك أن هذه العلاقة لم تكن تتأتى فقط من كون معظم الفلاسفة غدوا، منذ ماض قريب، "أساتذة عموميين"، فمنشأ تلك العلاقة أبعد من ذلك: "إنها تكمن في كون الفكر صار يستمد شكله الفلسفي من الدولة كجوهر متقوقع على ذاته. إنه يبتدع دولة روحية، دولة مطلقة، دولة لا توجد في الحلم فحسب، ما دامت تعمل ذهنيا.
من هنا الأهمية التي تتخذها مفهومات الشمولية والمنهج والسؤال والجواب، والأخذ والرد، والحكم والاعتراف والأفكار الصائبة، والحرص على أن نكون دوما جهة الأفكار المحقة. من هنا أيضا الأهمية التي تتخذها موضوعات "جمهورية العقلاء"، والبحث والتقصي (شأن التقصي البوليسي) الذي يقوم به الذهن، ومحكمة العقل، و"الحق" في التفكير، مع ما يستلزمه كل ذلك من وزراء للداخلية وموظفي الفكر الخالص. لقد غمر الفلسفة سعي نحو أن تغدو لغة رسمية لدولة خالصة. وهكذا أخذ الفكر يعمل وفق أهداف دولة حقيقية، وفق دلالات سائدة، وفق متطلبات الوضع القائم". لم تعد الفلسفة إذن خاضعة للمؤسسة، بل غدت هي ذاتها مؤسسة، غدت "المؤسسة".
خارج المؤسسة
الفيلسوف "المعلم" يعمل خارج المؤسسة وضدها، بما فيها مؤسسة "تاريخ الفلسفة" أو، كما يقول دولوز، "دولة تاريخ الفلسفة". لذلك هو لا يتكلم إلا باسمه الخاص، وهو لا "يمثل" أحدا. إنه ليس صوت أحد. من هنا تلك الحركة الدؤوبة، و"تغيير المواقع"، و"الخروج" الذي لا يتوقف. "الأستاذ العمومي" يعيش مع المؤسسة تجذرها واستقرارها وطقوسها و"تقاليدها" و"برامجها" ومخططاتها، وهو حلقة في سلسلة إعادة إنتاج الثقافة، أما "المعلم" فهو "مضطرب"، متنقل رحال.
مقابل الانضباط والضبط اللذين تفرضهما "المؤسسة"، ينفتح المفكر الحر على "شيء من الاضطراب، شيء من فوضى العالم". ههنا ترفع عن أعلام تاريخ الفلسفة ومتونها كل قدسية، ولا يغدو المعلم "يمثل شيئا" على حد تعبير دولوز، أي أنه لا يكون صاحب مذهب، ولا حتى صاحب رأي، وإنما يجعل من الفلسفة تمرينا لا نهاية له على التفلسف، بل تمارين على التفكير. في هذا النوع من التفلسف لا نعود أمام التلقي والتحصيل، لا نعود أمام معلومات ومعرفة، ما يهم هو التحرر والانفتاح على الجديد، ما يهم هو "الخروج"، هو "ابتداع المسافات التي تبعد"، هو إحداث ثقب في ما يبدو ممتلئا، وفجوات في ما هو منغلق.
يسعى "الفيلسوف المعلم" إلى إنقاذ الفلسفة وإخراجها من أسوار الجامعة، بل من الأسوار على اختلاف أنواعها، حيث تغدو المعرفة عائقا ضد الفكر، بهدف إنقاذها من مرض التأويلات والشروح والتعليقات، وجرها بعيدا من التقاليد الفلسفية التي رسخها تاريخ الفلسفة بما يعطيه من قدسية للنصوص، وتقديس لأسماء الأعلام، وتأليه للمعاني، مع ما يستدعيه كل ذلك من مرور عبر "الدواخل": "دواخل" الوعي، و"دواخل" المفهوم، و"دواخل" النصوص، ودواخل الأسوار.
عن مجلة : المجلة