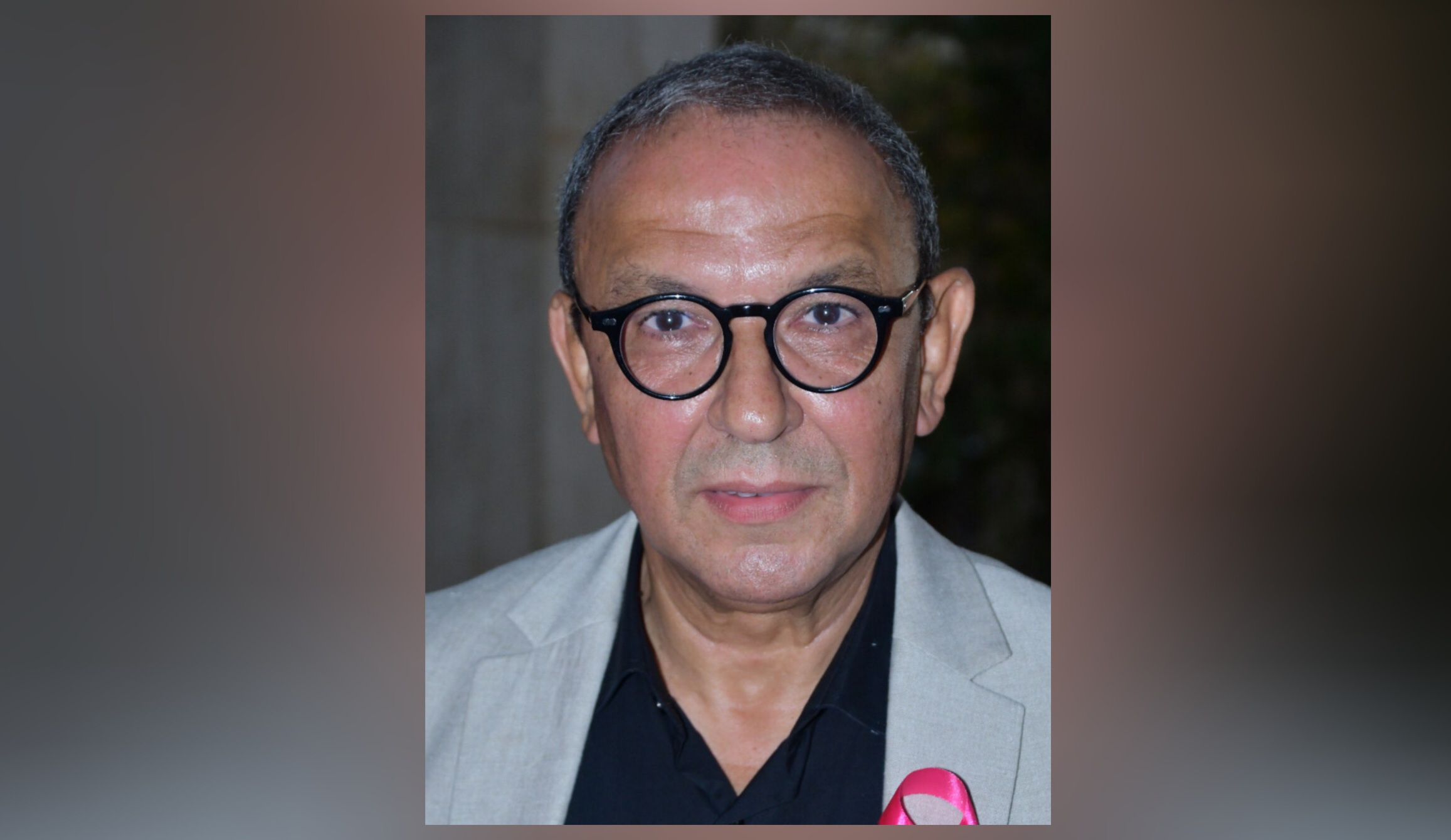تفاعلا مع السؤال البرلماني التي طرحه محمد أوزين عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول تقنين القنب الهندي بإقليم تاونات، يقدم عبد العزيز الخبشي، قراءته النقدية لهذا السؤال، مسلطًا الضوء على غياب العدالة القانونية والمادية والتجارية للمزارعين الصغار.
ويبيّن الكاتب الخبشي، كيف أن القانون الحالي لم يمكن هؤلاء الفلاحين من الاستفادة الحقيقية، بل فضّل مصالح الوسطاء والمستثمرين الكبار، مع غياب رؤية تنموية شاملة تدمج الفلاحين في سلاسل القيمة المضافة، ويطرح مقارنة مع تجارب دولية ناجحة تؤكد أهمية العدالة المجالية والاجتماعية لضمان نجاح المشروع.
ويبيّن الكاتب الخبشي، كيف أن القانون الحالي لم يمكن هؤلاء الفلاحين من الاستفادة الحقيقية، بل فضّل مصالح الوسطاء والمستثمرين الكبار، مع غياب رؤية تنموية شاملة تدمج الفلاحين في سلاسل القيمة المضافة، ويطرح مقارنة مع تجارب دولية ناجحة تؤكد أهمية العدالة المجالية والاجتماعية لضمان نجاح المشروع.
إن السؤال الكتابي الموجه من طرف النائب البرلماني محمد والزين عن حزب الحركة الشعبية، والموجه الى وزير الداخلية حول الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار بإقليم تاونات، يعيد إلى الواجهة واحدة من أعقد القضايا التي رافقت مسار تنزيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. فبينما جرى تسويق هذا القانون كمدخل تنموي شامل يهدف إلى تحسين أوضاع الفلاحين الصغار في مناطق زراعة هذه النبتة، فإن الواقع الميداني يؤكد أن النتائج لا تزال بعيدة كل البعد عن الوعود، وأن المستفيد الأكبر حتى الآن هم الوسطاء، والشركات الكبرى، والمستثمرون القادمون من خارج هذه الأقاليم، في حين ظل الفلاح البسيط في الهامش، محروماً من الحقوق التي يفترض أن تكون في صلب المشروع. إن أهمية هذا السؤال لا تكمن فقط في بعده الرقابي البرلماني، بل كذلك في كونه يعكس حجم التذمر السائد وسط المزارعين الذين كانوا ينتظرون عدالة اجتماعية ومجالية من خلال هذا الورش، فإذا بهم يصطدمون بواقع من الإقصاء والتهميش، حيث لم ينجح القانون بعد في إعادة الاعتبار لهم كفاعلين اقتصاديين أساسيين في هذه السلسلة. وهنا يمكن أن نقارن التجربة المغربية مع تجارب أخرى مثل كندا التي ربطت منذ البداية بين تقنين القنب وتوفير إطار اقتصادي يسمح لصغار المزارعين بولوج السوق، ما جعلهم شركاء فعليين بدل أن يكونوا ضحايا للقوانين الجديدة.
فالقانون، كما صيغ، قدم نفسه على أنه يفتح آفاقاً لتقنين استعمالات القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي، وهو ما يتماشى مع توجهات دولية متزايدة نحو استثمار هذه النبتة في الصناعات الدوائية والتجميلية وحتى النسيجية. غير أن ما لم تتم معالجته بالعمق هو أن الفلاح البسيط في تاونات، أو شفشاون، أو الحسيمة، ظل عاجزاً عن ولوج هذه السلاسل الصناعية بسبب تعقيد المساطر القانونية، وصعوبة الحصول على التراخيص، وكذا بسبب عدم قدرته على مواكبة شروط الإنتاج الحديث المرتبط بالمختبرات والجودة والقدرات التقنية العالية. وبدلاً من أن يصبح القانون آلية لتمكين هؤلاء المزارعين، تحول إلى أداة لخلق فجوة جديدة بينهم وبين السوق، حيث دخلت شركات قوية بخبرات مالية ولوجستية، بينما ظل الفلاح التقليدي مجرد مزود خام، محروم من فرص التثمين والتسويق التي كانت ستشكل أساس تنمية حقيقية. وإذا ما استحضرنا تجارب مثل الأوروغواي التي اعتمدت نموذجاً يضمن سيطرة الدولة على السوق وتوزيع العائدات بشكل منصف، ندرك أن المغرب اختار طريقاً مختلفاً لكنه يفتقر إلى آليات واضحة تضمن للفلاحين موقعاً عادلاً داخل السلسلة الاقتصادية.
إن ما يثير الانتباه أكثر هو أن الإقليم الذي يشكل موضوع السؤال الكتابي، أي تاونات، يعد من بين الأقاليم التي ظلت لعقود طويلة مرتبطة بزراعة القنب الهندي، لكنه ظل في الوقت ذاته خارج دائرة الاهتمام التنموي. فالمناطق الجبلية في تاونات تعاني من هشاشة بنيوية، سواء على مستوى البنية التحتية، أو على مستوى الخدمات الاجتماعية، أو حتى على مستوى الاستثمارات المنتجة. ومن ثمة، فإن تقنين القنب الهندي كان يمكن أن يشكل فرصة تاريخية لإدماج هذا الإقليم ضمن دينامية وطنية جديدة، إلا أن الواقع عاكس ذلك، إذ ظل المزارعون الصغار يشعرون بأن المشروع لم يأت ليخدمهم بقدر ما جاء ليستجيب لضغوطات دولية، أو لمصالح اقتصادية محصورة. السؤال الذي يطرحه النص البرلماني بذكاء هو: أين هي حقوق هؤلاء المزارعين القانونية والمادية والتجارية؟ وهل نحن بصدد مشروع تنموي حقيقي أم مجرد عملية لإعادة هيكلة السوق بشكل يخدم المستثمرين الكبار على حساب الفلاحين الصغار؟ إن ما يزكي هذه الشكوك هو أن مناطق أخرى في العالم حينما خاضت تجربة التقنين جعلت البنية التحتية والتنمية المحلية شرطاً أساسياً للانخراط، وهو ما لم يحدث بالقدر الكافي في حالة تاونات.
ولعل جوهر المعضلة يكمن في غياب مقاربة تنموية مندمجة. فالقانون جاء محكوماً بهاجس أمني وقانوني أكثر من كونه محكوماً برؤية تنموية عادلة. لذلك، تم التركيز على ضبط الزراعة، والتحكم في مساحات الإنتاج، وضمان توافق الاستعمالات مع التزامات المغرب الدولية، دون أن تكون هناك خطة متكاملة تضمن إدماج الفلاحين في سلاسل القيمة المضافة. كان المنتظر أن نرى تعاونيات محلية قوية، وأن يتم تمويل المزارعين بمشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على تثمين الإنتاج محلياً، وأن يتم تحفيز الشباب في هذه المناطق عبر برامج تشغيل مرتبطة بالتصنيع والتسويق. لكن ما نراه في الميدان هو أن المزارع البسيط لا يزال يبيع محصوله بأسعار زهيدة، في غياب إطار تجاري يحميه من جشع الوسطاء، وفي غياب بنية تعاونية حقيقية تمنحه القدرة التفاوضية في السوق. وتجربة كولومبيا التي حاولت إخراج المزارعين من دائرة المخدرات غير المشروعة نحو الزراعات البديلة، تبين أن غياب دعم مؤسسي قوي للتعاونيات يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الأوضاع، وهو ما يهدد بأن تعيش التجربة المغربية السيناريو ذاته.
إن السؤال البرلماني يفتح أيضاً نقاشاً حول العدالة المجالية. فبينما كان الهدف من إدماج أقاليم مثل تاونات وشفشاون والحسيمة هو تحقيق تنمية متوازنة ترفع الغبن التاريخي عن هذه المناطق، فإن ما حدث هو العكس تقريباً. إذ ظلت المناطق تعاني من نفس التهميش التنموي، وظلت الطرق والبنيات الأساسية ضعيفة، وظلت فرص الاستثمار الصناعي منعدمة تقريباً، ما يجعل الفلاحين رهائن واقع محلي فقير، حتى لو سُمح لهم بالزراعة القانونية. فالتقنين هنا لم يغير جوهر العلاقة بين الفلاح والدولة، بل على العكس، قد يكون رسخ شعوراً بأن القانون صيغ لمصلحة قوى أخرى، بينما ظل هو مجرد عنصر تابع بلا حماية حقيقية. إن مقارنة سريعة مع التجربة الإسبانية، حيث تحولت بعض المناطق الفقيرة في كاتالونيا إلى مراكز تعاونيات للقنب ذات طابع اجتماعي وقانوني، توضح أن النجاح مرهون بوجود رؤية تعطي الأولوية للعدالة المجالية، لا فقط للضبط القانوني.
ولعل أبرز نقطة تستحق التوقف هي الحقوق التجارية. فالفلاحون الصغار يفتقدون اليوم إلى أي قدرة على التفاوض المباشر مع شركات التصنيع والتسويق. إنهم ببساطة جزء من حلقة إنتاجية أدنى، يتم التحكم فيها من خلال تراخيص إدارية معقدة، ومن خلال شروط تقنية تعجيزية في أحيان كثيرة، بحيث لا يجد الفلاح أمامه سوى خيار القبول بالفتات أو الانسحاب من المشروع. هنا بالضبط تكمن خطورة الوضع: فحين يشعر المزارع أن القانون لم يمنحه الحماية التجارية المطلوبة، فإنه قد يعود إلى السوق السوداء أو الزراعات غير القانونية، مما يفرغ المشروع من أهدافه ويعيد إنتاج نفس الإشكاليات التي قيل إن القانون جاء لمعالجتها. ولعل هذا ما حاولت بعض الدول تلافيه عبر فرض أسعار دنيا لحماية المزارعين الصغار، مثلما فعلت بعض الولايات في أمريكا التي أقرت آليات لضمان استفادة المزارع من جزء من أرباح السوق.
كما أن ما يغيب تماماً عن النقاش الرسمي هو مسألة العدالة الاجتماعية. فالمزارع الصغير ليس مجرد منتج، بل هو فرد يعيش في بيئة هشة، يحتاج إلى دعم اجتماعي، وتأطير تقني، وإلى برامج تكوين، وإلى إدماج في دينامية محلية تنموية. القانون وحده لا يكفي إن لم يرافقه استثمار في الرأسمال البشري لهذه المناطق. وهذا بالضبط ما يلمح إليه السؤال الكتابي عندما يتحدث عن ضرورة بلورة مقاربة مندمجة تضع في قلبها استثمار الموارد المحلية والرأسمال البشري. غير أن المثير أن وزارة الداخلية، بوصفها الجهة الوصية، ظلت تركز على الجوانب الأمنية والإدارية، بينما غاب البعد التنموي والاجتماعي الذي كان سيشكل شرط نجاح هذا الورش. إن تجربة البرتغال في دمج مقاربة اجتماعية ضمن سياساتها المتعلقة بالمواد المخدرة قد تكون ملهمة للمغرب، لأنها أعطت الأولوية للإنسان على حساب المقاربة الزجرية وحدها.
إن التعاطي مع هذه القضية يجب أن ينتقل من مجرد مقاربة ضبطية إلى مقاربة حقوقية وتنموية. لا يمكن أن نتحدث عن مشروع استراتيجي إذا لم يكن الفلاح الصغير هو المستفيد الأول منه. ولا يمكن أن نعتبر القانون ناجحاً إذا ظلت شركات محدودة تستحوذ على سلاسل القيمة بينما ظل المزارع رهين الهشاشة. لذلك، فإن السؤال البرلماني ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو في العمق صرخة احتجاج نيابية تنقل صوت آلاف الفلاحين الذين يشعرون بأنهم خارج اللعبة. وما لم تتم معالجة هذه الإشكالات، فإن المشروع برمته مهدد بالفشل، لأنه لن يحقق العدالة الاجتماعية ولا التنمية الموعودة. وإن كان المغرب قد أراد أن يقدم للعالم تجربة متفردة في هذا المجال، فإن أي نجاح لن يكون ممكناً دون إدماج المزارع الصغير في قلب المشروع، وإلا ظل القانون مجرد غطاء تجميلي يخفي نفس التفاوتات.
وفي الأخير، يمكن القول إن ما نحتاج إليه اليوم هو إرادة سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للمزارعين الصغار باعتبارهم شركاء في التنمية، لا مجرد أدوات إنتاج خام. ويتطلب ذلك مراجعة آليات التمويل، وتبسيط المساطر، وتقوية التعاونيات، ومنح الفلاحين حماية قانونية وتجارية حقيقية، وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل الشباب المحلي، مع استثمار البنيات الأساسية في الأقاليم المعنية. وحدها هذه المقاربة المتكاملة يمكن أن تجعل من مشروع تقنين القنب الهندي ورشاً وطنياً ناجحاً، بدل أن يتحول إلى مجرد غطاء لتكريس التفاوتات الاجتماعية والمجالية. وهنا قد يشكل الانفتاح على التجارب الدولية المختلفة، من كندا إلى الأوروغواي، مرجعاً يمكن أن يساعد في تجنب أخطاء الحاضر وبناء نموذج مغربي خاص يحقق التوازن بين الضبط القانوني والتنمية.