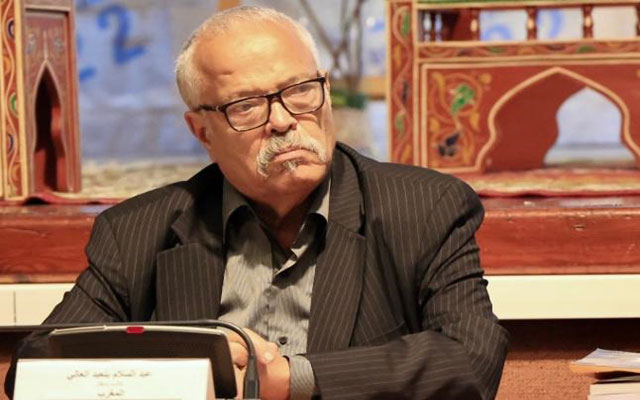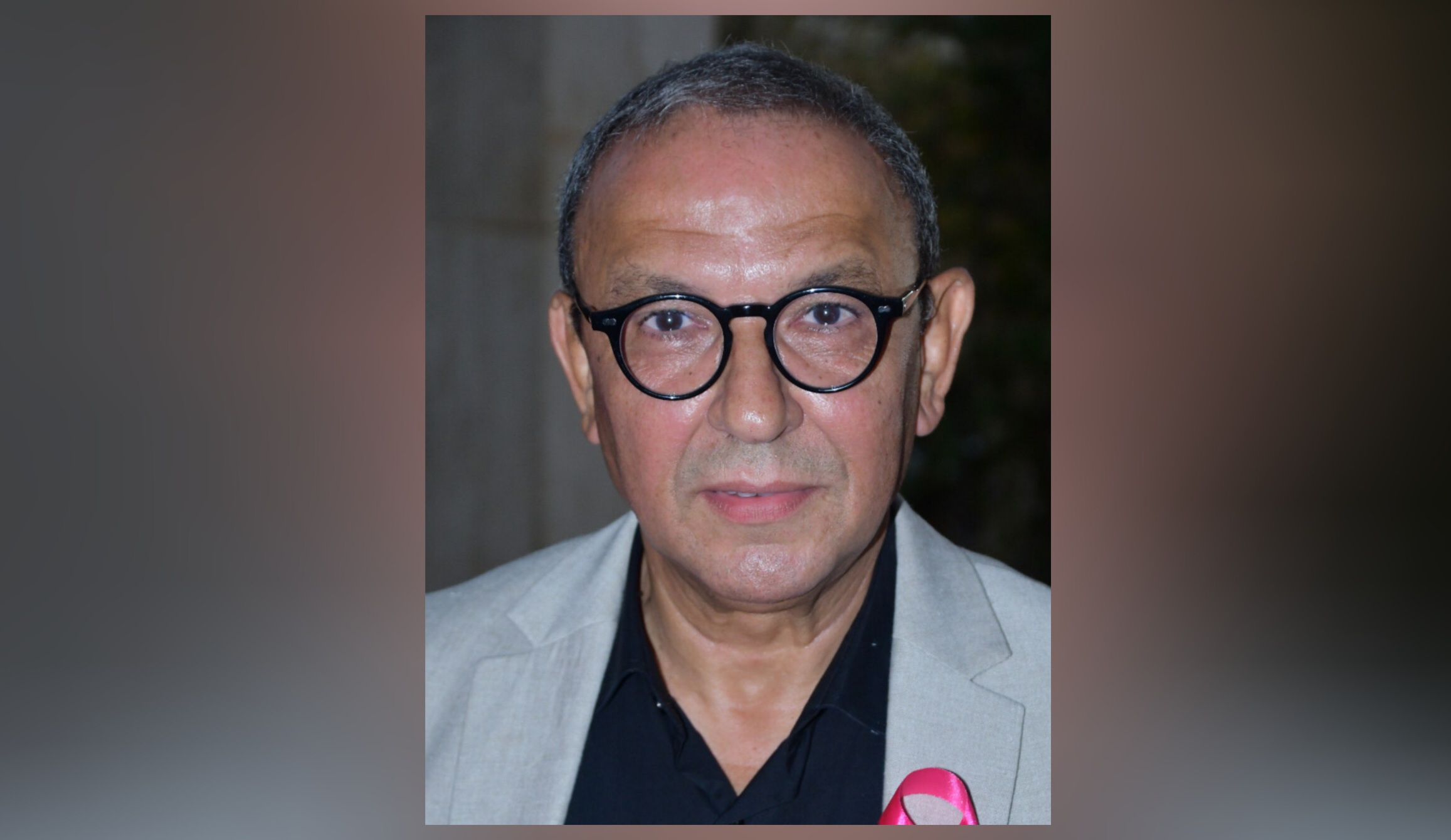لست في حاجة إلى مناسبة من المناسبات كي أتذكر السي محمد، الذي عرفته لمدة غير قصيرة، زميلا في المرحلة الطلابية، وزميلا في الحياة المهنية، والأهم من ذلك ربما، زميلا في الكتابة والتأليف.
تعرفت على سبيلا عندما التحقت بالسنة التحضيرية بكلية الآداب بالرباط سنة 1963. لست أذكر بالضبط أين ومتى كان لقاؤنا الأول، غير أن ما هو أكيد أن كل من كان في تلك السنة التحضيرية، وهي كانت سنة مختلطة لا تضم الفلاسفة وحدهم، بل كل من كان في الكلية آنئذ، كان يعرف سبيلا، نجم الحركة الطلابية أولا، ولكن أيضا لأنه كان، وبمعيار الوقت آنئذ، واستعارة لعبارة عادل امام، "لأنه كان على خلق".
عندما أرى الانتشار الواسع لسلسلة "دفاتر فلسفية"، سواء داخل المغرب أو خارجه، أشكر في نفسي كل من كان وراء نشر تلك السلسلة وانتشارها، شاعرا أنها ستظل تضم اسمينا بجوار بعضهما لمدة لن تكون قصيرة.
ما جمعنا، السّي محمد وأنا، ليس فقط كتبا وترجمات، بل أساسا مفهوم معين عن "الكتابة الفلسفية". فنحن التقينا أساسا في انصرافنا معا عن الكتابة الفلسفية في شكلها المعهود ومنابرها المألوفة، وانتهاجنا منهجا في التأليف والنشر ينزل الفلسفة من عليائها، ويخرجها عن معهودها، ليقحمها في اليومي.
من أجل ذلك سأحاول، في هذه المناسبة، أن أبرر مسعانا هذا بالوقوف عند شكل الكتابة والتأليف الذي دأبنا عليه، وتبرير تلك الممارسة الوقحة بعض الشيء، التي تمثل في نوع من الابتعاد عن الكتابة الفلسفية الرصينة، والميل الى تجميع ومضات فكرية لا تخضع لقواعد لعبة التأليف المعهودة، وخصوصا الفلسفي منه. بل إنها تتخذ وسائل نشر منابر ما كانت الفلسفة لترضى بها حتى وقت غير بعيد. وبالمناسبة فقد كان السي محمد ربما من بين الأوائل الذين أنزلوا الفلسفة عندنا الى الصحافة حتى لا نقول "صحّفوها".
لن يتعلق الأمر بطبيعة الحال، بعرض نظري حول الكتابة وحواملها، ولا بأهمية الكتابة المقطعية، والتوقف عند المفكرين الذين أرسوا أسسها الفلسفية ابتداء من الرومانسيين الألمان حتى رولان بارط، اذ إن ذلك لن يكفي لتبرير ما إذا كان هذا الشكل هو الطريق الأنسب للكتابة الفلسفية في عالمنا العربي الذي يظهر أنه في حاجة ماسة الى كتابات تـمهيدية تعليمية تحترم قواعد التأليف والنشر المعهودين.
يجد هذا الأمر تبريره اذا استحضرنا خصوصية الوضع الفلسفي عندنا، ذلك الوضع الذي عرف، ولمدة غير قصيرة، تعثرا في تدريس الفلسفة في مدارسنا وكلياتنا، هذا التعثر الذي لا بد من التذكير بالفضل الذي كان لسبيلا في النضال من أجل مقاومته خصوصا في إطار رئاسته لجمعية الفلسفة. كما أنه قد يلفي مبرره في عدم مواكبة برامجنا لمستجدات ذلك الدرس، فضلا عن عدم التوفر الكافي لأمهات النصوص بلغة متيسرة، الأمر الذي يحول دون ممارسة الفلسفة تفكيرا وتدريسا وربما كتابة وتأليفا.
قد يبدو مبررا أول اذن لانتهاج ذلك النوع من الكتابة التي لا تخضع لقواعد الدرس والتأليف والنشر التقليدية كان هو البحث عن منفذ يجعل كل هذه العوائق التي أشرنا اليها لا تقف حجر عثرة إلا أمام شكل من أشكال الممارسة الفلسفية، أي ما يدعى عادة كتابة رصينة، أعني تلك الكتابة التي تحرص على توظيف معرفة فلسفية دسمة، وتنصبّ على تاريخ الفلسفة وتنقب في نصوصه.
لكننا نعلم أن تاريخ الفلسفة ذاته، غربيّه وعربيه، قد عرف ممارسات وأشكالا للكتابة على هامش ما يمكن أن ندعوه تاريخا رسميا. إلا أن الأهم من ذلك هو أن الفكر ذاته عرف هو كذلك، لا تحولا في الشكل والأسلوب فحسب، بل حتى في المحتويات والمرامي. فهو لم يعد اليوم يتعقب الأخطاء وينشغل بوضع قواعد لتوجيه العقل، كما لم يعد ينحصر في النقد وتبين حدود الصلاحية، وانما أصبح مقاومة، ومقاومة تكافئ في عنادها لا صلابة الأخطاء، ولا قوة الأوهام ومكرها، وانما ما يدعوه دولوز البلاهة والترهات.
مقاومة البلاهة ربما لا تكفيها رصانة العقل الديكارتي، ولا حتى صرامة النقد الايديولوجي وشراسته، وانما هي تحتاج، ولنقل فضلا عن ذلك، تحتاج ربما لعقلانية ماكرة ساخرة تقف عند ومضات الحياة المعاصرة، لا لتترصد أخطاء المعارف، ولا لتكتفي بفضح أوهام الايديولوجيات، وانما لتقوم بنوع من "التشريح"، كما يقول أحد العناوين الصغرى لكتب السي محمد، ورصد "منطق الخلل" الذي يهيمن على تلك الحياة ويطبعها.
الا أن ذلك لا يعني البتة إهمالا للفلسفة وتاريخها. فلم تكن السخرية التي كنا نمارسها، استهتارا، كما لم تكن محاولة رصد منطق الخلل خللا منطقيا. كل ما في الأمر أنه تبين لنا وقتها، أن النص الكلاسيكي مضمونا وشكلا ربما لم يعد كافيا لمتابعة نبضات الحياة المعاصرة، وأن الوقوف عند تلك النبضات يقتضي كتابة ليست أقل رصانة، وانما أقل رزانة، وأقرب الى "السخرية" والمرح و "اللعب".