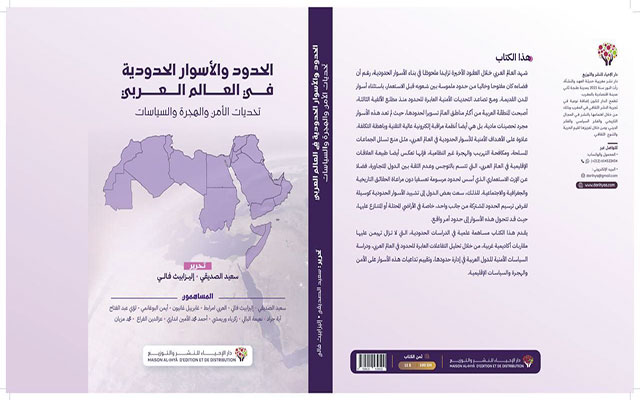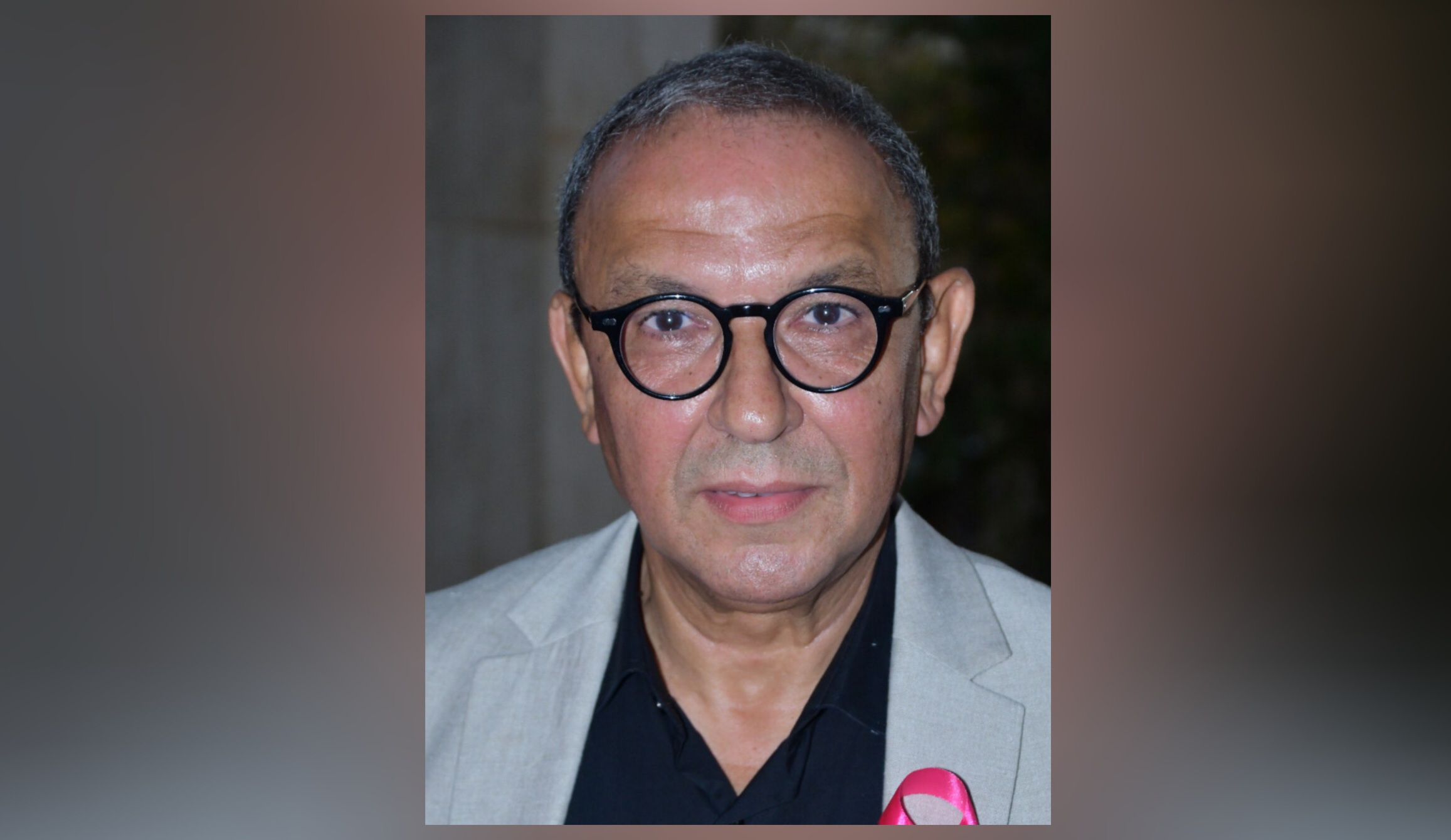صدر مؤخرا عن دار الإحياء للنشر والتوزيع كتاب "الحدود والأسوار الحدودية في العالم العربي: تحديات الأمن والهجرة والسياسات"، من تحرير كل من سعيد الصديقي، أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وإليزابيث فالي من جامعة كيبيك بمونتريال. وقد ساهم في فصول هذا الكتاب الجماعي باحثون من جامعات مغربية وعربية وكندية، وينتمون إلى فروع معرفية مختلفة.
يأتي هذا الكتاب ليملأ فجوة كبيرة في الدراسات الحدودية في العالم العربي ويقدم إضافة علمية هامة، حيث يساهم في تأسيس أجندة بحثية جديدة في هذا المجال الذي يهيمن عليه بشكل رئيسي باحثون من أمريكا الشمالية.
يتناول الكتاب بعض جوانب التفاعلات العابرة للحدود في العالم العربي، بما في ذلك استجابة الدول لهذه التفاعلات، فضلا عن تقييم السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة أمن الحدود في بعض الدول العربية.
ويتميز الكتاب بتنوع فصوله من حيث الموضوعات والتخصصات، مما يعزز التكامل والشمولية ويشجع على تعميق البحث في المواضيع الفرعية من خلال مشاريع علمية مستقبلية. أحد أهداف الكتاب الرئيسية هو المساهمة في تأسيس تخصص دراسات الحدود في العالم العربي.
يرى محررا الكتاب أن الإنسان أنشأ الأسوار منذ القدم لحماية جماعته من الغزوات، كما في سور الصين العظيم، الذي كان نموذجا لتحصينات دفاعية موحدة. ومع تطور الحضارات، شيدت الأسوار لحماية المدن الكبرى من الاعتداءات. وقد اكتسبت الأسوار في العصر الحديث أبعادا سياسية وأمنية، كما ظهر في جدار برلين الذي أصبح رمزا للفصل الأيديولوجي والسياسي خلال الحرب الباردة، وشكل سقوطه عام 1989 نهاية مرحلة وبداية أخرى في العلاقات الدولية. وبعد الحرب الباردة، تسارعت وتيرة بناء الأسوار نتيجة التغيرات الأمنية والهجرة غير النظامية والتهديدات العابرة للحدود. فقد بني تسعة جدران خلال الحرب الباردة، وسبعة أخرى بين 1991 و2001، ثم تصاعدت وتيرة البناء بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث تضاعف عدد الدول التي أنشأت أسوارا حدودية.
وفي العالم العربي، تعد ظاهرة الأسوار الحدودية -حسب محررا الكتاب- حديثة نسبيا، إذ كان الفضاء العربي مفتوحا إلى حد كبير قبل مرحلة الاستعمار. غير أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في تشييد هذه الأسوار، سواء من حيث عددها، أو طولها، أو الميزانيات المخصصة لها، أو التكنولوجيا المستخدمة في بنائها، ما جعل المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تحصينا بأنظمة مراقبة إلكترونية متطورة ومكلفة. ورغم اختلاف دوافع بناء هذه التحصينات باختلاف السياقات، إلا أنها تتشابه عموما في شكلها وبنيتها والتقنيات المعتمدة في تشييدها. وتوجد هذه الأسوار الحدودية في مختلف مناطق العالم العربي. فبالإضافة إلى الأسوار التي بنتها إسرائيل على كل خطوط تماسها مع العرب والفلسطينيين، فإن دولا عربية كثيرة، خاصة في منطقتي الخليج والمغارب، شيدت تحصينات أمنية وعسكرية على حدودها لدواعي أمنية أو سياسية. توجد هذه الأسوار على حدود الدول العربية الآتية: السعودية-اليمن، والسعودية-العراق، والإمارات-السعودية، الإمارات-عمان، وعمان-اليمن، والكويت-العراق، والأردن-سوريا، وتركيا-سوريا، والعراق-سوريا، العراق-إيران، وتونس-ليبيا، والجزائر-تونس، والجزائر-ليبيا، والجزائر-مالي، والجزائر-النيجر، والمغرب-الجزائر (من الجهتين)، بالإضافة إلى الجدار العسكري المغربي في إقليم الصحراء، والسياجات الاسبانية في محيط مدينتي سبتة ومليلية (المغربيتين المحتلتين في الشمال).
بالإضافة إلى المقدمة التي كتبها محررا الكتاب، يتكوّن الكتاب من عشرة فصول. يتناول العربي امرابط في الفصل الأول مفهوم الحدود الإقليمية باعتبارها انعكاسا للعقل البشري قبل أن تتجسد ماديا، مشيرا إلى دور القوى السياسية والدينية في ترسيم الحدود. كما يناقش التناقض بين الحدود الذهنية والإقليمية وتأثيرها على النزاعات المستمرة.
وتعالج إليزابيث فالي وغابرييل غانيون في الفصل الثاني ظاهرة الأسوار الحدودية من منظور نقدي، مركزين على آثارها الكلية (مثل الحد من التدفقات العابرة) والجزئية (مثل تأثيرها على المجتمعات الحدودية)، ويخلصان إلى أن "جميع الأسوار تنتهي دائما، بطريقة أو بأخرى، بالسقوط”.
أما أيمن البوغانمي، فيفكك في فصله إشكالية الدولة القطرية العربية وحدودها في ظل العولمة والصراعات الهوياتية، معتبرا أن التحديات الحالية تعكس تحولات أعمق في مفاهيم الانتماء والهوية.
وفي فصل "حواجز بين الأشقاء" يركز سعيد الصديقي على الأسوار الحدودية في منطقة الخليج العربي وتحليل أهدافها الأمنية والسياسية.
من جانبه، يناقش لؤي عبد الفتاح الجدران الإسرائيلية كأداة استعمارية إحلالية تقوم على الفصل والهيمنة، مؤكدا أنها ترقى إلى جريمة الفصل العنصري.
أما آية جراد، فتسائل استراتيجيات عسكرة الحدود في تونس، موضحة كيف تحولت استراتيجيات أمن الحدود في البلاد، وتأثير خطاب الأممية على المجتمعات الحدودية.
وتقيم نعيمة البالي و زكرياء وريمشي في دراسة ميدانية فعالية تسييج الحدود المغربية الجزائرية، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية على ساكنة شرق المغرب.
ويحلل أحمد الأمين انداري التحديات الأمنية التي تواجهها موريتانيا في ظل غياب الجدران الحدودية، بسبب هشاشة الإمكانات وتعقيد الجغرافيا.
كما يستعرض عز الدين الفراع في قراءة سوسيولوجية علاقة الحدود الكولونيالية بالمجتمع المحلي في شمال شرق المغرب.
ويختم محمد مزيان بفصل حول الهجرة غير النظامية في المغرب الكبير، مركزا على غياب التنسيق الإقليمي في تدبير الحدود، وصعوبة التوفيق بين الأمن والالتزامات الدولية.
ويعد هذا الكتاب أحد مخرجات المؤتمر الدولي (نحو أجندة جديدة للدراسات الحدودية) الذي نظمته العام الماضي جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بالتعاون بين كلية الحقوق بفاس وجامعة كيبيك بمونتريال (كندا) وجامعة شرق فنلندا.