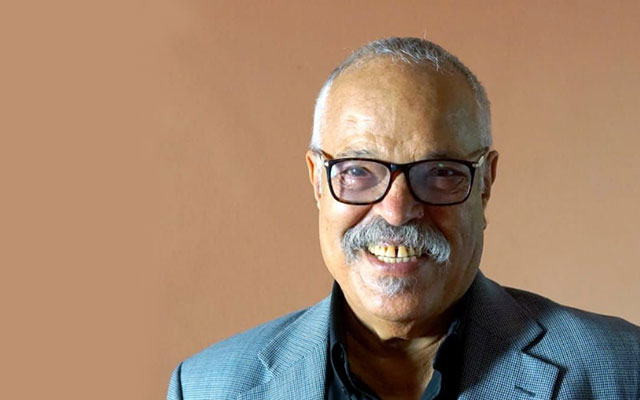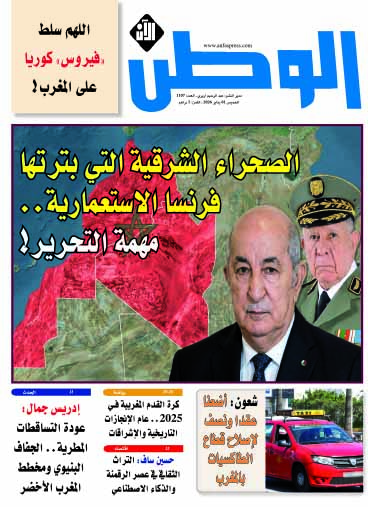“حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.”
بهذه الصيغة ورد النص في الفصل 14 من أول دستور للمملكة المغربية سنة 1962، وحافظت دساتير 1970 و1972 و1992 و1996 على نفس الصيغة وفي نفس الفصل. ولم يتغير موقع حق الإضراب إلا في دستور 2011، حيث انتقل إلى الفقرة الثانية من الفصل 29 .
بهذه الصيغة ورد النص في الفصل 14 من أول دستور للمملكة المغربية سنة 1962، وحافظت دساتير 1970 و1972 و1992 و1996 على نفس الصيغة وفي نفس الفصل. ولم يتغير موقع حق الإضراب إلا في دستور 2011، حيث انتقل إلى الفقرة الثانية من الفصل 29 .
وبين دستور وآخر، ظل الرأي العام ينتظر صدور القانون التنظيمي الذي سيحدد الشروط والإجراءات لممارسة هذا الحق ،إلاّ الفرقاء الاجتماعيون، المعنيون مباشرة بالموضوع، فكانوا يعلمون علم اليقين أن الحكومات المتعاقبة لن تقدم على هذه الخطوة.
ففي عز قوة النقابات، التي كانت هي المحرك الأساسي للصراع الاجتماعي في المغرب، فقد كان من الواضح أن أي قانون تنظيمي لا تؤشر عليه لن يمر رغم تعاقب 17 حكومة، كان لكل منها برلمانها وأغلبيتها وانتخاباتها، وفي المقابل كان للفرقاء الاجتماعيين الشارع بأجرائه وموظفيه وتجاره ومعطليه. لكن بعد 63 سنة، اختلّ الميزان فتقوّى رأس المال، واحتلت التنسيقيات الفضاء العام، وهرمت جلّ النقابات. فدقّت الساعة التي طالما انتظرتها الحكومات لستة عقود، فصدر القانون رقم 97.15.
لا شك أن هذا القانون التنظيمي يشكّل خطوة متقدمة لتنظيم أهم الية الصراع الاجتماعي ببلادنا . فهو يهدف إلى ضبط العلاقة بين الأطراف الثلاثة: الحكومة، والباطرونا، والنقابات. وهي معادلة صعبة حاولت منظمة العمل الدولية نفسها معالجتها أو الحفاظ على توازنها منذ تأسيسها سنة 1919، حتى قبل إنشاء منظومة الأمم المتحدة، دون أن تتمكن من إيجاد حل نهائي.
لكن يبقى السؤال مطروحاً في سياقنا الوطني: هل قانون الإضراب ،في صيغته الحالية ,والتي يمكن اعتبارها متوازنة في عمومها ، سيساهم في تعزيز السلم الاجتماعي داخل الإدارة والمقاولة في ظل واقع انتقل فيه التدافع الاجتماعي إلى الفضاء العمومي ؟
لعل الأرقام المتوفرة لدى مصالح وزارة التشغيل ووزارة الوظيفة العمومية تبرز محدودية الانتساب النقابي حتى للمركزيات النقابية التاريخية التي قادت الصراع الاجتماعي في المغرب منذ عقود فما بالك بالآخرين .كما ان الفرق المهول في عدد مندوبي الأجراء المستقلين مقارنة بالمندوبين ، يعتبر مؤشرا دالا .
فمن المستفيد من هذا الفراغ؟ ومن يتحمّل مسؤولية التراجع؟
كنت أعتقد أن الإصرار على إخراج هذا القانون في هذه الولاية البرلمانية بالذات ،سيواكبه تقدير سياسي من النخبة البرلمانية لما لهذا النص من أهمية مركبة. فدساتير المملكة الستة رفعت حق الإضراب إلى مستوى القانون التنظيمي، وهو بذلك لا يتقدّم عليه من حيث القوة القانونية إلا الدستور، ثم يليه تراتبيا القانون العادي، فالمراسيم، ثم القرارات الإدارية.
ويمكن الجزم بأن قانون الإضراب هو أهم قانون تنظيمي جاء به دستور 2011، لأنه يدبر مصالح الأفراد والجماعات والطبقات الاجتماعية، ويحمي البلاد من انزلاقات الصراع الاجتماعي الذي لا مفر منه في أي مجتمع حي.
لكن، وللأسف، مرة أخرى، تخلف المؤسسة البرلمانية موعدها مع التاريخ ومع المجتمع .فغياب 291 نائباً من أصل 395 اي 74% خلال جلسة التصويت لا يمكن اعتباره حدثاً عرضياً، بل هو انعكاس لخلل أعمق في علاقة الناخبين بالمنتخبين، وفي علاقة هؤلاء بالمسؤولية التمثيلية والشأن العام. وحتى وإن كانت الحكومة قد توفقت ونجحت في تمرير قانون تنظيم الإضراب فإن مجلس النواب قد رسب في امتحان ثقة المواطنين والحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية.
واذا كان الشيء بالشيء يذكر ،فإن معدل حضور النواب في جلسات التصويت على القوانين العادية بمجلس النواب الإسباني لا يقل عن 250 نائباً من أصل 350. أما في الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تضم 577 نائباً، فيتراوح الحضور في جلسات التصويت بين 350 و400 نائب دائما .
يقول جون ستيوارت ميل وهو فيلسوف بريطاني مشهور "الديمقراطية لا تعني فقط حق الانتخاب، بل تعني أولاً وأخيراً واجب التمثيل الصادق.”
ليبقى السؤال العريض قائماً في الأخير :
هل الغياب البرلماني في المغرب مجرد أزمة تمثيلية أم خلل ديمقراطي؟
ما رأيكم ؟