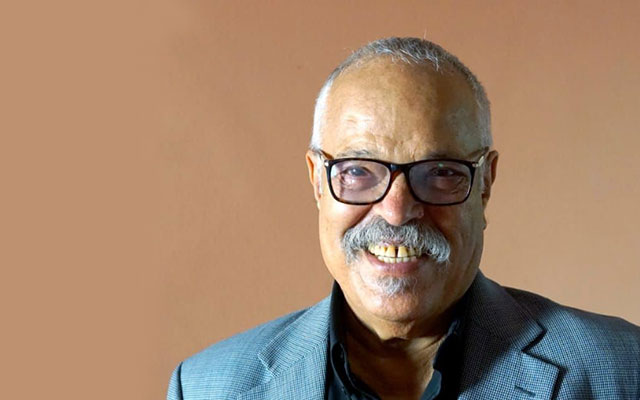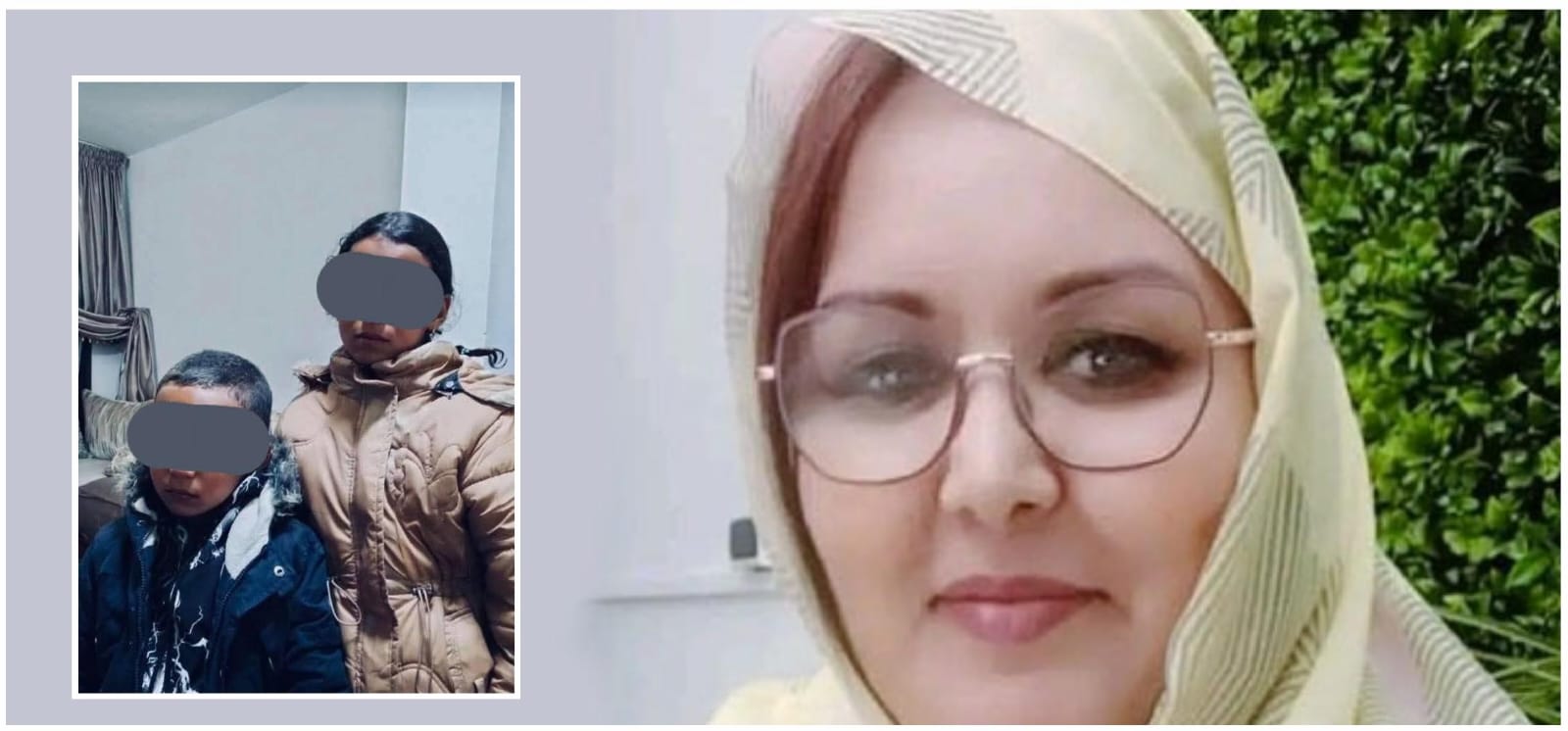يتلقى المغاربة يوميا ضغط هذا الارتباك الناجم عن فقدان النجاعة القيمية لمنظومتهم الأخلاقية التي يقرون بمشروعيتها. فإن كانوا يقرون بأن الخداع والكذب مرفوض أخلاقيا، فإنهم يعدمون الكفاءة العملية للقيمة التي تجعلهم يثمنون الابتعاد عن الكذب والغش والخداع، حتى أصبح الغش ثابتا في المجال العام لتبادلاتهم الاجتماعية، والمبدأ الوحيد المستولي على معاملاتهم مع بعضهم. إذ أضحى كل مغربي يفترض مسبقا أنه ينتظر في أية معاملة مع مغربي آخر، الأسوأ، أي الغش والخداع، وأن السلوك الأصلي، الذي يشكل قاعدة لتصرفات المغربي إزاء غيره، هو الغش أو الخوف من الغش. وهو ما أغرق العلاقة البينية التي تصل المغاربة ببعضهم في حالة قصوى من الشك المتبادل، والاتهام المسبق.
كل ما سبق يعني شيئا واحدا هو أن المغاربة مزقوا ميثاقهم الأخلاقي الذي يضمن انسجامهم كمجتمع منظم، وأن المجتمع المغربي يجتاز تجربة قصوى لانعدام النجاعة القيمية. فالغش الذي أضحى يشكل، مع الأسف، القاعدة العامة للمبادلات الاجتماعية بين المغاربة، يُضعف الثقة المتبادلة التي تمثل الضامن الوحيد لاستمرار المجتمع. وهو ما يهدد بدخول المجتمع في حالة تصدع، تفقده طاقة اشتغاله كمجموعة منظمة. لأن غياب عنصر الثقة المتبادلة، يدفع الفرد في اتجاه تحصين مصلحته الخاصة بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ذلك، أكانت مشروعة أم لا، وبغض النظر عن عمق الضرر الذي يمكن أن يُلحقه بالغير والمجتمع. وهو ما يعتبر مقدمة صارمة لدخول المجتمع إلى حالة حرب أهلية مُقنعة يتطاحن فيها الناس من أجل حماية مصالحهم الخاصة تحت غطاء نظام أخلاقي وقانوني عديم الفاعلية والجدوى.
وفي المغرب، لا نعدم مؤشرات موجعة عن وشوك دخول المجتمع إلى المرحلة الأسوأ، فبقدر ما تُقربه حالة الغش العامة التي استحالت إلى مبدأ أخلاقي، من قولة هوبس الشهيرة "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"، فإن النتيجة القصوى لذلك ستعيدهم إلى حالة "حرب الكل ضد الكل" التي بذل تطور التنظيم الإنساني الذي أفرز الدولة مجهودا هائلا لتجاوزها والحيلولة دون العودة إليها.
من أجلى هذه المؤشرات تبني خرق القانون والاستهتار بأحكامه كمبعث للمباهاة الاجتماعية، وتحويل احترام القانون إلى مظهر للغباء وفي أحسن الأحول إلى علامة للسذاجة التي تثير التهكم. تُعزز ذلك مظاهر الفوضى والرفض التلقائي لتكسير كل الأنظمة وتعطيل السير العملي لكل القوانين على أرض الواقع سواء بواسطة الرشوة وما يرافقها من مسلكيات إيقاف إنفاذ القوانين والأنظمة المنظمة لقطاعات المجتمع (من زبونيات ومحسوبيات وغيرها) أو بالفعل الإرادي للأفراد الذي يظهر في الحياة العامة على شكل تصميم وإصرار لعدم جعل ممارساتهم اليومية في الحياة مجالا لتصريف إرادة القانون. لذلك نرى أن الراجل في الشارع العام يعمد إلى استعمال الطريق المخصص للعربات عوض التزام الرصيف، أو يقترب إلى أن تتبقى بينه وبين الممر الخاص بالراجلين مسافة جد قليلة، فيفضل أن يعبر الشارع، لكي لا يظهر بمظهر مُحترم القانون المنضبط لقواعده، أي بمظهر السلوك المدني الذي أصبح يظهر كسلوك مشين في مغرب الأزمة الذي نتحدث عنه.
لكن ما يُعلن عن نفسه في عمق هذه الممارسات، هو أن رفض القانون والتباهي بعدم احترامه الذي أضحى سائدا في كل المجالات، هو نوع من الرفض للتنظيم المدني للوجود الجماعي الذي يقوم على توازن الحق و الواجب، حيث يكون حق الآخر واجب علي ويكون حقي هو واجب الآخر.
في خرق القانون يُعطل الناس هذا التوازن ، والأسوأ من هذا فهم يتنكرون إلى ما يضمن تواجدهم الجماعي، ويعوضونه بنرجسية المصلحة الخاصة.
يرتبط ذلك بشكل نسقي بما هو أخطر، إذ أنه يكشف إلى أي حد لم يعد الناس بالمغرب يجدون ما يشبع إحساسهم بشرعية القانون. مثلما يمس رؤيتهم إلى المجال العام الذي لا يرون فيه سوى رقعة لممارسة الحرب من أجل تحصين مجال المصلحة الخاصة. لذلك نجد كل مجالات القطاع العام تتعمق أزمتها، وكل طرف يساهم بنصيبه في دفع هذا القطاع نحو الاندحار.. لأن في مجتمع محكوم بمنطق الانعدام المطلق للثقة المتبادلة، وبغياب النجاعة القيمية، وبالتنصل من أساسيات الوجود المدني واحتقاره، ينعدم أيضا ما يضمن التواجد السلس لمجال المصلحة الخاصة مع المجال العام. ولذلك، فإنه لا أمل في كل مشاريع تأهيل القطاع العام بمختلف مجالاته، لأن الأمر في ذلك لا يعود إلى ضعف التعبئة المالية وغياب النية والمقصد العام من أجل الإصلاح، وإنما إلى استفحال منظومة يستولي منطقها على المجتمع بكامله، ويدفعه إلى التقهقر نحو مصير التصدع. فالناس اليوم، يعرفون في قرارة أنفسهم أن المهمة القصوى للتواجد في المجال العام هو ممارسة الحرب على رقعته والعودة بما يكفي من الغنائم، هذه الحرب التي تمارس اليوم بوسائل رمزية في انتظار نضج شروط تحولها إلى حرب بكل مضمونها المادي.
تعلن سلوكات المغاربة وتصرفاتهم أنهم لا يَأْمَنون على أنفسهم من بعضهم البعض. كل واحد يشعر بأن الآخرين يشكلون تهديدا كبيرا لكيانه. عندما يتوجه إلى المستشفى أو المصحة يتوجس من الموت بسبب إهمالهم أو نقمتهم أو بدافع الجشع، عندما يطلب حقا في المحكمة يفترض مسبقا ضياعه، عندما يخرج إلى الشارع لا يرى في وجوه المارة سوى ملامح لص.. المغربي اليوم كائن مسكون بهاجس كونه غير محمي بالمطلق، عليه أن يعول على نفسه فقط، وأن يعد ما يكفي من الأسلحة للدفاع عن مصالحه، ولذلك، نجد في كثير من الحالات أن الوسيلة المثلى لتحصين حقوقه هي السطو على حقوق الآخرين، لذلك ينتشر الغش في كل مكان من مجالات المجتمع، من الخطاب إلى الفعل، لأنه في عمقه أسلوب في إدارة هذه الحرب الداخلية.
لا تُظهر الملامح العامة للحياة أن المغاربة في تلقائيتهم يكنون اعتبارا داخليا للرابط المدني الذي يقوم على الاعتراف المتبادل بينهم ويترسخ بالإقرار بتوازن الحق والواجب، والأسوأ في ذلك فهم يعانون فقدانا كبيرا للدولة التي تقلصت هيبتها كثيرا في السنوات الأخيرة..
كل المؤشرات التي يُظهرها المغرب اليوم تقول إن الدولة تسير في اتجاه حتمية واحدة هي التلاشي. فقانون الأنثروبي يُعلن عن نفسه فيها بقوة. لا نلمس ذلك فقط من خلال متواليات من تفويت صلاحياتها، أو من حالة الارتباك التي تحكم أداءها من القمة حتى القاعدة، بل، وهذا هو الأهم، في حقول انطباقها التي كشفت أن الدولة اليوم في وضعية من يقاوم من أجل البقاء، وليس من يبسط نفوذه الشرعي باطمئنان.
لا تستطيع الدولة المغربية اليوم أن تفرض هيبة علامة ممنوع المرور في زقاق صغير، لا أحد يأبه إلى جوهرها القانوني وأساسها الأخلاقي، وكل ما يُنتبه له هو كونها احتياطي من العنف الذي لا يقدر أحد مداه، لذلك فعندما تنحني الرؤوس لها (وهو ما يتقلص يوما بعد يوم)، لا تفعل ذلك احتراما لجوهرها القانوني، وإنما رعبا من احتمال التعرض لدرجة من العنف الذي تنطوي عليه، إنها في نظر المغاربة شكل من العنف، لا يكنون أي ولاء له و إنما يخافون من نتائجه.
تبدو الدولة اليوم عاجزة عن حماية مجال اختصاصها ومعقل شرعية وجودها وحقل انطباقها، أي المجال العمومي. ففي كل لحظة تُنمى أشكال متباينة من التطاول على المجال العمومي وعلى إبطال المفعول الشرعي للقاعدة القانونية. تَقوّى ذلك من خلال ما تَرَاكَم من سنوات بعدما استكانت أمام نفوذ الخواص، وتفاقم عبر تحركات جماعية منسقة أو أفعال تلتقي موضوعيا مع بعضها، في الغاية، وهي النيل من نفوذ الدولة في مستويات مجهرية لا يكاد المسؤولون ينتبهون لها.
من المظاهر الدالة على الوضع الوهن للدولة اليوم بالمغرب، كونها تشتري السلم مقابل التنازل عن إنفاذ القانون. يحدث ذلك يوميا في مجالات كثيرة. فهي خشية التصادم مع المجتمع، تغض الطرف عن ظواهر خرق القانون والتلاعب بمقتضياته، أو في أحسن الأحوال تجتهد في إيجاد مخارج سياسية بعيدا عما تقتضيه عمومية القاعدة القانونية. أحدث ذلك ظاهرة معقدة ذات نتائج مصيرية بالنسبة لمستقبل الدولة وسيادتها الداخلية. ومن أهم وأخطر هذه الظواهر، تقلص درجة المجالات التي تنظمها فعلا الدولة على أرض الواقع، أي مجالات نفوذها. إذ هناك قطاعات من الواقع تطور قوانينها الخاصة بعيدا عما تقره الدولة. بمعنى أنها تطور بديلا تنظيميا عن الدولة. يحدث ذلك مجهريا، حيث نلمس في مستويات معينة تكسير دائم للتفعيل العملي للقوانين وتعويضها بقواعد أخرى ينضبط لها الناس، حتى تحولت الدولة في نظرهم إلى مجرد خطاب ليس له أي مفعول في واقع الحال، أي لا يملك أي تحقق مادي يمس حياة الناس.
يُستهان عادة بمثل هذه الوقائع، التي ترسي في حقيقة أمرها مبادئ بديلة. إذ أنها تشير، بشكل مقلق، إلى أن السيادة الداخلية المزعومة للدولة (والمطلوبة في نفس الآن)، هي سيادة جزئية فقط، مجالها الأكبر صوري، أما على أرض الواقع، فالدولة تُدفع لأن تكون مجرد طرف صغير في صراع كبير متعدد الأطراف.
ينبغي أن ندمج في معالجتنا لإشكالية الدولة في المغرب اليوم، مفهوما آخر، هو نجاعة الإشباع. إذ أن الدولة ينبغي أن تكون مشبعة للرغبة في الاعتراف الشامل المتبادل بين أفراد المجتمع، وعن طريق هذا الإشباع يتحقق التقاطع ما بين حرية الفرد والدولة، ويتعمق التكامل بين العمل لحساب المصلحة الخاصة والعمل للصالح العام، حيث يكون كل عمل شخصي عملا لصالح المجتمع. وعندما تفقد الدولة نجاعتها في الإشباع، تكف عن إنتاج مبررات الولاء في نفوس من تسود باسمهم، أي تفقد شرعية قبولهم بها، هذا الفقدان الذي يبدأ بإشارات رمزية، ويزيد في التطور عبر مظاهر واقعية إلى أن يصل إلى ذروته.
لا يجد الناس بالمغرب أنهم يشكلون غاية لبعضهم البعض، بقدر ما يتصورون أن الآخرين مجرد وسيلة لتحقيق منافع تخصهم في عالمهم الشخصي. وفي حقيقة الأمر فإن قاعدة وجودهم الجماعي تبتعد يوما بعد يوم عن أن تكون مجتمع موحد، يتعاون فيه أعضاؤه ويتضامنون من أجل غاية موحدة هي رفاههم المشترك. مثلما لا يجدون في الدولة ما يشبع توقهم إلى الاعتراف الشامل. وهو ما يعمق الفجوة بين الفرد والدولة، التي لم يعد يظهر حضورها بالنسبة إليه مجالا للحق والحرية. فإذا استعملنا لغة هيغل، فمن المفروض أن تكون الدولة من حيث هي الحقيقة العينية للحرية، المجال الذي يجد الفرد في تحققه كامل فرص الاعتراف به، وأن في الدولة تتأمّن شروط تحصين مصالحه الخاصة وحقوقه وحريته. في هذه الحالة ستكون الدولة اللحمة المفقودة اليوم بين المغاربة، أي اللحمة بين الحق والواجب، وسيكون القيام بالواجب السبيل الأمثل لتأمين الحقوق، إذ لا تستحق الدولة من الناس واجبات إلا بقدر ما تضمنه لهم من حقوق.
أزمة الإشباع مست أيضا السياسة، التي لم تعد مشبعة بالنسبة للمغاربة، بل أضحت عنصرا من بنية الغش السائدة. ولم تعد الممارسة الديمقراطية للسياسة الوصفة السحرية التي من شأنها أن تخلق نوعا من الاطمئنان إلى المستقبل، بمعنى أن قدرتها على تفعيل يوتوبيا الأمل قد تعطلت نهائيا. يعود ذلك لأسباب متعددة، أوجهها اختزال الديمقراطية في البعد التمثيلي، الشيء الذي حول السياسة إلى سوق تحكمها منافسة شرسة للمضاربة في آراء الناس و ردود أفعالهم، يسيطر عليها أولئك الذي يشكل الصراع حول المناصب هدفا استراتيجيا بالنسبة إليهم.
أرست الديمقراطية التمثيلية، فجوة كبيرة بين انتظارات الناس من السياسة وانتظارات محترفي السياسة. فالساسة يعتبرون الانتخابات غاية إستراتيجية، لأنها آلية لإشباع رغبتهم في الوصول إلى المناصب العليا والتصرف في شؤون الدولة، بغض النظر عن النتائج المترتبة عن ذلك، لذلك يكفي أن تكون الانتخابات نزيهة، فذلك يشكل إنجازا مهما في نظرهم. أما بالنسبة لعموم الناس فالانتخابات، وإن كانت تعبيرا عن إرادة النسبة الغالبة من المصوتين، فهي لا تعني بالمطلق أي شيء من دون تغيير فعلي وملموس في تفاصيل حياتهم. بمعنى أن الانتخابات لن تكون في نظرهم سوى وسيلة، قد تكون جيدة أو سيئة، لإحداث تغيير مرجو في حياتهم، بشكل يوسع من حرياتهم الشخصية ويقوي من فرص الرفاه والسعادة والاستقرار. الساسة يقدسون الوسيلة (الانتخابات) والمواطنون ينتظرون النتيجة ولا شيء غيرها. لذلك فكثير من الخطوات التي تمثل بالنسبة للساسة إنجازا مهما وتطورا كبيرا، لا تشكل شيئا ذي قيمة في نظر المواطنين. ويترتب عن ذلك نتيجة جد هامة، هي أن الساسة يعيشون في عالم، وعموم المواطنين في عالم آخر، مع قطيعة صارمة بين العالمين.
عزز ذلك الدستور الجديد المصوت عليه في فاتح يوليوز 2011، الذي اعتبر نقلة نوعية مؤسسة لتعاقد جديد. لكنه فتح الباب لتكريس الفجوة بين محترفي السياسة وعموم الناس. فقد تحولت كثرة المجالس والهيئات المنتخبة والمعينة ذات الطبيعة الاستشارية التي يحفل بها الدستور الجديد، مجالا لتحفيز أطماع السياسيين وإرضائهم، وصارت هذه العملية في نظر الناس قناة لجعل الفعل السياسي مرهونا بشكل مقنع من الإرشاء، يتلقى فيه الفاعل السياسي نوعا من المجازاة أو الترضية.
يستدعي سياسيو المغرب عناصر هذه الأزمة في خطابهم، ولا يتورعون في التباهي بها، كما لو كان ذلك مظهرا من تحديث فعلهم السياسي. وهكذا تجدهم يتحدثون عن الماركتينغ السياسي، أي التسويق السياسي، ويعتمدونه بنوع من الاعتداد بشرعيته، لأنه يتماشى مع قناعتهم العميقة بأن السياسة مجرد سوق، أي فضاء يتدخل فيه طرفان أحدهما يبيع والثاني يشتري، وهذه العملية ليس لها من اسم ثان في لغة الاقتصاد سوى التجارة. إنهم بذلك يماهون بين السياسة والتجارة، ويشرطون الديمقراطية بحرية السوق، ويجعلون من رأي المواطن البضاعة الأهم لمبادلاتهم التجارية. وهم بذلك يعمقون انفصال الفعل السياسي عن قاعدته الأخلاقية، ليتحول إلى مجرد لعبة، لا أحد فيها ملزم بما يبيعه للناس من وعود. لذلك يسهل على السياسي المغربي أن يتاجر بأفكار ومواقف وشعارات قبل الانتخابات وسرعان ما يتخلى عنها بمبرر تغير الظروف. لذلك لا يظهر الساسة المغاربة في عيون المغاربة اليوم إلا كمضاربين شرسين.
هؤلاء الساسة يضربون في عمق الوجدان المغربي وقناعاته فكرة أن الديمقراطية أسلوب في الحياة وطريقة في العيش يتقاسمها جميع أفراد المجتمع، ويحولونها إلى ما وصفه إيف فاركاس بشكل من النزال السياسي من أجل الحصول على السلطة، حيث تغدو الديمقراطية "أعجوبة قصاصات الورقة الصغيرة التي تتمخض فتلد جبلا" (أيف فاركاس: الرياضة والسياسة والفلسفة، ترجمة عبد الجليل الأزدي وبلعز كريمة، دار سبو، مراكش، 2011، ص 110).
وهم بذلك يعززون شروط تخلي المجتمع عن المشروع الديمقراطي، والبحث عن بدائل أخرى مخيفة، لأن الديمقراطية كما كرسها السياسيون، لم تعد سوى حرفة فئة معزولة يحركها الجشع السياسي الذي يرى في المنصب غاية في حد ذاتها تكفي نفسها بنفسها.
أخطأ المغرب طريقه نحو المستقبل، عندما لم يُعرف المواطن باعتباره الفاعل السياسي الأول، وعندما جعل فيتشتية صناديق الاقتراع الضامن الوحيد لحماية المشروع الديمقراطي، وعندما فصل الدولة عن قاعدتها الأخلاقية.
ما يتجاهله ساسة المغرب اليوم، أي في العقد الثاني من الألفية الثالثة، هو أن هناك عمل متفرق في مختلف قطاعات المجتمع وفي مستويات صغيرة منه، لخلق بدائل أخرى عن الدولة، عن قوانينها، ومجهود عملي لإبطال سيادتها في مجالات مجهرية من الحياة قد لا يُنتبه لها. وما يشتغل في قلب كل ذلك هو تنمية الشعور بالحاجة إلى شرعية جديدة لا تستطيع الدولة في وضعها الحالي استيعابها. وهي حاجة عندما تتواطأ الشروط لنضجها ستفضي إلى الكارثة، التي لا يرغب كل ذي عقل أن نصل إليها.
تكتب العناصر السابقة سيناريو مشؤوما لنهاية وشيكة لمنظومة تشتغل اليوم بشروط انهيارها. إذ لا المجتمع ولا الدولة ولا الوسيط بينهما باتوا يجدون مبدأ كليا يضمهم إلى غاية واحدة. بل إن عناصر التناقض الداخلي بينهم تعتمل بقوة وعنف، وتُراكم يوما بعد يوم نتائج لا تقل مأساوية عندما نأخذ إسقاطاتها المستقبلية بعين الاعتبار. حتى صار المغرب كفرد ومجتمع ومؤسسات، أقرب إلى الصورة التي رسمها هيجل في "العقل في التاريخ" لشيخوخة روح الشعب، أي أنه وجود بالعادة، له دوام شكلي فقط، فاقد للحماس الذي يتسم به هدف الحياة في الأصل، إنه "مجرد وجود حسي خارجي قد كف عن أن يندفع بحماس في سبيل هدفه أو موضوعه" (العقل في التاريخ. ت ع، ص 140)، فإذا كانت روح الشعب توجد وتستمر في المجموع الكلي لمنظماتها ومؤسساتها، وفي الأعمال والأحداث التي تصنع تاريخها، وإذا كانت الأمة هي ما تكونه أعمالها، كما قال هيجل، فعلينا أن نستحضر بكل ما أوتينا من يقظة تاريخية أن "الشعب لا يمكن أن يموت ميتة عنيفة إلا عندما يموت في ذاته ميتة طبيعية" (ص 141).