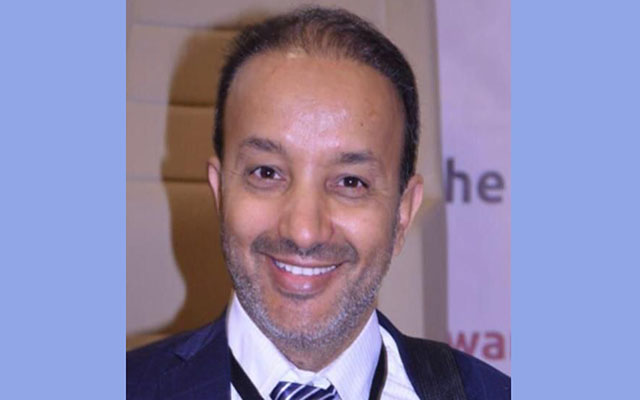لم يأت إعلان المجلس العسكري في مالي إنهاء العمل، على نحو فوري لا يقبل التأجيل والتفاوض، بـ "اتفاق الجزائر للسلام" الموقع عام 2015، مفاجئا أو مثيرا للاستغراب، خاصة أن هذا القرار أتى بعدما «لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و«الأعمال العدائية» التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق»، بحسب بيان المجلس العسكري.
فقد فطنت السلطات العسكرية في مالي، إلى اللعبة القذرة التي تقوم بها الجزائر، باحتضانها لكل أسباب الحفاظ على التوتر في الدولة الساحلية، فضلا عن إمساكها بأوراق إثارة القلاقل والنعرات وإفشال أي نزوع إلى الأمن والاستقرار، والحال أن العسكريون الماليون الذين انقضوا على السلطة في بلادهم عام 2020، قاموا بإبعاد بعثة الأمم المتحدة «مينوسما»، واتهموا قواتها بـ «تأجيج التوترات المجتمعيّة»، كما طردوا القوات الفرنسية راعية «اللاستقرار» في المنطقة.
لقد أدرك الماليون أن القوة الاستعمارية الفرنسية لم ترفع يدها عن مالي، بل اختارت خطة بديلة باستعمال الجزائر كـ «آلة للتحكم عن بعد»، وذلك بدعم دولة الكابرانات سياسيا وعسكريا ولوجيستيكيا واستشاريا ضد كل دول الجوار بالمغرب العربي وبمنطقة الساحل، وعلى رأسها المغرب ومالي، للحفاظ على نفوذها الكلاسيكي في غرب إفريقيا. ذلك أن فرنسا التي ما زالت تؤمن بقدرتها على الحركة والفعل في الساحة الإفريقية «رغم اندحارها في مجموعة من دول الساحل» لم تجد أي دولة مستعدة للقيام بـ «المناولة» لتنزيل أجندتها الجديدة في إفريقيا إلا دولة خونة الثورة الجزائرية. وهذا ما أقرت به باريس حين أكد المستشار الخاص للرئيس الفرنسي للشؤون العسكرية الأميرال جان فيليب رولاند، في زيارته الأخيرة إلى الجزائر، أن «التنسيق الأمني مع الجزائر، بشأن ملف مالي والوضع في منطقة الساحل، ضروري، ومن الواضح أن الجزائر تلعب دوراً مهماً للغاية في أزمة الساحل».
ومما يؤكد ذلك أن باريس أجبرت الجزائر، قبل الانسحاب من مالي، على ضرورة استشارة الجزائر في أي ترتيبات أو خطوات، مهما كانت طبيعتها تخص منطقة الساحل، وألا يجري تنفيذ أي سياسات في المنطقة من دون أن تطلع قصر الإليزي على ترتيباتها، لكونها مسألة تتصل بالأمن القومي لفرنسا ومصالحها الحيوية في إفريقيا، خاصة أن صحراء شمال مالي وشرق النيجر تضم ثالث أكبر احتياطي من اليورانيوم الذي تنهبه باريس لتلبية 75% من احتياجات فرنسا الكهربائية «إنتاج الوقود النووي».
وقد طرحت هذه الاشتراطات، حسب المراقبين، بوضوح في الاجتماع الأمني والعسكري غير المسبوق لـ 26 غشت 2022، الذي جمع كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية من البلدين، بمن فيهم إيمانويل ماكرون ووزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، ورئيس أركان الجيوش الفريق أول تييري بوركارد، والمدير العام للأمن الخارجي برنارد إيمي عن الجانب الفرنسي، والحاكم الفعلي للجزائر سعيد شنقريحة، رفقة تابعة عبد المجيد تبون والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي عن الجانب الجزائري. ولهذا يقول هؤلاء المراقبين أن فرنسا، على مستوى الملف المالي، نفضت يدها من عملية «برخان»، لكنها عادت من نافذة الجزائر التي خضعت عن عمد لإرغامات المناولة مقابل استمرار ماكرون في إدارة ظهره لـ «مغربية الصحراء» والالتحاق بواشنطن ومدريد وبرلين.
لقد فهم الممسكون بالسلطة في مالي أن الجزائر وفرنسا قد توصلتا إلى تفاهمات تخص باماكو، وأن ماكرون أقر «صيغة جديدة» للوجود الفرنسي، وذلك استجابة لمتغيرات سياسية ومجتمعية عميقة في مالي، لم تعد معها أي إمكانية للقبول بالتحكم الاستعماري، خصوصاً مع تسلم الحكم من قبل نخبة عسكرية مناهضة لباريس، وارتفاع منسوب الاحتجاج الشعبي الرافض لأي حضور فرنسي بمالي تحت أي عنوان كان، خاصة بعدما انتهى التدخل العسكري الفرنسي، الذي انطلق منذ 2013 إلى الإخفاق في القضاء على المجموعات المسلحة والإرهابيين. ومن تم فإن إلغاء «اتفاق الجزائر للسلام» مؤشر قوي على وجود تحوّل حقيقي في موقف النخبة المالية من الجزائر، حليفة فرنسا في إدارة التوتر على مقاس مصالحها الاقتصادية الحساسة في مالي، ورأس حربتها في خلط الأوراق وتحريك البيادق لإعادة الاضطرابات، خاصة وأن الجزائر دأبت، كما جاء في بيان المجلس العكسري في مالي، على «تنظيم لقاءات مع جهات معادية للحكومة المالية»، و«تشجيع جماعات انفصالية واستضافة معارضين للسلطة الحاكمة». وهو ما يؤكد تماما أنها منخرطة في تنفيذ المخطط الفرنسي القاضي بإدارة الشأن المالي «عن بُعد»، ولو كان الثمن هو انهيار الأمن تماماً، حتى تقول للماليين ولدول الساحل، وللدول التي تتطلع إلى الطلاق مع باريس، إن الاستقرار في المنطقة دون فرنسا أمر غير ممكن.
لقد أدت المتغيرات الجديدة في دول الساحل الإفريقي إلى إرغام فرنسا على إعادة ترتيب استراتيجيتها في المنطقة في ظل التنافس الفرنسي الأوروبي، وفي ظل دخول قوى دولية صاعدة على خط الصراع على الموارد، وأيضا في ظل التهديدات الأمنية والصراعات العرقية. غير أن الجزائر المغمورة بانتهازيتها العسكرية وتطلعاتها التوسعية وأوهام «الزعامة الإقليمية» الموروثة عن سيء الذكر الهواري بوخروبة، اختارت أن تسير في ركاب باريس مأخوذة بأحقادها على المغرب، بل على دول الجوار قاطبة، بما فيها تونس التي تحولت إلى «ولاية» من ولايات الجزائر ، كما جاء على لسان الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني الجزائري السابق الهواري تيغرسي، خلال شهر يوليوز 2022 في تعليق له على العلاقات التونسية/الجزائرية بالموقع الإخباري «سكاي نيوز عربية»، وذلك مقابل جرعة كهرباء وقليل من السكر والزيت وحفنة من دنانير «سوناطراك». والآن جاء الدور الآن على مالي التي طالبت العسكر الجزائري بـ «الحد من التصور الخاطئ الذي يعتبر مالي حديقة خلفية للجزائر». أما بالنسبة لموريتانيا، فقد انكشف إعلام الكراغلة برمته حين تعامل مع «المنتخب الموريتاني» كفريق قاصر ليس بإمكان بمقدوره إخراج المنتخب الجزائري من سباق كأس الأمم الإفريقية، حيث تأكدت عقدة الزعامة والتفوق و«القوة الضاربة».
قد يقول قائل إن الموقف الجزائري يرتبط بقضايا الأمن القومي للبلاد مع جوار صعب تمليه التوترات بمنطقة الساحل، وأيضا الحرب الدائرة على الواجهة الليبية. غير أن هذا القول مردود عليه إذا علمنا أن الأمن العسكري الجزائري يقف وراء كل القلاقل التي تؤرق بلدان المنطقة، بدءا من الإشراف المباشر على إنتاج وتمويل جماعة البوليساريو الانفصالية والإنفاق بسخاء على كل ما يعاكس مغربية الصحراء في المحافل الدولية والتحالف مع جنوب إفريقيا وإيران وحزب لله ضد المغرب، مرورا بالحرب التي شنتها قوات البولسياريو على نواكشوط في سبيعينيات القرن الماضي، والعملية المسلحة التي قام بها كوموندو عسكري على ثكنة بحفصة التونسية في يناير 1980 انطلاقا من مدينة تبسة بالجزائر، ناهيك عن حرب الكهرباء ومواد التموين التي تمارسها الجزائر على الشعب التونسي، وصولا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لمالي والنيجر وليبيا، بل إن أجهزة المخابرات العسكرية الجزائري هي التي تقف وراء خلق ما سمي بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، حسب ما انتهى إليه الباحث الأنثروبولوحي جيرمي كينان الذي أصدر كتابا تحت عنوان «الصحراء المظلمة».
ولا يحتاج المرء إلى عناء كبير ليفهم أن باريس تراهن على الأطماع الجزائرية للحفاظ على جميع الأوراق في يدها، بما في ذلك «التوازن الدقيق بين الرباط والجزائر». ففي الوقت الذي تحول المغرب إلى لاعب اقتصادي منافس في غرب إفريقيا، لجأت فرنسا إلى استحداث خطة أخرى تتماشى والتغيرات الحاصلة، إقليمياً ودولياً، بما فيها عرقلة المغرب على مستوى قضيته الوطنية ومحاولة خنقه بالإبقاء على التوتر والمبالغة في إبراز التهديد العسكري الذي تمثله الجارة الشرقية؛ وهو ما يعني وضع الرباط أمام امتحان صعب، ما قد يدفعها للعودة مرغمة إلى أحضان باريس، والتخلي عن طموحاتها الاستثمارية في غرب إفريقيا، والقطع مع شركائها الأفارقة، وترك الحبل على الغارب لتفعل فرنسا كل ما تشاء في مستعمراتها السابقة. وهذا ما تجربه، الآن، مع باماكو؛ وذلك بتسخير جيش الكراغلة وأجهزة استخباراته للإشراف المباشر على بناء تمردات للمجموعات المسلحة للطوارق في شمال مالي، أو لتهدئة الأوضاع عبر مفاوضات تتم على مقاس الأجندة الفرنسية. إذ من المتوقع أن يراهن الحلف الجزائري- الفرنسي على إشعال تمرد الطوارق والأزواد كما حدث في سنة 2012، ما دام المجلس العسكري المالي قد أخلى عاتقه من «اتفاق الجزائر للسلام»، بل من المتوقع أن يبادر الجيش الجزائري إلى التدخل عسكريا بدعوى «منع قيام إمارة إرهابية» على حدوده الجنوبية، وفق السيناريو الذي تفضله باريس، خاصة أن الجيش المالي لطالما وجد صعوبة في وأد تمرد الطوارق نظرا لإمكانياته المحدودة، وأيضا لشساعة المنطقة، ودراية المتمردين الطوارق بدروبها الوعرة.
غير أن السؤال الذي يُطرح في هذا السياق هو: هل سيورط جيش شنقريحة نفسه في حرب قد تستنزف قدراته، في ظل اشتغاله الطويل على صب الزيت على توتر الأوضاع على حدوده الشرقية والغربية أيضا؟ وبمعنى من المعاني، هل سينجح الفرنسيون في إرغام شنقريحة على ملء الفراغ العسكري الذي خلقه انسحاب القوات الفرنسية من مالي؟ وهل سيسمح الجيش المالي للجزائر بالتدخل العسكري في أراضيها؟
إن المظاهرات الشعبية المنددة بالتدخل الجزائري في الشؤون المالية التي عرفتها باماكو، تعكس حجم الاستياء الذي وصل إلى الشارع المالي، وهو ما يعيد إلى الأذهان الشعارات المناوئة لفرنسا التي رفعها محتجون ماليون من قبل، مما يؤكد أن عورة جيش الكراغلة قد انكشفت، كما يؤكد أن الجزائر ما هي إلى دولة مناولة لا تحترم لا حسن الجوار، ولا سيادة الشعوب، ولا حقها في تقرير مصيرها. كما تؤكد الطابع التآمري لقصر المرادية، وأنه خاضع تمام الخضوع لقصر الإيليزيه.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"