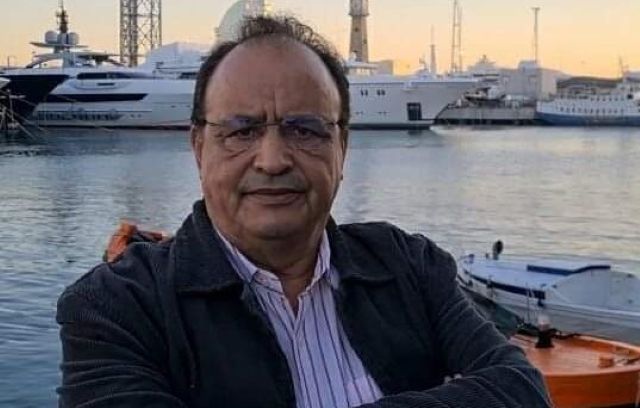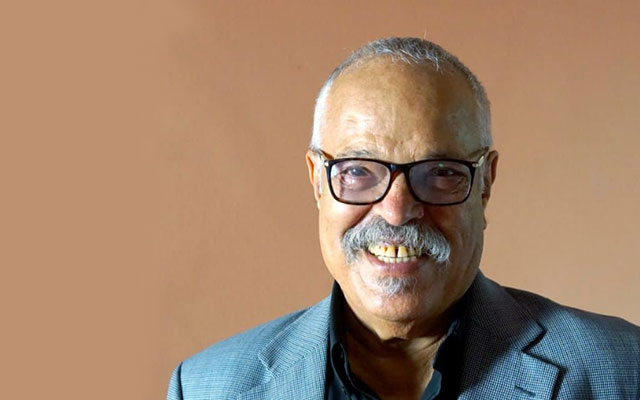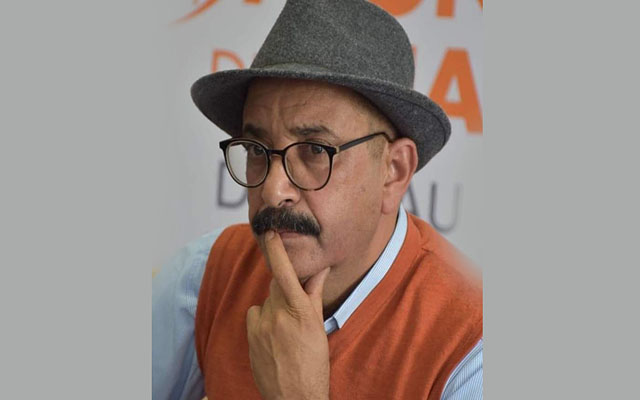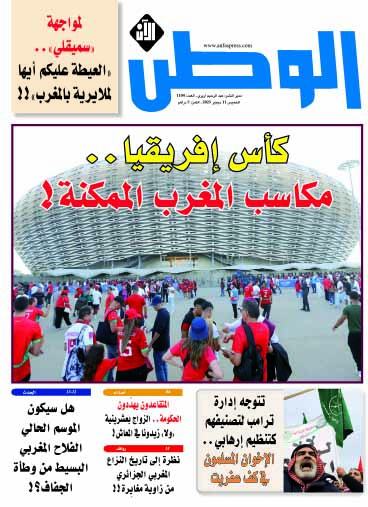موضوع معقد له علاقة بالخلفيات الثقافية، وبالمصالح الظاهرة والخفية عند أشخاص أو تنظيمات. بل وهناك من يتعامل بسذاجة مع الموضوع.
أن يقع الحديث عن القبيلة ويتم لفت الانتباه إليها كتنظيم بشري ما قبل نشوء الدولة، فلذلك إشارات خطيرة، أبرزها أننا أمام إعصار أو زلزال سيضرب مؤسسات الدولة، والانتهاء معها والعودة الى القبيلة كمجال للاحتماء!
لعل البعض ينظر إلى القبيلة كنطاق فلكلوري أو كحنين إلى زمن ماض، حيث كان البعض يرتع في البساتين ويحضر الولائم والمواسم والأعراس في نطاق القبيلة.. لكنه، لا يدري شيئا عن باقي الخلفيات.
أنثربولوجبا نشأت القبائل بين جماعة من البشر على مساحة جغرافية محددة، تتسع أو تضيق حسب شروط القوة أو الضعف. ومن عدد من الناس يجمع بينهم عرق أو سلالة أو جد مشترك.
ليس لهم من تنظيم قانوني غير العرف، أي ما تعودوا عليه، وهو معرض للمزاج وتوازنات القوى المتواجدة داخل القبيلة، بحيث إنها لا تكون على انسجام تام أبدا..
فالخلافات إذا ما ظهرت، تحل تلقائيا لصالح القوي، أو تعرض على شيخ له نفوذ، أو على جماعة من الأشخاص يمثلون التوازنات الداخلية.
لا تسامح داخل القبيلة مع "البراني" الذي يورّث هذه الصفة "المشينة" لذريته..
كما يمكن للقبيلة عقد تحالفات مع قبائل أخرى مجاورة، سواء لمواجهة خصوم مشتركين، أو استغلال الماء والأرض والغابة الخ.
القبيلة لا تعترف بالدولة سوى تحت الإكراه كما ظل يحدث في تاريخ المغرب منذ عهد الأدارسة.
وإذا ما عصت القبيلة الحكم المركزي، ينعث ذلك بـ"السيبة" كما في سجلات مؤرخي السلاطين. ولكن نفس الموقف ينعث من طرف جهات أخرى بـ"الثورة" أو "العصيان" المشروع، وكانوا يجدون المبرر لذلك، سواء بسبب الخروج عن "الشرع" أو عدم القدرة على مواجهة الغزو الأجنبي كما حدث مع البرتغال أو الإسبان الخ.
وأحيانا كان ينجح "العصيان" ويلتف حوله الناس، ويكون ذلك نواةً لتشكيل دولة جديدة، تدخل بدورها في نفس دوامة دول سابقة.
القبيلة نقيض الدولة، الأولى ترعى عناصرها والمنتمين لها، ليس لديها قانون واضح، ولا تقوم على مؤسسات.. بينما الدولة تنظيم حديث رغم ما ظهر من بوادره في زمن سابق كحالة مدن الاغريق مع بعض التحفظ (...)، تقوم على فصل السلط وتوازنها، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية والمراقِبة، السلطة القضائية.. ويمكن إضافة سلطة الإعلام وسلطة المجتمع المدني.. ويطول الحديث عن هذه السلط وما مدى تداخلها، وصلاحياتها ونجاعتها.. لكن عنصر المواطنة ما يجمها كلها. وكذلك إعطاء الأهمية للمواطن (ة) الفرد في حريته الانتخابية. أي أن شرعية مؤسسات الدولة تستمدها من الانتخابات..
هذا على المستوى النظري، وقد وقع تطبيقه على نطاق واسع في العالم، وهناك نماذج ناجحة في هذا الشأن، على الأقل تحد من الخلافات، وتمنع نشوء الحرب الأهلية، ويمكن الحديث هنا عن تجربة فيدرالية سويسرا مثلا..
صحيح أن الديمقراطية تجربة ناشئة في حياة البشرية، وهي تتعرض للطعنات باستمرار من طرف اللوبيات ومن لا مصلحة لهم فيها ومن طرف من ينقُضون وعودهم الانتخابية.. كما تتعرض للنقد، بحيث إنها لم تعد أفقا يلبي طموح جميع المواطنين، ويمكن ذكر حالة فرنسا بهذا الصدد، حيث إن المنتخَب يصوت على قرارات يرفضها الشارع! ولكن، رغم ذلك فالمجال مفتوح للجميع، سواء حق التعبير أو الاحتجاج أو تشكيل الأحزاب ودخول غمار الانتخابات الموالية وتغيير موازين القوى سلميا..
ما وفرته الدولة من مساواة بين المواطنين، لا يمكن مطلقا للقبيلة أن تعرفه.. ومن يدعم مفهوم القبيلة ويعلي من شأنه إما أنه جاهل للعواقب، أو يظن الأمر مجرد مزحة ولهو وفرجة. وكان أحد وزراء الداخلية في المغرب مفتونا بهذا الأمر لغاية خبيثة في نفسه.
لا يمكن في المدينة أن تجد أذانا صاغية لمفهوم القبيلة وتقبّله، وخاصة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، حيث تمازجت العناصر، وشكلت مجتمع المواطنة، والقبيلة مجرد ذكرى عند كبار السن عندما يتحدثون عن "لبْلاد".. أما في القرى فمازال الحديث عنه جاريا، لكنه يخفت يوما عن آخر، ولا مستقبل للقرية أو للقبيلة، من يظن ذلك، كمن ينفخ على الرماد.