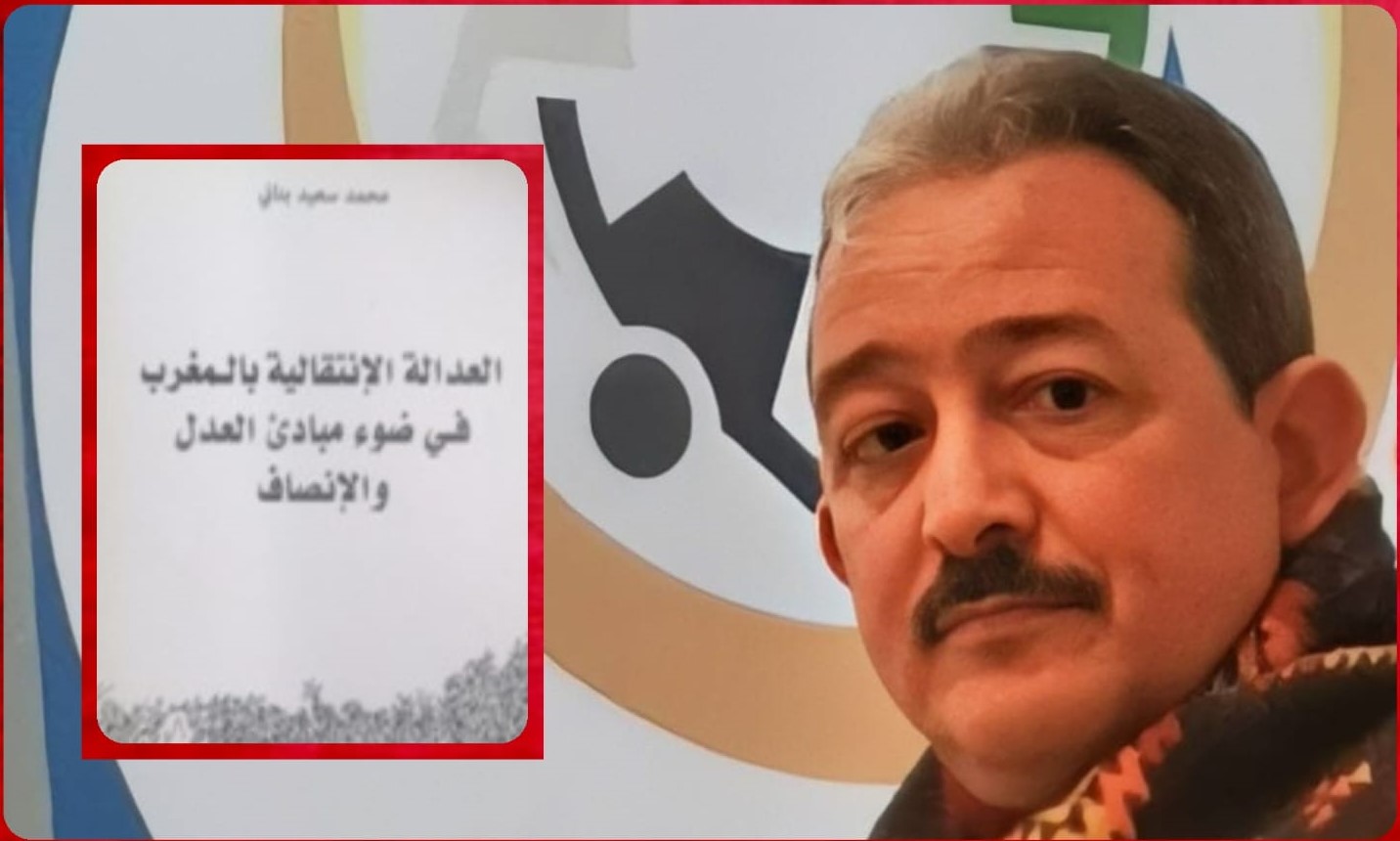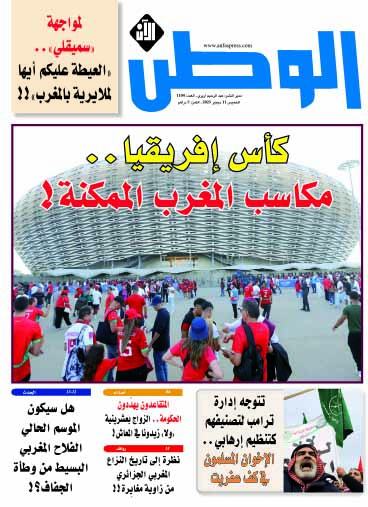نقدم في قراءة متأنية لكتاب " العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء مبادئ العدل والإنصاف"، لمؤلفه الدكتور محمد سعيد بناني، الكاتب والباحث والقاضي والحقوقي المغربي، والمدير السابق للمعهد العالي للقضاء وعضو هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال، ومسؤولا في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وشغل العديد من المناصب والمهام القضائية التي تقلدها طيلة مساره المهني، وكان عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011. ومن ضمن الإصدارات التي نشرها:
"موسوعة فقهية في قانون الشغل" من خمس أجزاء (سبعة مجلدات)؛
"عقد العمل بالدول العربية"؛
"المجلس الاستشاري ولغته"؛
"دستور 2011: قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف"؛
وأخيرا نشرت له ضمن العدد 113 من (سلسلة مواضيع الساعة) عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد)، كتاب بعنوان "التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟"؛
أما كتاب "العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء مبادئ العدل والإنصاف" الذي نشرت ووزعت طبعته الأولى عام 2016، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، قامت بطبعه مطبعة الأمنية بالرباط، يقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط، وهو عمل بحثي وتوثيقي مخصص لموضوع التعويض في تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، سياقا واجتهادا وبناء وتقعيدا، لأحد أبرز المختصين المغاربة في القانون الاجتماعي.
العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء مبادئ العدل والإنصاف
يتألف كتاب "العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء مبادئ العدل والإنصاف"، من إهداء خص به المؤلف "المغرب الذي يعشقه"، ثم أتبعه بكلمة فريدة وضح فيها المقصود من استعماله لمفهوم "الهيئة" والقاسم المشترك بين "هيئة التحكيم.." و"هيئة الإنصاف.."؛ (وذلك من منطلق الفقرة الأولى من المادة 17 من النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تنص على أنه،" يتولى فريق العمل المكلف بجبر الضرر: مواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة سابقا، فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وذوي الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف"). ص: 5
بعد ذلك أدرج مقدمة تقع في 7 صفحات من الصفحة 7 إلى 13 التي حررها في شهر مارس 2015، أتبعها بقسم تمهيدي خصصه لثمان مقدمات منطقية كبرى - تمتد من الصفحة 15 إلى 62 - انبنا عليها مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، انبثقت من إرادة ملكية، واكبت محطات عمل هيئتي التحكيم.. والإنصاف..، فمن جهة تروم (الطي النهائي العادل والمنصف والحضاري لهذا الملف، وتعبئة كل الطاقات لاستكمال بناء دولة الحق والقانون الذي يعد خير حصانة ضد كل أشكال التجاوزات)، ص: 7، ويزيد في توضيح ذلك بالقول:( إن التوازن المتبصر للعدل الصائب في العدالة الانتقالية يتميز بالتفرد، وهنا تكمن أهميته، لأنه انطلق في تنوعاته من فريق متجانس، يتبنى الأخلاق في سياق حضارة تتجلى في أسمى معانيها، حتى يستطيع أن يبعد التقادم وأن يخرق مبدأ عدم رجعية القانون، وأن يبعد القواعد المسطرية المعرقلة للوصول إلى الحق، فالعدالة الانتقالية بالمغرب تحتل مكانة متميزة في مجال التحليل، بمنطق قد لا يبدو قويا بالنسبة للبعض، الذي لم يتبن عقلانية الهيئة). ص:10، كما تروم من جهة أخرى "إعادة الاعتبار لكرامة الضحايا، ومواساة عائلاتهم، وتحقيق المصالحة السمحة الكاظمة للغيظ"؛ ويعلل ذلك في الصفحة 10 بالقول:( لأنه من الصعب، بل من المستحيل أحيانا، تحقيق العدالة المثالية، بتعصيب العينين وحمل السيف في مواجهة الجميع بكفتي ميزان متساويتين، للقول بأنك عادل، إذ أن ذلك قد يحيلك بالعكس، إلى مناطق خطرة، لن تحقق فيها العدل المبتغى، فالهيئة عندما كانت "تشرع" أو "تجتهد"، فإنها كانت أمام وقائع وحالات ذات مضامين اجتماعية مختلفة ومتعددة، انعدمت فيها الممارسات الأخلاقية الواجبة
المتابعات الزجرية). مضيفا: ( لقد كان هاجس الهيئة هو ترجيح الحقيقة الواقعية على الحقيقة القانونية، وهذه إحدى نقط القوة في العدالة الانتقالية بالمغرب)، وهي بذلك خلقت لنفسها مقتضيات إجرائية؛ واستقطبت مبادئ متداولة، لكنها سمت بها، وجعلتها مفاهيم حقوقية..؛ وأدارت ظهرها لمعايير المسؤولية الجنائية ..؛ وأبانت بصفة جلية بأنها لا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات، مستحضرة نداء الملك من "أن المغرب قد أقدم بحكمة وشجاعة، على ابتكار نموذجه الخاص، الذي جعله يحقق مكاسب هامة، في نطاق استمرارية نظامه الملكي الدستوري الديمقراطي"، و"أنه يستشعر نسبية بلوغ الحقيقة الكاملة، التي تمتنع حتى على المؤرخ النزيه، وبأن الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله سبحانه"، وهو ما تم التأكيد عليه سلفا. فكان النداء الملكي إشارة قوية، دعمت عزيمة الهيئتين في تطوير مفهوم العدل والإنصاف، ويجزم المؤلف القول بأن:(ما قامت به الهيئة من تطوير لهذه المفاهيم وغيرها، وما شيدته من أبراج تطل منها لانتقاء أجود المقتضيات الحقوقية، المساهمة في إرضاء الضحايا أو ذوي حقوقهم، وفي طي صفحة الماضي المؤلم، يعتبر إثراء كبيرا لمجال العدالة الانتقالية بصفة عامة) ص:8؛ مضيفا:( إلا أننا نرى بأن استعمال هذه المفاهيم ضمن النظام القانوني برمته، سيشوش، في اعتقادنا، على هذا الأخير. وبذلك نفضل القول بقلب النظام القانوني إلى نظام حقوقي في مجال العدالة الانتقالية، ولا يمكن القول في هذه الحالة بوجود تناقض بين الحق في العدالة العادية وبين الحق في العدالة الانتقالية، وإنما نحن أمام نظامين مختلفين، تتميز فيه هذه الأخيرة، من منطلق العوامل التي انطلقت منها أو أحاطت بها، بالقرب من المثالية). ص:9
المقدمات المنطقية الكبرى لمسار العدالة الانتقالية بالمغرب
هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وهيئة الإنصاف والمصالحة:
في خطاب بتاريخ 9 أكتوبر بمناسبة افتتاح الملك الراحل الحسن الثاني السنة التشريعية 1998-1999:(...إن المغرب اختار لأن يكون ملكية دستورية بكل ما في الكلمة من معنى، وأساس هذا المعنى هو: العدل واحترام حقوق الإنسان، وإننا نريد، وعزمنا أكيد، أن نطوي نهائيا في غضون الستة أشهر المقبلة ملف حقوق الإنسان).
بعد ذلك أصدر الملك محمد السادس أمره بإحداث هيئة تحكيم مستقلة بجانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتحديد التعويض المترتب عن الضرر المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق، وفي خطاب العرش 30 يوليوز 2000، صرح بالقول:( وفي هذا السياق الرامي إلى تركيز دولة الحق والقانون أولينا عناية خاصة لحقوق الإنسان، وأحدثنا هيئة مستقلة ... لتعويض الضحايا حرصنا على أن تعمل بكامل العدل والإنصاف..).
وبمناسبة استقبال جلالته لأعضاء المجلس الاستشاري.. وأعضاء هيئة التحكيم.. وذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 دجنبر 2000، أعرب باقول:(.. نعرب عن كبير تنويهنا بما تحلى به أعضاؤها من حكمة وتجرد وموضوعية في معالجتهم لقضية شائكة، مؤكدين عزمنا الراسخ على تعزيز هذه اليئة بجميع الوسائل المادية والبشرية، من أل الطي النهائي العادل والمنصف والحضاري لهذا الملف، وتعبئة كل الطاقات لاستكمال بناء دولة الحق والقانون الذي يعد خير حصانة ضد كل أشكال التجاوزات).
وبتاريخ 7 يناير 2004 وشح الملك أعضاء هيئة التحكيم بأوسمة ملكية، وأعلن عن تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة؛ التي صرح عضوها أبان الأستاذ أحمد بنيوب، قائلا:( لقد تحقق شوط مهم جدا مع هيئة التحكيم ولكن الملف لم يغلق... فبالموازاة مع أعمال الهيئة بقيت الطلبات العادلة والمشروعة للضحايا وعائلاتهم وممثليهم والحركة وسائر القوى المجتمعية المندرجة في مسار الانتقال الديمقراطي المغربي، وبذات الدرجة، وبعد ذلك وقبله بقي حق المجتمع برمته وحق الدولة في طي عادل للملف).
التنصيب قال الملك:( ومع استحضار اختلاف التجارب الدولية في هذا المجال، فإن المغرب قد أقدم بحكمة وشجاعة، على ابتكار نموذجه الخاص). ص:21.
مفاهيم أساسية لمنطلق عمل هيئة التحكيم وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، ومنها:
التحكيم في العدالة الانتقالية من طبيعة خاصة؛ حيث أثار نقاشا فقهيا بشأن طبيعته القانونية، إذ أن فريقا يرى أنه من طبيعة اتفاقية، وفريق ثان يرى أنه ذو طبيعة قضائية، وفريق ثالث يعتبره ذو طبيعة مختلطة أو مزدوجة...، فإن الواقع هو أن هيئة التحكيم المستقلة، وهي تحمل صفة التحكيم في التسمية المعطاة لها، لم تنشغل بالتقسيم الفقهي لطبيعتها القانونية، لأنها تعتبر نفسها
مستقلة عن المقتضيات الواردة بشأن التحطيم في قانون المسطرة المدنية، وأنها تنتمي إلى عدالة من طبيعة خاصة، وهي العدالة الانتقالية. يتقدم إليها الضحية أو ذوي حقوقه.. بطلب مع إشهاد كتابي للتحكيم والقبول بقراراتها التي لا تقبل الطعن ونافذة. وبعد أن حلت هيئة الإنصاف والمصالحة محل هيئة التحكيم قبلت الطلبات دون إشهاد كتاب، واعتبرت بأن مجرد تقديم طلب في الموضوع أمر كاف لقبول التحكيم لديها، وعلى اعتبار أن اختصاصاتها غير قضائية. ص: 27 و28.
الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاغتراب الاضطراري:
فعرفت الأول على أنه "التصرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة، والمتمثل في أخذ شخص معين بدون وجه حق وسلب حريته واحتجازه.. فيظل في حكم المجهول.. مع حرمانه من كل حماية قانونية؛
أما الاعتقال التعسفي؛ احتجاز تقوم به أجهزة الدولة دون مراعاة الشروط الجوهرية والإجرائية المتعلقة بسلب الحرية، بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية سياسيا أو نقابيا أو جمعويا؛
كما تم تضمين الاختفاء القسري حالات الاغتراب الاضطراري؛ حيث وجد بعض الأشخاص أنفسهم مضطرين للجوء إلى خارج الوطن، وأحيانا حتى داخله، بسبب ما كان يتهددهم من مخاطر لمشاركتهم في الحياة العامة..، ودون حماية قانونية.
العدالة الانتقالية بالمغرب عالم متشابك استوجب التفكير بمنطق المفاهيم المتطورة:
إن الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة هي التي قادتها إلى الانتقال إلى اللغة الحقوقية، التي أبانت عن تقاطعات تشغل ذهن الهيئة؛ ولقد مر تنظيم نظام الهيئة من مرحلتين؛ الأولى، من قبل هيئة التحكيم، التي أصدرت النظام الداخلي، والأخرى، من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت النظام الأساسي. واعتدت الهيئتين اللغة الحقوقية الوثيقة الصلة بمبادئ العدل والإنصاف، وهي مبادئ حقوقية نتيجة تراكمات معرفية، بدل اللغة القانونية.
من دولة القانون إلى دولة الحق:
كانت مرجعيتها متمثلة في الخطاب الملكي بتاريخ 9 دجنبر 2000، الذي جاء فيه التأكيد على العزم الراسخ على تعزيز الهيئة بجميع الوسائل المادية والبشرية، من أجل الطي النهائي العادل والمنصف والحضاري لهذا الملف؛ تعبئة كل الطاقات لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، الذي يعد خير حصانة ضد كل أشكال التجاوزات. ص:41
مع المفاهيم الحقوقية، فالهيئتان معا، عملتا على ملاءمة الأسلوب بالموضوع، لتلتحم هذه الملاءمة بالحق أكثر من القانون، والاقتراب من المثالية الخصوصية الموصلة إلى الحق؛ فتم ربط القانون بالعدالة والإنصاف.
ربط الحق بالقانون:
يقول الأستاذ إدريس العلوي العبلاوي :" تبدو الصلة وثيقة بين القانون والحق، فالقانون باعتباره مجموعة من القواعد القانونية يفرض بذلك نظاما معينا، وهو الذي يخول الحق فيضع بين يدي الشخص سلطة تمكنه من أن يعمل على وجه معين في علاقته بغيره". ص:46
فطرح السؤال الأساس؛ عن أي حق نتحدث؟ حيث تم التوصل إلى الحق في التعويض بمفهومه الواسع يقابله الحق في طي صفحة الماضي المؤلم.
الحق كعدالة:
يرى المؤلف أنه عندما يطرح السؤال ببساطة أمام العامة:(ما هي العدالة؟ فإن صمتا مطبقا يخيم برهة، ثم تتقاطر الجمل بنبرات مختلفة، وبمفردات، وبأساليب قد تتسم بالفظاظة أو بالشراسة.. غلخ، فالإنسان يبقى صامتا أمام طلب تعريف العدالة، ليفاجئك الآخرون، "إذا كنتم تزعمون الدفاع عن العدالة ولا تعرفون معناها ، فأنتم جهلاء، مخالفون للصواب، فاصمتوا إذن، وانسحبوا، واتركوا العارفين بها يشتغلون"). ص:49
اعتماد مبدأ العدل في العدالة الانتقالية:
يستشهد المؤلف في هذه المقدمة 7 بنص المادة 22 من النظام الداخلي لهيئة التحكيم، بالنظر في الطلبات طبقا لقواعد العدل والإنصاف، وهو ما ورد في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، إلا أن ما يجب الانتباه له في هلتين المادتين، كونهما لم تصدرا عن السلطة التشريعية (المفهوم المتميز للعدل والقانون في مجال العدالة الانتقالية؛ ذلك أن العدل بصفة عامة يتجاوز القانون، ومفهوم العدل أوسع من مفهوم القانون، والعدل في العدالة الانتقالية خارج نبدإ التمايز، ونابع عن تعاون مجتمعي ناجع، ومن خلال التوازن المتبصر للعدل الصائب في العدالة الانتقالية). ص:52 إلى57
الحــق كإنصـــــاف:
رجحت الهيئة المنطق الحقوقي، الذي لم يعد يفصل لديها بين الحق والأخلاق، بدل المنطق القانوني، فسمي أعضاء الهيئة ب"المشرعين الحقوقيين" ثم ب"القضاة الحقوقيين"، الذين كانوا مطوقين بالوصول إلى الحق كإنصاف في مختلف مراحله، أي عند وضع "القواعد".. وخلق "الاجتهادات" من منطلقات حقوقية تعتبرها الهيئة عقلانية وصائبة، فالهاجس هو إيجاد عدالة لم تكن قواعدها قائمة سابقا، ولكنها عدالة تم تحضيرها فجأة من قبل حقوقيين. ص:58
هذا الوضع المتفرد، طرحت تساؤلات بشأن مفهوم الإنصاف؟ حيث اعتبره البعض "قانون عالمي" يطال الجميع، وبذلك يقلص الهوة القائمة في القانون، ذلك أن ضرورة اللجوء إلى الأمن يمكن أن يؤدي بإبعاد القانون، المتسم بالجمود، عن العدل. ولهذا فإن "الإنصاف" أداة بإمكانها أن تقلص الهوة، وتتأثر، نوعا ما، من القانون لصالح الإنصاف، إذ القانون قد لا يكون عادلا لفئة من الناس.
أما الباب الأول، فموسوم ب:
"في العدالة الانتقالية"
ضمن المؤلف هذا الباب الانطلاقة نحو العدالة الانتقالية بالمغرب كابتكار لنموذج خاص، يستحضر عدة جوانب(سياسية، حقوقية ومجتمعية)، في سياق خياري الخلق والتأويل، ومن منطلق مبادئ العدل والإنصاف، التي تتطور من منبع المقدمات الثمان الكبرى السابقة الذكر للهيئة، لإرضاء الضحايا أو ذوي الحقوق، وطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، وما كان ذلك أن يتم إلا باعتماد العدالة الانتقالية على منطق وإيديولوجية متميزين. ولتوضيح ذلك بدقة كبيرة قسمه إلى ثلاثة أقسام، من الصفحة 63 إلى 128، وهي:
القسم الأول:
الانطلاقة نحو العدالة الانتقالية بالغرب:
قسم مكون من أربعة أجزاء من الصفحة 63 إلى 81، وهو كالتالي:
ماهية العدالة الانتقالية بالمغرب، آلية تحكيمية من نموذج خاص، أي (العدالة الانتقالية والعدالة في المرحلة الانتقالية؟؛ وكل تجربة لها خاصيتها وخصوصيتها؛ على اعتبار أن العدالة الانتقالية هيئة غير قضائية، كما أن منحى العدالة الانتقالية لا ينسجم مع القواعد القانونية؛ بينما العدالة الانتقالية بالمغرب تفوق الموجهات الواردة دوليا)؛
العدالة الانتقالية والقانون الطبيعي، أية علاقة؟(الكونية في استنباط مثالية العدل من مبادئ القانون الطبيعي؛ القانون الطبيعي يكمن في الإنسان)؛
سمو مشروعية العدالة الانتقالية بالمغرب على شرعية عدالة القضاء، بمعنى:(العدالة الانتقالية حارسة للشرعية الحقوقية؛ باعتبار هذه الأخيرة إطار ثقافي كوني؛ مظهر العقلانية الشرعية في العدالة الانتقالية بالمغرب؛ من الشرعية إلى المشروعية التي تخص محاكمة المشروعية للقانون وللحق، وتموقع المشروعية ضمن السياسي والحقوقي)؛
بينما خصص الجزء الرابع لإشكالية ذات أهمية قصوى في فهم الموضوع ألا وهي: هل أنشئت العدالة الانتقالية بالمغرب لمواجهة أزمة العدالة؟
القسم الثاني:
المسلسل العام للعدالة الانتقالية بالمغرب:
ويتألف بدوره من أربعة أجزاء بسطها في الصفحات من 82 إلى 100، كما يلي:
العدالة الانتقالية أمام مسلسل "التشريع" المتمثل في (معطيات نظام العدالة الانتقالية بالمغرب؛ وضحايا الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في قلب العدالة الانتقالية؛ والتخلي عن فكر المؤسسة القضائية)؛
سلطة العدالة الانتقالية في استنباط الحلول، من خلال السؤال الجوهري التالي(ما مدى سلطة العدالة الانتقالية في استنباط الحلول؟؛ وهيمنة "الاجتهاد" في مجال العدالة الانتقالية)؛
القبول بمبدأ العدالة الانتقالية في مجتمع حضاري متسامح، يروم الطي النهائي لملفات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، والمراد بها الطي الحضاري لملف الأحداث المؤلمة؛ على اعتبار أن تسامح المغاربة ترسيخ للهوية المغربية، لما تحقق من تطور حضاري لمبادئ التسامح في مجال العدالة الانتقالية بالمغرب؛
تربة العدالة الانتقالية بالمغرب، ممثلة في إدراج المبررات الغائبة في العدالة الانتقالية، وسمو الأخلاق والثقة في العدالة الانتقالية في مواجهة الشعور بالإثم.
القسم الثالث:
منطق العدالة الانتقالية وإيديولوجيتها:
أفرد لهذا القسم الصفحات من 101 إلى 125، عبارة عن 5 أجزاء، معتبرا:
العدالة الانتقالية دينامية بين الهدف وتأويله، من خلال اعتبار أن نموذج العدالة الانتقالية كبديل للعدالة العادية؛ وخارج مفاهيم "الرجحان"؛ وأن لا ثمن لها؛
مع استقامة منطق الفكر الحقوقي مع مبدإ العدالة الانتقالية؛ حيث إكساب مبادئ العدل والإنصاف عناصر متميزة، إلى جانب الدوافع الرامية إلى تحضير منطق العدالة الانتقالية؛ أي المنطقين القانوني والحقوقي، والتزام وحدة المنطق في مقررات الهيئة؛ كضرورة، ينضاف إليه الالتزام الشخصي بالمنطق الناجح للهيئة؛
اعتماد وحدة ومرجعية العدالة العادية والعدالة الانتقالية في بناء العدل والانصاف لا يفيد وحدة الاجتهاد؛ حيث العدالة الانتقالية مؤسسة لوضع حد للحيرة أمام المبادئ أو المفاهيم غير المحددة؛ والتوفيق بين السلطة التقديرية والتأويل في العدالة الانتقالية؛
العدالة الانتقالية في خضم القيم الحقوقية، وذلك بتضمين القيم في مبادئ العدل والإنصاف؛ وإبراز صور العدل والإنصاف في مرآة واقع العدالة الانتقالية وقيمها؛
"إيديولوجية" العدالة الانتقالية بالمغرب كإطار لفكر، من خلال أخلاقيات سياسية وقانونية وحقوقية، على اعتبار عدالة ذات "إيديولوجية" معينة؛ وإظهار المستوى المؤسساتي للعدالة الانتقالية، وممارسات متميزة لـ"أيديولوجية" متميزة في مجال العدالة الانتقالية، واعتباره لنظام مبادئ العدل والإنصاف في خطاب العدالة الانتقالية خطاب "إيديولوجي"، باعتبار العدالة الانتقالية وضمان "المصلحة العامة الموسعة" لصالح الوطن.
بينما عنون الباب الثاني، ب:
"في مبادئ العدل والإنصاف"
ضمنه المؤلف منطلق مبادئ العدل والإنصاف، واللجوء إلى مبدإ الإنصاف كمفهوم واسع جدا، يتخطى كل التراكمات الفكرية والإيديولوجية، المترسبة في ذهن الساسي أو القانوني أو الحقوقي، بحيث يصبح عمل الهيئة تمرينا من طبيعة خاصة، يقود إلى فن استعمال المعارف النظرية لحل إشكالات مجردة في مجال معين، وفق عمليات ذهنية وعقلانية ذات ارتباط بالإثبات، بهدف السعي إلى إيجاد الحلول الرائدة في سياق العدالة الانتقالية، وهو ما خول لهذه الأخيرة فضاء حرا في اتخاذ القرارات. وقسمه إلى خمسة أقسام على امتداد الصفحات من 129 إلى 269، وجزأه كالتالي:
القسم الأول:
منطلق مبادئ العدل والإنصاف:
عالجه من خلال 7 أجزاء، تتشكل من:
البحث في المبادئ العامة من قبل الهيئة في مجال العدالة الانتقالية، انطلاقا من معنى المبدإ، ومكانة العدل والإنصاف في العدالة الانتقالية، وابتعادهما عن اللغة المتداولة؛
إحلال مبادئ العدل والإنصاف في العدالة الانتقالية محل القواعد القانونية، وهو ما يبرز من خلال فن "التشريع" لدى الهيئة، وكيف ساهم نظام القيم في إحلال العدالة الانتقالية محل العدالة العادية، والفطرة السليمة عند الهيئة؛
مبدأ "القواعد العامة" للهيئة في خضم المبادئ العامة؛ تعني "مفاهيم وقواعد عامة" ذات الارتباط بالعدالة الانتقالية، في حين تتعدد المبادئ العامة في الشكل وفي الجوهر، وتطبيق "القواعد العامة" للهيئة على الأحداث موضوع النظر من قبلها؛ حيث إن شروع عمل الهيئة كان محددا بأمر ملكي، اعتبارا لكون "القواعد العامة" في العدالة الانتقالية تمنح حقوقا جديدة، ذلك أن تأثير "القواعد العامة" للهيئة كان على مجموع السلطات؛
مبادئ العدل والإنصاف في العدالة الانتقالية بالمغرب أكثر شساعة؛ حيث تجاوز المبدإ للمفهوم المتداول في المؤسسات الأخرى، ذلك أن مبدأ العدل والإنصاف مجال خصب لضبط الحقيقة؛
إبعاد المتداول في "الشريعة العامة للقانون"، باعتماد مبدأ عدم رجعية القانون، التقادم، الحكم بأكثر مما طلب، وأداء الشهادة دون يمين؛
مبادئ العدل والإنصاف تخفض من صرامة القانون الجامد؛ للتمكن من الاقتراب من العدل والإنصاف في التحكيم بصفة عامة لا يفيد التطابق مع تحكيم الهيئة، والمناداة على الإنصاف في العدالة الانتقالية كسلوك ديمقراطي؛
البحث عن عناصر الجواب، وذلك بالتفكير في مدى الحلول النابعة عن القرارات المبدئية، والتفكير في مدى قيمة الحلول.
القسم الثاني:
عمل الهيئة في مجال العدل والإنصاف تمرين من طبيعة خاصة:
وضح ذلك من خلال 3 أجزاء، وهي:
استقلال مفهوم العدل والإنصاف في مجال العدالة الانتقالية، لكون أعضاء الهيئة ليسوا بالضرورة من أسرة العدالة، مع اعتماد معايير التعويض وجبر الضرر من منطلق مبادئ العدل والإنصاف، والبحث الحر للهيئة في مجال العدل والإنصاف، الذي انبثق من إدراك تطلعات العدالة الانتقالية؛ حيث تطور البحث في المبادئ يتطور من خلال النظر في الوقائع، وصعوبة الإدلاء بإجابات مقنعة في كل الأحيان؛
مبادئ قيم العدل والإنصاف من جهة الاستدلال الحقوقي، بمعنى انتفاء تعسفية قيم العدل والإنصاف في مجال العدالة الانتقالية، وتجنب التعسف من قبل الهيئة، واعتماد مباد قيم العدل والإنصاف في مواجهة البحث عن الباعث الصحيح؛
انسجام "القواعد الشرعية" من قبل الهيئة، أي تناسق المبادئ فينا بينها لحل قضايا الأحداث المؤلمة، واللجوء إلى إرادة "المشرع"، باعتماد المنهج الغائي للهيئة؛ وذلك لتحقيق الأهداف من خلال التأميل الموسع لــ "القواعد العامة"، وتطبيقات المنهج الغائي لدى الهيئة.
القسم الثالث:
العمليات الذهنية في عقلانية العدالة الانتقالية وارتباطها بالإثبات:
مكون من 7 أجزاء، تتشكل من:
العمليات الذهنية المؤدية إلى مضامين المقررات التحكيمية؛
توجه الذهنية الحقوقية نحو عدالة مثالية؛
العمليات المتتالية لإصدار المقررات بـ (وضع الوقائع في سياق حقوقي، ورجحان الحقيقة الواقعية على الحقيقة القانونية)، إلى جانب التحقق من الوقائع وتقديرها؛ لتكوين القناعة لدى الهيئة من خلال (إدراج مبدإ الإنصاف في لإثبات، والانتقال من الإقناع الشخصي إلى الحقيقة الموضوعية)؛ ثم الانتقال إلى مسلسل تطبيق المعايير في القضايا المعروضة على الهيئة باعتماد(روح العدالة الانتقالية كروح فئوية؛ وعدم الإقناع لا ينبثق من الحيثية ولكن من غموض مفهوم العدل والإنصاف)؛
القواعد ذات العلاقة بالإثبات؛ حيث ابتعاد الهيئة عن قواعد الإثبات العادية في مجال العدالة الانتقالية، أي(اقتحام العدالة الانتقالية لمساطر لا علاقة لها بمساطر المحاكم؛ والحرية في طريقة التفكير في مجال اٌثبات)، وارتباط تطبيق العدالة الانتقالية بعامل الزمان؛
وعي الهيئة بضرورة تطوير الهيئة للمسطرة الاستقصائية في المجالين القانوني والقضائي، من خلال تطوير المسطرة الاستقصائية وتبيان مزاياها، باعتبارها حماية من تعسفات المساطر لصارمة في العدالة الانتقالية، واعتبارا لمجال القرائن المطلقة أمام الهيئة، وإدارة الإثبات من قبل الهيئة(اللامبالاة بشأن الطرف الملزم بعبء الإثبات، واقتحام الهيئة لمجال الإثبات لا يبعد عنها سمة الحياد)؛
منهج التأويل لدى الهيئة، خاصة تأويل التوجيهات الملكية وروحها المنشئة للهيئة من خلال اعتماد "الأعمال التحضيرية" يقود إبلى التأويل وفق منهج منطقي معين للأدلة المتناسقة؛ ودور المنطق الجدلي في العدالة الانتقالية، نظرا لمراعات ذلك لأهداف المقدمات الثمان الكبرى للعدالة الانتقالية بالمغرب المشار إليها سلفا، كما أن المنطق المتجدد في العدالة الانتقالية منطق استنتاجي، مع خلق عقلانية في مواجهة التشريعات العادية، وذلك نظرا لاستيعاب العدالة الانتقالية بالمغرب للنظرية الغائية من إنشائها؛ ولكون المرجعية العقلانية في العدالة الانتقالية خيار أساسي لغايات معينة؛
التأويل البرغماتي (الذرائعي) الصائب لدى الهيئة مع اعتماد التأويل الضيق للحالات والأحداث.
القسم الرابع:
مسعى مبادئ العدل والإنصاف في إيجاد الحلول الرائدة في مجال العدالة الانتقالية:
تتشكل من جزأين، هما:
سلطة التقدير، خول للهيئة ذلك، مع الإدراك الموضوعي والشخصي لمبادئ العدل والإنصاف، وربط تلك السلطة بمبدأ الشرعية، ومنها شرعية التقدير والمحددات الاجتماعية، وفضاء سلطة التقدير وحدودها المؤسسية أي(الهيئة بين نظام القرار وفن "الحكم"؛ واللجوء إلى العدالة الانتقالية وهروب من "العدالة العادية"؛ كما أن "القواع" المحددة من قبل الهيئة لأساس قراراتها يختلف عن مضامين المفاهيم المعتمدة من قبلها؛
السلطة التقديرية للهيئة في سياق مبادئ العدل والإنصاف؛ باعتبارها سلطة واسعة في العدالة الانتقالية، إلى جانب التكوين الوجداني للقناعة من وقائع الطلبات، وإشكالات مبادئ العدل والإنصاف في العدالة الانتقالية أقل منها في العدالة العادية(المرجعية القانونية والمرجعية الاجتماعية).
القسم الخامس:
فضاء حرية الهيئة في اتخاذ القرارات:
تتكون من 7 أجزاء، هي:
مقررات الهيئة ومرجعية "الاجتهاد"؛ منها "الاجتهادات" الأولى للهيئة قرارات مبدئية؛ كتربة لاجتهاداتها؛ سواء "الاجتهادات" الموالية، و"الاجتهاد كحارس لــ "الأمن الحقوقي"، مع تأثير الخطاب الحقوقي الحي في "الاجتهاد"؛
المراقبة الذاتية للهيئة، في غياب فضاء لا يتسم بالتراتبية؛ وإطارا لضمان انضباط معين(مراقبة الهيئة لنفسها وتعليل مقرراتها)؛
مبادئ العدل والإنصاف أوسع من تكييف القانون مع الواقع؛ حيث اقتحمت العدالة الانتقالية الفكر الحقوقي، ل (أن الاستنتاج في العديد من الحالات سيكون عقيما، وأن الهيئة لا تقف صامتة أو متحجرة أمام "قواعد" وضعتها مسبقا، بل تحاول جرد الأحداث
البارزة)، وأخد الوقائع والمقتضيات بعين الاعتبار من خلال تحديدها لطبيعة تلكم الوقائع والأحداث وتكييفها؛ واندراج عمل الهيئة في نظرية التحول؟)، مع تحكم الهيئة في مسار البحث؛
عمليات لإفساح المجال نحو الحلول المناسبة، خاصة عالم القيم في العدالة الانتقالية نابع أساسا عن المجال التطبيقي، وعمليات الحفر للتنقيب على الأحداث كوقائع؛
مبدأ الحياد في العدالة الانتقالية بالمغرب، ويتمثل في قيام التجرد والضمير المحايد؛ حيث يطرح السؤال: فهل يمكن أن نتهم هذا المزيج من الأطراف المعنية، إن صح التعبير، بالانحياز؟؛ ثم إن التساؤل قد يطرح بشأن حياد الهيئة كهيئة تحكيمية، وبالطبع لا يمكن أن يتم ذلك في منطق العدالة الانتقالية إلا بالتكييف الذي منحته الهيئة لنفسها؛
إفساح مجال "التشريع" و"الاجتهاد" في العدالة الانتقالية نحو الرحمة، ذلك أن الجمع بينهما يروم تقديم الحلول المناسبة، خصوصا وأن الرحمة أقوى من العدل؛
من الأمن القانوني إلى الأمن الحقوقي؛ هذا الأخير مجال استثنائي في العدالة الانتقالية(مساهمة الأمن القضائي في تحقيق الأمن القانوني، واعتماد "الأمن الحقوقي" لفائدة قضايا محددة)، في ظل غياب تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق أمام الهيئة، ومساهمة العدالة الانتقالية بالمغرب في "الأمن الحقوقي"؛ حيث ورد في الصفحة 270 قول الأستاذ محمد سعيد بناني:
أم ما سميناه ب"الأمن الحقوقي" في العدالة الانتقالية بالمغرب، قد استطاع أن يخلق انسجاما "اجتهاديا"، كان نتيجة طبيعية لطبيعة المهمة التي رصدت للهيئة، والمتجسدة أساسا في ما يقود إلى طي صفحة الماضي المؤلم، من خلال دراسات معمقة، واجتماعات مستمرة لمناقشة المستجدات، قصد إيجاد الحلول الملائمة، وترسيخ التناسق بين المبادئ والنتائج،.. ونعتقد بأن ما سهل مأمومرية الهيئة في مجال الأمن الحقوقي، أن "الاجتهادات" الصادرة عنها، تجسد في حد ذاتها قرارات مبدئية مكملة ل"القواعد" الصادرة عنها، هذه الأخيرة التي تناسلت فيها المفاهيم والمبادئ، أساسها العدل والإنصاف).
خاتمـــــــة -
كما سبقت الإشارة، فمن خلال تقديم الإصدار يتبن على أنه عبارة عن بحث توثيقي خصص أساسا لموضوع التعويض في تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، التي ركز عليها الكاتب، والكتاب قراءة ورصد لمختص يعد من أبرز المتخصصين المغاربة في القانون الاجتماعي.
يسعى في كتابه "العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء مبادئ العدل والإنصاف"، الذي أثرى ولاشك الخزانة الحقوقية، بإماطة اللثام عن فترة صعبة عاشها المغرب طبعتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولتحقيق العدالة الاجتماعية أثناء المرحلة الانتقالية، كان لزاما على الدولة أن تنهج مجموعة من التدابير من أجل طي صفحة الماضي وتعزيز العدالة والإنصاف والمصالحة، حيث عمدت إلى تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما عمل على تفكيك عنوانه تفكيكا مفاهيميا، بالإشارة إلى أن مفهوم "العدالة الانتقالية" و"الإنصاف"؛ أضاف إلى ذلك في تصديره للكتاب توضيحا مفاهيميا أساسيا خص به عبارة "الهيئة"، موضحا ذلك بالقول: (إن بحثي، إذ يستعمل عبارة الهيئة، فالقصد هو هيئة التحكيم المستقلة ... وهيئة اٌنصاف والمصالحة، وإبراز الإسم الكامل لإحداهما فقط، يكون للضرورة.) ص:5
صفوة القول، إنها قراءة ورصد مختص من داخل مسار تقعيد الاجتهاد واعتماد المقاربة في مجال التعويض في التجربة المغربية من هيئة التحكيم المستقلة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة من بين التجارب الخمس الرائدة دوليا في مجال العدالة الانتقالية، كما يمثل بالنسبة لنا وبدون شك إضافة نوعية للمكتبة الحقوقية وطنيا ودوليا.
يستجمع المؤلف القول حول مؤلفه في ثلاث فقرات رصينة، جعلها خلاصة تعريفية خصص لها خلفية غلاف كتابه، جاء فيها:(إن العدالة الانتقالية بالمغرب انبثقت من إرادة ملكية سامية، مكنت هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وهيئة الإنصاف والمصالحة من اقتحام عالم لا يمكن وصفه بالسياسي الصرف، ولا بالحقوقي الصرف، ولا بالاجتماعي الصرف، ولا بالقانوني الصرف، ولا بالتحكيمي الصرف، ولا بالفقهي الصرف؛ إنه عالم العدالة الانتقالية بالمغرب؛ المتميز بطبيعة خاصة، تتقاطع فيه المبادئ والمفاهيم، وطنيا ودوليا، ولعبت الهيئتان من خلاله أدوارا رائدة، لا تخلو من تعقيد).
ثم يضيف بأسلوب ينم عن "تمغربيت" متجذرة، وعشق المغرب وخصوصيات المغاربة التي تظل مطبوعة على الدوام باستثناءات عبر كل محطات المغرب التاريخية بإيجابياتها وسلبياتها، فيحسن القول: ( وأرى جازما بأن المغاربة أضفوا إلى محاسنهم وصفاء قلوبهم لبنة أخرى إلى التسامح الديني والثقافي، بل وإلى كل أنواع التسامح الواردة ب"إعلان مبادئ بشأن التسامح" الصادر عن اليونسكو، وهي لبنة المصالحة الكاظمة للغيظ، أي التسامح مع الذات، فاقتنعت شخصا بأنه إذا كانت آثار العدالة الانتقالية من الناحية المادية قد تكون، لدى البعض، ذات تكلفة مالية مرتفعة، فإنها تكلفة لا ثمن لها).
على ما سبق، يأتي بالقول في خاتمة مقدمته أنه:( إذا كان نتاج العدالة الانتقالية بالمغرب قد وجد صدى إيجابيا، طيبا؛ لدى جلالة الملك، مؤسس المبادرة فنوه ومجد؛ ولدى المجتمع المغربي بكل فئاته وأطيافه فاستحسن ورحب؛ ولدى الضحايا أو ذوي حقوقهم فأبانوا عن حضارة الصفح، فإن للمغرب، وقد تم استحضار مقاربته في العديد من المنتديات الوطنية والأجنبية، أن يفخر ويعتز بما أنتجه فكره، الذي لم يكن حبيس المتلقي للمفاهيم ليجاريها فقط، بل المجدد لها والمتفوق عليها، ليصبح مرجعا ينطلق من أنه ليس هناك إبداع بالتقليد. وحق له تبعا لذلك أن يرسم على صدر تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب: "صنع بالمغرب - Made in Morocco").