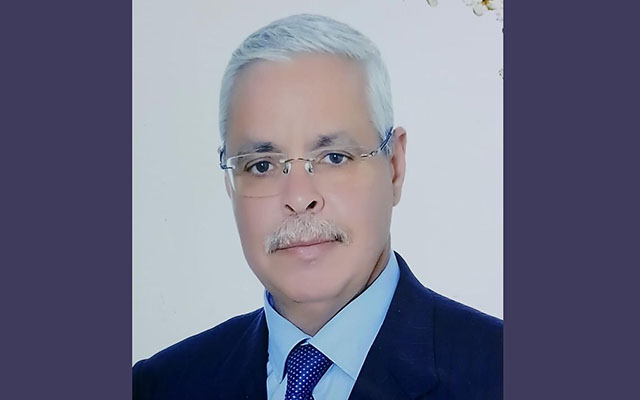حتى نخرج من أي غموض محتمل منا وقوعه. وحتى نكون واضحين، وحتى نتحقق من مفهوم "السنة" أولا، ومن مفهوم "التصوف" ثانيا. ندعو المتصوفة إلى تقديم أي عون ممكن لنا، متى تبين لهم ولمؤيديهم أو لمناصريهم بأننا موغلون في الإساءة إليهم وإلى تشويه صورتهم تحديدا عن قصد. وإن هم فعلوا، فنحن على استعداد تام للتسليم بكل ما يشتغلون به، أو على الأقل للتسليم ببعض مما به يشتغلون! إذ المسألة منحصرة في حدود هذه الآية القرآنية "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".
ولتحديد مفهوم السنة، نؤكد بأن أيا كان، لم يتردد في "انصرافها إلى أسلوبه عليه السلام وإلى طريقته في حياته الخاصة والعامة. والمدينة المنورة كانت أحرص البلاد على السنة النبوية، حتى سميت "دار السنة" -وبها نشأ الإمام مالك- وفي جنباتها المشرفة بدأ مفهوم "السنة" يأخذ شكلا سياسيا واجتماعيا إلى جانب الشكل الديني الأساسي! فالرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بأن من أحدث في المدينة حدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكأن في هذا الحديث إيماء إلى براءة الله ورسوله من كل منشق عن الجماعة، خالع يد الطاعة مؤثر البدعة على السنة".
مما نفهم معه أن السنة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأن "مفهومها" أغنى وأن "ما صدقها" أفقر، لأنه واحد لا أكثر. فصح أنه لا يمكن اعتبار قول غيره، وفعل غيره، وتقرير غيره في الدين سنة بأي وجه من الوجوه. وهذه القناعة ذاتها خاضعة للوصول إليها للمنهج الاستقرائي القائم على المتابعة والاستقصاء. كما سنبين ما تحققنا منه للتو:
1- قال محمد بن إدريس الشافعي في "الرسولة": "وما سن رسول الله، فيما ليس فيه حكم، فبحكم الله سنه"، وكذلك أخبر الله في قوله: "وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله".
2- ما ورد في الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية ليس على وجهه، قال صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
فظاهر الخطاب بين في أن وجوب الالتزام بالسنة أمر موجه من المختار إلى كل مسلم، إنه خطاب عام، لا يستثنى منه أحد، لا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، مما يدرك معه أن السنة غير مضافة إليهم في الحقيقة. فالواقع الذي لا شك فيه، هو أنها مضافة إليهم من باب المجاز. فإن كانوا مهديين راشدين، فبحكم الاتباع، لا بحكم الابتداع. فلا يتصور خروجهم بتاتا عن السنة، بقدر ما يتصور إصرارهم على التمسك بها تنفيذا لأمر المختار صلى الله عليه وسلم. فيكون أمره باتباع سنة الخلفاء المهديين الراشدين، أمرا يقتضي تكملة مسكوتا عنها في الخطاب النبوي المطاع. فقد أمرنا باتباعهم ليقينه الراسخ بأنهم لن يخرجوا أبدا عن سنته. فمن اتبعهم في القول والفعل والتقرير، فكأنما اتبعه صلى الله عليه وسلم. لأنهم يحذون حذوه حذو نعل بنعل كما يقال.
3- في مقدمة تفسير ابن كثير، بعد تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه". قال: يعني السنة، والسنة تتنزل عليهم بالوحي (يقصد على الرسل)، كما يتنزل القرآن (على النبي صلى الله عليه وسلم). إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الشافعي على ذلك بأدلة كثيرة.
فالصحابة أيا كان موقعهم من الصحبة، لا تتنزل عليهم الأقوال والآراء بالوحي. فكيف ندعي أنهم يسنون السنن؟ وكيف نمد هذه القناعة إلى الحد الذي نتكلم عنده عن سنن الأولياء والصالحين! (أقوال! نظريات! ممارسات!)؟
4- عندما نقول "سنة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فمعنى هذا الكلام عند يحيى بن آدم (شيخ ابن حنبل)، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة، وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد"؟
قال عمر بن الخطاب -وهو على المنبر بحضور جمع من الصحابة- "يا أيها الناس: قد سنت لكم السنن، وفرضت عليكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا"! مما يعني أن كل خروج عن سنة رسول الله ضلال وتضليل!
ولم يقف عمر عند هذا الحد، يعني عند حد لا حق فيه لأي كان أن يفرض على المسلمين فروضا جديدة؟ أو يضيف إلى ما سن من السنن سننا جديدة، فقد خرج ابن وهب وغيره أنه قال: "السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا حد الرأي سنة للأمة"، بحيث يقدم أحدهم مفهوما جديدا للتوحيد! ويقدم غيره كيفيات في التعبد بعيدة كل البعد عن سنن المختار صلى الله عليه وسلم.
وكانسجام مع أقوال من سقنا حديثهم عن السنن، وكانسجام مع قول عمر الأخير، يقول الشاطبي في "الاعتصام": "من سن سنة" معناه: من عمل بسنة، لا من اخترع سنة. ثم قال رحمه الله: "من سن سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة، لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة، أو سيئة، لا يعرف إلا من جهة الشرع. لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة -وإنما يقول به المبتدعة، أعني التحسين والتقبيح بالعقل- فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع، وإما قبيحة بالشرع".
يعني أن كل ما لم يثبت عن رسول الله قوله، أو فعله، أو تقريره في الدين، ثم قال به وفعله وقرره غيره، يعتبر لاغيا باطلا ساقطا لا يعتد به! إنه من بدع المحدثات فيه! وليرحم الله إمام المغاربة مالك بن أنس حين يقول ويكرر كلما سمع ببدعة من البدع: وخير أمور الدين ما كان سنة/ وشر الأمور المحدثات البدائع
وماذا عن التصوف الذي لا ننكر وجود أصوله في كل من الكتاب والسنة؟ إنه بوجه عام طريقة سلوكية في التعبد قوامها التقشف والزهد، والتخلي عن الرذائل، والتحلي بالفضائل، لتزكو النفس وتسمو الروح، وهو حالة نفسية يشعر فيها المؤمن المخلص الصادق المتسنن بأنه على اتصال مستمر بالحق سبحانه. وهذا الاتصال كي يتم تحقيقه، والتأكد من صحة وقوعه، لا بد فيه من شرطين بدونهما -كما قال سيد الطائفة البغدادية الجنيد بن محمد القواريري- هما اعتماد الكتاب والسنة في كل ما يتعلق بالدين. يكفي قوله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا"!
والتصوف بالمعنى الذي قدمناه موجزين، متوفرة في الذكر الحكيم والسنة النبوية معالمه المضيئة، ودواعيه المؤيدة للاشتغال به، إنما في حدود الاعتدال والوسطية، بعيدا عن المغالاة التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم قيد حياته بالكافي من الحزم والصرامة والتحذير الشديد من مغبة ما سوف ينتج عنها من ابتعاد عن سبيل الله المستقيم، عملا بقوله عز وجل: "وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله".
ومن تحذيره صلى الله عليه وسلم من المغالاة في الدين ما رواه أبو جحيفة عن والده الذي قال: "آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبدلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعط لذي كل حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سلمان".
قال أبو إسحاق الشاطبي: "وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع، وما يرجع إليه، والضيف بالخدمة والتأنيس والمواكلة وغيرها. والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة، والنفس بترك إدخال المشقات عليها، وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم، وبوظائف أخر، فرائض ونوافل أكد مما هو فيه، والواجب يعطي كل ذي حق حقه، وإذا التزم الإنسان أمرا من الأمور المندوبة، أو أمرين أو ثلاثة، فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها فيكون ملوما".
وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها (أي إنها قليلة). فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا! وقال الآخر: إنني أصوم الدهر لا أفطر! وقال الآخر: إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا! فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا"؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة".
وإن حذر صلى الله عليه وسلم من المغالاة والتطرف الدينيين، فإنه حذر كذلك من "الابتداع" الذي يعني: "إحداث طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية". والحال أنها ليست كذلك، وإنما هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: وضع الحدود، كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبادة. والاقتصار في المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة. والتزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، والتزام العبادات المعينة في أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته.
مع أنه تبث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه أمر الدين والدنيا. وهذا لا يخالف عليه من أهل السنة. فإذا كان كذلك، فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب، أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه، لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم.
قال عبد الملك بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون تلميذ مالك (ت 214ه): سمعت مالكا يقول: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله يقول: "اليوم أكملت لكم دينكم". فما لم يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا".
فالمبتدع إذن: "معاند للشرع ومشاق له. لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة. وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في تعديها -إلى غير ذلك- لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. وإنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثمة طرقا أخر، وليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعين. كأن الشارع يعلم، ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع، أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين"!
فليتأكد القارئ إذن بأن التصوف كزهد وكمجاهدة وكمراقبة وكمحاسبة للنفس من خلال العمل الدؤوب على التخلي عن مذموم الخلق وكالتحلي بمحموده، لا نقابله ولا نقابل أهله بالازدراء والإنكار،، إنما على أساس اتباع السنة والكتاب. أما أن نترك أقوال المصطفى وأفعاله عليه السلام، ونرتبط بقناعات وبممارسات صوفية أساسها الأهواء والاستحسان، بحيث إننا نغض الطرف عما يجري العمل به من طقوس تعبدية ومن آراء أبعد ما تكون عن أي دعم نقلي يؤيدها، فذلك ما لم نقبله ولن نقبله ما حيينا. إذ أننا لا نتحمل التغاضي عن قوله سبحانه: "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون"! ولا التغاضي عن قوله عز وجل: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون..".