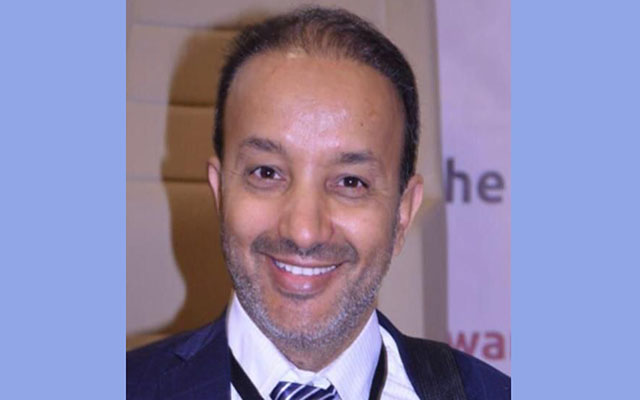دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينين وإدانة الهمجية الصهيونية، تدخل في مجال التعبير عن الضمير الإنساني للمغرب
دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينين وإدانة الهمجية الصهيونية، تدخل في مجال التعبير عن الضمير الإنساني للمغرب تطرح علينا علاقات المغرب مع الشرق الأوسط، كقاعدة أساسية للفهم، ضرورة القبض على "الشيء الأخضر" في هذا الفضاء الذي تسيطر عليه سياسة المشانق!
أما السؤال الضروري هنا، فهو: "هل نحن محصنون ضد الشرق الأوسط؟". هل “الشرق الأوسط” مجرد مصطلح جغرافي غير محدد؟ أليس المغرب، على المستوى الثقافي والتاريخي والسياسي، جزءا لا يتجزأ من هذا الشرق الأوسط؟ ألا يساهم المغرب، بقدر ما، وذلك بإيلاء وجهه شطر الشرق الأوسط، في تكريس هذا الكيان، خاصة أن الأمر لا يتعلق بكيان جيوسياسي وثقافي منسجم، بل بكيان يتكون من أكثر من 20 دولة قومية ذات طموحات ومصالح مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان؟
ألا يعتبر المغرب، تبعا لذلك، شرق أوسطيا ما دامت الإمبراطوريات الأوروبية ما زالت تعتبر مستعمراتها القديمة مجرد بيادق في لعبة شطرنج عالمية؟ أليس الملحق جزءا من النص، كما يقول المناطقة “الشرق الأوسط الكبير”؟ ألا يخضع الشرق الأوسط، ومنه المغرب، للمنطق الاستعماري نفسه، ما دام الغرب “حتى في الأفلام الهوليودية”، يعمل بإمكانية حدوث السيطرة الكاملة على الشرق الأوسط وتفكيك بنياته وإعادة تشكيله والتحكم في مؤسساته؟
ليس في هذه الأسئلة أي كبح للتفاعل بين المغرب والشرق الأوسط، كما أنها لا تحمل أي دعوة ضيقة الأفق لإطلاق قطيعة جغرافية وسياسية وثقافية مع منطقة تتميز بالتحرك المستمر على نحو دراماتيكي.
إن التعامل بنوع من الجدية الشديدة مع الشرق الأوسط يقتضي، أولا، الخروج من “بطن الحوت”، وأن يعيش المغرب مشاكله بمعزل الارتدادات القادمة من هناك، دون السقوط في “وحدة المشاكل” و”وحدة الصراعات”، ودون الانخراط في عض القضايا الإنسانية العادلة، أو الاتكاء على قواعد دولية وجيو سياسية تخرجه من سياقه الإقليمي، وتدفعه دفعا إلى الاحتراب والتنافس العسكري.
فالموقع الجيو-ستراتيجي للمغرب يجعله في تماس مع ثلاث قارات “إفريقيا، أوربا، أمريكا”، ومع ضفتين بحريتين “المتوسطية والأطلسية” يسود فيهما “الجوار الصعب”. وهذا ما يقتضي الاستمرار في نهج “الإقناع المضطرد” للعقلاء في هذا الجوار على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة، فضلا عن تنويع شراكاته، مع الانتباه إلى التحولات التي تعتري العالم.
إن هذا الإدراك يقتضي أن يعمل المغرب خطوة خطوة من أجل البناء الذاتي على أساس الدفاع القانوني والسياسي على قضاياه ومصالحه، ليس على أساس “الهويات القاتلة” أو بالأحرى “الارتباطات التاريخية” أو “القرابات الثقافية والدينية. كما يقتضي هذا الأمر التفكير، بصوت عال ودون أي مركب نقص، في مفهوم الوطن، وتحديد الانتماء إليه، والدعاية له، وخدمة مصالحه، دون الوقوع في الانغلاق.
إن هذا الإدراك يقتضي أن يعمل المغرب خطوة خطوة من أجل البناء الذاتي على أساس الدفاع القانوني والسياسي على قضاياه ومصالحه، ليس على أساس “الهويات القاتلة” أو بالأحرى “الارتباطات التاريخية” أو “القرابات الثقافية والدينية. كما يقتضي هذا الأمر التفكير، بصوت عال ودون أي مركب نقص، في مفهوم الوطن، وتحديد الانتماء إليه، والدعاية له، وخدمة مصالحه، دون الوقوع في الانغلاق.
لا ننكر أن للشرق الأوسط دورا ثقافيا قديما في المغرب. غير أن الاستمرار في التحديق حصريا في هذا الشرق ليس قدرا ما دامت هناك خيارات أخرى يتم القفز عنها.
بالتأكيد ليس من السهل الهرب من الشرق الأوسط. لكن الرسوخ المستمر في الصدى، والإقامة الدائمة في صراع يؤجل التركيز على البيت الداخلي لتحقيق الإقلاع التنموي، والتعامل مع الشرق الأوسط كامتداد عضوى تفوق أهميته أهمية الذات، كلها عوائق موضوعية للتحول المنشود. ذلك أن المغاربة يتفاعلون مع ما يجري في غزة أو بيروت أو دمشق أو عمان أو بغداد، أكثر من تفاعلهم مع ما يجري في العيون أو ورزازات أو الرباط أو الدار البيضاء أو جرادة أو زاكورة. يتفاعلون مع مقتل حسن نصر الله أو إسماعيل هنية أكثر من تفاعلهم مع ملاحقة الفاسدين في البرلمان أو المجالس المنتخبة أو مع ملف نهب ثرواث المغرب من طرف مركب مصالحي على حساب تفقير الأغلبية الساحقة من الشغب المغربي. يتفاعلون مع خطاب المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أكثر من تفاعلهم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وهذا مؤشر قوي على نوع من الاغتراب السياسي التي تتحكم فيه، دون شك، أسباب إيديولوجية وثقافية وتاريخية.
إن نصرة القضايا الإنسانية العادلة، بما فيها دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينين وإدانة الهمجية الصهيونية، تدخل في مجال التعبير عن الضمير الإنساني للمغرب، ومواجهة الظلم وممارسة الضغط بالاصطفاف إلى جانب المقهورين ضد المعتدين والظالمين.
من الممكن أن “نفهم” اهتمام المغاربة بالشرق الأوسط، لما له من حضور ثقافي وديني وعروبي و”قومجي” تاريخي. غير أن القضايا العادلة، التي ينبغي أن نتضامن معها، لا توجد فقط في الشرق الأوسط، بل وُجدت في جنوب إفريقيا ونيكاراغوا والفيتنام والكامبودج وميانمار ، ولم نر أو نسمع أن الشارع المغربي هب للشجب والإدانة والتنديد. مما يجعلنا نطرح هذا السؤال بالقوة: هل تكال القضايا العادلة في العالم بمكيالين؟ هل الإنسان في أمريكا اللاتينية أقل درجة من الإنسان الفلسطيني أو اللبناني أو الأردني أو السوري في سلم الإنسانية؟ هل الديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية وفي آسيا أقل دموية من الاحتلال الاسرائيلي؟ هل ما كان ما يقع في جنوب إفريقيا أقل تنكيلا مما يقع في غزة؟ هل ما يتعرض له شعب الروهينغا، وهم مسلمون، من حرمان من أبسط الحقوق المدنية والإنسانية وتعرضهم للقتل والتهجير والاقتلاع والعبودية، أقل تدميرا مما تعرض له السوريون والعراقيون على أيدي داعش؟
أليس الاهتمام بالشرق الأوسط والتماهي مع مشكلاته وتناقضاته ضرب من الاستيلاب المدروس الذي تصنعه الآلة الإعلامية الطاحنة لقنوات دول الخليج؟ ألا يشترك القومجيون واليساريون والأصوليون والليبراليون والمخزنيون والعلمانيون والسلفيون، على نحو مدهش، في هذا الاستيلاب؟
أسئلة تستحق أكثر من وقفة مع الذات، وأيضا مع ما يجعل المغرب في القلب والعقل معا، ولا يدين بالتبعية لأي تكتل آخر، إلا على أساس التعاون من أجل المصالح المشتركة؛ فالوحل ليس قدرا، والإقامة في مشاكل الآخر، كيفما كان هذا الآخر، لن تزيد الوضع إلا تعقيدا..
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"