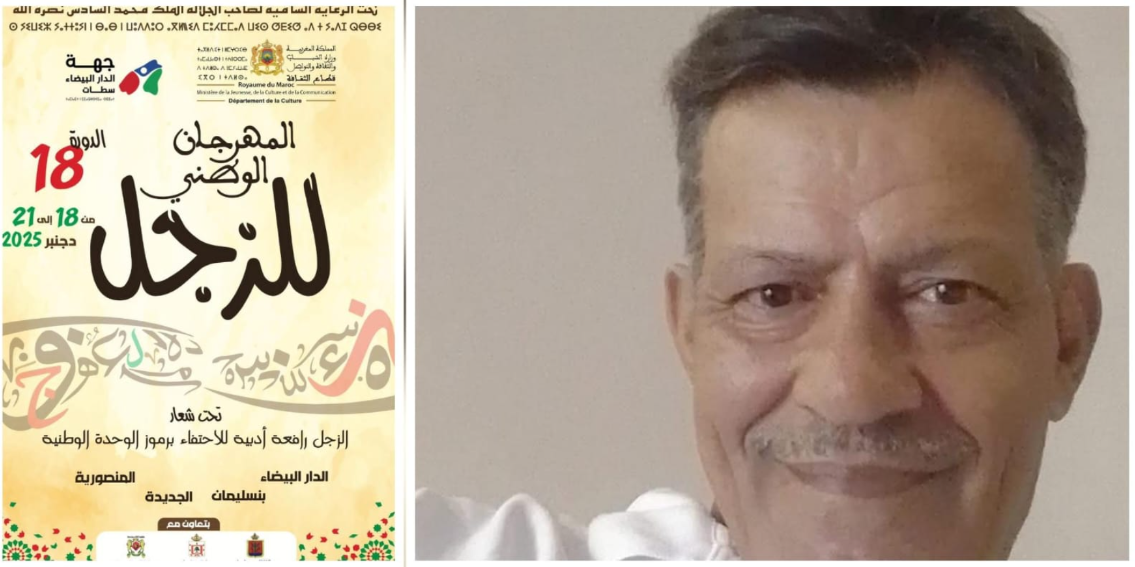كنت أسكن بحي البرنوصي بالبيضاء، حيث المجال كان مؤثثا بمنازل cifm والباطيما لعوجا وديور الملكية وبلوك السلاوي فقط وملايير الأطنان من الأتربة تحيط بالحي من كل جانب. الطريق الوحيدة التي كانت معبدة هي طريق الرباط وبضع أزقة بئيسة بالحي. لم تكن آنذاك لا دار الشباب ولا ساحات ولا نوادي ولا جمعيات تؤطر الأطفال والمراهقين في خرجات ترفيهية او رحلات لمخيمات. اللهم البحر الذي كان ملاذنا (شواطئ: النحلة ولبلايا وبيكيني وزناتة الكبرى،وهي الشواطئ المفضلة لدى أبناء جيلي بحكم أنها الأقرب الينا والتي كنا نرتادها مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا).
ذات يوم من شهر ماي- وعمري لم يكن يتعدى 13 سنة- قال لي والدي - رحمة الله عليه- : غدا جي عندي لكوبانية (أي الشركة التي كان يعمل بها)، غادي نسيفطك لعروبية عند جدك وعمتك. البحر راه واعر اولدي، وكل يوم كنخاف مني كتمشي ليه."
أجبت والدي: "ولكن راني ماكنعرفش فين جات لكوبانية؟
رد علي: ساهلة: "غانخلي فلوس الطوبيس عند أمك وشد نمرة 32 ونزل في بلاكة قرب الحبس ديال درب مولاي الشريف راه الشيفور يوريك. ومن هناك شد نمر 12 ونزل في ساحة كونكوس حدا القصر ديال الملك. وراه الشيفور عاود ثاني غاي يوريك.وسول أي واحد على وزين "شنوف" وجي عند العساس يدخلك عندي".
لم تكن عندنا حقائب او حتى قفة إضافية لأضع فيها ملابسي، فتكلفت والدتي(أطال الله في عمرها) بحزم "صرة"(وهي عبارة عن فولار جمعت فيه بضع سراويل وقمصان وفوطة صغيرة)، وسلمتني 5 دراهم لأسدد ثمن الطوبيس(الحافلة 32 و12).
مازلت أتذكر سحنة وجه سائق الحافلة 32 التي أقلتني ذاك اليوم من البرنوصي الى درب مولاي الشريف.لقد نفذت وصية المرحوم والدي حرفيا. إذ ما أن صعدت وسددت التذكرة قصدت السائق مباشرة لأطلب منه إرشادي حالما نصل لدرب مولاي الشريف لأنزل وأستقل حافلة أخرى. كان ذاك السائق رؤوفا وخدوما. كنت في كل مقطع أسأله: "أش من بلاصة هذي أبالحاج؟" كان لا يكتفي بإعطاء الاسم فقط، ولكن كان يشرح لي دلالته او السياق الخاص بكل مكان اجتازه الطوبيس:" لابيطا. حديقة الحيوانات. زرابة الخ...".
لما اقتربت بنا الحافلة من درب مولاي الشريف، شجعني ذاك السائق بأن أكمل المشوار نحو المعمل الذي كان يشتغل فيه والدي مشيا على الأقدام بدل أن استقل الحافلة رقم 12، خاصة بعد أن أقنعني بأن الوقت في صالحي بحكم أني ذهبت صباحا والمسافة لن تطلب سوى ساعة او ساعة ونصف مشيا على الأقدام.
أغرتني النصيحة والمحاولة خاصة وأني سأوفر ثمن التذكرة ل"دواير الزمان!"، فضلا عن كوني يافع ومدرب أصلا على المشي لمسافات طويلة جدا.
لم يكن يدرك والدي رحمة الله عليه أن خوفه علي من أن أغرق في البحر ، ولم يكن يدرك سائق الطوبيس(نمرة 32) وهو ينصحني بأن أكمل المشوار مشيا على الأقدام من درب مولاي الشريف الى "وزين شنوف" قرب القصر الملكي بالحبوس بأن تلك كانت بداية عشق جنوني مع مدينة الدار البيضاء. فالمقطع الذي قطعته مشيا على الأقدام وأنا صغير -أسأل هذا وألتمس من ذاك إرشادي للطريق- كان بمثابة "فاتح للشهية"، جعلني أقرر العزم على خوض التجربة بمفردي وفي أحياء أخرى، بعد عودتي من "التحريرة" في "لعروبية" في مطلع أكتوبر.
صادفت عودتي من "العروبية" بعد انتهاء العطلة، حلول رمضان. وكان هاجسنا (أنا وأبناء الدرب) بحي البرنوصي هو "كيفاش نجيبو لمغرب"(أي كيف سنقضي الوقت من انتهاء الدرس بالكوليج الى حين آذان المغرب). حكيت لهم مغامرتي من درب مولاي الشريف الى طريق مديونة(وكانت فعلا مغامرة شيقة وغنية)، واقترحت عليهم أن نكررها. وافق العديد من ابناء الدرب في ان يخوضو التجربة.لكن عدلنا الفكرة، وذلك عبر التنقل كل يوم نحو وجهة ما، لاكتشاف حي واحد في كل يوم.
وهكذا سطرنا جدولا زمنيا يقضي بأن نذهب في اليوم الفلاني نحو سيدي مومن، وفي اليوم الثاني نحو الحي المحمدي، وفي اليوم الثالث نحو العنق، وفي اليوم الرابع نحو ساحة السراغنة، وفي اليوم الموالي نحو كاريان بنمسيك وهكذا ذواليك.
أذكر أن مغامراتنا تلك لم تكن تنتهي ونحن في منازلنا بحلول آذان المغرب. فكثيرا ماكانت المسافة طويلة كان يصعب علينا قطعها ذهابا وإيابا في ظرف زمني قصير بشكل كنا نضطر إلى طلب الإفطار "على باب الله" قرب قيسارية أو لدى محسنين كانوا ينصبون خياما عشوائية لإفطار العابرين.
لم يحدث أن تناولنا في غالب الأحيان، فطور رمضان بمنازلنا. فلذة اكتشاف الدارالبيضاء وتنوع أحيائها كان يحفزنا على المضي في المغامرة لأبعد حد، وهي المغامرة التي مازلت أتلذذ بها مشيا على الأقدام إلى اليوم، وأترحم على روح والدي الذي قاده الخوف من أغرق في البحر إلى أن أغرق في حب الدارالبيضاء.
رحم الله والدي، ورحم الله سائق تلك الحافلة، ورحم الله كل من أنار لي دروب المعرفة الحضرية العالمة.